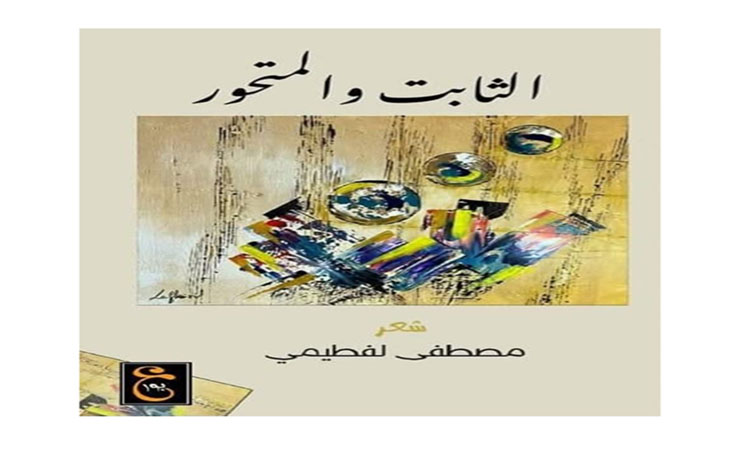يقول تقي الدين الحموي «وتوخَّ حسن النسق عند التهذيب، ليكون كلامك بعضه آخذاً بأعناق بعض»
هو ما نبحث عنه في كل تجربة شعرية من حيث شعريتها، ، وبعد الخيال عبر التخييل.. هذا التمفصل يجعل من التجربة تعيش ذاتها بمفهوم النحن.. دون إغفال المتلقي، والمتلقي القارئ بين الذوق والاهتمام النقدي، وبين هذا الأخير وتجليات القراءة عبر الاتجاهات والمدارس الأدبية، والدراسات اللسنية بمختلف جنسياتها، مادام هذا الشكل قائم بين الشاعر والقارئ.. فوقعه على هذا الأخير كما يرى بول فاليري في المعنى الشعري حين تنتعش الكلمات من خلال ألوان التفاعل اللفظي الداخلي.
هذا المدخل في اعتقادنا يفتح أفق ملامسة ديوان «الثابت والمتحور» للشاعر مصطفى لفطيمي، من حيث إشباع الهوية والكينونة الذاتية، التي تفرض خصوصياتها التخييلية على الذات الشاعرة ككيان ضمن فضاءات، وعوالم خارجية/ الواقع في أنطولوجيته الشعرية.. تستقي منه مفاتيحها الداخلية لنسيج جدلية الأنا والأنا النحن، وكيفية ترجمته تخييليا.. لذلك نذهب مع ألفريد أدلر أن « الذات نظام داخلي وخارجي، ذو صفة شخصية تعطي للشخص الذي يكتنفها طابعا حياتيا مميزا».
ما يلفت الانتباه هو هذا التناص مع «الثابت والمتحول» لأدونيس.. ولا شك في أن الرؤية الشعرية للفطيمي تجبّ معها أثر الدراسة إلى الإبداع، فأثره الفعلي على قصائد الديوان ليس تلقائيا، بل محطة استراحة لشاعرية الشاعر، حين أرادت أن تكون هذه الثنائية لها مفعولها الشعري، منفلتة عن التأريخ بمفومهه الأدبي أو النقدي، هي «..عملية إرادية، وموجهة تماما من قبل الشاعر، الذي يشعر بما يريد أن يبدعه». حسب إدغار ألان بو
هذه الجدلية قائمة في حياتنا، نستقي جذورها من المفارقة، أو التضاد على مستوى التركيب التناسقي لمكونات العنوان المفهومية.. فالمتأمل في هذا النسق، يدرك ثبات الأصل رغم بعض التغييرات. أي كيف يمكننا تمثل أصول، أو ثوابت قائمة الجذور، ولو تتخذ من نفسها صورا تساير الزمن في صيرورته.. وهذا اللحاق للزمن بالمتخيل يفرض علينا ملاحقته في قصائد الديوان في بعدها الإنساني. فرغم هيمنة الأنا، لا يعبر الشاعر عن قضايا شخصية محضة، بل عن وجود الذات الواعية بالوجود الخارجي، تعبيرا عن معاناة تتمظهر صورها في طبيعة المقول.. إذن فالأنا هي التأمل في الذات والكون:
لا قلب لي
وفي جوف الأرض طفل
لا قلب لي، وعلى الهواء، صراخ امرأة تمسح كحلها
وتبكي
لا قلب لي وفي جوف الأرض رائحة الموت
وصخرة تسد الطريق
هذه الأنا، فرضت ذاتها غرائبيا في الديوان بسرياليتها نحو تأسيس موقع لرؤية شعرية تغطي في امتدادها لوحاته، وما تقبض عليه هذه الأنا الشاعرة من قصائد متباعدة في الزمن، عميقة النبض التخييلي، ليس لها ترتيب كرونولوجي نقيس به استمرارية شعرية لفطيمي في تصاعدها، أو العكس:
ويحها اللغة
حين أكتب للعاشقة
لا أترك مسافة، فقط أحمل مظلة وأمسك بخيط الصاعقة
إن الإيمان بالفعل الشعري، أو الإحساس الذي ينشأ مع الإبداع لا نفحص اختماره، بقدر ما نلين إلى خباياه، كي نعمل على تعرية وقائعه من حيث استجابة الذات المادية للذات الشعرية في أفق محاورة الآخر/ النحن لإقناعه بذاتها الجماعية. تصورٌ بين اليقظة واللاوعي، يحكم صيرورة الشاعر الشعرية ويرمي إلى إثبات تجربته الإبداعية:
من منا يجر الشمس ــ قليلا ــ جهة البحر
من منا يجر الظلال البعيدة إلى الحقول
ويجمع كل الحجر في سلة القصب
حين تهيمن الأنا الشعرية في القصائد باستغرابيتها، يبدو معها متخيل لفطيمي الشعري ذا طبيعة نفهم منها الواقع، الذي يلوح في الأفق بالغياب والتلاشي، حتى يجد مصب تدفقه الشعري:
هذه صورتي
المدقوقة على جدار قديم
كل ما فيها ظلال محروقة
ومدهونة بزيت مغشوش
هذا الانفلات من الذات رغم سيطرتها ضمائريا بمنحى عن كل الاعتبارات التي تقف حاجزا ضميريا.. هو ما يبعث إطلاقيتها في وجه تناقضات الواقع، وما تلفه من ضبابية وعتمة نحو أفق مسدود بحثا عن مخارج تفي بحاجاتنا بشكل من الأشكال. فليس تشاؤما منه هذا السقف، بل ترميزا لتفاوتاته وسريانها المتباين. فالشاعر يريد التحرر من الالتزام الجمعي باستعمال ضمير الأنا، كما هو الشأن بالنسبة لإيغوركون Igor Semyonovich Kon في كيف تلخص الأنا الشعرية شاعريتها كي تلتفت إلى التجربة أولا، ثم كيف يمكنها أن تتضمن، أو تحاور الآخر تيماتيا فتقتلع منه ترسيخ ذاتها الشعرية، أو تقتلع منها بعض أوراقها التخييلية حتى لا تسمو إلى المجرد المطلق وتتيه فيه:
هل أخطأت
حين عدت إلى البحر….
أسأل عن سفينة محملة بالنعوش
حين عدت إلى اليابسة
أسأل عن مدينة نائمة في العسل
ومن حولها الأسلاك.. والنقوش
ليس من عجب أن يؤسس الشاعر رؤية للحياة، ما بين رغبة وجودها وحركيتها من الولادة بصيغة ما، ومن مخاطر وعي شقي ندرك معه صعوبة مواجهة الحياة.. هذه المحنة التي تواجه الذات الشاعرة/ الذات الإنسان لا بد لها من التنقيب المستمر عن وسائل وإمكانيات المقاومة. فالإحساس بالكيان وكيفية إثباته ضرورة ملحة:
في الصورة المدقوقة بمسمار
لا تظهر وسامتي.
فقط شامتي،
وآثار ندوب على الجبين
… وحين انتبهت
أخذت ريشة وكتبت:
هناك، ثمة حياة
فالشاعر لا يقف عند محنة الذات لأجل ذاتها. بل كيف ترسم عالما يجيش بالحزن بكل تقلباته، التي تحد طموحاتها نحو عوالم تستجيب للرغبة والأمل المفقودين اضطراريا منه، وكأن هذه الأنا الشعرية كما في نظر عز الدين إسماعيل.. «..التي تتكلم في القصيدة.. أنا أخرى تختلف في قليل أو كثير عن أنا الشاعر».. إذ نلاحظ هذا الاسترسال لحالة الحزن والخسران تحريضا عما هي السبل التي تحسم هذا الصراع. أو غلبته بمفهوم ابن خلدون كقوة ضاربة تفرض التعبير عنها:
أنا وهزائمي
وفي وقت واحد خرجت الظلال مائلة من خيمة الشعراء
من سواي؟
يخسر حروبه الصغيرة، فيخرج من الخيمة مائلا بعينين
زائغتين، وبفكرة عن الحب، وأخرى عن النهر.
هذه الحال للأنا في تغذية مشاعرها، تكمن في استثمار أي عنصر يفي حاجتها الوظيفية كالمرأة مثلا ومكونات المحيط اللتين تستأثران بالاهتمام لمفعولهما وجدانيا، حتى يتم التماهي لخلق عالم تتجاذبه كل مفصليات هذه الأنا المثخنة بالأنين والحنين، بمعنى أن الأنثى ممر حكائي لكل هذه المتلاشيات، فتتناثر أنّى شاءت من شعرية الشاعر. وهذا ما يميز الشعر من خلال المعنى أيضا في نظر بول فاليري :
ها أنا أحمل المدينة على رأسي
وأمشي مسافة بساقين من خشب
أنا وأنت، سنغمض عينينا،
وننفخ في القصب
وفي نشارة الخشب
إن الإبحار في اللغة الشعرية يستهدف عادة التخييل الشاعري، وحيوية المعجم اللغوي تستمد شعريتها من السياق، وليس وضعية المعجم اللغوي من حيث الدلالة فمالارميه يعتبر أن كلمات الشعر حية « يشعل بعضها البعض».
إن الشاعر يدرك هذا التداول في اختراقه أغلب قصائد الديوان، وبالتالي يكرس اختيار «أيقونات» تميز المعجم المتحكم في بُناها لغويا، وكجسد يستعصي معه نسق شعرية المتخيل بمفهوم كيليطو، أي توظيف معظمه في كل نص حسب متطلباته (الفراشات، ريش القبرات المقاهي الشوارع الأشجار الزجاج النفخ الحجر الورق شفتيك البحر الشعراء) هو ممر رؤية الشاعر إحاطةً بالثوابت والمتحولات، مادامت الذات الشاعرة بمفهومها المزدوج (الانفرادي والجماعي) تسعى إلى اقتحام قصائد الديوان من حيث الإمساك بضحاياها المعجمية في أفق ما تستلزمه هذه الرؤية منها، ومن الكون حولها..
فالشاعر يسعى جاهدا أن تكون اللغة نفسها التي هي المتخيل في التفكير.. كي تؤدي وظائفها بكل عشق متأصل فيه للكتابة، فالحساسية الجمالية عند إدغار موران «.. هي قدرة على التجاوب مع الصدى.. مع النظام الخاص للأصوات …». هاجس يرافق مخياله، حتى يستوطن ديوانه امتداداً للذات الهاربة منا، لا تعترف بكينونتها إلا إقرارا بالتجربة، وإبرازها بتعبير متناغم، وهدوء يعم مساحة شخصه الفعلي..
إذن هناك مرجعية معجمية ، تعاود إنتاج ذاتها حسب بنى كل نص على حدة. تصبح الخيط الناظم بين قصائد الديوان ككل.. وهذا التميز يليق بالشاعر، وباختياراته المتشعبة ضمن قصيدة النثر.. فأسلوب لفطيمي هذا نقاربه بما يقوله بارث باعتبار» الأسلوب معطى فيزيقي ملتصق بذاتية الكاتب.. إنه سجنه وعزلته، العنصر الذي لا يحده العقل، ولا الاختيار الواعي». ومنه تتعدد البنى النسقية التي تسمو بالظواهر اللغوية إلى ما هو شاعري «يقتفي في نظمها آثار المعاني وترتبها على حساب ترتيب المعاني في النفس» كما يقر ذلك الجرجاني.. فجميع المتحورات التي أتت بالقصائد، أو لنقل الخط الزمني الذي يشد وثاق هذه القصائد دلاليا، يطغى عليه الزمن الحاضر (يجد تخرج..أجرى أرى أحمل يعصف..) ليس فقط في بناء الأنساق الداخلية للجمل، وإنما يتردد الفعل بنفس الصيغة أحيانا مما يثير ظاهرة التكرار وأهميتها الدلالية (أدفعها/ أدفع، أنفخ/ أنفخ، أحمل/ أحمله، أقف/ أقف، أرى/ أرى، يمر/ يمر…) وكأن الشاعر يعيد ترتيب هذا الثابت بطريقة تتجاوز ما يمكن تجاوزه، واستحضار المطلوب في شكله الحالي كي ينبئ بواقع الكتابة لديه.. الواقع الذي يكسر فيه الثوابت، وتكون الأنا الشعرية جسراً نحو الآفاق المقصودة باعتبارها كليشيهات تخييلية تعكس ما هو ثقافي واجتماعي ونفسي.. ولا يعقل ألا تلتئم أنا القصيدة كعنصر بؤريٍّ في صور انزياحية لجمل، أو مقاطع شعرية حسب خصوصيات كل منها (أقضم، أضعها، بيدي، أن كنت، أأكذب، أزعم، أمشي…) بين الذات الشاعرة والذات الكينونة حتى نقبض على نبض كينونتها، ومحاولة إشباع أفكارها/ رؤاها الشعرية بين التفكير والوجدان كأساس لبناء شعري يمكن أن يترجم المرغوب من الواقع الخارجي بالبحث في الدوافع والبواعث كما فعل فرويد في تحليله لروايات دوستويوفسكي ولوحات دافنشي.. أي كل ما يتعلق بهذه الأنا/ النحن من منظور فلسفي، إلى التحكم في كل أشكال الوعي الصادرة عن هذه الأنا/ أقصد الشاعرية بانتمائها الوجودي في أبعاده القيمية نحو تكريس نوع من الشعرية، التي تلتفت إلى هذا الخصاص أملا في الخلاص منه، بمعنى أن الانزياح في الديوان ليس فوضويا، وإنما ينبعث من لغة تهدم المألوف (حين تركت وجهي، كيف تسكن في غيمة من ورق، أحمل المدينة على رأسي، هذه اللغة كم نتفنا ريشها، عيناي من عقيق وحجر، القصائد حدائقنا المضيئة…) إلى متخيل شاعري يحتاج تأويله كيفيةً تتمكن من شفراته، كما يذهب إلى ذلك بارث: النص «بناء ذو طبقات أو مستويات وأنساق.. ونزع الغشاء يكشف عن آخر»
إن تجربة لفطيمي تدخل في نقاش لا متناه مع الذات الشاعرة، فالأنا الشعرية تخدم رغباتها ومصالحها حين تصبح هالة يتمحور حولها النص، ثم توزَّع خارجه بكيفية تستجلب مادتها من الهوية التخييلية التي يحاكيها باللغة، في شكل تقاطعات تأتلف وتختلف حسب المادة/ الموضوع أو الرؤية…
إذن فالشعر نلجأ إليه كلما أردنا اختراق الفضاءات التي تتحدانا في الواقع.. لذلك فقصائد الديوان رغم شاعريتها، تحاول تفجير مكامن الذات لتنقيتها نسبيا.. وملاذٌ لآفاق مفتوحة نتوقعها، ونلامس منها الاحتمالات التي نتغياها مصوغات لطموحاتنا، وما نحلم استهداف غاياته ومراميه…