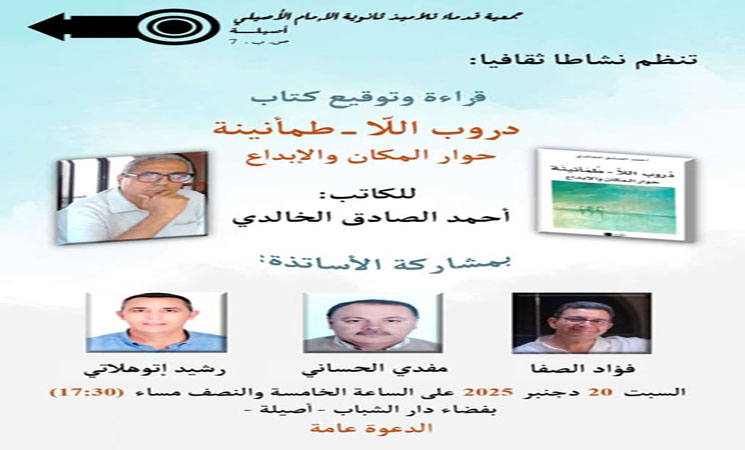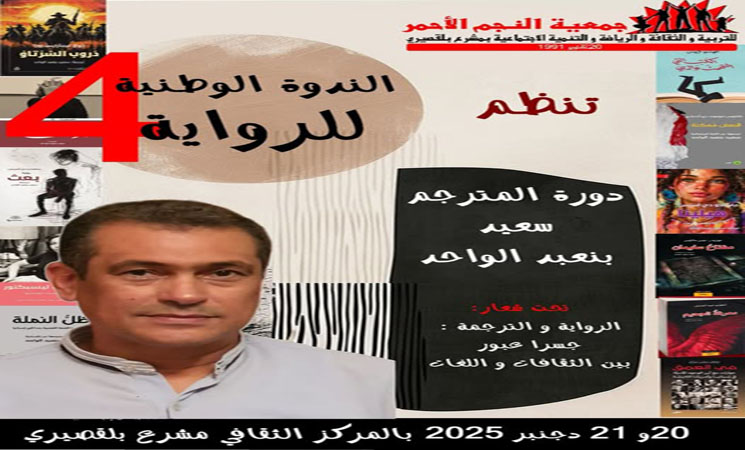راكم الكاتب أنيس الرافعي تجربته القصصية في مستويين رئيسين، وهما: التزامه التام بكتابة القصة القصيرة دون غيرها من الأجناس الأدبية الأخرى؛ وثانيها التجديد الذي يكتنف كل نص وكل مجموعة قصصية، أي أنه يتجدد ويجدد عالمه القصصي حسب المقامات التي يدخلها، فقد أضحى هذا الاسم علامة في التجريب القصصي عندنا في المغرب، والعالم العربي كذلك.
بهذا المعنى، نستطيع القول إن أنيس الرافعي احتفالي تجريبي بامتياز؛ حتى وإن كان هذا التوصيف غير دقيق وقابل للمساءلة والنقاش، حيث من الصعب وضع الأدراج لدس هاته التجربة القصصية وغيرها.. وهي بالجملة تريح القارئ، وتضعه قاب قوسين أو أدنى في وضعية مطمئنة. هذه الطمأنة هي التي تسكت السؤال مثلما تزيل القلق من هذا القارئ أو ذاك الذي يدخل كاتبا أو آخر عبر تصنيفه لقتله في آخر سطر من قراءته. لا نريد قتل الكاتب ولا نصوصه بقدر ما نتغيا مشاكسته بقليل من التأمل في هذه النصوص المطروحة أمامنا؛ وهي نصوص تعبث بقارئها وكاتبها معا، فهي من جهة تتواطأ مع قراء فضوليين يعشقون وضع الكاتب في درج من أدراج مكتبته ويحكمون إغلاقه حتى يختنق في دواخلهم، ومن جهة أخرى ينفلت الكاتب من هذا وذاك ويتحرر من أي درج يتم الاعتقال فيه، مثلما يسخر من هذه الأدراج النقدية والقرائية، ويسخر من نظامها العام والتضاعيف التي تتركها.. أنيس الرافعي يمارس هذا المكر على ذاته وعلى قرائه أيضا، لأنه – ببساطة – يضع كل ما هو مرتبط بالمنتوج السردي، والذي نسميه عادة بالقصة القصيرة موضع سؤال، حيث يتم هذا الذي نكتبه سؤالا ومعناه أنه يفقد الثقة في المؤسسات الأدبية التي أنتجته، وهو كذلك يخلخل نظامها العام. هذا المنتوج الذي يوضع سؤالا يرتبط ضمنيا بحواشيه المتضمنة فيه من الكتابة وطقسها والكاتب ومكان الكتابة، ورؤية الكاتب…
هذه الحواشي اللامفكر فيها عادة عند كتابنا،لا يدخلها أنيس الرافعي إلى فضائه إلا بداعي لا ليقول فيها قولا فصلا؛ بل ليشارك القراء في بناء استراتيجية كتابية يتفرد بها صاحبها..
نحن إذن أمام قراءة المجموعة القصصية لأنيس الرافعي والموسومة بـ››الحيوان الدائري». عنوان يدفع قارئه إلى الدهشة والاندهاش من كاتبه. هذا الأخير الذي يعطي مساحة زمنية للتفكير في العنوان، وكأن العنوان هو العتبة الرئيسة للكتاب ككل؛ حتى وإن كان يتضمن اعتباطيته كما فعل التسمية تماما.. لكن غرابة العنوان هي ما تضيف لهذا الكاتب تفرده المائز، ربما يمكن العودة- بنظرة برقية– إلى عناوين المجاميع القصصية السابقة سنجد أن صاحبها يولد المعنى منها، ويعطي للعنوان أفقه الاستراتيجي في الرؤية الإبداعية والكتابية. العنوان، إذن، حسب مؤلفه يشكل استراتيجية في الكتابة. لذلك يظل الكاتب في هذه النصوص التي نقرأها تؤسس عوالمها على كاتب مثقف قلق متمرد، محتج ضد كل شيء قائم من القلم إلى الورقة وما بينهما.
يشكل المكر والخدعة استراتيجيتين في الكتابة عند أنيس الرافعي، فهو لا يعبث بالكتابة من حيث أصولها وفروعها ولا حتى في قيمتها والامتحان الذي تخضع له عند أولي الأمر، ولا حتى الدفع بقارئه نحو النهر دون أن يطفئ عطشه بقدر ما تندفع نصوصه نحو ذاك الخيط الذي لا تكون فيه هناك، ولا هنا.. فالكتابة عنده نص رائق وجميل. «عقبان أمام جثة» يعبث بقارئه وكاتبه معا، حيث كل شيء ممكن في كتابة القصة، وكل تمرد على نظامها والسلطات الثاوية خلفها سبيل لإدخالك حساب الطول والعرض في جسدك وروحك معا في لحظة تتقيد فيها الكتابة.
يجرك السارد بمفعول أغنية جولييت غريكو «الأوراق الميتة» لتكون بداية القصة ونهايتها. هكذا، تبدو خدعة الكاتب عند صاحبنا مزدوجة في الأول وبكثير من المكر، يضع قارئه أمام مجموعة من الأسماء الدالة في زمننا الثقافي كخرق للطبيعة والثقافة معا، وهو بذاك يعيد للكائن الطبيعي مقامه خارج فعل الكتابة؛ لكن من الجهة الأخرى يتقدم الكاتب مقدما نفسه لجمهور قرائه لا من حيث طقس الكتابة ولا المرجع الذي يحضنها. ففي الأول يختار الكاتب باعتباره علامة بارزة الانخراط في زمن العولمة عبر الكتابة على هاتفه النقال بأصبع واحد، وهو ما يشير إليه بذكاء شديد بين السيارة المخترقة الأوطوروت والموسيقى المنبعثة من السيارة والهاتف النقال.. نحن إذن في عالم سريع، ولا أحد يستطيع النظر إلى السلحفاة، ولا إلى أزقة مدننا القديمة؛ فالطريق أضحت سيارة والكتابة أمست كذلك.
لم يعد للكاتب لمس قلمه ولا حتى النظر في بياض الورق الذي يعيده للكفن، إنه أمام شاشة باردة برودة أصبعه، ولأنها كذلك فهو يسخر من الحبكة وتضاعيفها، الكاتب مهتم بجنون السيرك والألاعيب المقدمة على ركحه، مثلما هو مشدود إلى بعض الكتاب دون غيرهم (هذا ما تعلنه افتتاحية هذه المجموعة القصصية). لا عجب، إذن، أن يجمع الكاتب ذاته وكتابا آخرين من الغرب والشرق وكائنات خرافية، وحيوانات وتواريخ، وأمكنة…
في خلاطة، تحاول القصة القصيرة إضافة توابل مراكشية تليق بذواقين مهرة، كما أن هذه الخلاطة تلد لك نصا باهرا يحاول تسميته كي يعطي لذاك الخليط العجيب غرابته… لا تتوق القصة في نهايتها كما لا تبدأ بعنوان جديد بقدر ما هي لعبة لولبية يكون فيها المشي أو المسير إيقاعها الخاص وتكون المغنية مرجعا رئيسا حين ينتبه الكاتب في شاشة هاتفه النقال، وكأن المغنية هي التي تعيده إلى صوابه، لا يعني الصواب هنا نقيضا للخطأ بقدر ما يحيل على توازن اللاتوازن. التوازن يعيده كتاب آخرون في ضيافتهم الباذخة أحيانا والشحيحة في أحيان أخرى. هذه الدعوة (ص 23، 25،32…) التي تربك النص، مثلما تأزم المرجع والدلالة، إنه يدفع بالمرجع إلى أبعد نقطة، ويقوم بتفجيره عنوة.
يحلو للكاتب اللعب بالكائنات المحيطة به وبذاته وقرائه كذلك، يقوم بذلك بمهارة فائقة، وأكثر من ذلك فهو ينبه قراءه إلى أنه يلاعبهم بالخطوط والخيوط والتخطيط في رقعة محترقة بسواد الحكاية. تبدأ القصة الأولى ولا تنتهي في بعض السطور من القصة السادسة التي تعلن المحو، محتفية به كما لو كان الكاتب يعلن القصة ويقوم بمحوها في السطر الأخير، لا يتعلق الأمر هنا بفعل بطارية ولا حتى بحرارة مفترضة بقدر ما يكون المحو استراتيجية في الكتابة.
هاهنا، يتعدد منطق الحكاية، وفي توالدها تستعيد منطقها في حوار ماكر مع كتاب آخرين وكأن هؤلاء هم الجمرة التي تجعل وجوده حاضرا في زمن أضحى فيه الوجه قناعا، والتحول مسخا والحضور غيابا والكتابة محوا. ثمة فقرات باعثة على ذلك واستدعاؤها هنا لا يقدم القصة ولا يختمها؛ ولكن المدهش هو التشبيه الذي يقيمه الكاتب في أكثر من مرة تشبيه محمول على الطبيعة، وكأن الكاتب يقلب المعادلة الأنثروبولوجية من الطبيعة إلى الثقافة عبر عكسها وإيقاع قارئها في حساب أصابع يده، يقول في الصفحة 30: «تخيلت في لحظة أني رجعت إلى شقتي مسرعا مثل فهد مرقط في محرك سيارة، ثم رغبت أن أكرر على لوحة الحاسوب مشاهدة جميع الأفلام الرائعة التي رأيتها خلال العقود الثلاثة الأخيرة؛ غير أني وجدت لوهلة أولى كل الأقراص المضغوطة ممحوة من البيانات الرقمية المسجلة عليها».
مثل هذا النموذج مساحة مثلى للتفكير في الإيقاعات النصية للكاتب مثلما يضمر المنحى التجريبي والذي يعتلي صهوته كاتب يتقن عمله، ويبرع فيه. في الإحالة التي طرحها في هامش ص37، وهي توضيح ما يخفيه الكاتب وكأنه يعلق بيانا مهما، كطريق لخلخلة قرائه وإدماجهم في العالم الجديد الذي يخلق الفوضى على الأشياء ويدمر نظامها بكثير من النقد.
تستفزك تشبيهات أنيس الرافعي بالحيوانات «كلب مريض» وكلب سمين أو دود أو فراشة وما إلى ذلك من الحيوانات التي يعيدها الكاتب بكثير من السخرية والمودة، وهي تشبيهات تحيلنا كذلك على هذا القلب الموجود بين الثقافة والطبيعة.
في حادثة غريبة من زمن الشعر العربي القديم، في مديح شاعر ما للخليفة شبهه بالكلب وكاد حاجبه أن يقتل الشاعر؛ غير أن الخليفة نبهه إلى وضعيته، أمر حاجبه بوضع الشاعر في جناح أمير في الخضرة والماء والوجه الحسن.. وبعد أيام جاء الشاعر ليقول كلاما يليق بالملك ووضعه الجديد.
أنيس الرافعي في كتابته هاته يقلب المعادلة عبر خلق قلق للقارئ، لا نريد الإحالة على كافكا ولا حتى على كتاب آخرين، بقدر ما نريد وضع الكاتب داخل نصه يسخر من التسلط الثاوي خلف خطاب المنع والحجر الصحي، ومن اللغة والكتابة القصصية بالتفاصيل التي تعودنا عليها ويسخر كذلك من التصنيف الذي هيأه الناقد لهاته الكتابة أو تلك في نص لافت «من قطع يد أمين الخمليشي؟» والذي يكون فيه الأمين مجرد برواز يضع فيه الكاتب مشاهد مختلفة لليد في زمن الكوفيد، حيث يعيش السارد عازلا و منعزلا، لا أحد يحك ظهره.. لذا، وجد في هذه اليد البلاستيكية صينية الصنع وسيلة لذلك؛ إلا أن هذه اليد ستتحول بين لحظة وأخرى إلى يد مقطوعة، إلى يد شخصية كاتبة، ثم إلى يد تلعب بها القطة، ثم إلى يد حقيقية، وأخيرا يجد اليدين في الثلاجة.
هذا التحول يكبر في زمن الأزمة، زمن لا أحد يرغب في الآخر. زمن القيامة. كل امرئ يقول نفسي نفسي، والكل يخاف من الكل… من هنا، تتسع دائرة الكوابيس، ودائرة الحقائق التي تتكلم في الحلم ودائرة انهيار السرديات الكبرى، تكون فيها الكلمة كشعرة معاوية، والفضاء الأزرق مجالا لنسيان الكينونة، بهذا المعنى يدخلنا الكاتب عنوة إلى سلسلة من القصص، والتي تنتظم بخيط شفاف واحد وهو أزمة الكوفيد، باعتبارها الخوف من الموت، هذا الموت الذي يدفع التشبيه إلى الأعلى، وحيث يكون الحيوان الذي يشبهنا بعيدا من قلق الموت وقصيا من أية جائحة قد تصيبه. إنه محرر من هذه الصفات. لذا، فهو الأجدر أن تتشبه به.
لا غرابة، إذن، أن تكون المجموعة القصصية «الحيوان الدائري» تحتفي بتجريبيتها، وتصنع كتابة ضد كل شيء قائم، وعلى النظام السائد في الثقافة والطبيعة وعلى نظام المؤسسة والخطاب.. وبالجملة على كل شيء قائم، فالكاتب يقلب كل المعادلات التي تعودنا عليها في مدارسنا وجامعاتنا، قلب ساخر من هذه الرتابة، والتفاهة التي تحوطنا وتجعل منا أشباه الشبيه بينما الأصل في الطبيعة يحتفي به أنيس الرافعي.. قصص هاته المجموعة لا تشبه القصص التي قرأناها في الماضي والحاضر؛ إنها قصص تخترق كل التوصيفات التي ذكرها الفقيد الكاتب عبد الرحيم مؤدن.
لذا، يمكن وضعها في صيغة بين اللعب الإلكترونية التي يتحرش بها الكاتب كما لو كان طفلا، والأفلام السينمائية من السينما الكلاسيكية إلى سينما المؤلف، والموجات الجديدة في العالم وكذلك أفلام الخيال العلمي والأغاني، وموسيقا الشعوب، والأساطير القديمة وكتاب من أوروبا وأمريكا اللاتينية والمغرب…
كل ذلك يستحضره الكاتب بين الفينة والأخرى كما لو كان شخصا محوريا في القصة، هذه التوليفة تتشكل بسحرية ودائرية، قصص تبهر قارئها وتخدعه بشكل لافت كما لو كان أنيس الرافعي يكتب فقرات/ مقاطع ويقدمها للقارئ كي يبحث عن الوصل والفصل بين هذه المقاطع، وهي لذلك تحتفي بسحر تجريبي.
أنيس الرافعي: احتفالي تجريبي في القصة القصيرة

الكاتب : حسن إغلان
بتاريخ : 17/10/2025