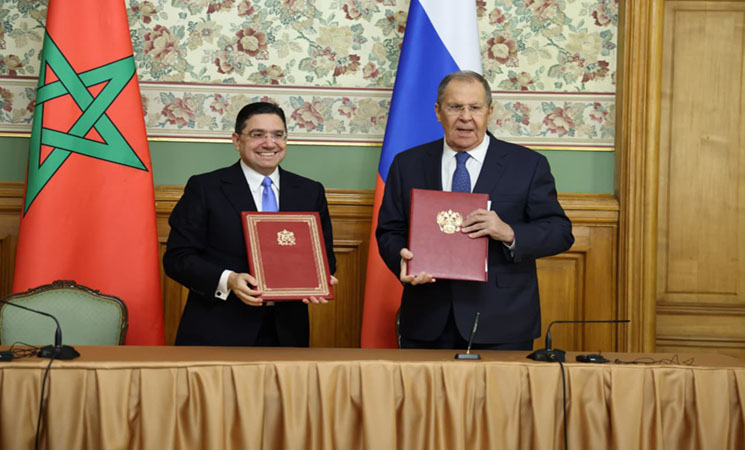ولد إدغار موران – واسمه الحقيقي هو إدغار ناهوم- يوم 8 يوليوز 1921 بالعاصمة الفرنسية باريس. حصل على درجة في التاريخ والجغرافيا، ودرجة في عام 1942، ونال دكتوراه فخرية من 14 جامعة عالمية. وقد عمل عالمَ اجتماع ومفكرا وباحثا في المركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا، كما كان يرأس الوكالة الأوروبية للثقافة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (يونسكو).
بدأ موران نشاطاته في إطار الحزب الشيوعي الفرنسي عام 1941 وتركه نهائيا عام 1951 وخلال الحرب الأهلية الإسبانية عام 1936 انضم إلى صفوف المقاومة الشيوعية السرية، واختار اسما مستعارا هو «موران» الذي احتفظ به طوال حياته.
انضم عام 1945 إلى الجيش الفرنسي في ألمانيا، وترأس في العام التالي مكتب الدعاية في الحكومة العسكرية الفرنسية عام 1946. وفي عام 1950، التحق الفيلسوف الفرنسي بالمركز الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية، وأصبح مديرا للأبحاث في المركز عام 1970.
كتب موران العديد من الكتب والمؤلفات التي تناولت قضايا فكرية مختلفة، وترجمت للعديد من اللغات، أول هذه الكتب نشر 1950 وحمل اسم «عام ألمانيا صفر»، و»النقد الذاتي» عام 1959 وتطرق فيه لقطيعته مع الشيوعية. وفي عام 1977 نشر الجزء الأول من مؤلفه «المنهج» الذي طرح فيه مفهوم فكره المركب، ثم في 1989 نشر كتاب «فيدال وعائلته»، ثم «التجوال» عام 2006، و»طريقتي» عام 2008. كما أصدر كتابا في مجال السينما بعنوان «السينما أو الإنسان المتخيل»، إلى جانب كتاب «الثقافة والبربرية الأوروبية»، و»أين يسير العالم» وغيرها من الكتب..
– ما الذي يعنيه الإنسان L’humain؟
– هذا السؤال الذي لا يُثير اهتمام البعض منّا وحسب بل جميعنا لم يُعالج قطّ في منظومتنا التربويّة، سواء أكان ذلك في الابتدائي أو الثانوي أو في التعليم الجامعي. هناك بكلّ تأكيد اختصاص نُطلق عليه الأنثروبولوجيا لكنّه محصور في المجتمعات القديمة «التي لم تعرف الكتابة».
غير أنّ كلمة «أنثروبولوجيا» المهمّة كانت تعني في القرن التاسع عشر المعرفة التي تضمّ العلوم المختلفة المتعلّقة بالإنسان ومن بينها العلوم البيولوجيّة والفيزيائيّة، في حين أنّ الإنسان اليوم، في شموليته وتنوّعه، أصبح في منظومتنا المعرفيّة والتعليميّة غامضا مُتجاهَلا ومنسياّ. صحيح أنّ كلمة ”الإنسان” / L’homme مهمّة في هذا السياق إلاّ أنّها غير كافيّة، ولكنّها ليست كافية لماذا؟ بداية لأنّها تُشير إلى الفرد وتَسْتبعد المجتمع، ثمّ لأنّ لها دلالة مُذَكَّرَة رغم أنّ الكلمة محايدة و تُخفي في ثناياها، بشكل من الأشكال، مضمونا مؤنّثا. لهذا أفضّل الاسْتناد على عبارة الإنسان L’humain بدلا من الإنسان L’homme.
الإنسان ثلاثي التعريف
إنّ التعريف الأوّل ثلاثيّ لأنّه لا يتضمّن الفرد فقط، بل المجتمع الإنساني والنوع البيولوجي أو بالأحرى العرق البشري. وإذْ أتطرّق إلى هذا الثالوث فلكي أشير إلى العلاقة المتينة التي تجمع بين هذه المواضيع الثلاثة، لأنّنا لا نستطيع القول أنّ الإنسان هو 33% فرد و33% مجتمع و33% بيولوجيا. ما يمكن قوله، أنّ الإنسان هو 100% فرد و100% اجتماعي و100% بيولوجي. لماذا؟ لأنّ المؤكّد، من وجهة النظر الاجتماعيّة، أنّ الانسان عنصر صغير من مجتمع ما، تتسرّب إلى عقله، خلال تنشئته، الثقافة والّلغة والأخلاق والأفكار فيتغذّى منذ ولادته من المجتمع وعن طريقه.
ليس من الغرابة في شيء أن يتضمّن الجزء الكلّ، إذا علمنا أن كلّ خليّة من جسمنا كجلدنا مثلا إنّما تحتوي على مُجمل الإرث الجيني الوراثي. وبطبيعة الحال يقتصر الأمر هنا على جزء تمّ التعبير عنه وتفعيله في الخليّة، لكنّ الكلّ بوصفه كذلك يحضر في هذا الجزء الصغير. وهو ما يمكن أن نطلق عليه مبدأ الصورة ثلاثيّة الأبعاد. ففي التصوير الفوتوغرافي نجد أنّ كلّ نقطة في الصورة تعكس نقطة أخرى من الشيء المعبّر عنه كالسيارة مثلا. في الصورة ثلاثية الأبعاد كلّ نقطة تحتوي عمليّا على مجمل الشيء، لا الجزء في الكلّ فقط بل الكلّ في الجزء، وهو الأمر الذي يستدعي القول أنّ الكلّ هو 100% فردي، وأنّ الانسان هو أيضا 100% اجتماعي .
والأمر نفسه يتعلّق بالكائن البيولوجي، لأن الفرد الإنساني هو لحظة، وجزء صغير ضمن نوع ونظام إنتاج متواصل. وهذا الجزء هو نتاج عمليّة شاملة تتضمّن بداخلها الكلّ: ففي الدماغ توجد مجمل الجينات التي تكون حاضرة في الجسم أيضا. والمبدأ نفسه نجده لا في القول أنّنا 100% أفراد، لكنّنا أيضا 100% عناصر من النوع البشري. ولا تتوقف، هنا، العلاقة بين الفردي والاجتماعي والبيولوجي.
إعادة إنتاج النوع
لنأخذ مثلا العلاقة التي تربط الفرد ونظام إنتاج النوع، فلكي يُحافظ هذا النظام على بقائه يتطلّب الأمر تزاوج فردين مختلفين جنسيّا لإنتاج نسل يواصل بدوره التطوّر. بمعنى آخر نحن نتاج عمليّة إعادة إنتاج النوع الإنساني، ولكنّنا في الوقت عينه المنتِجون، أي نحن المنْتَج والمنتِج في آن واحد. وهو الأمر الذي يستدعي إدخال فكرة أخرى: تتعلّق بوجود ”حلقة” سميتها ”متكرّرة”، والحلقة المتكرّرة هي المسار الذي تكون فيه المنتَجات ضروريّة لإنتاجها الخاصّ. وهذا الأمر يعني أنّ الأفراد البشريّة في النوع هي من الضرورة بمكان لإنتاج النوع نفسه، وهو التماثل ذاته الذي نعثر عليه في المجتمع: فالفرد هو مُنْتِج المجتمع الذي يُنتجه.
إنّ المجتمع هو حصيلة تفاعلات بين الأفراد لا حصر لها، لكنّه يتضمّن أيضا عددا من السمات الخاصّة به كالثقافة واللّغة وسلطة الدولة. وهذه المميزات تكتسب مشروعيّة وجودها انطلاقا ممّا سَمَيته ”نظاما” ويعني ما يلي: ليس الكلّ هو إضافة الأجزاء، بل تتشكّل على مستوى الكلّ مميّزات وصفات جديدة نُطلق عليها انبثاقات. فمثلا جزيء الماء له صفات خاصّة لا نجدها في ذرّات الهيدروجين والأكسيجين التي تشكّله. والكائن الحيّ، حتّى البكتيريّا، تشكّل من مجموع تفاعلات بين جزيئات فيزيو – كيميائيّة، لكن الكائن هذا يتمتّع بصفات لا توجد على مستوى الجزيئات الفيزيو-كيميائيّة، كالقدرة على الإنتاج الذاتي والترميم الذاتي والإدراك، إلخ.
يتمّ توطين اللغة والثقافة، وهما من خصائص المجتمع، في الأفراد وترسيخهما فيهم: فينضوي، عندئذ، الكلّ تحت الجزء، ومن دون توقّف يَنتج هذا الكلّ عن طريق التفاعلات بين الأفراد. فلو دمّرنا المجتمع بقنبلة نوويّة، ستسلم معالم مثل الإليزيه وقصر البوربون ومدرسة الدراسات العليا والسوربون، لكنّ البشر يختفون والنتيجة لا وجود للمجتمع. إنّنا بوصفنا أفرادا، من خلال تفاعلاتنا، منْ يُجدّد المجتمع ويُعيد تجديده، وهو الأمر الذي يعني، علاوة على ذلك، أنّ المجتمع يُنتج أفرادا إنسانيّين على وجه الدقّة، لأنّه يضطلع بمهام اكتمالهم عن طريق تمكينهم من اللّغة والثقافة. ليس في وسع المرء الفصل بين المفاهيم الثلاثة المتعلّقة بالفري والاجتماعي والبيولوجي، ولا امكانيّة أن يعمل الواحد منها من دون الآخر، فالشكل المبسّط لهذا الثالوث يُخفي في الواقع تفاعلات معقّدة، إلاّ أنّ هذا الإنسان الثلاثي يُغفله التعليم عندنا.
صورة الإنسان L’humain
يَعرض نظامنا التربوي فصلا مأساويّا بين هذه الأقطاب الثلاثة الأساسيّة للإنسان، فيتمّ تدريسه على نحو منفصل من منظور البيولوجيا ومن منطلق العلوم، ولعلّ خير مثال على ذلك طريقة التعاطي البيولوجي مع الدماغ وبشكل خاص في علم الأعصاب في حين يُسجَّل العقل في مجال علم النفس، فيتمّ الفصل بين العلوم الطبيعيّة والعلوم الإنسانيّة لتحليل العنصر ذاته المكوّن للإنسان. كذلك هي العلاقة، بين الفرد والمجتمع، منفصلة في العلوم الانسانيّة في كثير من الأحيان. إنّ الاتجاه السائد في السوسيولوجيا هو اعتبار الأفراد، محدّدين بدقّة، كدُمى، تقريبا، يعتمدون على سيرورات اجتماعيّة، على وضعيتهم في المجتمع، على طبقتهم وعلى عاداتهم، إلخ، فيميل الفرد إلى الذوبان في السوسيولوجيا، والمجتمع إلى الذوبان في البسيكولوجيا، باستثناء علم النفس الاجتماعي، وهو فرع من المعرفة هجين يجمع قدر المستطاع بين مجالين متباعدين. ويُعزى هذا التقارب، كما غيره من التقاربات، إلى أحداث بارزة تعود إلى القرن الماضي سمحتْ بإعادة التفكير في الحدود الموجودة بين علم النفس وعلم الاجتماع.
ومع ذلك، وفقا للقاعدة العامّة، فإنّ العلوم الانسانيّة مجزوءة وتتقلّص وشائج القربى فيما بينها بشكل جذري ما يفضي إلى انهيار تامّ لفكرة الانسان. فالمجهودات، لوصل الإنساني بالبيولوجي كانت، بكل أسف، مختزلة. وتعدّ مساع ناقصة لم تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المعقّدة للكائن الإنساني. لنأخذ حالة السوسيو بيولوجيا التي تزعم فهمها للمجتمعات البشريّة انطلاقا مما يحدث في المجتمعات الحيوانية، لاسيّما على مستوى الجينات، نجدها تحاول التعرّف على السلوكيات المحدّدة من الجينات، وهو ما قام به ريتشارد داوكينس Richard Dawkins في كتابه الجين الأناني Le Gène égoïste، ووفق طرحه فإنّ الجينات هي التي تتحكّم فينا أشخاصا وأفرادا ومجتمعا، ولن نكون سوى ظواهر ودمى. وبهذا نصل إلى هذه العبثيّة: ها هو جزيء كيميائي يكاد يتمتّع بقوّة إلهيّة. من جهة أخرى وُجدتْ محاولات لاختزال المجتمعات الانسانيّة في الطريقة التي تسير عليها المجتمعات الحيوانيّة كالموجودة عند قردة الشمبانزي والبابوان، ومن الواضح أن الأمر هنا لا يخلو من سطحيّة لأنّه لا يأخذ في الحسبان الشقّ الخاصّ بالمجتمع الإنساني.
صحيح أنّنا من حيوانات ”الرئيسيات” كأبناء عمومتنا الغوريلا، وورثنا من الثديّات هذه العاطفة بين الأمّ وابنها، ونحن أيضا من الفقاريات، لكن الأمر لا يقتصر على هذا، لأنّنا في المقام الأوّل مجموعة منظّمة من الخلايا، وخلايانا هي أخوات-بنات للخلايا الأولى الحيّة التي ظهرت على هذه الأرض قبل ثلاث أو أربع مليارات سنة. بمعنى آخر نحن نحمل فينا تاريخ الحياة، ليس كلّ ما هو حيّ لأنّنا لا نحمل تاريخ الحشرات ولا تاريخ الزهور والنباتات بل التاريخ الذي يعود إلى الخلايا الأولى.