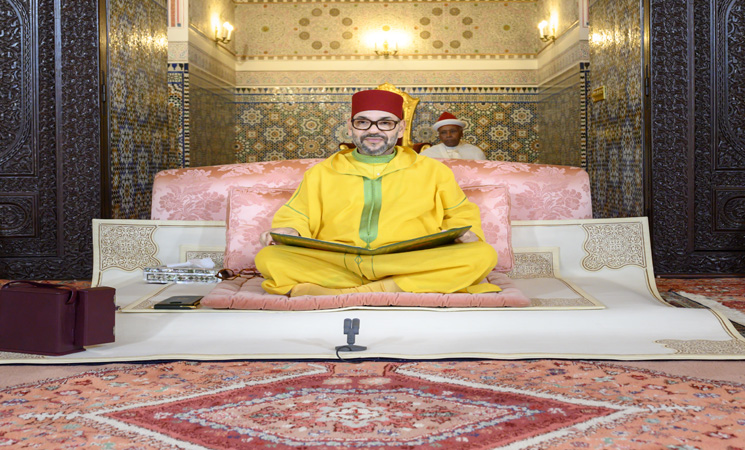بعد حصول المغرب على استقلاله، اعتبر مبدأ التعريب ركنا أساسيا في بناء المدرسة الوطنية إلى جانب التوحيد والتعميم والمغربة، وهي مبادئ منسجمة مع متطلبات تلك المرحلة التي كانت تتوخى بناء الدولة الوطنية عبر تعزيز استعمال اللغة العربية (التعزيز الكمي) بغاية توحيد التعليم العمومي وتجاوز الوضعية التي تركها المستعمر الفرنسي، وكانت تجربة التعليم الحر بالمغرب حاضرة وقوية بفضل احتضانها ورعايتها من قبل الحركة الوطنية، لذا أصبح التعليم المسمى «حرا» أو «معربا» تعليما عموميا، فتهاوت المدارس الحكومية الفرنسية لتحل محلها تدريجيا مدارس مغربية حديثة تتلقى فيها ناشئتنا تعليمهم باللغتين العربية و الفرنسية (الفرنسية بقيت لغة تدريس المواد العلمية)، ثم ازدادت سرعة التعريب مع خلق منافذ لإنقاذ المعربين (معلمين ومتعلمين) موازاة مع الشروع في إعادة تنظيم التعليم الأصيل، ولقد ارتبط هذا المسار» التعريبي» بمبدأ تعميم «المغربة» أكثر من ارتباطه بالتوحيد والتعريب.
وفي سنة 1970أصبحت «المغربة» في صدارة الترتيب، يليها التعريب ثم التعميم ثم التوحيد، وربما كان ذلك من أسباب تعثر مبدأ تطبيق مخطط التعريب وعدم وضوح أسس و غايات اعتماده مبدأ وطنيا بفعل تطور العلاقات الدولية والصراع الإقليمي وموقع المغرب ضمن هذا الصراع الدولي، وكذا التطور والاكتساح التكنولوجي و ما يتطلب ذلك من انفتاح على حضارات و ثقافات و لغات عالمية .
بعد مرور أكثر من ستة عقود على التطبيق الجزئي والعشوائي لهذه المبادئ الوطنية الاربعة ما يزال هناك استمرار في عدم وضوح موقف السياسة الحكومية من المسالة اللغوية وخاصة قضية « التعريب». فلا الميثاق ولا الرؤية الاستراتيجية للإصلاح ولا قانون الاطار اكدوا بشكل واضح ودقيق على «مسالة التعريب» ولا حسموا في عدد من الاشكالات المتعلقة بالسياسة اللغوية بشكل عام، والحسم في مناهج واساليب تدريس اللغات الاجنبية وكيفية الاستفادة منها في تعليم العلوم والتقنيات وجعلها جسر عبور الى ثقافة العلم والتكنولوجيا، وبالتالي الى ثقافة الحداثة والعولمة والانفتاح الحضاري..
إن مسألة (التعريب) التي شرع المغرب فيها منذ 1978 خلقت وضعا لغويا ملتبسا ومتداخلا بين المجال المعرفي للمادة الدراسية وبين البعد الثقافي للغة التدريس، مما جعل كثيرا من الساسة والمهتمين بالشأن التربوي يعيدون باستمرار طرح السؤال الأزلي عن المبادئ الكبرى للحركة الوطنية – وخصوصا مبدأ التعريب – وهي المبادئ التي شكلت أساس النضال من أجل بناء مدرسة عمومية مغربية الهوية.
إن المسالة اللغوية في نظامنا التربوي والتعليمي تقتضي النظر إلى اللغة وأي لغة في أبعادها وامتداداتها الذهنية والنفسية والاجتماعية والثقافية عوض إفقادها كل خصوصياتها باختزالها إلى بنية أو بنيات مجردة على الطريقة البنيوية.
فكيف تم الحديث عن المسألة اللغوية في الوثائق الإصلاحية من الميثاق إلى قانون الإطار؟
دعا الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى توسيع فضاء اللغات داخل النظام المدرسي، وذلك بإقرار اللغة الفرنسية منذ السنة الثانية من التعليم الابتدائي وإدخال لغة أجنبية ثانية في التعليمين الابتدائي والإعدادي وإقرار اللغة الأمازيغية كلغة وطنية يجب تدريسها للتلاميذ في المدارس الوطنية في التعليم الابتدائي اعتقادا في أن توسيع هذا العرض اللغوي سيموضعنا ضمن نسق لغوي لساني متعدد.
واعتبارا للأهمية الخاصة للغات في تحسين جودة التعلمات وفي النجاح المدرسي وفي النهوض بالبحث التربوي والعلمي دعت الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 إلى تنويع لغات التدريس لاسيما باعتماد التناوب اللغوي لتقوية التمكن من الكفايات اللغوية لدى المتعلمين، وتوفير سبل الانسجام في لغات التدريس بين اسلاك التعليم والتكوين.
وبناء على ما سبق ركز قانون الإطار رقم 51.17 على هندسة لغوية تعتمد في المناهج والبرامج والتكوينات المختلفة على مبادئ تعطي الأولوية للدور الوظيفي للغات المعتمدة في المدرسة الهادف إلى ترسيخ الهوية الوطنية واكتساب المعارف والكفايات وتحقيق الانفتاح على المحيط المحلي والكوني وضمان الاندماج الاقتصادي واجتماعي والثقافي.. وكل ذلك عبر إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة مع إعمال مبدأ التناوب اللغوي في تدريس بعض المواد ولا سيما العلمية والتقنية.
لكن رغم أهمية هذه التوصيات والمرتكزات الخاصة بإرساء تعددية لغوية والإعمال التدريجي للتناوب اللغوي كآلية لتعزيز التمكن من اللغات عن طريق التدريس بها، إلا أن الوضع اللغوي في مؤسساتنا التعليمية لايزال يعاني من اختلالات مزمنة، وضعا معقدا خلق انعكاسات متعددة على أنماط الكفايات اللغوية الواجب تطويرها وإنماؤها لدى المتعلم، وكذا على المقاربات البيداغوجية والديداكتيكية والثقافية اللازم توظيفها لتعليم وتعلم كل واحدة من هذه اللغات الوطنية والاجنبية، إضافة إلى ضعف حلقات التكوين المستمر للمدرسين والمؤطرين.
اليوم كما بالأمس يعود من جديد نقاش السياسة اللغوية المتبعة في مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي خصوصا بعد مصادقة البرلمان على القانون الإطار رقم51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي تم الإشارة فيه إلى إقرار التعدد اللغوي أو بالأحرى التناوب اللغوي كخيار تربوي يستثمر في التعليم المزدوج أو المتعدد اللغات لكن جزءا من هذا النقاش المتطور والحاد كان حول التعريب والتعدد، اكتسى بعضه طابعا إشكاليا ومنهجيا، وغلف بعضه الآخر بغلاف العاطفة «القومية»، فعادت اصوات تدعو للتعريب اللغوي دون التعريب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي، ودعت أصوات أخرى إلى إزاحة التعريب من الفصول الدراسية باسم الحداثة والتقدم ومسايرة العصر.
الكثير من المدافعين عن التعريب لا يتجاوز فهمهم لهذه المسالة ( تعميم ذلك اللسان والمنطق المتضمن فيه) كما أشار لذلك الأستاذ عبد الله العروي معتقدا (أن هذا الاتجاه خاطئ منهجيا وخطير على المجتمع إذ محكوم عليه أن يحارب كل تجديد ثقافي وأنه مبني على واقع يظهر أول وهلة وجيها إلا أنه يخطئ فهم وتقويم ذلك الواقع) .عبد الله العروي– ثقافتنا في ضوء التاريخ – ص221
والتعدد يراه خصوم التعريب باعثا على التسامح والمساواة بين الثقافات والشعوب وأداة لتنمية قدرات المتعلم على التواصل.
ولفهم جانب من مسألة التعريب وخلفياته، يمكننا الاستئناس برؤى ومواقف العالم اللغوي والباحث عبد القادر الفاسي الفهري و قراءات المفكر والمؤرخ السياسي المغربي عبد الله العروي.
1-هل المجتمع يمكن له أن يكتفي بلغة واحدة ؟
رأى عبد الله العروي أنه لا يوجد مجتمع يمكن أن يكتفي باستعمال لغة واحدة حيث هناك مستويات لغوية متفاوتة في كل مجتمع، ميز منها أربعة ورتبها من الأقل إلى الأكثر تجريدا وهي اللهجات – واللسان المكتوب- واللغات الاصطلاحية والمنظومات الرمزية للعلوم النظرية.
وكل مجتمع يعرف هذه المستويات اللغوية الأربعة ولكن المستوى الثاني هو المتميز عنها(اللسان المقوعد) لأنه يقوم بدور الوساطة غير انه يتميز بالجمود وعدم التطور لأنه مقوعد، أما اللهجات واللغات الاصطلاحية والمنظومات الرمزية فتروج في وسط ضيق.
وجود هذا التعدد اللغوي واللهجي الذي تعرفه المجتمعات هو الذي دفع عبد القادر الفاسي الفهري للدعوة إلى سن سياسة لغوية متزنة ومتوازنة تنظر إلى مختلف مكونات الوضع اللغوي بالمغرب، وهي أن لا تهيمن اللغة الأجنبية على السوق اللغوية الوطنية فتضيع اللغة العربية واللغات واللهجات المحلية، ولا هيمنة اللغة العربية وحدها فتضيع اللغات الأجنبية التي هي أداة الانفتاح.
التعدد اللغوي محمود من حيث المبدأ لأنه كما يراه الفاسي الفهري رأس مال رمزي يمكن توظيفه في الاتصال بالثقافات والشعوب الأخرى، وإن كان أن هذا الأمر قد يؤدي إلى إشكالات ومتاعب وصعوبات على مستوى المجتمع وسياساته الاجتماعية والثقافية والتربوية .
ان السياسة اللغوية المتزنة في نظر هذا الفقيه اللغوي تقوم على مبدأ التعدد والتنوع اللهجي من جهة وعلى مبدأ التعدد اللغوي من جهة ثانية، والتعدد اللغوي هو الذي يتيح الانفتاح على العالم ويتيح الوصول إلى المرجعيات والمعلومات التي نحتاج إليها والتي لا تمكننا اللغة العربية وحدها من ربط الصلة بها.
يتبع
إشكالية التعريب وأزمة التعدد اللغوي في نظامنا التعليمي 2/1

الكاتب : محمد بادرة
بتاريخ : 07/04/2022