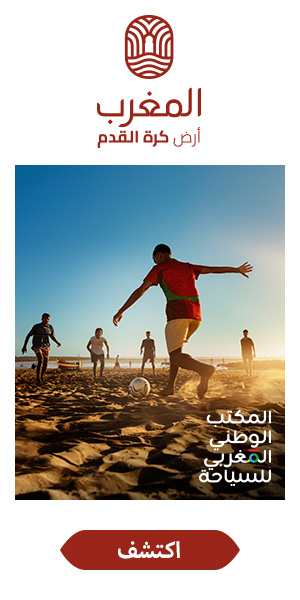66 سنة مضت على إرساء أسس النظام الوطني للصحة لأول مرّة في 1959 تاريخ المناظرة الوطنية الأولى وما تلاها إلى غاية 1980، مرّ خلالها هذا النظام بمتغيرات ذات بعد إصلاحي خلال فترات معينة من تاريخ المغرب، ما بين 1981 و 1994، مع استحضار محطة 1978، فالمرحلة الثالثة التي انطلقت مع سنة 1995 التي شكّلت بدورها منعطفا مهما في تاريخ المنظومة الصحية لبلادنا، مرورا بمرحلة دستور 2011 والمحطة التي تلته ما بين 2013 التي عرفت تنظيم المناظرة الوطنية الثانية للصحة و 2021 ، ثم مرحلة 2022 إلى اليوم.
محطات ومراحل مهمة كان من المفروض أن تزيد من قوة المنظومة الصحية وأن تجعلها قادرة على تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين بشكل عادل ومتكافئ دون أن تحول دون تحقيق ذلك إكراهات مادية أو بشرية، لكن الذي وقع هو أن المغاربة وبعد طول انتظار وصبر، وبعد أن أعياهم واقع حال الصحة العمومية، خرجوا للاحتجاج ولإسماع أصواتهم لكل المعنيين. أصوات عبّرت عن الأنين والألم، وكشفت عن معاناة كبيرة، يجدها الصغير والكبير للاستفادة من الحق في الصحة الدستوري، وانتقدت مرارة لحظات ما قبل ولوج المستشفى وإبان ذلك وبعده، بما أن الحصول على الخدمة الصحية لم يكن بالنسبة للعديد من الحالات بلسما وعلاجا من أمراضهم؟
بالمقابل ترتفع أصوات أخرى للاحتجاج، وهذه المرة يتعلق الأمر بعدد من مهنيي الصحة في القطاع العام، الذين يعيش عدد منهم الاحتراق الداخلي، من أجل مواجهة ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية وصعوبات التكفّل بالمرضى، في ظل ضعف بنية الاشتغال وغياب الحدّ الأدنى من وسائل العمل، وفقا لتعبير الغاضبين، الذين لا يخفون امتعاضهم من حجم العبء عليهم، ومن أوضاعهم المادية والإدارية، ومن الخطر الذي يتهدد بعضهم جراء غياب الحماية القانونية التي تؤطر بعض المهام التي يأمرون بالقيام بها!
هذه الوضعية ساهمت فيها طريقة تدبير عدد من التحديات التي حدّت من مردودية الصحة العمومية، وجعلت القطاع العام يتحول من قاطرة للصحة إلى مجرد “تابع” لا يستقبل سوى 20 في المئة من المرضى الذين يتوفرون على تغطية صحية، ولا تلج أبوابه إلا الفئات الهشة المعوزة التي تعجز عن توفير المال من أجل العلاج، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
الحكامة
تعتبر الحكامة النقطة التي تتقاطع عندها كل الأعطاب، في ظل منظومة صحية يطبعها التشتت وغياب “الالتقائية”، بين ما هو مركزي، سواء ما يربط الوزارة الوصية بباقي القطاعات الوزارية الأخرى في الجانب المشترك المتعلق بالصحة العامة، أو ما يصلها بمصالحها في الجهات مع استحضار امتداداتها المختلفة في هذا الإطار، بالإضافة إلى غياب خارطة صحية جهوية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المحلية، وتجيب عنها على مستوى التكوين والتوظيف وتوفير الخدمات الضرورية لأجلها، أخذا بعين الاعتبار الهوّة ما بين القطاع العام والخاص، وغياب شراكة فعّالة وناجعة، يلمس المواطن آثارها الإيجابية دون أن يكون لذلك كلفة مادية ثقيلة تزيده عبئا على عبء الأمراض التي يعاني منها.
وما يزيد من حجم الاختلالات هدر الزمن في تنزيل الإصلاحات، كما هو الحال بالنسبة للهيئة العليا للصحة، على سبيل المثال لا الحصر، التي من المفروض أن تتحمل مسؤولية التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وأن تكون لها صلاحيات إبداء الرأي في التوجهات والسياسات العمومية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وأن تشرف على الاعتماد الخاص بالمؤسسات الصحية، وأن تضطلع كذلك بمهمة تقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص مع تقديم توصيات ومقترحات تخص الجانب الصحي.
هذا التعثر الذي تبدو ملامحه كذلك، وإن بدرجة متفاوتة، في تنزيل باقي الوكالات الأخرى، وما رافقها من اضطراب على مستوى الهيكلة، والمهام، والمبادرة بمعالجة الملفات المتراكمة والثقيلة، والتي ساهمت في شلّ حركية هذا المجال لفترة ليست بالهينة، وخاصة على مستوى وكالة الأدوية ومنتجات الصحة.
ولأن الحال هو نفسه، فإن المجموعات الصحية الترابية التي هي نتاج دراسة وتفكير على عهد الوزير آيت الطالب، التي قيل بأنها ستساهم في تقليص “الهوّة الصحية” ما بين المستشفيات والمواطن، بتنظيم مسلك العلاجات أساسا، الذي يرفضه البعض لغايات خاصة، والتي هي عبارة عن تجمع للبنيات الصحية التابعة للقطاع العام في إطار مؤسسة واحدة مستقلة جهويا ماليا وإداريا، سواء على مستوى البنيات أو الموارد البشرية أو المالية، تعرف هي الأخرى تعثرا في التنزيل، بل أن المعطيات القادمة من شمال المملكة التي تحتضن أول مجموعة صحية ترابية تعتبر النموذج الذي من المفروض أن يشكل حافزا على إطلاق باقي المجموعات في الجهات الأخرى، لا تطمئن ولا تعد بالكثير من التفاؤل، بسبب عطب الحكامة الذي يحضر بقوة في كل مستوى من مستويات المنظومة الصحية.
الموارد البشرية
يعتبر الخصاص في الموارد البشرية الورقة التي ظل عدد من المسؤولين الذين تعاقبوا على تحمل مسؤولية قطاع الصحة “سياسيا” يشهرونها في وجه المحتجين، مواطنين وإعلام ونواب برلمانيين وغيرهم، دون أن تجد الوزارة أي وصفة لعلاج هذا “المرض” الذي يؤدي ثمنه باهظا المريض والمهني على حد سواء، طبيبا كان أو ممرضا أو تقنيا للصحة أو إداريا في أي مرفق صحي عمومي، وهو ما تؤكده الأرقام مقارنة بالمعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، إذ يتجاوز الخصاص في الأطباء 30 ألف طبيب وفي صفوف الممرضين وتقنيين الصحة 60 ألفا، أي ما يصل إلى حوالي 100 ألف طبيب وممرض، مع وجود استمرار أعطاب أخرى بالتوازي، كما هو الحال بالنسبة لهجرة الأطباء إلى الخارج، نموذجا، الذين يقدّر عددهم بحوالي 16 ألف طبيب، وهو نفس عدد الأطباء في القطاع العام تقريبا، في حين يتراجع العدد في القطاع الخاص إذ يقدر بحوالي 12 ألف طبيب؟
هذا الخصاص الكمّي يرافقه كذلك سوء توزيع كيفي، فكثير من المستشفيات تفتقد لطبيب مختص في مجالات الأعصاب نموذجا أو القلب والشرايين أو طب النساء والتوليد أو غير ذلك، ويتعذر إجراء تدخلات جراحية بها، بالمقابل هناك مستشفيات أخرى تتوفر على الأخصائيين الجراحيين لكنها تفتقد للطبيب المختص في التخدير مثالا، وبين النوع الأول والثاني، يدخل المريض في دوامة بدون مخرج، ويجد نفسه ضحية لهذا الوضع الذي تغيب عنه الحكامة، وهو الأمر الذي يجعل الكثير من المرافق الصحية هي عبارة عن جدران إسمنتية يتم تشييدها وتدشينها ولا تؤدي المهام الملقاة على عاتقها.
التغطية الصحية والإنفاق الصحي
على الرغم من قرار تعميم التغطية الصحية، وضدا عن الأرقام التي تقدمها الحكومة، فإن الولوج إلى العلاج يبقى مكلّفا خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا يزالون إلى غاية اليوم بدون تغطية صحية، أو المعنيين بنظام “أمو الشامل” الذي يسددون اشتراكات شهرية، الذين حرمهم المؤشر من الاستفادة “المجانية” من الصحة العمومية، أو باقي المنخرطين في مختلف الصناديق الاجتماعية، حين ولوجهم تحديدا إلى القطاع الخاص، الذي قد يُدفعون إليه دفعا خاصة بسبب طول آجال المواعيد والتذرع بأعطاب التجهيزات البيوطبية المختلفة الضرورية لاستكمال الفحوصات، وذلك بسبب التعريفة المرجعية المتقادمة التي تجعل كل مريض يتحمل حوالي 60 في المئة من النفقات العلاجية عن كل ملف مرضي، فضلا عن تفاصل أخرى، تجعل الكثيرين لا يطرقون عيادة الطبيب ولا يبحثون عن العلاج كيفا كانت طبيعته إلا عند الضرورة القصوى، لأن أسرة فقيرة أو متوسطة، لا يمكن أن تسدّ كل احتياجاتها الاجتماعية والاقتصادية في شهر واحد، ويزداد الوضع سوء وتفاقما حين تحدث الطوارئ الصحية داخل الأسرة، وحين يطال المرض أكثر من فرد من أفرادها؟
سوق الدواء
أقدمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومن خلال مرسوم 2013 على القيام بمجموعة من الخطوات من أجل تخفيض أسعار عدد من الأدوية في بلادنا، والتي تعتبر عدد من أنواعها جد باهظة مقارنة بسعرها في دول أخرى والذي قد يصل إلى عشرة أضعاف الثمن المحلي. هاته الخطوة ساهمت بالفعل في مراجعة بعضها بشكل مقبول لكن البعض الآخر لم يتجاوز منسوب التخفيض فيها بضع دراهم، في حين لا تزال أدوية أخرى جدّ مكلّفة بعيدة عن كل تناول، بل أن عددا منها لا يشمله، شأنه في ذلك شأن تدخلات طبية مختلفة، التعويض لأسباب غير مفهومة إلى غاية اليوم.
الوزارة التي أقدمت على هذه الخطوات، تقاعست في المقابل عن تطوير سوق الأدوية الجنيسة التي تظل دون المستوى المطلوب والتي لم تصل إلى سقف 40 في المئة من التداول بعد، كما أن قراراتها أدت إلى انقراض العديد من الأدوية، خاصة منها “البسيطة” على مستوى السعر، حيث تم حرمان المواطنين منها لأن هامش الربح لم يعد كافيا لبعض المختبرات المعنية بها، وهو ما يضرب في العمق كل توجه يهمّ تحقيق السيادة الدوائية، بما أن الأمن الدوائي في هذا “الحدّ الأدنى” بات صعب التحقيق، ليس لغياب مواد أولية في التصنيع واختفاء الأدوية من السوق العالمية كما هو الحال بالنسبة لبعض الأدوية ولكن لأن الجهد يتّجه لتوفير أدوية باهظة الثمن التي يكون هامش ربحها أكبر، دون إغفال تبعات ما يقع والتي ترخي بظلالها على القطاع الصيدلاني وعلى مهنيي هذا القطاع كذلك.
أسئلة التكوين
لقد تابع الجميع كيف أصيبت كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة خلال المرحلة السابقة بالشلل نتيجة الحراك الذي احتضنته في علاقة بالنقاش المرتبط بتقليص سنوات التكوين، وقد أدى التدبير المتأزم لهذا الملف إلى احتقان عارم وإلى تبعات مختلفة، كان له ما بعده، والذي يتبيّن اليوم بأن صفحته لم تطو نهائيا، فعدد من الكليات تعرف بين الفينة والأخرى تذكيرا بمطالب أطباء الغد، ونفس الأمر يشمل ملف الأطباء الداخليين والمقيمين، هذا في الوقت الذي اتخذت فيه تدابير للرفع من أعداد الخريجين لكن هاته الخطوة ترافقها علامات استفهام كثيرة تتعلق بالتداريب السريرية وبأسئلة الجودة وبمسار التكوين والتخرج وظروفه المادية والمعنوية، وهو ماتعكسه الشهادات الصادمة لعدد من الأطباء الذين كشفوا من خلال خرجاتهم بعضا من تفاصيل ما عاشوه من طرف بعض المشرفين على تكوينهم!
تحديات أخرى
في ظل كل هاته الإشكالات تٌطرح تحديات أخرى متعددة على المنظومة الصحية مرتبطة بارتفاع أمد الحياة واتساع دائرة الأمراض المتعلقة بمرحلة الشيخوخة، واتساع رقعة الأمراض المزمنة، وغياب سياسية صحية وقائية فعلية، مع استمرار تحديات مواجهة وفيات النساء الحوامل والأطفال دون سنّ الخامسة، إضافة إلى عودة عدد من الأمراض التي اختفت في وقت سابق كداء الحصبة نموذجا، مقابل ظهور أمراض وبائية جديدة خلال السنوات الأخيرة، مع ما يعني ذلك من إمكانية ظهور فيروسات ومتحورات أخرى، أم الصحة النفسية والعقلية فهي الغائب الأكبر وللشوارع أكبر شاهد على هذه المعضلة التي تحاول الكثير من الأسر إخفائها باحتضان مرضاها في صمت.
كل هذا وذاك، ومعها ورش للرقمنة يسير سير السلحفاة، لا يزيد إلا من حجم الصعوبات التي قد تعترض المريض المغربي في الولوج إلى الصحة، إذا لم يتم إعادة النظر في كيفية تدبير هذا القطاع بالشكل العقلاني والناجع، الذي يقطع مع مظاهر الفساد والفوضى وكل أشكال الريع، مع التنصيص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، لا باعتماد ورقة الإعفاء وإعادة تدوير المسؤولين الذين تبث إخلالهم بمهامهم، وكذا العمل على تطوير عوامل الجذب لتشجيع المهنيين على الرفع من مردوديتهم، إذ تكفي إطلالة بسيطة على النتائج الخاصة بفتح مناصب مالية تخص مدراء مستشفيات للوقوف على حجم العزوف، الذي تغذيه الاستقالات بل والغياب المستمر ومقاطعة أماكن التعيين، إما لدوافع موضوعية بسبب غياب وسائل العمل وانعدام هامش التحرك وصلاحيات التدخل، أو لغايات ذاتية، بسبب إغراءات تجعل البعض يضع مصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة، ويبحث عن دخل أكبر وربح أكثر على حساب كل القيم.