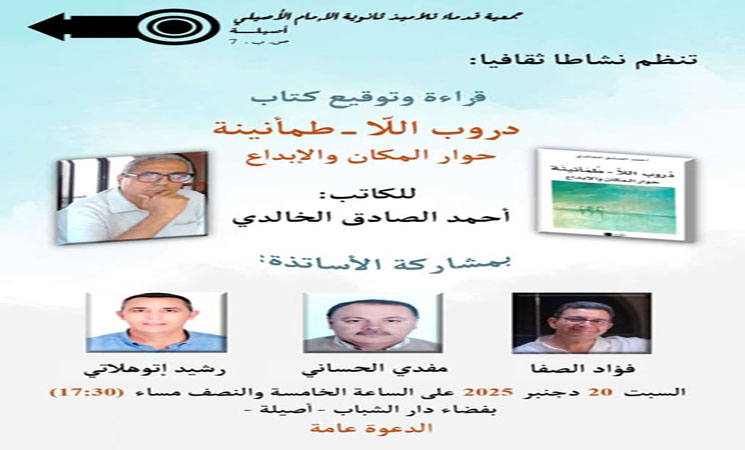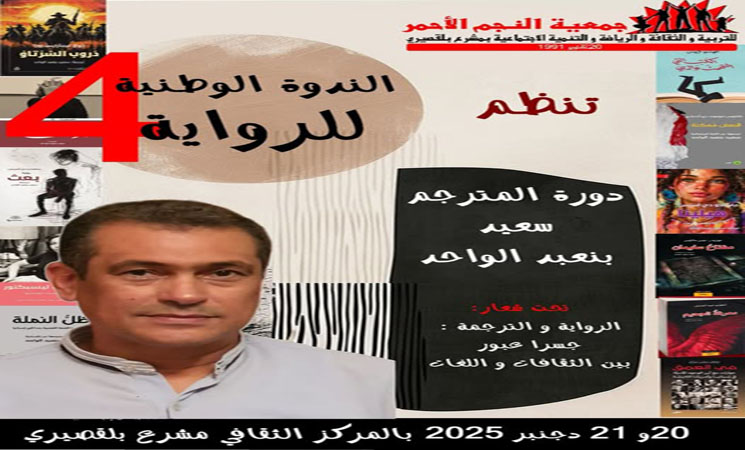يتذكر التاريخ ذلك السجال الشهير الذي دار ببلد الوليد [1551-1550] ما بين الدومينيكي بارتولومي دو لاس كساس واللاهوتي خوان جينز دو سيبولفيدا. وهو السجال الذي تمحور حول ما إذا كان الهنود الحمر بشراً أم لا، وبالتالي ما إذا كانوا يملكون روحاً. المثير في هذا السجال هو أنه حتى وإن كان لاس كساس قد دافع فيه عن الهنود، معتبراً إياهم بشراً مثلنا، إلا أنه لم يتردد في القول بأن «إنسانيتهم تلك ناقصة». بهذا يكون لاس كساس قد أضفى شرعية على استعمار الشعوب غير الأوروبية بدعوى «إكمال إنسانيتها» وتمكينها من صعود سلم التقدم للحاق بركب «الإنسانية الحقة» كما يجسدها الإنسان الأبيض العقلاني والمتحضر.
مع حلول القرن السابع عشر سيدشن الإنسان الغربي حقبة جديدة، شكل فيها سجال بلد الوليد تمهيداً لها، حقبة شعارها «التقدم» وأداتها العلم، كما تجلى ذلك بوضوح مع الفيلسوف البريطاني فرنسيس بيكون [1561-1626]، ومع أيضاً الفيلسوف وعالم الرياضيات الفرنسي نيكولا دو كوندورسي [1743-1794].
بيد أن فكرة «التقدم» هذه لم تكن لتتحقق لولا استقلال الفكر الغربي عن وصاية مؤسسة الكنيسة، استقلال على المستويات الثلاثة الرئيسية: المعرفة، مع روني ديكارت، والأتيقا، مع إيمانويل كانط، وأخيراً استقلال المجال السياسي عن الوصاية الكَنَسِيَة، وهو ما تجلى مع صدور إعلان الحقوق ببريطانيا سنة 1689، إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776 وأخيراً إعلان حقوق الانسان والمواطن بفرنسا سنة 1789.
بهذا بدأت ملامح مشروع مجتمعي جديد تتشكل على أنقاض النظام القديم، نظام العصر الوسيط، مشروع قائم على الإيمان بالإنسان والعقلانية والعلم، وبقدرته، أي قدرة الإنسان، على السيطرة على الطبيعة وبناء عالم يسوده العدل. هكذا حمل الإنسان الأبيض على عاتقه مشروع تطويع ليس فقط الطبيعة، بل و»تطويع» الشعوب الأخرى وإخراجها من ظلمات «الهمجية» إلى أنوار «التحضر»!
لكن القرن التاسع عشر سيحمل معه بذور تصدع ستطال تداعياته مجمل الشعارات البراقة التي بشر بها عصر «الأنوار»: تزايد وتيرة استعمار الشعوب غير الغربية، التي عرفت بدايتها منذ القرن الخامس عشر، الثورة الصناعية ونتائجها الاجتماعية الكارثية وما ترتب عنها من تفكك للقيم التقليدية وبداية بزوغ النزعة الفردانية [في هذا الصدد يمكن العودة إلى البحث السوسيولوجي الذي أنجزه عالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم عن الانتحار] وظهور فلسفات الريبة والشك مع كل من كارل ماركس، فردريك نتشه وسيجموند فرويد.
لقد طال نقد هذه الفلسفات مركز العقلانية حين أبان ماركس عن خلفياتها الأيديولوجية والصراعات الاجتماعية الثاوية خلفها؛ وحين كشف فرويد زيف مقولة الوعي ومركزية العقل في سيرورات الفعل والتفكير والاحساس البشري؛ في حين توجه نيتشه بمعوله لهدم النواة الأساسية للعقلانية المتمثلة في الذات العاقلة كما تشكلت مع ديكارت ولاحقيه، مؤكداً على أن «الأنا» ما هو في نهاية المطاف سوى وظيفية نحوية fonction grammaticale تحولت بفعل أوهام الفلاسفة العقلانيين إلى جوهر مفارق.
ليس هذا فحسب، إذ ستعرف نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 انهيار اليقين والأسس التي قامت عليها المعرفة العلمية. لقد اعتقد علماء القرن 19 أنهم على مشارف كشف «الشفرة الخفية للخلق»، وأن مجمل القوى المتحكمة فيه يمكن إرجاعها إما إلى قوانين نيوتن أو ماكسويل أو قوانين الديناميكا الحرارية. ظلت بعض التفاصيل الجزئية عالقة، بيد أن بيان لغزها مسألة وقت فقط، على الأقل هذا ما ظنه أولئك العلماء: يتعلق الأمر هنا بالإشعاع الصادر عن جسم نظري هو «الجسم الأسود». لكن تبين أن ما اعتبر جزئية «بسيطة» هو في الواقع قمة الجليد التي تخفي في أحشائها عالماً فسيحاً من الألغاز (°).
هذا العالم الفسيح هو ما ستحاول الميكانيكا الكوانتية استكشافه اعتماداً على بنية رياضية صورية مختلفة تمام الاختلاف عن البنيات الصورية المألوفة في الفيزياء الكلاسيكية. قاد هذا الاستكشاف في النهاية إلى تفكيك مركزية الذات، وهدم أنانيتها المفرطة، التي كادت أن تتحول إلى «معبود جديد»، وبذلك تكون هذه الفيزياء قد عبدت الطريق للانتقال إلى ما بعد-الحداثة، وبالتالي زرع الشك اتجاه كل ما قامت عليها الحداثة الغربية من مبادئ ومقولات.
كانت هذه إذن بانوراما عامة جداً لما ميز الحضارة الغربية مدة أربعة قرون، من هنا السؤال: بأي معنى يمكن أن تكون الإبادة الجماعية وجها آخر للحداثة؟ كيف لفكرة ألهمت آمال شعوب ونظم حكم، أن تتحول إلى كابوس؟
يستحضر الروائي الفرنسي الكبير لويس-فردنان سيلين في روايته «رحلة في أقاصي الليل»، مشهد ضابطٍ يسأل جندياً نجى من كمين عن مصير المؤونة، بينما الجندي كان يحاول سرد تفاصيل ذلك الكمين والقتلى الذين سقطوا جراءه. لكن المثير أن الضابط لم يأبه لأمر القتلى فظل يتساءل عن مصير المؤن!
وفي مقطعٍ آخر لا يخلو من عبثية، يصور سيلين مشهد بطل الرواية، الجندي باردامي وهو يتساءل عن جدوى الحرب، والجدوى من سقوط هذا العدد الكبير من القتلى!
أما الروائي البرتغالي جوسيه ساراماغو فيقدم في روايته «العمى» مشهداً لا يقل إثارة عن الذي قدمه سيلين: بلد أنتشر فيه وباء غريب، وباء العمى، اضطرت معه السلطات إلى وضع حاملي العدوى، المصابين منهم والمحتمل إصابتهم، في مكانٍ معزولٍ أملاً في الحد من انتشار المرض. كانت الأوامر واضحة للجيش: «اقتلوا كل من حاول الفرار أو حتى الاقتراب من بوابة المبنى!» وهو ما تم فعلاً، ودون تردد.
قد تكون هذه المشاهد الخالصة إبداعاً صادراً عن خيال روائيين كبار، والحال أنها تخفي ضمن ثناياها ما هو أعمق: يتعلق الأمر بالتنظيم العقلاني للأفعال واستبعاد سؤال الأخلاق. ليس المهم عدد القتلى، بل الأهم هو ما يُمَكِّن من الحفاظ على البقاء [المؤن]، وفق حسابات عقلانية مضبوطة لا تدخل في حسابها سوى منطق الربح والخسارة. ليس مهماً أيضاً عدد العُزَّل الذين يمكن إعدامهم [إن هم تجرؤوا على الخروج]، بل الأهم هو ضمان أمن الدولة وإزالة كل ما يمكن أن يشكل تهديداً وجودياً لها.
تفنن القاموس السياسي المعاصر في إبداع مصطلحات خاصة لحجب هول كوارث الحروب والإبادة الجماعية، مصطلحات من قبيل «الحرب النظيفة» [وهل هناك حقاً حرب نظيفة!]، والخسائر الجانبية (1) [وهل قتل أزيد من 50 ألف طفل في غزة خسائر جانبية؟!]، و»تخليص الشعوب من الاستبداد» [بارتكاب مجازر في حقها !]…الخ. لكن، وبعبارة كانطية، ما الذي جعل هذه الأفعال المشينة والمروعة ممكنة؟ ما الذي أتاح قتل الملايين من البشر، في المستعمرات وفي الحرب العالمية الثانية وفي فيتنام والعراق ودارفور والبوسنة والهرسك… والآن في غزة؟
يقول الأنثروبولوجي والفيلسوف الفرنسي جاكي أسياج «يشكل نوع معين من القتل الجماعي المدعوم من جهاز الدولة، أي المدعوم من الطبقة السياسية الحاكمة أو من قبل جماعة وطنية، ظاهرة حديثة، بل ظاهرة مميزة «للحداثة». تقتضي الإبادات الجماعية تنظيماً وعقلانيتاً [التشديد من عندنا]. في هذا السياق، يلاحظ تزايد عدد تلك الإبادات خلال القرن 20. وما نخشاه هو أن تتكرر أكثر فأكثر… « (2) [وهو ما نشهده الآن في غزة]. ملاحظتان تستدعيان الاهتمام هنا:
أما الأولى فهي أن الإبادة سمة مميزة للحداثة؛
أما الثانية فتتمثل في كون التنظيم والعقلانية شرطان لفعل الإبادة.
إن ما يلزم الإشارة إليه هنا هو أن الحداثة في جوهرها قامت على فكرتي التنظيم والعقلانية. هذا ما عرضه السوسيولوجي والفيلسوف الألماني ماكس فبر في تصنيفه للأفعال الأربعة(3):
الفعل العقلاني الموجه بهدف؛ الفعل العقلاني الموجه بقيمة؛ الفعل العاطفي أو الانفعالي؛الفعل التقليدي.
فالفعل العقلاني الموجه بهدف، هو الفعل الصادر عن المهندس أو المُضَارِب الذي يتوخى الربح أو الجنرال الذي يقاتل لتحقيق الانتصار…الخ. إنه فعل مؤسس على حساب الربح والخسارة، دون اعتبار لما يمكن أن يترتب عن الفعل من الناحية الأخلاقية (4).
أما الفعل العقلاني الموجه بقيمة، فهو الفعل الذي تحكمه مثل وقيم عليا؛ هو عقلاني لكن غايته غير محددة بمعطى خارجي، إنها أفعال أخلاقية ترمي، على سبيل المثال، إلى تحقيق العدالة ولو كان ذلك على حساب التضحية بالذات أو بالمصالح الشخصية… (5)الخ.
لقد شيد ماكس فيبر فهمه للحقبة المعاصرة على هذه التصنيفات الأربعة، مؤكداً على أن ما يميزها، أي ما يميز تلك الحقبة، هي العقلنة، عقلنة تتجلى على وجه الخصوص في اكتساح الأفعال العقلانية الموجهة بغايات جميع مناحي النشاط البشري، سواء أكان هذا النشاط اقتصادياً أو نشاطاً يخص التدبير البيروقراطي لدواليب الدولة. في هذا الاطار يقول ريمون أرون «ينزع المجتمع الحديث برمته إلى التنظيم العقلاني الموجه بغاية، وبالتالي فإن المشكلة الفلسفية لحقبتنا هذه، مشكلة وجودية بامتياز، هي في رسم حدود مجال المجتمع حيث مازال هناك ويلزم أن يظل هناك فعل من نوع آخر.
يرتبط تصنيف أنماط الفعل في النهاية بما يشكل نواة التفكير الفلسفي لماكس فيبر، ويتعلق الأمر بروابط التآزر والاستقلالية ما بين العلم والسياسة.» (6).
إن إسكات صوت الضمير الأخلاقي والإعلاء من قيمة العقلانية الحسابية المجردة من كل القيم [وهو الأمر الذي لم يكن ليحدث لولا الفصل الذي أسست له الحداثة ما بين الفعل العقلاني الموجه بهدف والفعل العقلاني الموجه بقيمة]، شكلا معاً شرطاُ أساسياً لأفعال الإبادة الملازمة للحداثة الغربية. إن هذا الجانب المتوحش الذي أفرزته النزعة العقلانية الغربية (7)هو ما سبق وأشار إليه الفيلسوف وعالم الاجتماع البولندي زيغمونت باومن [في محاضرة كان قد ألقاها سنة 1990 بمناسبة منحه جائزة أمالفي الأوروبية للسوسيولوجيا] حين استحضر ما كتبه ولتر بنيامين سنة 1940 في رسالة موجزة قائلاً: «هذا الذهول الذي نحن فيه لا يمكن أن يكون نقطة الانطلاق لفهم تاريخي حقيقي، إلا إذا كان هذا الذهول (8) يعني الادراك بأن مفهوم التاريخ الذي ولده فيه يتعذر الدفاع عنه.
والمتعذر الدفاع عنه هو مفهوم تاريخنا- الأوروبي – باعتباره ثورة الإنسانية على الحيوان الذي يسكن داخل الإنسان، وانتصار المنظومة العقلانية على وحشية الحياة الهمجية الفظة البشعة. والمتعذر الدفاع عنه أيضاً هو مفهوم المجتمع الحديث باعتباره قوة تهذيبية جلية، ومؤسساته بوصفها قوى للتحضر، وقواعده الإلزامية كسدود منيعة تدافع عن الإنسانية الضعيفة ضد سيول الرغبات الحيوانية.»(9)
يمثل ما كتبه هنا الفيلسوف الألماني ولتر بنيامين إدانة صريحةً لحقبة بأكملها، الحقبة المعاصرة التي جعلت من شعار الأنوار والتحضر والديمقراطية وحقوق الإنسان… «كتابها المقدس». حقبة كان هذا الفيلسوف شاهداً على أحداثها المأساوية، أحداث انطلقت شرارتها من بلدٍ أنجب أبرز العقول في مجالات شتى: في العلوم والفلسفة والشعر والآداب، يتعلق الأمر هنا بألمانيا. في هذا السياق يقول الفيلسوف والطبيب النفسي ميخائيل بيناسياك «مع الهولوكوست سوف يحدث تصدع في صرح العقلانية، خصوصاً وأن هذا التصدع نابع من ألمانيا، بلد العقلانية المسيحاني كما قد يقال –لقد رأى ماركس على سبيل المثال في كل من ألمانيا وإنجلترا البلدين الطليعيين اللذين يمكن أن تنبثق منهما الاشتراكية. لقد كانت ألمانيا موطن مفكري العقلانية الكبار، من إيمانويل كانط إلى مارتن هايدجر، هايدجر الذي انخرط في الحزب الاشتراكي الوطني…عند نهاية الحرب العالمية الثانية، برهن هؤلاء المفكرون الألمان أننا قد نفكر حقاُ في الشر، في الوقت الذي كنا فيه من قبل على قناعةٍ بأن التفكير الصحيح يقود إلى التفكير في الخير [التشديد من عندنا]» (10).
لم يكن ما عرف بأزمة الأسس التي طالت العقلانية الغربية، بدءا من سنة 1900، لتهم سوى العلماء والنخب الفكرية البارزة. لكن مع الهولوكوست أضحت الأزمة عالمية، أزمة أخلاقية أسقطت كل مزاعم الحداثة، تلك الحداثة التي قامت، بحسب مخائيل بيناسياك، على فرضية أساسية تقر بأن التفكير السليم يفضي إلى التفكير في الخير لا الشر. نحن هنا كما يقول بيناسياك: «أمام فرضية وحدة الجوهر ما بين التوظيف السليم للعقل وفعل الخير –كما أن العلم لا يمكن أن يسدي للإنسانية سوى الخير [التشديد من عندنا]. لكن مع أوشفيتز وهيروشيما، أصبحنا نعي أن أولئك الذين يفكرون بشكل سليم هم بالضبط من فكروا جيداً في الشر [التشديد من عندنا]. النتيجة الثانية، …هي أن أولئك الذين لا يفكرون بشكل «سليم» (11)من وجهة المنطق الرياضي، يمكنهم مع ذلك التفكير في الخير. كل منا، حتى وإن لم يكن متعلماً ولم تكن ثقافته واسعة، وأي شعب مهما بلغت درجة تطوره التقني، يمكنه مع ذلك التحرر والتوجه إلى ما هو خير. إنها بداية فكر العالم-الثالث.»(12).
تعيدنا هذه المفارقة الواردة في ما كتبه هنا بيناسياك، مفارقة «النخب» و»العامة»، إلى تساؤل أعمق طرحه زيغمونت باومان قائلاً: «هل الفضيلة مكتسبة بالتعلم أم هي هبة الطبيعة؟ هذه هي المعضلة التي واجهت الرومان القدماء، وهي معضلة عويصة بالقدر نفسه الذي نشعر به في عالمنا المعاصر: هل الأخلاق تُدَرَّس أم إنها أنموذج كامن في الوجود الإنساني؟ هل هي تنشأ عن عملية التفاعل الاجتماعي والاندماج في المجتمع أم إنها «موجودة ولها مكانها» قبل بدء جميع أنواع التعلم؟ هل الاخلاق من إنتاج المجتمع، أم أنها، مثلما يؤكد ماكس شيلر، على العكس من ذلك تماماً، وإن شعور الشخص، جوهر جميع السلوكات الأخلاقية، هو أساس الحياة في المجتمعات؟»(13).
يقدم لنا حجم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني جراء ما يتعرض له من جرائم بشعة موثقة بالصوت والصورة، وفي حينها، جواباً، على الأقل بالنسبة لي، عن هذه التساؤلات. شعوب من ثقافات وأعراق وعقائد ولغات مختلفة خرجت للتعبير عن إدانتها للأفعال الهمجية والبربرية التي يقترفها الاحتلال في حق شعب محاصر لعقود عديدة. لم يكن لهذا التآزر الدولي أن يكون لولا هذه «الإرادة الخيرة» التي توحد البشر كبشر وتجعلهم يدركون هول ما يتعرض له بشر مثلهم، بشر جردوا من إنسانيتهم بقرار سياسي، وإجماعٍ من قبل ساسة عالمٍ يزعم أنه مهد «التحضر» والحداثة.
بيد أن المثير للانتباه هو أن الإبادات الجماعية التي اقترفت ضد شعوب وأعراق مختلفة، ما كان لها لتحدث لولا هذا التحالف الذي تم ما بين العلم [كمظهر من مظاهر الحداثة، والمعبر الأبرز عن النزعة العقلانية الموضوعية الخالية من كل القيم الأخلاقية ومن كل ذاتية.] والدولة الحديثة [كتنظيم بيروقراطي هرمي، حيث الأوامر، حتى الأكثر إجرامية منها، تنفذ دون ضمير بحكم الموقع الذي يحتله الفاعل في سلم سلطتها].
لقد مد العلم، خصوصاً في شقه التقني (14)، الدولة بكل ما تحتاج إليه في عملية الضبط الشاملة للأفراد والمجتمعات بشكل انتزعت معه مسؤولية كل واحد عما يصدر منه من أفعال مشينة وقذرة. ولن نجد أفضل من أمثلة التواطؤ المكشوف لشركات كبرى، كميكروسوفت، ومواقع تواصل اجتماعي وإعلام دول غربية وغير غربية، وتوجيه لقنابل بالأقمار والذكاء الاصطناعي لاستهداف وقتل المدنيين وعلى رأسهم أطفال غزة، لن نجد قلنا أفضل من هذه الأمثلة لبيان هذه العلاقة الوطيدة ما بين العلم والتقنية في عالمنا المعاصر. فهل كان اختبار جميع تقنيات القتل والدمار بتسليطها على المدنيين العزل أمراً عارضاً أم سياسة مقصودة ومدروسة بدقة؟
يجيبنا جوناثان ليدر ماينارد عن هذا التساؤل في كتابه «الأيديولوجيا والقتل الجماعي» بقوله: «في الواقع احتقر آرثر هاريس، رئيس «قيادة القاذفات» البريطانية بداية ً من فبراير 1942، المعارضة «العاطفية» لقصف المدنيين [التشديد من عندنا] ومحبطاُ من جهود الحكومة لتضليل الجمهور. وطالب بتوضيح الأهداف الحقيقية للقصف الجوي، وكتب:
«الهدف من «هجوم القاذفات المتآلف»…هو تدمير المدن الألمانية، وقتل العمال الألمان، وتعطيل حياة المجتمع المتحضر في أنحاء ألمانيا كافَّة. يجب التأكيد على أن تدمير المنازل، والمرافق العامة، والمواصلات، والأرواح…على نطاق غير مسبوق…هو هدف مقبول ومقصود لسياسة القصف. وليس نتيجة ثانوية لمحاولة ضرب المصانع» (15).
أتذكر في النهاية مقطعاً من عرضٍ مسرحي ساخر للفنان الفرنسي، من أصول أفريقية، Dieudonné وهو يعرض ساخراً مشهد جندي من جنود الاحتلال موجهاً درونه إلى عمق غزة لقصف أطفالها، وبينما هو يحتسي كأس نبيذ، طلب من زوجته مده ببعض المكسرات، وحين سألته: أين أنت؟ أجاب: أنا الأن فوق غزة! بذلك يكون الوجه التقني للحداثة قد أتاح القتل بضمير مرتاح!
ما أشبه البارحة باليوم يا غزة!
هوامش
(°) يعود الفضل في ذلك إلى الفيزيائي الألماني ماكس بلانك الذي تمكن من تفسير ظاهرة الطيف الصادر عن الجسم الأسود، لكن الثمن كان باهضاً، إذ كان لزاماً عليه التخلي عن أحد المبادئ الأساسية التي شيدت عليها الفيزياء الكلاسيكية صرحها أي مبدأ الاتصال!
بهذا الخصوص هناك تصريحات لعدد من المسؤولين والمستعمرين الإسرائيليين الموثقة بالصوت والصورة التي تعتبر أن استهداف الأطفال وقتلهم هو أمر مشروع، مما يثبت زيف مقولة «الخسائر الجانبية».
– Revue L’homme 170/2004, pp. 231-244
استندنا هنا على ما ورد في كتاب:
Raymond Aron : Les étapes de la pensée sociologique, Éditions Gallimard, 1967, pp. 500-511
– أتذكر هنا ما قالته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت حين سألتها الصحفية ليزل يشتال عن قتل نصف مليون طفل عراقي جراء الحصار، حيث ردت قائلة: «أعتقد أن الثمن يستحق»، أي أن قتل أولئك الأطفال إذا كانت الغاية، على الأقل الظاهرة، هي إسقاط صدام حسين، فلا حرج!
– يمكن إدراج ما أقدم عليه أفراد أسطول الحرية ضمن الفاعلين الذي تحركهم، رغم اختلاف جنسياتهم وعقائدهم وألوانهم، قيم وغايات إنسانية عليا. كذلك الشأن بالنسبة للشابة الأمريكية راشيل كوري التي داستها جرافة إسرائيلية حين حاولت ثني سائقها عن هدم منزل أحد الفلسطينيين؛ أول أيضاً إقدام الجندي الأمريكي أرون بوشنل على حرق نفسه تضمنا مع الشعب الفلسطيني في غزة…الخ
– Raymond Aron : Les étapes de la pensée sociologique, Éditions Gallimard, 1967, p. 501
– يميز الفيلسوف والمحلل النفسي ميخائيل بيناسياك Miguel Benasayag في حوار مطولاً أجري معه، وتم تجميعه في كتاب تحت عنوان استبداد الخوارزميات La tyrannie des algorithmes، ما بين العقلانية le rationalité والنزعة العقلانية Le rationalisme. تعني هذه الأخيرة بالنسبة له ذلك الإيمان المبالغ فيه وغير المعقول في العقل، في حين تشير العقلانية إلى ذلك المجموع المبني تاريخياً وهندسة متغيرة لا تختفي، بل تعرف تحولاً هاماً. لذا فالعقلانية لا تقر أن المعرفة السابقة قد هدمت، بل أن كل ما تقول به هو أنها معرفة ناقصة.
– يقصد الذهول أمام ما حدث لليهود إبان الحرب العالمية الثانية أو ما يعرف بالهولوكوست.
– باومن، زيغمونت. [1989] الحداثة والهولوكوست. ترجمة حجاج أبو جبر-دينا رمضان 2019. بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الصفحة 346.
– القولة مأخوذة من نسخة إليكترونية غير مرقمة:
Miguel Benasayag : La tyrannie des algorithmes, éditions Textuel, version numérique 2019.
– لا يمثل التقدم التقني شرطاً رئيسياً للتقدم الأخلاقي، يكفي استحضار حالة أسرى المقاومة الفلسطينية ومقارنتها بالمختطفين في سجون الاحتلال لإثبات صحة هذا التحليل.
– Miguel Benasayag : La tyrannie des algorithmes, éditions Textuel, version numérique 2019
– باومن، زيغمونت. [1989] الحداثة والهولوكوست. ترجمة حجاج أبو جبر-دينا رمضان 2019. بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة و السياسات الصفحة 342.
– الاحتلال وهو يوجه طيارة بدون طيار فوق غزة لقصف أطفالها، وبيده كأس خمرٍ طالباً من زوجته مده بقطع من المكسرات، وحين سألته
– ماينادر، ليدر جوناثان. الأيديولوجيا والقتل الجماعي، السياسات الأمنية المردكلة للإبادات الجماعية والفظائع المميتة، ترجمة محمد الدخاخني 2025. الطبعة الأولى بيروت. الشبكة العربية للأبحاث والنشر، الصفحة 276.
(*) مترجم وباحث
في فلسفة العلوم