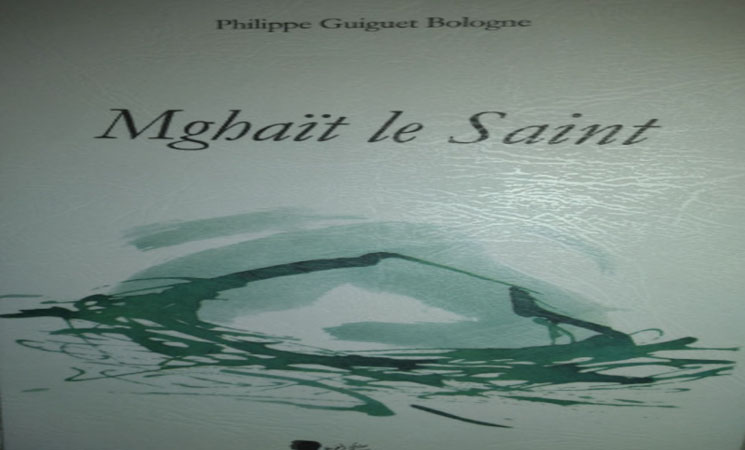الإبداع والمكان.. سلطة للحكي بلا ضفاف، وآفاق مشرعة أمام نظيمة الخلق والتأمل والاستلهام. لا يحمل المكان صفات الإقامة فحسب، ولا خصائص المستقر فحسب، ولكنه قبل كل ذلك، منبع السكينة التي تصنع مباهج الحياة وتمنح للوجود ميسمه الخاص ونكهته الفريدة وأحلامه النوسطالجية. لذلك، ظل هذا الموضوع مثار استقطاب متواصل ليس –فقط- بين صفوف المبدعين والفنانين، ولكن –كذلك وبنفس القدر- لدى كل من يصنعون صفة العمق ومنزع التميز وألق التفرد في السلوك وفي العشق وفي تجسير أسباب التباعد بين ضغط الحياة اليومية من جهة، وبين سمو البعد الفرداني داخل غوايات الذات الباحثة عن صفائها من جهة ثانية.
مناسبة هذا الكلام، صدور العمل الجديد للكاتب فيليب كيكي بولون، تحت عنوان «سيدي امغايث»، باللغة الفرنسية، سنة 2020، وذلك في ما مجموعه 96 من الصفحات ذات الحجم المتوسط. والكتاب، استثمار صوفي لخصوبة المكان ولطراوة الوجوه، يعيد -من خلاله- المؤلف استكمال حلقات تأملاته العميقة في حصيلة التراث الرمزي الذي اشتغل عليه في كتابه الأول الصادر سنة 2019 تحت عنوان «نيلة» والذي خصصه للاحتفاء بتجربة الفنان التشكيلي خليل غريب. لا يتعلق الأمر بدراسة تاريخية حول ضريح سيدي امغايث، ولا برصد جغرافي لتحولات الفضاء السوسيومجالي، ولا بانبهار عجائبي بجمالية الموقع السياحي الذي يؤثثه الضريح، بقدر ما أنه سرد تأملي يحتفي بطريقته الخاصة بدهشة اكتشاف فضاء فطري، لايزال يحافظ على معالم تجانس مكوناته البشرية والطبيعية والثقافية، استنادا إلى موروث رمزي غني ومتنوع، أصيل في التاريخ وفي الهوية وفي الانتماء.
يقع ضريح سيدي امغايث -اليوم- داخل المجال الترابي لجماعة الساحل الشمالي التابعة ترابيا لدائرة أصيلا على بعد كيلومترات قليلة جنوب هذه المدينة في اتجاه مدينة العرائش. ويشرف هذا الضريح على شاطئ استثنائي في كل شيء، في بهاء جماله، وفي أساطيره العجيبة، وفي قصصه اللامتناهية حول دور المنطقة في مجابهة جحافل الغزو البرتغالي الذي ضرب مدينتي أصيلا وطنجة سنة 1471، وفي تساكن وجوه الساكنة مع تفاصيل تراب الأرض لحد التماهي، ثم في ارتباط مدينة أصيلا ب»تركة» هذا الفضاء وبقدسية هذه البركة المتوارثة جيلا بعد جيل.
لقد قيل الشيء الكثير حول هذا الفضاء، وبرزت أعمال تاريخية رصدت أدواره المثيرة في سياق المد الجهادي المواجه للغزو الإيبيري للقرن 15م، وخاصة عند الحديث عن محطات كبرى في مسار هذا المد، مثلما هو الحال مع معركة «الحومر» الشهيرة التي نجد تفاصيل عنها في مصنفات المرحلة مثل كتابات الحسن الوزان وبرناردو رودريغيز. وفي المقابل، انشغل مبدعو مدينة أصيلا باستلهام خصوبة «المكان» لإنتاج نصوص على نصوص، وكتابات على كتابات، وإبداعات على إبداعات، اختارت الاحتفاء بمعالم هذه الخصوبة لإنتاج سرديات مخصوصة ونظم شعري فريد في موضوعاته، مثلما هو الحال مع أعمال بعض الرواد من أمثال أحمد عبد السلام البقالي، ومحمد البوعناني، والمهدي أخريف، وعبد السلام اللواح،…
لقد أحسن فيليب كيكي بولون التقاط تفاصيل الجمال داخل هذا الفضاء الفريد، فترك لعينه، عين المبدع الملتفتة للتفاصيل وللجزئيات، متعة البحث عن متعها الفريدة المنفصلة عن صخب العالم وعن ضجيج الآخر، في مقابل إشباع سكينة الروح وإرواء ضمئها من إكسير الذات الباحثة عن صفاء السكينة. في هذا الإطار، جاءت قراءته تفكيكية لثروة هائلة من الرموز اللامادية التي يحفل بها فضاء سيدي امغايث، وهي رموز لا يلتفت لها سكان المنطقة بحكم طابعها الاعتيادي اليومي، وبحكم أن «المكان» لايزال على الفطرة، فطرة الولي الصالح وبركته وكراماته الغائبة/الحاضرة. وكأني به حارس أمين ينتصب في كل وقت وحين، ناشرا ظله ضد كل أشكال المسخ الذي بدأ يتسرب إلى المنطقة، ليمس بعذريتها وليجردها من انزوائها الذي ظل يصنع بهاءها على امتداد العهود الطويلة الماضية.
يعتمد نص فيليب كيكي بولون على حكي عجائبي، ينهل من أساطير الفضاء المتوسطي الواسع، وينفتح على تاريخ البحار وقصص المستكشفين والرحالة، وينبش في معالم جمال المنطقة وفي السلط الرمزية لحارسها الأمين، الولي «سيدي امغايث». وفي هذا الجانب بالذات، تبدو الكتابة التخييلية والتأملات الانطباعية والتفاعل الفكري، مدخلا لإعادة قراءة رؤى «الآخر» الأوربي تجاه تفاصيل الواقع الحميمي للناس البسطاء الذين يصرون على دوام أنساقهم المعيشية الفطرية في التعبير عن ذاتها في الموقف وفي السلوك وفي نظم تدبير الحياة اليومية. لذلك، انفتح المؤلف في «مقارناته» على معالم الخصوصية داخل أقاصي الفضاء المتوسطي الواسع، ليسقط خلاصاته على واقع فضاء سيدي امغايث، الأمر الذي يتيح للمؤرخ مداخل مهمة لإعادة مقاربة نظيمة التمثلات الذهنية التي أضحت تحملها نخب أوربا الراهنة تجاه المجالات المغلقة داخل أقاصي عوالم ما وراء البحار.
يحضر التاريخ قويا في نص فيليب كيكي بولون، يحضر التاريخ من زاوية الاستثمار الإبداعي والتخييلي. ومن هذه الزاوية بالذات، فإنه يكتسب القدرة على التوثيق للتراث الرمزي اللامادي بشكل قد لا نجد مثيلا له داخل بنية النصوص التاريخية التخصصية في معناها الحصري الضيق وفي أدواتها المنهجية في البحث وفي التدقيق وفي التقصي وفي التدوين. هي كتابة متحررة من قيود الأدوات الإجرائية التي يفرضها منطق المؤرخ وصرامته المعروفة. باختصار، هي كتابة تعيد تحقيق التصالح الضروري مع خصوبة فضاء الظل، وثروات الهامش، ونزوات المنسي. لذلك، فهي أداة أساسية في فهم تحول ذهنيات «الآخر» في تلقيه للصور وللكليشيهات المحلية، بعد أن يحقق التصالح الضروري مع عينه المبدعة، فتشيح عن الاستيهامات العجائبية الموروثة عن الكتابات الكولونيالية لمراحل الاستعمار. وفي ذلك تعبير جلي عن إخلاصها في الاحتفاء بالإنسان، أي إنسان، وفي حسن الإنصات لفضيلة السكينة التي تضفي على هذا الإنسان إنسانيته.