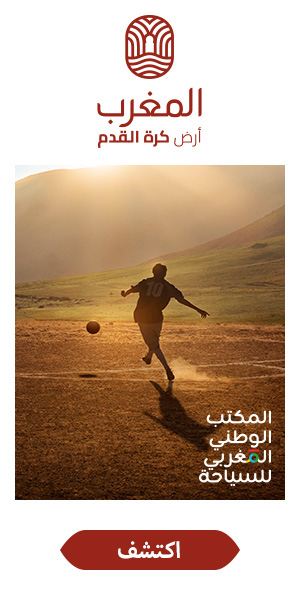ناقش الباحث خالد مصلوحي، الإطار بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يوم الاثنين 10 نونبر 2025 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا (التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط)، أطروحته المعنونة بـ «السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011»،
وتركز البحث على تحليل الدور المحوري للسلطة التنظيمية في تفعيل المبادئ الدستورية والسياسات العمومية، باعتبارها أداة لتجسيد الشرعية القانونية وضمان نجاعة القرار العمومي، مع إبراز حدودها القانونية والدستورية وعلاقتها بالمؤسسة الملكية والسلطة التشريعية، إلى جانب دور القضاء
في مراقبة شرعيتها.
وبعد المناقشة نال الباحث درجة الدكتوراه بميزة مشرف جدا في القانون العام
والعلوم السياسية.
الأهمية الموضوعية لدراسة السلطة التنظيمية
تبرز أهمية دراسة هذا الموضوع من الناحية الموضوعية في كونه يمس جوهر الدولة الحديثة القائمة على قاعدة الشرعية القانونية. فالسطة التنظيمية هي الأداة المحورية التي تُحوّل المبادئ الدستورية إلى واقع عملي ملموس، وتُمكّن الحكومة من تفعيل السياسات العمومية والقوانين عبر نصوص تنظيمية تُنزل مقتضياتها بدقة، دون إضافة أو نقص أو إخلال بالقواعد الدستورية والمواثيق الدولية المصادق عليها. وهي بالتالي مرتبطة بحقيقة وفعالية السياسات والمشاريع الحكومية في مختلف المجالات ، في الاقتصاد والاجتماع والمال والاستثمار.
وهي وسيلة مقيدة بضوابط صارمة دستورية وقانونية، حيث أن خرق تلك الضوابط يمكن أن يجعل القرار التنظيمي منحرفًا، ويضر بمصالح الدولة والمجتمع، ويؤدي إلى تضخيم المنازعات الإدارية والمس بهيبة وشرعية المؤسسات.
وتبرز الأهمية بالخصوص أن الموضوع لا يلامس فقط جوهر تنظيم السلط، والعلاقات بين المؤسسات الدستورية بل بارتباط الموضوع بكل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
فالمؤسسة التشريعية لا يمكن لها أن تضبط كل تفاصيل ومجال التقنين، والحياة الحديثة معقدة جدا ، في مجالات المال والاقتصاد والصحة والبيئة و التعليم و الحماية الاجتماعية …( شروط فتح المصحات، تحديد التسعيرة المرجعية، بروتوكلات التلقيح، ضبط المناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات في الأسلاك، تحدد كيفية دعم المقاولات وطرق مراقبة الجودة، تبسيط المساطر القانونية.
تنظيم الحياة يتطلب تقنينا ديناميا، يمزج بين قواعد الأمن القانوني من جهة، وسرعة التدخل التنظيمي للاستجابة للتحولات والتغييرات ، حفاظا على نجاعة القرار العمومي.
الإشكالية والفرضية
أولا : الإشكالية
يندرج هذا البحث ضمن الدراسات الدستورية وعلم السياسة والقانون الإداري ، وتتمثل الإشكالية المركزية في السؤال الآتي:
ما هي حقيقة السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011، أخذا بعين الاعتبار العلاقة مع المؤسسة الملكية؟
تتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية:
ما العلاقة بين السلطة التنظيمية والمجال المحفوظ للملك؟
ما أثر التعيينات في المؤسسات الاستراتيجية على ممارسة رئيس الحكومة لاختصاصاته التنظيمية؟
ماهي القواعد الضابطة للتشريع التنظيمي ، وما علاقة رئيس الحكومة بفريقه الحكومي، حماية للقرار التنظيمي من كل منزلق دستوري قانوني أو تدبيري ، يمس جوهر السياسات العامة و العمومية للدولة.
وكيف يمارس القضاء، الدستوري والإداري، رقابته على هذه القرارات ، حماية للشرعية
ثانيا : فرضية البحث
تنطلق الفرضية من كون دستور 2011 أحدث نقلة نوعية في توزيع الاختصاصات، إذ منح رئيس الحكومة سلطة تنظيمية أصلية، لكن ممارسة هذه السلطة قد تتأثر بواقع التوازنات السياسية، و بمركز الملكية المحوري في نظامنا السياسي أو بالاختلالات المرفقية، على مستوى الفاعل العمومي من حيث الإعداد و التصور و المشاورات ودراسة الأثر و فحص قواعد المشروعية و التنسيق و التدقيق ، قبل اتخاذ القرار التنظيمي.
ثالثا : منهجية البحث
اعتمدنا في هذه الدراسة ، منهجية تقاطعية ،تجمع بين التحليل الدستوري والقانوني والسياسي، ولا تقتصر على دراسة النص الجامد بل تربط ذاك بالممارسة الفعلية.
تبنينا منهجا بسيطا «المنهج الوصفي والتحليلي» لعرض وتفسير النصوص الدستورية والقوانين ذات الصلة.
ويُكمّل ذلك ، المنهج التاريخي لتتبع تطور هذه السلطة لغاية 2011.
كما استعانت الدراسة بنصوص مقارنة بالاستئناس بالتجربة الفرنسية ذات التأثير الواضح على التشريع المغربي.
إضافة إلى ذلك، تحليل قرارات القضاء الدستوري و الإداري ، حيث تبرز الإشكالات الحقيقة و لعملية من الناحية الدستورية و القانونية ، و أثر ذلك على علاقة المواطن بالإدارة و سياستها العمومية ، و التجاوزات التي تحدث بفعل اختلالات تدبير القرار التنظيمي .
تناول هذه الدراسة بشكل معمق الأصول النظرية والتاريخية للسلطة التنظيمية في المغرب، مستعرضةً تطورها من مرحلة اللاتنظيم إلى الضبط الدستوري، مروراً بتنظيم السلط وفق دساتير 1962-1996، وصولاً إلى تقوية مكانة رئيس الحكومة بعد دستور 2011 وما نتج عنه من توازن مقترح بين السلط. كما تتطرق الدراسة إلى المجال الدقيق للسلطة التنظيمية، مؤصلةً نظرياً لظهورها ضمن سياق مبدأ الفصل بين السلطات في النظامين الفرنسي والمغربي، ومحددةً أنواع المراسيم التنظيمية في القانون المغربي (دستورية، تشريعية، وتطبيقية). وفي قسمها الثاني، تركز الدراسة على توزيع الاختصاص التنظيمي بين الملك ورئيس الحكومة، حيث يُنظر إلى رئيس الحكومة باعتباره صاحب السلطة التنظيمية الأصلية، مع تحديد المجالات المحفوظة للملك. وتختتم الدراسة بتحليل الرقابة الدستورية والإدارية على القرارات التنظيمية، موضحةً دور القضاء الدستوري في حماية مجال الاختصاصات والفصل بين التشريع والتنظيم، بالإضافة إلى آليات الطعن القضائي ضد المراسيم والقرارات التنظيمية.
أولا: دستور 2011 – دستور «الملكية الثانية»
شكل دستور 2011 نقطة تحول جوهرية، ارتقى بالنظام السياسي المغربي من ملكية تنفيذية/شبه رئاسية إلى ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية. كان التحول الأساسي هو تقوية صلاحيات رئيس الحكومة في المجال التنفيذي (تغيير اسمه من «الوزير الأول» إلى «رئيس الحكومة»)، وأصبحت سلطة الملك مقيدة بتعيينه من الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات (الفصل 47).
صلاحيات رئيس الحكومة المعززة: أصبح فاعلاً رئيسياً في التعيين في المناصب العليا، وتم دسترة مجلس الحكومة كهيئة تداولية برئاسته للمصادقة على النصوص التنظيمية ونشرها مباشرة، مع حفظ المجال المحجوز للملك (الأمن الروحي والدفاع الوطني). دور الملك: يمارس دوراً موجِّهاً للسياسات العامة وحكماً في القضايا الكبرى الاستراتيجية.
ثانيا: الملك والمجالات المحفوظة (الفصلان 41 و 53)
يمتلك الملك سلطة تنظيمية حصرية بناءً على الفصلين 41 و 53:
1- في الشأن الديني (الفصل 41 – أمير المؤمنين)
الاختصاص الحصري: ظل المجال الديني محجوزاً لإمارة المؤمنين ولا يمكن تفويض السلطة فيه.
الملاحظات والإشكاليات: انتصرت الملكية لمفهوم الدولة المدنية. واقتُرح تفويض المجال التنظيمي المرتبط بالتدبير الإداري والمالي لرئيس الحكومة في هذا الشأن (دون المساس بالجوهر السيادي)، أسوةً بإدارة الدفاع الوطني، لمعالجة عدم الاتساق في النصوص الصادرة بعد 2011.
2- مجال الدفاع الوطني (الفصل 53 – القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية)
الإدارة التشاركية: يُدار بمنطق تشاركي واستشاري. تخضع المراسيم والقوانين لمسطرة مصادقة مزدوجة (مجلس الحكومة ثم المجالس الوزارية)، ليَبُتّ فيها الملك، صاحب الاختصاص الأصلي.
إشكالية الخلط: سُجل استمرار الخلط بين المجال التنظيمي والقانوني في الظهائر الشريفة.
الاختصاص الحصري لرئيس الحكومة والدور التوجيهي للملك
الاختصاص الحصري لرئيس الحكومة: في المجال التنظيمي
يصبح الاختصاص التنظيمي حصرياً لرئيس الحكومة في جميع المجالات الأخرى خارج نطاق التدبير الديني وإدارة الدفاع. يتم المصادقة على المراسيم والقرارات في مجالس الحكومة، وتُرفع تقارير لاحقة للملك للاطلاع.
الدور التوجيهي للملك
تظل الملكية عنصراً مؤثراً وموجِّهاً للسياسات العمومية عبر صلاحيات دستورية وأعراف مكرسة، لضمان وظيفتها الرئاسية والتوازن بين السلطات. وتتمثل وسائل التوجيه في:
الموافقة المسبقة على مشروع قانون المالية وقوانين الإطار.
آلية الخطب الملكية لتحديد الأولويات.
توجيه الرسائل للمناظرات الوطنية أو لرئيس الحكومة مباشرة.
تشكيل لجان موضوعاتية لتحديد توجهات استراتيجية.
جلسات العمل الملكية لمتابعة ملفات استراتيجية (تؤدي لاتخاذ قرارات تنظيمية من الحكومة).
التأثير في القرارات ذات الطابع الاستراتيجي أو الرمزي المرتبطة بالهوية الوطنية واللحظات المفصلية.
ملاحظة عامة: احترمت الملكية المقتضيات الدستورية شكلياً في إدارة العلاقة مع رئاسة الحكومة، لكنها تملك وسائل دستورية أو عرفية لتوجيه التعليمات في إدارة الملفات واتخاذ القرارات التنظيمية المرتبطة بالمجالات المختلفة
ضوابط صياغة القرار التنظيمي والمسطرة المتبعة
نص القانون التنظيمي رقم 65.13 (المادة 20) على إصدار نص تنظيمي يحدد دليلاً مرجعياً لكيفيات إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، وهو التزام لم يتم الوفاء به بعد. ومع ذلك، أصدرت الأمانة العامة للحكومة عام 2015 وثائق مرجعية (دلائل حول تحيين النصوص، دراسة الأثر، وصياغة النصوص القانونية).
تُشكل هذه الوثائق إطاراً عاماً لضمان تجويد التشريع واحترام قواعد التراتبية القانونية، والكتلة الدستورية، والاتفاقيات الدولية، وتحديد اختصاص مجالي القانون والتنظيم. تتبع مسطرة الصياغة والإعداد الخطوات الرئيسية التالية:
الإعداد: يكون الاختصاص لقطاع وزاري واحد أو قطاعات مشتركة، مع إمكانية تدخل الأمانة العامة كـ “صاحبة قلم».
الأمانة العامة للحكومة: تلعب دور الهيئة الرقابية لضمان مطابقة النصوص للدستور وعدم تناقضها مع المنظومة القانونية، وحماية الشرعية الدستورية( صياغة دقيقة غير فضفاضة ) الحرص تحقيق الأمن القانوني (عدم رجعية القرارات التنظيمية، وتوفير مهلة زمنية قبل دخولها حيز التنفيذ، ووضوح القاعدة القانونية ومبدأ الثبات والاستقرار.)
اللجان الوزارية: قد تُشكل في بعض الحالات للتداول في المشاريع قبل عرضها على مجلس الحكومة.
التوزيع على أعضاء الحكومة: تُوزع المشاريع على كافة الأعضاء لأسباب سياسية ولتحقيق دراسة التقائية بين وجهات نظر القطاعات.
النشر الإلكتروني: لا يزال محدوداً، ويقتصر على النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالمال والأعمال والاستثمار المتعلقة باتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة (مرسوم 2009).
تهدف هذه الضوابط والشكليات إلى إنتاج تشريع ينسجم مع القواعد الدستورية ، و التراتبية القانونية و عدم تداخل الجانب التشريعي بالتنظيمي ، و التحقق من الاختصاص تجنبا للإلغاء.
وتحصين القرارات التنظيمية من عيوب المشروعية، و تمكن هذه الأجراءات من حسن تنفيذ القرارات و تعزيز الثقة بين الإدارة و المجتمع .
خاصة تلك التي قد تمس مجال تدبير السياسات العمومية، لذلك ينبغي تقييم أثار القرار قبل اعتماده من حيث التكلفة المالية والإدارية والاجتماعية، ويعد هذا الإجراء في كثير من التنظيمات المقارنة خاصة في الاتحاد الأوروبي إجراءا أساسيا
اشكالات وعيوب في الممارسة التنظيمية
سُجلت ملاحظات تنتقد ممارسة السلطة التنظيمية، رغم أهمية المشاورات والمداولة في المجلس الحكومي:
1. غياب أجل النشر وتأخير التنفيذ
المشكلة: لم يتم تحديد أجل لنشر المراسيم والقرارات الوزارية، مما يمنح الحكومة يداً غير مقيدة ويطرح تساؤلاً حول احترام الالتزام الدستوري بتنفيذ القوانين (مثال: تحديد أجل أربع سنوات لتنظيم الإنتاج الذاتي للطاقات المتجددة).
2. الإحالات على النص التنظيمي لتتميم مقتضيات قانونية
المشكلة: لجوء القانون للإحالة على نصوص تنظيمية لاحقة لتتميم مقتضيات قانونية، رغم أهمية رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مثل هذه القضايا (مثال: قضية السجل الاجتماعي الموحد).
3. تعدد الطبيعة الدستورية والتشريعية «للمرسوم»
المشكلة: وسيلة «المرسوم الحكومي» لا تقتصر على المجال التنظيمي (الفصلان 89 و 90)، بل تشمل مراسيم ذات طابع دستوري (كحل البرلمان)، أو طبيعة فردية (كالتعيين في مناصب عليا). هذا الترميز الموحد لوضعيات مختلفة يتطلب مراجعة.
4. الإحالات القانونية وغياب التداول
التفويض للقانون: تفوّض السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية تنفيذ القانون دون تحديد وسيلة أو أجل، ودون تvتيب جزاء عند الإخلال (مثال: 129 نصاً أحال على 880 نصاً تنظيمياً).
قرارات الوزراء (تهريب الحق التداولي): إحالة القانون على قرار أو مقرر لوزير لتنفيذ بعض مقتضياته، أو تأهيل المرسوم التنظيمي لوزراء لاتخاذ قواعد عامة، يُعد مخالفاً للدستور، كونه يُهدر مبدأ ارتباط السلطة التنظيمية برئيس الحكومة (الفصل 90) ويتجنب “الحق التداولي” للهيئة الوزارية (المجلس الحكومي).
5. اللجوء إلى المنشور الإداري
المشكلة: تلجأ الحكومة للمنشور الإداري في قضايا استعجالية أو استراتيجية، رغم أن وظيفته الأساسية هي الإخبار والتفسير، ولا يملك صلاحية سن قواعد قانونية جديدة عامة ومجردة.
أمثلة على عدم الشرعية: إصدار منشورات تناولت قضايا ذات طابع تشريعي (مثل «عرض المغرب» للهيدروجين الأخضر) أو قرارات مخالفة للقانون (كتسوية وضعية الأجانب بمنشور لوزارة الداخلية)، مما يهدر المقتضيات القانونية الأصلية. كما تم اللجوء لمنشورات للتعيين في مناصب عليا دون ضوابط قانونية أو ترخيص من رئيس الحكومة.
6. التفويض التشريعي ومراسيم الضرورة
الخلط والتوصية: أثير خلط بين التفويض التشريعي (الفصل 70) ومراسيم الضرورة (الفصل 81). يوصى بعدم تفويض الحكومة المجالات المالية والضريبية إلا بإجراءات تنظيمية ورقابية خاصة (في مجال الإعفاءات مثلاً). وفي حال الاستعجال، يُفضل اللجوء إلى مراسيم بقوانين (الفصل 81) لكون الحكومة مطالبة بتقديم ملابساتها ويُمكن مبدئياً معارضة استصدارها
مؤسسات صناعة التشريع والتنظيم
أشار النص إلى أن المؤسسات المساعدة لرئيس الحكومة في الإنتاج التشريعي والتنظيمي، وعلى رأسها الأمانة العامة للحكومة ، تبقى غير كافية لتدبير الاستشارة القانونية والرقابة القبلية اللازمة لحماية المنطق الدستوري والقانوني. لذا، دافعت الدراسة عن:
دعم الأمانة العامة للحكومة: لتعزيز الأمن القانوني وتفعيل مبدأ اليقظة القانونية في العلاقات الدولية الاقتصادية والاستراتيجية، مع استمرار مسلسل الإصلاح.
تدعيم مؤسسة الدواوين الوزارية: عبر إعادة تنظيمها وهيكلتها ووضع مقاييس علمية لشغل المناصب الاستشارية.
إحداث هيكل إداري مستقل تابع لرئاسة الحكومة لدعم دور رئيس الحكومة في قيادة وتوجيه السياسات العمومية.
مراجعة التنظيم القضائي للمملكة بإحداث مجلس الدولة المغربي ، له دور استشاري في المراسيم ذات الطبيعة التنظيمية لمساعدة الحكومة في رقابتها المسبقة على التشريعات و التنظيمات ، خاصة في ظل متغيرات تهم طبيعة النقاش العمومي في البلد ، ومكلف بالقضايا ذات الطابع الإداري كهيئة عليا في القضايا المرفقية.
اختلالات المنظومة القانونية والاجتهاد الدستوري
تميزت التجربة التشريعية المغربية، منذ فترة الحماية، بـ «فوضى» على مستوى الإنتاج التشريعي وغياب منطق تراتبي واضح بين القوانين والقرارات التنظيمية. ورغم محاولات الدساتير لـ «العقلنة البرلمانية والتجريد التشريعي»، فقد سُجلت الاختلالات التالية:
1. اختلالات التجريد التشريعي
المشكلة: عند لجوء الحكومات إلى مسطرة التجريد التشريعي، تُبقي على التسمية الأصلية للنص (كالظهائر الشريفة القديمة)، حتى لو كان النص ينتمي الآن إلى المجال التنظيمي بموجب الدستور.
النتيجة: هذا السلوك لا يساعد على تطهير المنظومة القانونية، حيث تظل ظهائر قديمة (مثل ظهير التقسيم الإداري أو نظام المحاسبة العمومية) مرجعاً، في مخالفة صريحة لقواعد التدرج القانوني (كان يجب إلغاء الظهير وإصدار مرسوم مكانه).
2. الاجتهاد الدستوري في الفصل بين القانون والتنظيم
الممارسة السابقة: كان القضاء الدستوري المغربي قليلاً ما يجتهد لوضع قواعد فاصلة بين المجالين التشريعي والتنظيمي، واكتفى بالأحكام الكلاسيكية.
التحول الجوهري (قرار 203-22 لعام 2022): يُمثل هذا القرار «ثورة» ومرجعاً جديداً، حيث تبنى معياري «عدم الاختصاص السلبي» و»الإغفال التشريعي».
نتائج قرار المحكمة الدستورية رقم 203-22:
عدم الاختصاص السلبي: يفرض على المشرع تنظيم كل ما ينتمي لمجال الحقوق والحريات الأساسية تنظيماً دقيقاً ومفصلاً، وعدم جواز التفويض في تنظيم تلك الضمانات.
الإغفال التشريعي: يمنع المشرع من إصدار صيغ قانونية غامضة أو ناقصة قد تؤدي إلى سوء فهم أو تأويل يمس الضمانات والحقوق الدستورية.
القاعدة العامة: كل ما يتعلق بـ الحقوق والضمانات ينبغي تنظيمها بمقتضى القانون.
الخلاصة وتأثير القرار:
هذا القرار يفرض على المشرع التدقيق الكافي في تنظيم المقتضيات لمنع التأويل الذي يمس بالضمانات الدستورية.تنطبق هذه القاعدة أيضاً على القرارات التنظيمية الصادرة بناءً على إحالات غير مبررة على قرارات وزارية خارج الهيئات التداولية.
خطر الإغفال: الإغفال التشريعي لا يمس فقط اختصاص المؤسسة التشريعية، بل يفتح المجال للسلطة التقديرية للسلطة التنفيذية باتخاذ قرارات قد تخالف جوهر القواعد القانونية، مما ينتج عنه كلفة على مستوى الخصومة والحكامة الإدارية.
الرقابة الدستورية والقضائية للقرارات التنظيمية
الرقابة الدستورية والإدارية على القرارات التنظيمية
يتناول هذا الجزء آليات رقابة النصوص التنظيمية في المغرب، ويسلط الضوء على الإشكاليات الحالية والمتوقعة:
1. الرقابة الدستورية المباشرة (التبعية)
القاعدة الحالية: لا يمكن في الدستور المغربي إثارة عدم دستورية المراسيم أو القرارات التنظيمية مباشرة.
آلية الرقابة: تُعتبر القرارات التنظيمية التفصيلية غير دستورية بالتبعية فقط، إذا صدر قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون الأصلي الذي استندت إليه.
2. تأخر تفعيل الدفع بعدم الدستورية (الفصل 133)
المشكلة: رغم إقرار مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين (الفصل 133)، فإنه لم يُفعَّل بعد بسبب تأخر الحكومة في تنزيله (مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24).
التأثير: هذا التأخر يعطل تطور الرقابة الدستورية وحماية الحريات.
3. اجتهاد المحكمة الدستورية في القانون التنظيمي للإضراب
الشرط الجديد: المحكمة أقرت بدستورية مادة في القانون التنظيمي الخاص بالإضراب، لكنها اشترطت أن تكون النصوص التنظيمية الخاصة به مطابقة لجوهر مقتضياتها.
التساؤل المستقبلي: يُطرح تساؤل حول ما إذا كانت المحكمة الدستورية ستسمح للقضاء الإداري (الغرفة الإدارية بمحكمة النقض) بـ مراقبة مدى دستورية تلك النصوص التنظيمية (خاصة بعد تفعيل الفصل 133)، وهي التي سبق ورفضت الرقابة الخارجية للتشريعات.
4. التوقعات المستقبلية (مراجعة دستورية ونظام الحكم الذاتي)
الحاجة الملحة: المملكة مقبلة على مراجعة دستورية لـ إقرار نظام الحكم الذاتي بالجهات، مما يتطلب إنشاء حكومات وبرلمانات جهوية تتخذ قرارات ذات بعد تنظيمي.
الضرورة الدستورية: لا بد من تمكين السلطة المركزية من حق الدفع بعدم دستورية قرار أو قانون جهوي يمس بالقواعد الدستورية الأساسية.
5. إشكال سلطة القضاء الإداري
تساؤل المشروعية: يُطرح تساؤل حول مدى امتلاك القضاء الإداري (بعد تفعيل الفصل 133) سلطة البت في مشروعية القرارات التنظيمية ومخالفتها للقانون التنظيمي، خاصة وأن القضاء الدستوري لم يمنح للقضاء العادي سلطة فحص دستورية المقتضيات القانونية.
مأمول التطور: يُعتقد أن تفعيل الفصل 133 سيُنشئ تراكماً قضائياً يدفع إلى مراجعة أساسية لـ توسيع هامش الطعن ليشمل المراسيم والقرارات التنظيمية.
6. الطعن أمام القضاء الإداري
القاعدة الدستورية: ينص الفصل 118 على أن كل قرار إداري (تنظيمي أو فردي) يمكن أن يكون محل طعن أمام محكمة النقض.
الممارسة الفعلية: لا تزال الدعاوى الإدارية قليلة ضد القرارات التنظيمية، رغم تسبب بعضها في إشكالات مجتمعية (مثل قضايا الأساتذة المتعاقدين أو إضراب طلبة الطب)، وكان أولى اللجوء للقضاء لتجاوز هذه الوضعيات.
تحصين القرارات الملكية وإشكالات التسمية
وظيفة الملك السيادية: يُمارس الملك وظيفة سيادية مرتبطة بحماية ثوابت المملكة ورئاسة الدولة. وبناءً عليه، لا ينبغي أن يتخذ الملك قراراً إدارياً مباشراً قد يُعرض للطعن القضائي (أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري)، بل يجب أن تُمارس السلطة التنفيذية من طرف السلطات الإدارية المكلفة.
تطهير وضعية الظهير: يجب تطهير وضعية «الظهير» (الذي يحمل حمولة تاريخية) لربطه فقط بالقرارات السيادية وتنفيذ القوانين ، سواء المصادق عليها برلمانياً أو التي يمارسها الملك في مجاله المحفوظ.
تفويض المجال التنظيمي المحجوز: يجب تفويض الاختصاص التنظيمي المحجوز للملك (ضمن المجالس الوزارية) إلى رئيس الحكومة ليتحمل تبعات القرارات التي يوافق عليها الملك.
تمييز القرارات الفردية الملكية: يجب على العقل الجمعي إعطاء تسمية ورمز خاص للقرارات الفردية الملكية (مثل التعيينات)، بحيث يتم تمييزها عن القرارات السيادية والتشريعية. ويُقترح إصدارها بصيغة «مرسوم ملكي بتعيين…» مع السماح لرئيس الحكومة بالتوقيع بالعطف، باستثناء التعيينات المرتبطة بالمؤسسات الدستورية المستقلة.
الطعن في الامتناع التنظيمي: يمكن الطعن في القرارات التنظيمية السلبية (امتناع الحكومة عن إصدار مرسوم تنفيذ القانون) بسبب الشطط في استعمال السلطة. لذا، يجب أن تصدر المراسيم في آجال معقولة يتم تقنينها بقوة القانون أو بتعديل القانون التنظيمي رقم 65.13.
إهداء خاص و شكر
و أخيرا أود أن أهدي هذا العمل لوالدي رحمه الله ، الذي أوصاني بضرورة الحرص على تتميم ، كان ذلك قبل يومين عن رحيله ، أهديه هذا العمل في هذا الشهر الغالي على الأمة المغربية بما يحمله من رمزيات التحرر و الاستقلال و استكمال الوحدة الترابية ، و هوأحد رجالات المغرب العظيم بقيادة ملوك شرفاء و وطنيين ، تحملوا مسؤولية الدفاع عن الوطن في وجه مؤامرات الخصوم.
أهدي هذا العمل لوالدتي حفظها الله ، ولأبنائي :العزيز المهدي و العزيزة هبة.
و اشكر أستاذي المكي السراجي شكرا خاصا ، بفضله و فضل الفريق البيداغوجي المتميز ، تتقدمهم رفيقته الفاضلة الأستاذة نجاة ، استطعنا استكمال البحث الأكاديمي ،
فقد كان هو الملهم لاختياري هذا الموضوع ، و هو سيد الباحثين في القرار التنظيمي .
و أشكر السادة أعضاء لجنة المناقشة مجددا على قبولهم مناقشة هذا العمل ، و سأكون سعيدا بملاحظاتهم التي ستشكل إن شاء الله قيمة مضافة لهذه الدراسة.