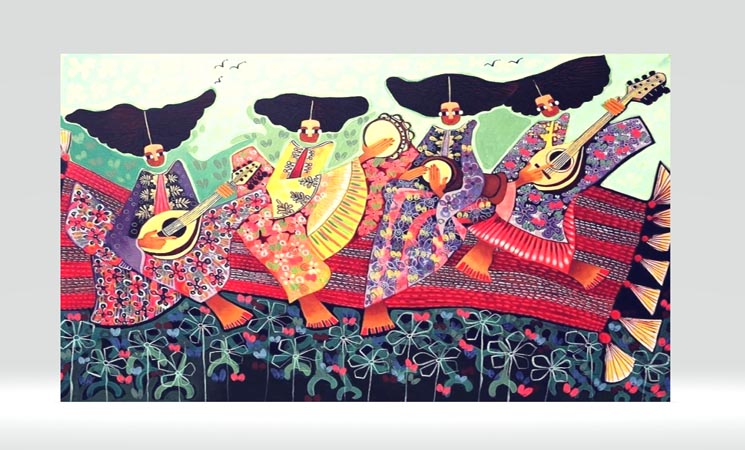مقدمة
يتحدد مرمى هذا العمل في التساؤلين المركزيين التاليين:
بأي معنى تتيسر لنا معرفه الماضي بالارتكاز على الثقافة الصوتية؟ ثم ما هي حدود اعتماد هذه الثقافة وثيقةً تقْدِر على كتابة مُجَدِّدَة للتاريخ الاجتماعي المحلي؟
سنقترب من هذين الاستفهامين التساؤليين من خلال الوقوف على المعالم العامة للمدرسة المغربية في التاريخ، والنظر في التطورات الفكرية والمنهجية التي طرأت على مسارها مع بروز جيل من المؤرخين يستلهم مستجدات ما سمي بالتاريخ الجديد؛ وهو الاتجاه الذي ينتمي إليه تأكيداً الباحث المغربي علال ركوك.
كتابة التاريخ الوطني:
مر مشروع كتابة التاريخ الوطني من مرحلتين: التأسيس النظري ثم مرحلة الاستقصاء المنظم التي انبنت على البحث والتنقيب على الوثيقة المغربية الأصيلة.
-مرحلة التأسيس النظري:
وتمتد من 1956إلى 1975. ارتبطت هذه المرحلة ارتباطا وثيقا بلحظة الاستقلال، ومشروع استتباب الدولة الوطنية، وبناء مجتمع جديد. لذلك اتجه اهتمام الباحثين صوب إعادة قراءة الإستوغرافيا المغربية، ونحو التفكير ثانية في الجهاز النظري، والمرتكزات العامة للإسهام الكولونيالي، وخلفياته الإيديولوجية في الدفاع عن مصالحه السياسية وقُصُودِه الاستراتيجية.
– مرحلة الوثيقة المحلية:
تم تحديد هذه المرحلة من 1976 إلى 1986. في خضمها تشكل جيل من المؤرخين جديد نهل معارفه النظرية من التطورات التي أحدثتها الانقلابات العلمية على مدار العقود الأخيرة في مجال المعرفة الإنسانية ومناهجها المختلفة. خلال هذه المرحلة انصب البحث التاريخي على الدراسات المنوغرافية المستندة على الوثيقة المغربية. فقد تبين لجرمان عياش، في هذا الصدد، وهو بلا غرور، أحد رواد هذا التوجه، أن المؤرخين الاستعماريين تطرقوا لمختلف أطوار تاريخ المغرب فأنجزوا دراسات نسقية حول المجتمع المغربي. والملاحظ أن هذه الإسهامات إن كانت في جزء منها على قدر كبير من الأهمية، بالنظر الى ما قدمته بصدد بنية السلطة المخزنية، وأشكال الصراع في البوادي، والإسلام، ومؤسسات الزوايا، والأسر الكبرى بالإضافة إلى الأعيان والزعامات المحلية، وسيكولوجيا الشخص المغربي، ونمط الثقافة السائدة… فإنها ظلت محكومة، إن بصورة جلية أو مستترة، بالفلسفة التطورية والنظرة الأورو-مركزية التي وسمت القرن التاسع عشر الشيء الذي جعلها تسقط أوصافا، ونعوتا غريبة على المجتمعات المغايرة، وتعتمد سلسلة من الثنائيات الاختزالية اللاجدلية: الشرق/ الغرب، التقليد/ الحداثة، البداوة/ التحضر(=التمدن)، المخزن/ السيبة، الأمازيغ/ العرب لتمرير مقولات اللاتمفصل بين الوطني والمحلي، ولتأكيد أن المغرب لم يكن أُمَّة ولا دولة بالمعنى المألوف لهذين المفهومين وإنما عبارة عن مجموعة من القبائل؛ والقِسْمات المتصارعة على الدوام؛ ولتدعيم أطروحتها الرامية إلى معاضدة الغازي لبسط السيطرة على المغرب لذلك جاءت تلك الكتابات، في الغالب الأعم، انتقائية، ومُغْرِضة لانكبابها على ترجمة التاريخ الأَخْباري، وسلسلة من الشهادات، ومجموعة من الأساطير «إما بطريقة السماع المباشر، وإما بنقل ما ورد في كتب من تقدمهم من الغربيين، إلا أنه لا يوجد من بينهم، في ما نعلم، أحد استفاد من مصادر مغربية مؤلفة باللغة العربية.» التي»يتوجب أن تبقى لها الكلمة- الفصل في البلد وخارجه.» غاية في تدقيق أمور كثيرة، ونفض الغبار عن أخرى، والتصدي لبياضات، وثغرات الدراسات الاستعمارية كالأوراق الخصوصية التي تحتفظ بها بعض الأسر المخزنية؛ وورثة المرابطين، والقضاة، والعدول ورؤساء الزوايا، والقيمين على بعض الأضرحة، وحفظة وثائق القبائل وأعرافها من مختلف الطبقات ومنها عقود الزواج، والطلاق، والخلع، والفريضة، وملكية الأراضي، والنوازل الفقهية، والرهن، والبيوع، وجرائد التركات، وضوابط عدد من المعاملات المتعددة الوجوه مثل القروض، والسلف، ووثائق الزوايا…
إن الاطلاع على هذه الأوراق والوثائق يسمح لنا، من غير شك، بالعثور على إشارات تاريخية ترتهن بالمواليد، والوفيات، وفترات الجدب والمجاعات، والجوائح، وأنواع الأوبئة، والأطعمة، وتاريخ تعيينات حكام القبائل، وطبيعة الصراعات القبلية وما سوى ذلك من الأحداث المحلية والعامة نفسها في أحايين بعينها.
في خضم هذه المدرسة إذن تشكل وعي مجموعة من الشباب المغربي بأهمية ، وقيمة البحث التاريخي الاجتماعي، كان من بينهم الأستاذ علال ركوك الذي فتح مدار انشغالاته المتعددة على التطورات النظرية والمنهجية التي أحدثها الجيل الثالث من مدرسة الحوليات وبخاصة مع الأستاذ «جاك لوغوف» الذي اعتبر الكتابة عن الماضي حصيلة لكل التواريخ الممكنة بالنظر إلى كونها إعادة بناء مسترسلة، ومنظمة لوقائع الماضي متى استجدت السؤالات الملحة؛ واقتضاها تبدل الأحوال، واستوجبتها اللحظة الحضارية الشارطة لإثراء المنطلقات الفكرية، والنماذج الإرشادية الساعية إلى ردم الحدود والمتاريس بين العلوم؛ وشحذ أدوات الاشتغال سعيا إلىتجديل الحوار بين النظرية الفعالة والواقع الاختباري.
هذه هي الاستراتيجية التي ستحرك الباحث علال ركوك لاقتراح مناولة في العمل قشيبة تُوثِر الاشتغال على وثائق مغايرة يُتَوسل بها تدشين فعل تأريخي مفتوح على منظورات شاسعة وآفاق رحبة؛ ومشروع طموح يَتوخى كتابة تاريخ وطني مختلف عما هو متداول؛ ومغاير عما دأبنا عليه، وعهدناه سالفا وذلك بالنبش في الهامشي والمقصي؛ واستجلاء المهمش والمنسي، وسبر بواطن الطبقات الدلالية للثقافة الصوتية.
لنستفهم بالمحصلة بهكذا صيغة: كيف للتراث الشفهي أن يكون وثيقة تاريخية، وسوسيولوجية في الآن عينه؟ وبأي معنى يفيد في تقديم معرفة معقولة ووجيهة بصدد أحداث الماضي؟
تساؤلان سيقذفان بنا في خضم استجلاء معنى ووظيفة وقيمة خطاب المشافهة الشعبي ثم في أتون صلات علال ركوك نفسه بهذا الخطاب.
الثقافة الصوتية:
لن يكون غرضنا هاهنا تحديد معنى الثقافة أو تَقفِّي معانيها ولوينتها؛ ولا تفصيل الكلام حولها والإفاضة فيه.
فإذا كنا نعني بالثقافة عموما الخيرات المادية والمعنوية، فإن «الثقافة الشعبية هي جملة المفاهيم والمعتقدات والطقوس- السلوك- والآداب الشعبية المتنقلة شفهيا، وهذه الآداب تشمل الشعر والحكم والأمثال والقصص والحكايات والغناء». بالإضافة إلى النكت والرموز، والوشم، والخط Calligraphie، والصوت وكل الأشكال التعبيرية وأضراب الفن الحاملة للتصورات الاجتماعية، والطاقات الخلاقة، الفياضة بأحلام وآمال الشعوب وآلامها التي تشكل في مجموعها من ناحية الإطار المرجعي والإيثوس Ethos الثقافي الذي يحدد به الانسان ذاته، ويحتمي به كيما يتميز به عن غيره داخل جغرافية الثقافات؛ويشكل من ناحية أخرى الذاكرة الجماعية النشيطة التي ترسخ شعبا في الزمان والمكان. فكثيرة هي النصوص الشيقة من فن العيطة الشعبية التي تُجْلِي براعة الشعوب، وبيداغوجيا التعبئة، وتذكي الحمية الجماعية التي تُعاضد مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية، وتُلْحِمُ الاتصال بينها لتخرج إلى واضحة النهار مكبوتها التاريخي؛ وتفجر بالتالي الصراع الدفين الذي تثغثغ به العلامات المتوارية في قوى الصمت هاته.
علال ركوك والثقافة الصوتية:
اعتباران اثنان يفسران، في ما أحسب، العلاقة الوثقى لعلال ركوك بالثقافة الصوتية:
اعتبار يرتبط بالتنشئة وبطبيعة المجال الآسفي-العبدي؛ وثان ذو وشيجة بحقل تخصصه ألا وهو التاريخ الاجتماعي المحلي.
الاعتبار الأول:
ينتمي علال ركوك مثل ما هو معروف إلى منطقة عبدة الشهيرة تاريخيا بثراء ذاكرتها الشعبية؛ ومروياتها المتواترة؛ بحيث يكاد ينعدم فيها التدوين التوثيقي المنظم.
وبالنظر الى هذا، يغلب على ظننا أن يكون الباحث علال ركوك قد استدمج بشكل أو بآخر كل ما يتعلق بالتنشئة وبالإيكولوجيا الثقافية لتنصهر، عبر الزمن، وتتفاعل في كيانه الشخصي لتضحى حافزه للانجذاب، ثم للتماهي مع أحد مكونات المجال، وقصدي هنا» فن العيطة « الذي تردده الذاكرة الجماعية، وتستحضره، بأشكال مختلفة، وفق المساق الحديث، وتبعا لمجرى الكلام، إلى حد أن باحثنا هذا يعد، إلى جانب الأستاذ»محمد أبو حميد»، مرجعا أساسيا في قضايا التراث الشعبي ليس فقط بحاضرة المحيط وأحوازها وإنما المغرب كله.
الاعتبار الثاني:
اختياره لعلم التاريخ حقلا لتخصصه بالجامعة المغربية، في مرحلة أولى، والجامعة الفرنسية في مرحلة ثانية، فالعودة إلى الوطن لممارسة حرفة المؤرخ كتابة، وتحقيقا فترجمة، وليتوج منجزه بأطروحة حدد قضاءها في موضوعة المقاومة المغربية التي تخلقت من مستتبعات صدمة الحداثة المترتبة على منازلة إيسلي في 1844؛ وواقعة تطوان عام 1860، ومحصلات مؤتمر الجزيرة الخضراء عام 1906 مضافا إلى كل هذا احتداد الاصطراع الداخلي التي سيفاقم الوضع لتُشْرَع أبواب المغرب أمام الأطماع الأجنبية مما سيفضي إلى بسط الحماية على مجموع التراب الوطني.
ارتكز علال ركوك في عملية التأريخ لهذه الأحداث على متنٍ تشكَّل من القصيد الزجلي المُغَنَّى الذي رواه المبحوثون عندما استفز الباحث حافظاتهم فحملها على الكلام والإفصاح عن فصول من المعارك الجهادية ضد الوجود الاستعماري. فضمن هذه القصائد الشعبية نعثر على طبيعة المقاومة وطُرُزِها، وكذلك على نوع الأسلحة والمعدات، والآليات العسكرية التي استعملت أثناء المواجهات؛ كما نعثر بين ثناياها على خصال ومواقف المجاهدين نحو العزم، والإقدام والتضحية، وكذا على الأساليب والممارسات السلطوية لدى القواد الكبار، بالإضافة إلى ما وَسَمَ سنوات البؤس، والجوع الشهيرة ب»عام البُون»، أو»عام يَرْنِي» المترتبة عن التقنين المفرط للمواد الغذائية الذي فرضته الحماية الفرنسية على المغاربة لمواجهة ظروف الحرب التي امتدت من 1939 إلى غاية 1945.
هكذا إذن وظف علال ركوك النص الشعبي كوثيقة تاريخية تمدنا بتفاصيل الماضي ودقائقه؛ وتسعفنا في الإنصات لنبض المجتمع وتَحَسُّسِ تضاريسه مثلما تمكننا أيضا من»»تغطية سلبيات ونقائص وثائق المعرفة التاريخية « الرسمية وبالتالي من»تجاوز القصور الذي تميزت به الكتابات التاريخية الحديثة التي اهتمت بما هو شائع ومشهور في مجال التاريخ المغربي».
إنه القصور الذي حدده الباحث علال ركوك في:
* كون الوثائق التي تم اعتمادها في كتابة تاريخ المغرب كالظهائر، والمراسلات السلطانية، ومراسلات الوزراء، وممثلي السلطة وتقاييد المداخيل الجمركية… مصادر ترتبط بأهل السلطان وأصحاب النفوذ والهيمنة.
* أن التاريخ تكتبه عاده الأطراف الغالبة والمسيطرة؛ لذلك يأتي معبرا عن سطوتها وقوتها؛ ومترجما لإيديولوجيتها و وجهة نظرها. من ثمة فغير مُنْبَغٍ البتة اختزال التاريخ في شخصيات بعينها واعتبارها دون غيرها صانعة للأحداث والوقائع.
* إن الأعمال السوسيولوجية وكذا الأنتروبولوجية تؤكد على مفاتيح أخرى تتيح إمكانية الاقتراب أكثر من المجتمعات الإنسانية، وتتمثل في الأقوال المهمشة التي ستسعف في إظهار جوانب أخرى مهمة لاتزال غميسة أو يعتريها لُبسٌ كثير.
بناء على هذا سيجتهد علال ركوك في توسيع معنى الوثيقة التاريخية إذ يقول:»إن النصوص الشفاهية من حيث هي وعي وذاكرة جماعية حية ستبقى تتصارع مع وهم التاريخ المدون» المغلوط» الى أن تفرغه من هذه المحتويات المُؤدْلَجَة لصالح صانعيه.» وبهذا سترتقي الرواية المتواترة مع علال ركوك الى مستوى السجل الذي»يحفظ كل الأحداث المتعلقة بالمجتمع…(الذهنيات، أنساق القانون، الإيديولوجيات)..»
يتحصل من المعطيات التي سقناها آنفا أهمية الثقافة الصوتية في تسليط الأضواء على مراحل معينة من تاريخ مضمر ومسكوت عنه، لهذا السبب أو ذاك، في الوثائق الرسمية التي تعارفنا عليها؛ ودأبنا على اعتمادها في كتابة تاريخ وطني مختلف ومغاير للمألوف. بيد أن هذا الطموح العلمي التواق إلى النبش في هذا المنسي؛ والرامي الى استنطاق المهمش فيه يستوجب حذرا إبستمولوجيا يدعونا إلى إعمال النظر في حيثياته لتقويمه أكثر.
إن ثقافة المشافهة تاريخ متحرك يضمن استمرارية الماضي في الحاضر والمستقبل من خلال الحكي الذي تتكفل به ذاكرة مسنين راكموا تجارب حياتية معتبرة تُقْدِرُهُم على عقد مقارنات بين أزمنة مختلفة؛ وتسعفهم على تقديم انطباعات، وملاحظات إزاء أحداث مضت وولت؛ وحيال ظواهر عايشوها؛ غير أن التعويل على هاته الأداة في جمع المعطيات الميدانية تعترضه عوائق شتى منها:
* ما يتعلق بلغة الراوي الشخصية، ومتى تمكنه من التعبير الدقيق المرتبط بانتمائه الاجتماعي، والمجالي والثقافي.
* تأرجح المُسْتَجْوَب أحيانا بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي إلى حد الخلط بينهما؛ واحتمال انتقائيته (=المستجوَب) للمواضيع التي يعرضها. فالراوي شخص/ إنسان لا يمكن فصله عن وسطه، ومحيطه الاجتماعي والثقافي كما عن تمثلاته، وأهوائه واقتناعاته.
لهذا فقد يصرح بأشياء ويحجب أخرى يحسبها حساسة الأمر الذي يطرح مسألتين: سلامة الذاكرة، والوفاء للماضي المطلوب معرفته والاطلاع عليه.
* الحذر المغلف بالخوف والاحتراس من المستجْوِب؛ ومن كل حديث قد يقتحم الراوي في صُلب أحداث سياسية واجتماعية عايشها أو كان فيها فاعلا.
يتبين بالاستناد الى كل ما سبق أن ثقافة المشافهة تُطْلِعُنا على «الواقع» لكنها لا تقدم تفسيرا ضافيا بصدده. إن الخبر الشفوي مُتَقَلِّبٌ على الدوام، ولا مستقر له في الزمان والمكان الأمر الذي يستلزممن الباحث تنويع مستندات بحثه،وشحذ تقنيات/ أدوات اشتغاله في أفق بناء سؤالاته الفاحصة؛ واستفهاماته الجذرية اعتبارا لكون المسعى يتمثل في العبور من المعطيات الخام صوب لحظة بناء معرفة علمية «فمن الديماغوجية-يكتب بول باسكون- الاعتماد على أن الذاكرة الشعبية تحتفظ بالحقيقة، كما أنه من الوهم الاعتماد فقط على الوثيقة المخزنية.» لأن الفائدة المنهجية والمعرفية تكمن في مقابلتهما ومساءلتهما بشكل دؤوب ومنتظم.