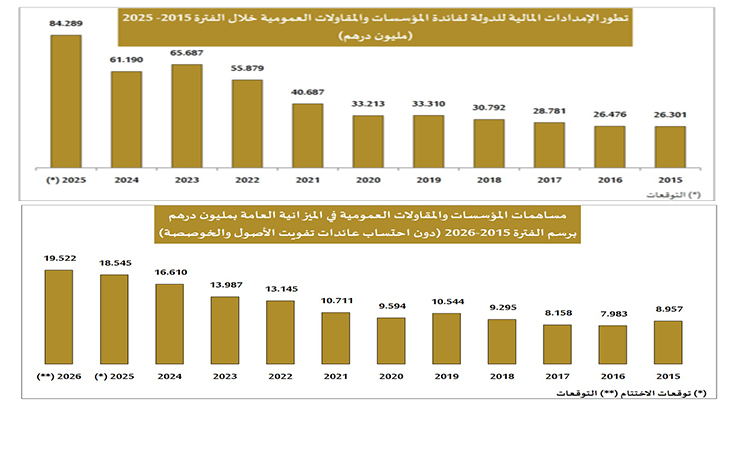ثمة تفصيل منهجي أساس يحكم صناعة التاريخ، بما هي صناعة تثوي داخل أنسجتها أسئلة النقد التاريخي لتجارب الأمم في الماضي على ضوء رهانات الحاضر، أو من حيث أنها سلسلة أوراش أكاديمية صارمة تُخضع نوازل الماضي لخطاطات منهجية متوافق حولها. مفاد هذا التفصيل أن التاريخ يظل كتابة خاضعة للتجدد باستمرار، ما دام الواقع كما ينافح عنه صاحب «خطورة الأفكار» الفيلسوف الفرنسي إدغار موران في حالة تشكل مستمرة. ولربما يكتسي هذا التجدد راهنيته من عمق منظومة الحداثة ذاتها، التي هي بالأساس تشرعن مشروع الاحتواء، احتواء سرديات الماضي في براديغمات اختزالية، بما يتناسب مع حساسيات اللحظة السياسية، وتوافقات مالكي وسائل الاكراه والانتاج/ المعاش باستعارة من صاحب المقدمة.
كل كتابة تاريخية بدون نسغ فكري مردود نِتاجها، وكل فكر بدون قالب زمني مبتور عن سياقه ومآله. تلك أهم خلاصة ناضل في سبيلها درس التاريخ في مسيرة كسب العلمية.
حينما يفكر الإنسان في الكتابة، فإنه يستند إلى أرضية معرفية، قد تكون صلبة، أو رخوة، أو بين بين، جزء منها يعود إلى التقاليد المرعية، إلى ركام الأبحاث والدراسات المنجزة، لإعادة تدوير حلقات الماضي بدافع راهني خالص. قد تكون هذه العودة أحيانا عائقا نحو الفهم، خاصة في موضوعات حوزت قدرا كبيرا من الجدارة والاقتدار. ليس كل ما يكتب جدير بالمُدراسة والاستقصا، يحظى بالإشادة والتقدير، سواء في مدار الجامعة، أو حتى خارج أسوارها.
التاريخ كما جرى تقعيده في كثير من الممارسات يدخل ضمن بنية الاستسهال. قديما كان كل من يتصدى لكتابة التاريخ يخلد إنسانا عظيما، لأنه يصر على حفظ ذاكرة الإنسان من النسيان. واليوم ظهر مرتزق الكتابة التاريخية plumitif الذي يعتاش من التاريخ كسبا وتكسبا.
ليس أخطر على التاريخ من الحداثة نفسها، الحداثة السائلة التي تحمل مشروعا متكامل الأركان، احتواء التاريخ، نسف صوت الهامش والمهمش، وإقبار صوتيات من كتب عليهم أن يظلوا دوما خارج مداراته الحزينة، مشاركة أو تأليفا. ظل التاريخ العربي الإسلامي في مصفوفاته الكبرى مجرد صورة ضمن روزنامة أحداث ووقائع متشابكة، صورة تشكلت حسب مخيال وحساسيات ومقاصد اللحظة السياسية وتوافقاتها. بالنهاية الكتابة التاريخية صناعة منهجية تخضع للتوافق. وعبر هذا التوافق تحتجب أصوات ورؤى، وتختفي أنساق وبنيات بمقدورها أن تعيد تشكيل صورة الماضي تشكيلا أقرب إلى منطق الحقيقة، منه إلى منطق الخيال والأسطورة. ليست هناك صياغة نهائية للتاريخ، ما دامت الأسئلة تطوق مختبر التاريخ بمقتضى تجدد مناهج المعرفة التاريخية. أوَ ليست الكتابة التاريخية العميقة هي تلك التي تترك وراءها رسيس رجع الصدى، وتحفر في الأزمنة والأمكنة حفرا هادئا وعميقا كما يحفر الماء صلابة الصخر؟
حينما نقرأ منجزنا الإستوغرافي بخلفية نقدية، نتوصل إلى حقيقة أساسية مفادها أن الإيديولوجي تغلب على الإبستمولوجي، والبراغماتي انتصر على النقدي، وهموم الحاضر فرضت نفسها على نزعات الماضي. هذه الرؤية ينشأ عنها كما يقول جيل جاستون « تاريخ يؤدي دور الإيديولوجيا «، أو يلعب دورها، في مدار تأليف تاريخي نشأ في ظلال السلاطين وبين أروقة البلاطات والسرايا.
ماذا لو غيرنا زاوية الرؤية صوب المشاريع الفكرية العربية الإسلامية؟ نحو إعادة استنطاق الأطروحات الكلاسيكية في الفلسفة العربية الاسلامية؟
تستوقفنا أطروحة حسين مروة المسماة «النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية»، وهي تتضمن رسيسا من تاريخ البؤساء والمحرومين بخلفية لا تخلو من هموم ماركسية معلنة. كان حسين مروة يبحث في جدران التراث العربي عن زوايا الممنوع واللامفكر فيه، كان يهم بخرق سلطة المتعالي وتقريب المهمش.
ورش التفكير في التاريخ من أسفل حقل لمقاربات منهجية تقع خارج مدارات نظرية المعرفة الكلاسيكية، وحتى خارج مناهج الحداثة ذاتها، حقل تقريب اللامفكر فيه، وكسر التمركز والإثنوثقافية الأنتربولوجية، حقل لالتقاء التاريخ بمباحث إنسانية جديدة. سبق لعراب الحوليات فرناند بروديل أن صدح بقول مأثور « التاريخ ابن زمانه، والقلق الذي يعتريه، هو ذاته القلق الذي يعتري قلوبنا وعقولنا».
لننصت إلى واحد من مؤرخي القرن التاسع عشر بفرنسا، المؤرخ شاتوبريان « حينما تجعلنا رذيلة الإنسان لا نكاد نسمع سوى قرقعة سلاسل العبيد، وصوت الوشاة، حينما كل شيء يرتجف أمام الطاغية، وعندما يصبح السعي إلى نيل رضاه وتحمل جوره، أمرين خطيرين حينئذ، يكون المؤرخ مطالبا بالانتصار للشعوب، فحينها يستمتع نيرون طالما يوجد داخل الامبراطورية تاسيتوس… «.
يطرح علينا التفكير في التاريخ من أسفل، أسئلة جادة حول صناعة التاريخ، بله حول أزمة الخطاب التاريخي أساسا، كيف نقدم فهما معقولا وواقعيا لأحداث الماضي؟ أو بتعبير أدق، كيف نجعل الأحداث تعرض في حقيقتها خارج التحكم الذهني للمؤرخ؟ هذا إذا ما انطلقنا من فرضية أن المادة التاريخية تعرض شبكة معقدة من التمفصلات والعلائق تحجب رأيا أو رغبة ساكنة في لاوعي المؤرخ.
الكتابة التاريخية بهذا التحديد مجرد صورة للتاريخ، وليست التاريخ نفسه، لا تخرج عن نطاق التاريخ المخيالي imaginaire، الذي تفرضه حساسيات اللحظة السياسية، كتابة تلتقي مع الأسطورة والخيال، زمن طفولة البشرية، لكنها كتابة يظل المتغير فيها عدم الاطمئنان. l’insatisfaction فكلما تطورت مناهج التاريخ كلما ارتفع منسوب الأسئلة حول موضوعات الماضي، واشتدت ضرورة الحفر في سراديب الماجرى، كلما صارت الصناعة التاريخية في قفص الإدانة. وربما هذا الموقف هو من يشجع مناهضي علمية التاريخ بنسفه من الأساس.
بمقتضى هذا التحديد، تتحول الكتابة التاريخية إلى محاولة سلبية استيلابية لتبديل تورخة بتورخة جديدة، historisation، إلى تبديل قراءة بقراءة جديدة، تعليق بتعليق، لهذا السبب بالذات اعتبر الفيلسوف بول فاليري منتوج التاريخ من أخطر العقاقير التي اكتشفها كيمياء العقل البشري، والانتاج الأكثر خطورة الذي أمكن للذهن البشري إنجازه.
التفكير في التاريخ من أسفل هو دعوة صريحة إلى تحرير ورش التاريخ من رواسب ذهنية المؤرخين، ومن وصاية المادة التاريخية التي تستضمر توجها معلنا، تخفي في العمق اشارات عميقة تعتمل في سدى حياة الناس العاديين، في بلد حكمت عليه إستوغرافيته أن يظل مشدودا نحو التاريخ، ومتماهيا معه بشكل مثير للانتباه. تطور مناهج التاريخ، وتغيير مقياس الملاحظة، سواء من فوق أو من تحت، لا يعني البتة حل أزمة الكتابة التاريخية، وتخليص الخطاب التاريخي من عقدة الصالونات، فكل قراءة للتاريخ تنسج وفق مخيال البيئة الحاضنة، ما دام السياق المتحكم يقر باستحالة توطين الوعي التاريخي كممارسة اجتماعية وثقافية تجاه الماضي. في هذا الصدد، يشير لوسيان فيفر إلى أن «التاريخ عبئ يقع على أكتاف الناس، ولا بد من تخفيف هذا الحمل» .
التاريخ المغربي كما العربي قتلته السياسة، حيث قطاع المعرفة ظل بيد البلاط، لم تتأسس استقلالية المؤرخ، وحينما لا يستقل المؤرخ لا يستقل التاريخ.
ورش التاريخ من أسفل من حيث النشأة والتطور مُحصلة مسار طويل من التجاذب والتجارب، من الاستمراريات والقطائع، من التراكمات والانقطاعات، من الفعل ورد الفعل، من التأمل والتساؤل حول بنية الانتاج التاريخي، وعبر هذا المسار المتعدد تحضر المعرفة التاريخية كتفكير، ككتابة، كصناعة، وكرهان للتجاوز ضمن مشاريع مجتمعية نهضوية، وأحيانا كخطاطات ديداكتيكية تعمد إلى تجسير فجوة التفاوت بين الممارسة العالِمة للتاريخ والممارسة المدرسية لمتلقي التاريخ.
كل بحث في المسار الإستوغرافي لتأليف تاريخي معين، وجب أن يتقيد بترسمية منهجية تُسائل ثلاث مُوجهات للعمل التاريخي:
أولا: بنية المصادر من حيث حالتها واستعمالاتها في سياق مأسسة الأرشيف وتسهيل الوصول إلى الذخائر والمضان التاريخية، ومن ثم تعميق الوعي الاجتماعي بالوثائق وأهميتها في صيانة الذاكرة الجماعية.
ثانيا: من حيث المناهج وتقعيد ممارسة مغربية حول انشغالات تاريخية كبرى مثل إشكالية التحقيب، حقول البحث، وإجرائية المفاهيم والمصطلحات.
وثالثا: من حيث أوراش البحث التي تجمع الباحثين في التاريخ، سواء داخل المدار الأكاديمي أو خارجه.
سبق لمؤسس الحوليات الفرنسية لوسيان فيفر أن اعتبر البحث في الإستوغرافيا كقاطرة تتوقف في محطات للمرور، بيد أنها لا تتوفر على محطة للوصول، نفس الفكرة نجدها عند المؤرخ عبد الله العروي في حوار مع مجلة» الوحدة» غشت 1986، حينما قال « كل مشكل تاريخي يتجدد طرحه بطرح التاريخ نفسه، ولا يمكن قول كلمة أخيرة فيه»…حيث تنهض الأجيال تواقة إلى الأخذ بناصية ماض ظل دون مستوى الادراك المتمكن.
تعدو الإستوغرافيا من حيث هي عملية تأريخية إعادة بعث لقضايا الماضي في قوالب جديدة، وفق سِجل إشكالي ومفاهيمي، تصنعه الأجيال التي هي في حاجة إلى التاريخ كماض، والتاريخ كذاكرة جماعية، والتاريخ كأفق للتحرر والانعتاق.
من يقرأ تاريخ المغرب بقليل من النباهة تستوقفه تحاليل تاريخية تمت مقاربتها عن طريق التقليد والتواتر، حتى لكأنها صارت قلاعا ممتنعة عن الإدراك من فرط تكرارها، إن لم تكن رافضة من حيث العمق للاندماج ضمن النسق التاريخي. المسألة تتلخص عمليا في وجوب المزاوجة بين ثنائية الحدث والبنية، بين التاريخ كسرد والتاريخ كإستوغرافيا، وأساسا بالانتقال من المجادلة الوطنية نحو النقد التاريخي الموضوعي والتفكيك المعرفي …لأن المسألة في النهاية هي مسألة مفاهيم، كما يلح على ذلك بول فاين. وهذه المفاهيم هي التي تميز التاريخ عن الوثائق، وتجعل المؤرخ ينشئ لغة مغايرة للغة الإخباري، ويقتحم عوالم أحوال المعاش، أو ما يُعرف في الإستوغرافيا الأوربية بالحضارة المادية، وما يرتبط بها من حركات امتداد، وظواهر انحسار، من أزمات مزمنة وحلول متكررة…هذا إذا سلمنا شرطا بأن الماضي البشري يُخلف أسئلة تتجاوز صناعة التاريخ وحده، نحو حقول معرفية أخرى، وأن عملية التركيب/ التألِفة تستوجب التحيين والانفتاح والتناهج إن أردنا أن يكون لها جدوى، وأن تدمج في مثوياتها هم التفكير من أسفل.
(باحث بجامعة القاضي عياض، مراكش)