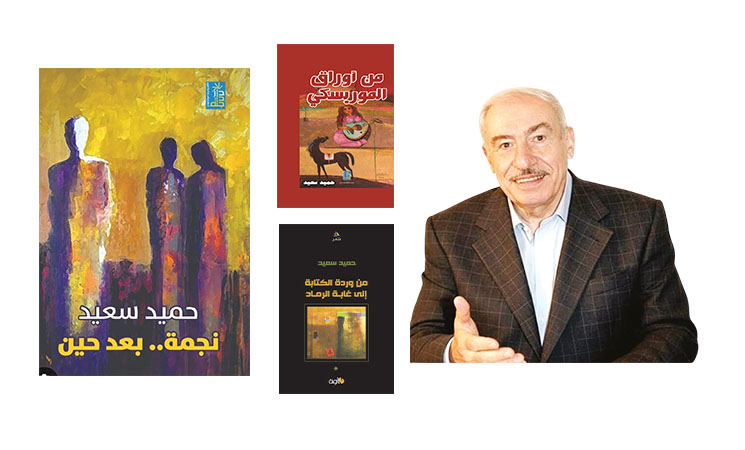يتسم الموقف الجزائري المعادي للوحدة الترابية المغربية بتهافتات تاريخية وقانونية وسياسية، لا يمكن استيعاب مدلولها إلا إذا تمت مقاربة ذلك الموقف في شروط السياق السياسي والجيوسياسي الذي حكم ويحكم رؤية وسياسة نظام الحكم الجزائري في بعديهما القطري والمغاربي.
ولئن كانت المنهجية الرصينة تقتضي مقاربة الموقف الجزائري من تحرير واستعادة المغرب لصحرائه، على ضوء مفاعيل الجدلية القائمة ما بين البعد القطري والبعد المغاربي، في رؤية وسياسة حكام الجزائر – فإن شرط المقام لا يسمح بسعة المقال، وبالتالي فإننا تروم، في إطار هذه المداخلة، تركيز النظر على ما تنطوي عليه الرؤية المغاربية لدى حكام الجزائر من هواجس مجاليه، مرتبطة بتصورات ومخلفات سياسة “الجزائر الفرنسية”، ومن عقدة باتولوجية، اعتل بها المغامرون من حكام الجزائر المستقلة(1).
ولا مرية، فإن الوقوف في وجه كفاح المملكة المغربية من أجل تحرير واستعادة أقاليمها الجنوبية، بل واستباحة حُرمة هذه الأقاليم عسكرياً غداة تحريرها، وإغلاق الحدود في وجه مواطني ومواطنات البلدين، في انتهاك صارخ لحرية تنقل الأشخاص والسلع، واستخفاف غير مسبوق بمصالح الشعبين.
وقد تأكد، بما لا يدع مجالاً للشك، أن رهان افتعال نزاع الصحراء المغربية، ومواصلة تأجيج حلقاته، على مدى أزيد من أربعة عقود، إنما يروم فرض مشروع انفصالي، يقوم على تزييف التاريخ وتحريف القانون، وبالتالي “شرعنة” تغيير التوازن الجيوسياسي في الحوض الغربي للمتوسط.
ولم تتورع هذه السياسة المغامرة عن الزج بـٍـ “اتحاد المغرب العربي” في نزاع مفتعل، بات يثقل كاهل الأقطار المغاربية، بكلفتيه المادية والمعنوية، وتهديد الأمن والاستقرار في الحوض الغربي للمتوسط، إذ لا أفق لهذه السياسات الرعناء – في غياب منطق الحكمة والتبصر – سوى المزيد من الاحتقان والتوتر.
أولاً: الجزائر ومخطط الانفصال:
1 – لطالما ردد دبلوماسيون جزائريون على منصة الأمم المتحدة، أن الجزائر “معنية ” بموضوع “الصحراء الغربية”، بحكم “مصالحها الجيوسياسية”، وأن لا حل للنزاع (المفتعل) خارج إطار هذا الاعتبار..
وبالفعل، فقد انصب الخطاب الدبلوماسي، والفعل السياسي، منذ مستهل السبعينات من القرن الماضي على الترويج لموقف ملتبس، ظاهره تعزيز المطالبة بتصفية الاستعمار الجاثم على “الصحراء الغربية”. وباطنه التمهيد لانتحال صفة الطرف “المعني”، إلى جانب المغرب وموريتانيا، بملف نزع استعمار “الصحراء الغربية”. بيد أن الموقف سيأخذ منحى جديداً، غداة الاتفاق المغربي-الموريتاني بتنسيق موقفهما المُطالب بالتحرير، منحى قوامه المراهنة على إقناع إسبانيا الفرنكوية بِـ “تفهم” مصلحة الجزائر في أن تكون طرفاً في مفاوضات تسوية النزاع !
لكن سرعان ما تحولت المناورات الجزائرية في مربع الكواليس السياسية والدبلوماسية، إلى مجابهة سياسية صريحة ومعلنة، عندما أقدم المغفور له جلاله الملك الحسن الثاني على إطلاق “المسيرة الخضراء” (6 نونبر 1975) من جانب، وامتنعت الحكومة الإسبانية عن حجز مكان لحكومة الجزائر في طاولة المفاوضات، التي أسفرت عن توقيع “اتفاق مدريد” من جانب آخر…
في خضم هذه التطورات المتسارعة، لكن الإيجابية، إذ أسفرت عن إنهاء الاستعمار الإسباني بالساقية الحمراء ووادي الذهب، بعد احتلال دام أزيد من تسعة عقود، انبرى الرئيس الراحل هواري بومدين – في مناخ ملؤه الشعور بالإحباط من جهة، والرغبة في الانتقام من جهة أخرى – إلى الالتفاف على إنجاز التحرير، عبر الإعداد والترويج لمشروع انفصالي تُسخر في واجهته “حركة تحرير”، تحولت بقدرة قادر إلى أداة انفصال.
ومن أجل دعم و”شرعنة” هذا النزاع المفتعل، تمت تعبئة جهاز الدولة الجزائرية، ضداً على إرادة شعبها، للانخراط في سياق استراتيجية هجومية تستند إلى ركيزتين اثنتين: أولاهما، ركيزة سياسية-دبلوماسية أسندت قيادة عملياتها إلى وزارة الخارجية الجزائرية، تحت مظلة السيد عبد العزيز بوتفليقة، وزير الخارجية آنئذ، بمساعدة – عند الحاجة – مجموعة من أطر حزب “جبهة التحرير الوطني”؛ ثانيتهما، ركيزة عسكرية، ميدانية، بقيادة طاقم عسكري من “الجيش الجزائري” أسندت قيادته إلى ضباط سامين، بقيادة الراحل العقيد سليمان هوفمان، أحد المستشارين العسكريين المقربين من الرئيس الراحل.
2 – وكما أوضحنا في أكثر من مناسبة، فإن تفعيل هذه الاستراتيجية، بشقيها العسكري والدبلوماسي، شكل ويشكل قوام السياسة العدائية الجزائرية ضد المملكة المغربية على مدى أزيد من أربعة عقود (1975-2018)(1)، وهي السياسة التي سهر القيمون عليها، عسكرين ودبلوماسيين، على تكييفها المتجدد مع المتغيرات السياسية، الإقليمية والدولية، لكن ثابتها كان واستمر منصباً على المزاوجة بين عمليات الاستنزاف العسكري، وحملات التشهير الدبلوماسي، في محاولة دائبة للالتفاف على قواعد الشرعية الدولية، ومبادئ وقواعد القانون الدولي.
وغني عن البيان أن المخطط الانفصالي الذي تسعى الجزائر إلى تمريره، نكاية بالمغرب من جانب، وتطلعاً إلى توفير فرصة للتمدد نحو المحيط الأطلنطيكي من جانب آخر، إنما هو مشروع موروث من عهد فرانكو. فقد سعى الأخير إلى إقامة “كيان صحراوي”، يكون مرتهناً، سياسياً ومجالياً، إلى الدولة الحامية له، إسبانيا، وذلك في سعيه الحثيث للالتفاف على نضال المغرب من أجل تحرير أقاليمه من جهة، والالتفاف، من جهة أخرى، على الضغوط التي كانت تمارسها الأمم المتحدة على إسبانيا من أجل تصفية استعمارها لإقليم “الصحراء الغربية”. ومن أجل التستر على الطابع الاستعماري لمخطط الانفصال الموروث، – والمُتَبنى –، تلجأ الآلة الدعائية الجزائرية إلى تزييف حقائق التاريخ وتحريف مبادئ القانون الدولي، والاستخفاف بقضايا الأمن والاستقرار في الحوض الغربي للمتوسط.
ثانياً: التاريخ في مواجهة التزييف:
عندما استجابت الأمم المتحدة (الجمعية العامة) لطلب المغرب باستصدار “رأي استشاري” من “محكمة العدل الدولية”، حول النزاع مع إسبانيا في موضوع الصحراء المغربية المحتلة آنئذ، وذلك وفقاً لمقتضيات البند 96، الفقرة 1، من ميثاق الأمم المتحدة(1)، كانت الأسئلة المطروحة على المحكمة كالآتي:
1 . هل كانت أرض الصحراء، موضوع النزاع، “أرضاً بدون سيد” (Terra Nullius) وقت احتلالها؟
2 .ماذا كانت الروابط القانونية لهذه الأرض مع المملكة المغربية والمجموع الموريتاني؟
ولئن أقرت المحكمة، بداية، أن هذه الأسئلة المطروحة قابلة – بحكم طبيعتها – للحصول على جواب مستند إلى القانون، ولا شيء غير القانون(2) – فإنها تستدرك في الفقرة 17 من نص “الرأي الاستشاري” للقول، بأن الإجابة على الأسئلة المطروحة تقتضي “أن تُحاط المحكمة علماً بالوقائع المرتبطة بهذه المسائل، أن تأخذها بعين الاعتبار، وعند الاقتضاء أن تبث بشأنها”(3).
وما يمكن استخلاصه من هذه الرؤية الرصينة في مقاربة الطابع القانوني للإشكالية المطروحة على المحكمة، أن المرجعية التاريخية للنزاع تشكل مسألة محورية في سياق استيعاب طبيعة النزاع، واستشراف أفق حله.
1 – ولا غرو، فإن استحضار واعتبار المعيار التاريخي في مقاربة نزاع “الصحراء الغربية”، يظل المعيار الأساس في سلم المعايير الأخرى، القانونية والسياسية، القمينة باستجلاء الحقيقة، وبالتالي دحض افتراءات حكام الجزائر بصدد “وضع” (Statut) أقاليم الصحراء المغربية بعد تحريرها واسترجاعها سنة 1975.
ويتعلق الأمر في هذا المضمار بضرورة استحضار الحقائق التاريخية التي تدحض المزاعم التي تم ترويجها إعلامياً ودبلوماسياً، منذ سنة 1975، حول ما يسميه حكـــام الجزائــر بـ “احتلال” المغرب لـِ”الصحراء الغربية”، وحول ما يدعونه من دعم للبوليساريو كـ”حركة تحرير”.
•فيما يتعلق بزعم “الاحتلال” المغربي لِـ”الصحراء الغربية”، فإن هذا الادعاء المغرض يتأسس في الحقيقة على مرجعية استعمارية صرفة، ويستبطن سياسة توسعية مضمرة.
أما المرجعية الاستعمارية لأطروحة “الاحتلال”، فتحيل إلى أسطورة “المغرب الغازي” (Le Maroc envahisseur) التي اخترعتها السلطات الاستعمارية الفرنسية من أجل “شرعنة” حملاتها التوسعية لاحتلال توات وتومبوكتو(1). وقد تبنت سلطات الجزائر المستقلة هذه الأسطورة الاستعمارية بغرض تبرير إبقاء الأراضي المغربية (توات / الساورة / تيديكلت /بشار / تندوف) التي ضمتها فرنسا إلى “الجزائر الفرنسية”، منذ عام 1900-1901 – وأضحت منذ ذلك الوقت تحت سيطرة الجزائر المستقلة(2).
أما السياسة التوسعية المستبطنة، فتشير إلى التطلعات الجيوسياسية كما غذاها منظور الراحل هواري بومدين للعلاقات مع دول الجوار المغاربية. وفي صميم هذه التطلعات “تكمن خلفية البحث الحثيث عن تمديد التراب الجزائري نحو المحيط الأطلسي، لما يُتيحه هذا التمدد من نقلة هائلة في مجال تصدير النفط والغاز إلى أوروبا من جهة، ولما يوفره من تحجيم التواصل التاريخي، الثقافي والسياسي والاقتصادي، للمغرب مع محيطه الإفريقي من جهة أخرى(3).
ومما لا ريب فيه، فإن تحرير واستعادة المغرب لأقاليمه الصحراوية الجنوبية، قد شكلا إفلاساً لمشروع التمدد نحو الغرب، وهو المشروع الذي سبق لأحد منظري السياسة الاستعمارية في شمال أفريقيا أن استشرفه، بقوله: “بإرساء الهيمنة الفرنسية على المغرب، فإن الهدف البعيد، بدون شك، ينبغي أن يكون، فيما يبدو، إعطاء الجزائر “حدوداً علمية”، والتي هي ليست سوى المحيط الأطلنتي، وتحقيق وحدة أفريقيا الشمالية في ظل هيمنتها”(4).
وعلى خلفية إفلاس مشروع التمدد نحو الغرب، وهو المشروع الذي تحكمه رؤية استعمارية متقادمة، متهالكة، لجأ أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية إلى التزييف الممنهج للتاريخ، في محاولة يائسة لِـ”شرعنة” مشروع انفصالي، بات يشكل معبراً لأجندة التمدد الجغرافي نحو المحيط الأطلنتي.
وإزاء هذه النوايا المبيتة، والمزاعم المروجة التي تضرب صفحاً عن ماضي الوحدة الترابية للمغرب، شمالاً وجنوباً، أطلسياً وصحراوياً، منذ قيام الدولة المركزية في المغرب الإسلامي في القرن الحادي عشر الميلادي، إلى الغزو الاستعماري، الإسباني-الفرنسي في منعطف القرن التاسع عشر – فإن استنطاق التاريخ، واستحضار معطياته وحقائقه، واستكناه أحكامه ودلالته، لتصيب في مقتل أطروحة “الاحتلال” التي أمست موضوع اجترار مزمن في الخطاب الدعائي لأعداء وحدتنا الترابية.
2- وفي هذا المضمار، فإن السجلات التاريخية، والرحلات الاستطلاعية، والدراسات الانتروبولوجية وغيرها من المصادر التاريخية، تجمع على ثابت الاندماج المتعدد، الثقافي والتجاري والمؤسساتي والسياسي، ما بين ساكنة الصحراء جنوباً، وساكنة المجال الأطلسي-المتوسطي شمالاً(1).
وبطبيعة الحال، فإن درجة هذا الاندماج كانت تتأرجح بين الصعود والهبوط، حسب الظرفيات التاريخية التي تطال الزمان، والتحولات الإيكولوجية التي تغشى المكان، ولكن الإطار الاندماجي ذاته، بمقوماته السياسية والجغرافية والاقتصادية والثقافية، ظل ثابتاً، صامداً في وجه التقلبات السياسية والمُلِمّات المناخية والأعاصِر الخارجية.
وقد شكلت الدول المركزية المغربية، سواء في صيغتها “الإقليمية”، كما كان الحال في العهود المرابطية والموحدية والمرينية والسعدية، أو في صبغتها “القطرية”، كما أصبح الحال في العهد العلوي – شكلت الدولة المركزية محور ومدار ذلكم الاندماج، منها يستمد ديناميته، وإليها تعود آلياته، وبها تتماسك وتتعزز لحمته.
ومن تم، فقد كان انخراط ساكنة الصحراء، قبائل وتُخباً دينية وعلمية وثقافية، في بيعة السلطان، وخضوعها لأوامره، واستكانتها إلى الولاة والقواد والقضاة المعينين من طرفه، واحتماؤها بسلطته ونفوذه، والصلاة تحت مظلته، واستجابتها لأمره بالجهاد والمقاومة، دفاعاً عن حياض الإقليم، وتصدياً لتسللات وتدخلات القوى الإمبريالية المتربصة به، وهَرَعُها التلقائي لاستقباله لدى مقدمه على رأس “محلته”، وغيرها من آيات التفاعــل والخضــوع والامتثال – شكل كل ذلك روافع قوية لوحدة الكيان المغربي، بشراً وتراباً وثقافةً.
وفي إطار هذا النسق من الروابط السوسيو-سياسية، والمقومات الترابطية، والعناصر التفاعلية بين السلطان – أمير المؤمنين، وساكنة الصحراء، قبائل وعشائر وزوايا ونخباً علمية وتجارية، يمكن قراءة واقع ومسارات العلاقات التاريخية بين المغرب المتوسطي-الأطلنطيكي، والغرب الصحراوي.
3- وفي هذا الصدد، فإن استحضار المسار التاريخي للقضية الوطنية، وإعادة الاعتبار لِـ “الوثيقة التاريخية” ذات الصلة، يمثلان عاملاً حاسماً في إماطة اللثام عن المخطط الانفصالي الكامن خلف أطروحة “الاحتلال”.
وفي هذا الاتجاه، يمكن التنويه ببعض الحقائق التاريخية، على سبيل المثال وليس الحصر:
I. إن منطلق الدولة المركزية التي حكمت المغرب الإسلامي منذ التاريخ الوسيط، كان من الصحراء أو تخومها. فقد انطلق الأدارسة وبَنُومَرين والعلويون من جهة الجنوب الشرقي، وانطلق المرابطون والموحدون والسعديون من جهة الجنوب الغربي، فساهمت الصحراء بذلك في “تجديد الأسر الحاكمة”(1).
وقد تعاقبت مراحل التاريخ السياسي بالمغرب، “بحسب وتيرة اندفاعات قبلية كبرى (…) وكأن الصحراء كانت ترمي السهول الأطلسية المغربية الخضراء بالفائض من سكانها كلما ضاقت بهم تلك الفيافي بما رحبت”(2).
وعلى امتداد حقبة تاريخية مديدة، تمتد من التاريخ الوسيط إلى التاريخ الحديث، ظل نفوذ الدول المتعاقبة على حكم بلاد المغرب ممتداً من أعماق الصحراء إلى ضفاف المتوسط، إذ كانت “البيعة” سائرة المفعول، يتحقق في كنفها أمنُ الطرق، ورعاية القوافل التجارية، بتأمين المحطات وتوفير الموارد المائية لها، وحماية السواحل الجنوبية، وهي مهام كان يسهر نواب سلاطين المغرب التاريخي من أهل المناطق الصحراوية على القيام بها. كذلك كان الحال على عهد المرابطين والموحدين والسعديين(1).
II. وفي حمأة التحولات الاقتصادية التي غشيت المجال المغربي في التاريخ الحديث، بتحول التيارات التجارية من الواجهة الصحراوية صوب الواجهة الأطلسية، انتقل مركز الثقل في مسلسل التشكل الدولتي المغربي من الصحراء إلى الجنوب الشرقي، حيث نهض شرفاء تافيلالت العلويون بتقلد مسئولية قيادة الدولة في القرن السابع عشر. وقد تحددت وتوطدت العلاقات بين أهل الصحراء وملوك الدولة العلوية في سياق نسق مؤسساتي جديد منذ العهد الإسماعيلي بصفة خاصة.
• ففي سياق حركة سلطانية إلى الصحراء دامت شهرين (1678)، قام السلطان المولى إسماعيل (1672-1727) بتفقد أحوال أهلها، فهرعت قبائلها إلى مبايعته(2)، والتفت حول الأعيان والقواد الذين عينهم من أهلها لمراقبة التحركات الأجنبية. وقد تدافعت النخب الصحراوية من علماء وشيوخ الزوايا وأعيان القبائل…، من أجل تعزيز أسس البيعة، وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار في ربوع الصحراء(3).
وبفضل جهود هذا السلطان الموحد، تعززت وتوطدت ممارسة السيادة المغربية على قبائل توات وتيكرارين ووادي الساورة من الصحراء الشرقية، وعلى المنطقة الممتدة فيما وراء درعة، من الساقية الحمراء ومجالات أولاد دليم، إلى منطقة شنقيط (موريتانيا حالياً)(4).
• وقد سار عل نهج المولى إسماعيل، سلاطين الدولة العلوية تباعاً، إذ يشير صاحب “الاستقصاء” إلى استمرار زخم علاقة الدولة بالصحراء بعد وفاة المولى إسماعيل، كما يشير الضعيف الرباطي في تاريخه إلى أطوار الحركة التفقدية التي قادها السلطان المولى سليمان (1792-1822) إلى المناطق الصحراوية، راسماً مسارها، وموثقاً وقائعها(5).
III. وتمثل حلقة التصدي والمقاومة للغزو الاستعماري للصحراء حقبة حرجة، لكنها عميقة الدلالة، سواء فيما يتعلق بما أبدته الساكنة الصحراوية من تشبث بهويتها المغربية أو فيما خاضته من مقاومة للغزاة، تحت راية السلطان.
• وفي هذا المضمار، فقد تولى السلطان مولاي الحسن الأول (1873-1894) بنفسه عملية الدفاع عن سواحل الصحراء، أمام الأطماع الأجنبية، وأعطى أوامره الصارمة لقطع دابر كل من تسول له نفسه عقد صفقات تجارية مشبوهة مع الأجانب الطامعين.
وتعزيزاً لسلطة الدولة في المناطق الصحراوية التي أصبحت هدفاً للأطماع الأجنبية، أصدر السلطان ظهيراً (1879) يعين بموجبه الفقيه، الشيخ ماء العينيين، نائباً سلطانياً على “بلاد سوس والصحراء”، وذلك للسهر على حماية الحدود الجنوبية، الصحراوية من أي تدخل أجنبي(1).
ومن الأهمية بمكان الإشارة، بصدد نص الظهير، إلى أمرين: أولهما، سِعة المجال الترابي الذي أنيط بسلطة النائب السلطاني المعين، وهو المجال الممتد من”بلاد بني بعمران وسوس الأقصى ومن وراءهم بني جرار ومن فوقهم من الجزوليين، قبيلة بعد قبيلة، من الأعرابيين الصحراء كلهم من بني باعمران إلى وادي نون للساقية الحمراء للطرفاية إلى منتهى العمارة من أيالتنا لتلكم البلاد…”(2).
أما الأمر الثاني، فهو طبيعة السلطة المخولة للنائب، بما يشبه ممارسة “حكم ذاتي” بمفهوم عصرنا: “وأن الفقيه الشريف المذكور”، يقول النص، “استوليناه عليهم ليكون نائباً عنا عليهم، تولية تامة شاملة شرعية بحمد الله…”(3).
ومن أجل تثبيت وتعزيز سيادة الدولة على الأقاليم الصحراوية، يقود السلطان المقاوم حركة سلطانية إلى الجنوب المغربي، حيث يستقبل جموعاً من وفود القبائل الصحراوية من كل الأصقاع، ومن العلماء والأعيان والفقهاء، ويوزع ظهائر تعيين قواد مخزنيين جدد، مكلفين بالسهر على حدود المغرب الجنوبية وحماية سواحل الصحراء(1).
وعلى إثر نزول جنود أسبان في شبه جزيرة وادي الذهب، وبناء مركز صغير، تحت حراسة حامية عسكرية محدودة العدد، لإعطاء الانطباع باحتلال عسكري لشبه الجزيرة(2) – سارع المولى الحسن إلى الإعداد لحركة ثانية للصحراء سنة 1886، للتصدي لهذه التسربات الأجنبية، ودعم حركة المقاومة التي رفع لواءها أولاد دليم سنة 1885، وتمكنوا من إرغام الأسبانيين المحتلين على الفرار، عبر البحر، نحو جزر الكنارياس(3).
وقد اتخذ السلطان، لدى وصوله إلى بلاد واد نون، جملة من الإجراءات العسكرية والدفاعية والتنظيمية والتجارية، الكفيلة بتأمين الدفاع عن الصحراء وسواحلها(4).
وقد أثمرت جهود السلطان مولاي الحسن، في مجال تنظيم الشأن الصحراوي والدفاع عن حوزته تَوثق الروابط بين أهل الصحراء وإخوانهم في الشمال(5)، كما تأججت روح المقاومة لدى ساكنة الصحراء ضد الأطماع التوسعية الأوربية(6).
وبفضل هذا المسار الكفاحـي، والتلاحم العضـوي بين شمال المغرب وجنوبه، لم تتمكن أسبانيا من فرض سيطرتها على أقاليمنا الجنوبية بكيفية مستقرة إلا في سنة 1934 (7).
• وعلى نفس المنوال، حظيت الأقاليم الصحراوية في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله (1757-1790)، برعاية متجددة، في سياق الإصلاحات التي باشرها، والتي ركزت على استتباب الأمن والاستقرار، وتشجيع التبادل التجاري، ونسج شبكة من العلاقات الدولية. وقد سهر على تحصين السيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية بموجب المعاهدات المبرمة مع الدول الأوروبية(1).
وقد واصل السلطان مولاي سليمان (1792-1822) توطيد سلطة الدولة على أقاليم الصحراء، بالرغم من دقة الظرفية السوسيو-سياسية التي أحاطت بحكمه(2)، فظل يتابع عن كثب أحوال المناطق الصحراوية ويتفقد شؤونها(3).
ولم يتوان السلطان مولاي عبد الرحمان (1822-1859) عن بذل جهود مضنية لتوفير العون المادي لأهالي الصحراء بسبب جانحة الجفاف التي ضربت المناطق الصحراوية(4).
• ومن جهة أخرى، فإن المعاهدات الدولية التي أبرمها السلطان سيدي محمد بن عبد الله (1757-1790)، المتعلقة بالنشاط الملاحي للسفن الأجنبية بالقرب من سواحل المنطقة الصحراوية، الواقعة فيما وراء واد نون جنوباً، وكذا مراسلاته ذات الصلة بحوادث وإشكالات هذا النشاط – توثق لحقيقة المجال الصحراوي المغربي ولامتداداته الجغرافية(5).
وفي نفس الاتجاه تُشير المعاهدات والاتفاقات التي أبرمها السلطان مولاي سليمان (1792-1822) مع الدول الأوروبية، إذ تُؤكد بدورها على واقع السيادة المغربية على السواحل الصحراوية المغربية(1)، وعلى الوحدة الترابية للمملكة ومشمولاته الصحراوية(2).كما تصب الاتفاقيات الدولية التي أبرمها السلطان مولاي عبد الرحمان مع دول أوروبية في دائرة الحرص الدائم، الثابت على تكريس الاعتراف الدولي بسيادة الدولة المغربية على أقاليمنا الصحراوية(3).
• وتشي هذه المعطيات التاريخية التي هي غيض من فيض أن الدولة المغربية مارست سيادتها على الأقاليم الصحراوية بجهتيها الغربية والشرقية بمدلول السيادة في القانون الإسلامي العام.
وقد اتسمت هذه السيادة بطابع الاستمرارية، والشمولية، والتجذرية في ظل الدولة العلوية، إذ يستخلص من المرجعيات التاريخية والدينية والثقافية والاقتصادية والحضارية التي يزخر بها المسار التاريخي لعلاقات الجنوب الصحراوي للمغرب بشماله(4)، أن اندماج المجال الصحراوي في الفضاء الأطلنطيكي-المتوسطي خلال التاريخ الوسيط، سرعان ما تطور وارتقى، في التاريخ الحديث، إلى وحدة كيانية، تستمد مقوماتها من التماسك الجغرافي، والتمازج المذهبي، المالكي، والتكامل الاقتصادي، والتواصل الثقافي، والترابط المؤسساتي بفضل شبكة الزوايا، التي تحول إكراهات المجال الجغرافي المديد، إلى فرص للتفاعل الاجتماعي والتواصل الثقافي بين الساكنة المنتشرة في ربوعه.
• وغني عن الإشارة أنه ابتداء من منعطف القرن التاسع عشر، سيواجه المغرب أطماعاً توسعية أخرى، هي الأطماع الفرنسية. فعلى خلفية ما تضمنته “معاهدة للامغنية”، الموقعة بين المغرب وفرنسا – عقب معركة إيسلي في صيف سنة 1844 – من مقتضيات حدودية ملتبسة(1)، شرعت القوات الفرنسية في التغلغل في بلاد آدرار، في الجنوب المغربي، مما أثار استنفار القبائل الصحراوية للمقاومة. وقد استجاب السلطان، مولاي عبد العزيز (1894-1908)، لطلب أعيان وشيوخ القبائل الصحراوية بدعم مقاومتهم، فأرسل إلى الصحراء وفداً مخزنياً يحمل إلى المقاومين الصحراويين السلاح والذخيرة. وقد تواصل إرسال الدعم اللوجيستيكي، تباعاً، للمقاومة الصحراوية في عهد المولى عبد الحفيظ(2).
• وقد شهدت هذه الحقبة العصيبة التي أصبح التواطؤ فيها قائماً بين فرنسا وأسبانيا لغزو مناطق الصحراء، بداية “تجزئ المجال الصحراوي” المغربي الفسيح، فأصبح جزء من الواجهة الأطلسية من الصحراء المغربية من نصيب أسبانيا، وأطلق عليه مصطلح “الصحراء الغربية”، بل و”الصحراء الأسبانية”، في “استخفاف” صارخ بالجغرافيا(3).
كما شهدت الحقبة فصولاً متوالية من المقاومة المستميتة، وسلسلة من المعارك الضارية التي خاضتها قبائل الصحراء، سنوات 1906-1910، بتوجيه ودعم من الدولة(4).
وتنطوي الرسائل السلطانية، والظهائر الحفيظية على جملة من الإجراءات التنظيمية والدفاعية والتعبوية التي اتخذت لتعزيز صمود القبائل الصحراوية في وجه التحرشات الفرنسية والأسبانية على تخوم الصحراء البرية والبحرية.
ومن جملة هذه الإجراءات، تقديم العون اللازم للكتيبة المخزنية المكلفة بحراسة الساحل المغربي بجهة طرفاية، ومنع السفن الأجنبية من الرسو أو النزول في ساحل قبيلة إزركيين، وإقامة مراصد في مرسى أساكا لمراقبة تحركات السفن الأجنبية(1). وقد توالت ملاحم المقاومة الصحراوية، بعد فرض “الحماية” على المغرب، على مدى عقدين (1912-132) بعد ذلك(2).
IV . في ظل نظام “الحماية” التي فُرضت على المغرب الشمالي، وحالة “الاحتلال” العسكري الذي جثم على المغرب الصحراوي، لم ينقطع التواصل والتفاعل بين الجنوب والشمال، كما لم تخمد حركة المقاومة في كل من طرفاية، وسيدي إيفني والساقية الحمراء ووادي الذهب(3).
ومن المعلوم أن الاحتلال الأسباني لمناطق “الصحراء الغربية” الذي تكرس بموجب الاتفاق الفرنسي-الأسباني لسنة 1904، لم يحل دون استمرارية النفوذ الرمزي للسلطان، بحكم مقتضيات “البيعة” التي لم تنقطع(4). فقد كان الشيخان: محمد الإمام، ومحمد الأغظف، يجسدان النفوذ السلطاني، الأول إلى جانب الحاكم العسكري بسيدي إيفني، والثاني إلى جانب نائب الحاكم العسكري الأسباني في عيون الساقية الحمراء، وكلاهما يحملان صفة النيابة عن خليفة السلطان بتطوان(5).
•وتجسيداً لرباط البيعة المتين الذي يشد قبائل الصحراء إلى السلطان، أمير المؤمنين، فقد هرع وفد من أعيان وشيوخ وعلماء وفقهاء الأقاليم الصحراوية إلى الرباط للمشاركة في تجديد بيعة السلطان سيدي محمد بن يوسف سنة 1928.
• كما لم يتوان أهل هذه الأقاليم عن التعبير عن رفضهم للظهير البربري (ماي 1930)، وعن الانخراط في حركة المطالبة بالاستقلال، سنة 1944، وعن المشاركة الكفاحية في “ثورة الملك والشعب”، غداة نفي الملك الشرعي للبلاد، محمد الخامس في صيف سنة 1953، فامتنعوا عن دفع الضرائب للمحتل الأسباني، وقاموا بتقصير الصلاة في المساجد، كما امتنعوا عن ذبح أضاحي العيد، لسنين وألغوا كل مظاهر الزينة والأفراح(1).
V . في فجر استقلال المغرب (مارس 1956)، استقر عزم “المجلس الوطني للمقاومة وجيش التحرير” على مواصلة الكفاح لتحرير الأقاليم الصحراوية بموافقة ودعم قائد الحركة الوطنية المغربية، جلالة الملك محمد الخامس(2)، فتحولت كتائب “جيش التحرير المغربي” من الشمال إلى الجنوب، لاستئناف الكفاح المسلح، في أفق تحرير الأقاليم الصحراوية المغربية(3).
وقد شكل استقلال المغرب سنة 1956، حدثاً هاماً، حاسماً في مسار كفاح ساكنة المغرب الصحراوي من أجل التحرير والوحدة، إذ رفع من منسوب مقاومتهم للاحتلال الإسباني. وفي هذا الإطار عُقد مؤتمر “أم اشكاك”، شرق مدينة العيون، برئاسة الشيخ محمد الأغظف، في منتصف شهر مارس 1956، بحضور حوالي خمسة آلاف من شيوخ القبائل وأعوانها(1).
ومن أهم قرارات هذا المؤتمر ضرورة مقاومة السياسة الاستعمارية الرامية إلى تقسيم المغرب، وإيفاد وفد من الصحراء إلى الرباط لتجديد البيعة للملك محمد الخامس، وطلب مساعدته لأجل تحرير الصحراء. وقد حظي الوفد الصحراوي باستقبال ملكي بالرباط. وهكذا تتقاطع إرادة الكفاح جنوباً وشمالاً، من أجل التحرير والوحدة.
• وبإرادة وطنية حازمة، استأنف المغرب كفاحه الوطني لتحرير ترابه الصحراوي الذي تناورت القوى الاستعمارية المحتلة، فرنسا “الحماية”، وأسبانيا “الاحتلال”، على استثنائه من مفاوضات الاستقلال سنة 1956(2).
وفي غمرة الحماس الوطني الذي رافق الإعلان عن الاستقلال سنة 1956، التحقت بالمغرب وفود الصحراء الشرقية والجنوبية(3)، وتعززت صفوف “جيش التحرير” بعشرات المئات من المقاتلين من الصحراء، وتوزعت كتائب المقاومة على واجهتي الصحراء المغربية، الشرقية والجنوبية. وقد حملت الانتصارات التي حققها “جيش التحرير المغربي” في الميدان في كلتا الواجهتين، القوتين المحتلتين، فرنسا وأسبانيا، على إبرام حلف عسكري، وتعبئة قواهما العسكرية، البرية والبحرية والجوية، وشن هجوم مشترك لسحق كتائب “جيش التحرير” من جهة، واقتراف جرائم “الأرض المحروقة” للنيل من معنوية الحاضنة الشعبية للمقاومة، من جهة أخرى(4).
• بيد أن هذا الهجوم الوحشي الذي خلف مئات الضحايا في الميدان، وتسبب في هجرة الآلاف من المواطنين المدنيين الصحراويين إلى شمال البلاد، لم يفُت في عضد الإرادة الوطنية لمواصلة معركة التحرير بوسائل كفاحية أخرى، وسائل النضال السياسي، والعمل الدبلوماسي.
وقد شكل الخطاب التاريخي لبطل التحرير، جلالة المغفور له محمد الخامس، بقرية المحاميد، بوابة الصحراء، منطلقاً وإطاراً لمرحلة جديدة من الكفاح المستميت في سبيل تحرير الصحراء المغربية(1). ففي يوم 25 فبراير 1958، أي في أقل من أسبوع من مجزرة إيكوفيون(2)، أعلن الملك، في خطاب تاريخي، في ساحة السوق بقرية المحاميد، أمام جماهير غفيرة قدمت من مختلف واحات درعة ومناطق الأطلس والصحراء، عزمَ المغرب المستقل على مواصلة طريق تحرير صحرائه(3).
ومما جاء في هذا الخطاب الهام:
«إن مما يسعدنا أن يستقبلنا في قرية المحاميد التي هي باب صحراء المغرب أبناءُ الذين استقبلوا جدنا في قرية أخرى من الركَيبات وتكنة وأولاد دليم وسواهم من قبائل الصحراء الشنكَيطية، وأن نستمع إليهم ومعهم فقهاؤهم وأدباؤهم وهم يؤكدون لنا، كما أكد آباؤهم لجدنا، تعلقهم بالعرش العلوي واستمساكهم بعُروة المغرب الوثقى التي لا انفصام لها (…) وليبلغ الشاهد منهم الغائب، أننا سنواصل العمل بكل ما في وُسعنا لاسترجاع صحرائنا وكلّ ما هو ثابت لمملكتنا بحكم التاريخ ورغبات السكان»(4).
• في سياق هذا التوجه الملكي الحازم، خاض المغرب “حرباً” ضارية، سياسية ودبلوماسية، واسعة النطاق على مختلف الأصعدة، الإقليمية والأممية والدولية عموماً، وعلى صعيد الأمم المتحدة بصفة خاصة، خلال الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي خصوصاً(1)، مطالباً بتحرير صحرائه، ومتصدياً بقوة لسياسة فرانكو الاستعمارية، ولسياسة حكام الجزائر التدخلية، عبر توظيف “دبلوماسية الشعار، وسياسة الدولار…”(2).
ثالثاً: صدقية القانون في رصانة مرجعيته:
إن استبطان التاريخ، واستحضار حقائقه وسياقاته، فضلاً عما يتيحانه من وسائل فعالة لإرساء الحلول القانونية للنزاعات الترابية الموروثة عن العهد الاستعماري على أرضية صلبة، تضمن حداً معتبراً من الإنصاف والصدقية – إنما يشكلان مرجعية محورية لا يمكن التغاضي عنها أو الالتفاف عليها…
I. ويعود تهافت منطوق “الرأي الاستشاري” الذي صاغته “محكمة العدل الدولية” – في بعض جوانبه – إلى أمور ثلاث:
أولها: إن بداهة المقاربة التي طرحتها “المحكمة” في مقدمة نص رأيها الاستشاري، وهي المقاربة القاضية بتأسيس المنطق القانوني على قاعدة “الوقائع” السوسيو-تاريخية، فيما يتعلق بطبيعة “الروابط القانونية” التي كانت قائمة بين سلطان المغرب وساكنة الصحراء، لم يتم تفعيلها في صلب “الرأي الاستشاري” الصادر.
وتشي هذه المفارقة بين ما هو نظري وما هو فعلي في مقاربة “المحكمة الدولية” للإشكالية المعروضة عليها على الرغم من الكم الهائل من الوثائق التاريخية التي تقدم بها الطرف المغربي، وأسس عليها ترافعه – بعجز عن استيعاب مفهوم “السيادة” في منطق ومنظور القانون الإسلامي العام، بل اكتفت بـ”إسقاط” مفهوم “السيادة” ومدلولها في القانون الدولي العام، الحديث، على واقع سوسيو-سياسي ذي خصوصية، وسياق تاريخي مغربي، إسلامي متميز.
ثانيها: إن “المحكمة الدولية لم تكتف بالإجابة عن السؤالين المعروضين، تحديداً، على تقديرها القانوني(1)، بل تجاوزت إطار “الاستشارة” المطلوبة منها، لتُوصي بضرورة تفعيل مبدأ “تقرير المصير” كمرتكز لفك “شفرة” النزاع الذي استلزم طلب رأيها الاستشاري”.
ولقد أوقع هذا “الاستطراد”، الغير ذي موضوع، في منطوق “الرأي الاستشاري”، الأمم المتحدة في “حلقة مفرغة”(2) من الجدل القانوني-السياسي حول منهجية تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
ذلك أن مقاصد مبدأ “تقرير المصير”، كما صاغته “الجمعية العامة للأمم المتحدة” في دجنبر 1960، كانت منصبة على تحرير الشعوب التي كانت موجودة ككيانات سياسية قائمة الذات، قبل أن ترزح تحت نير الاستعمار المطلوب تصفيته.
أما بالنسبة للدول ذات السيادة، العضوة في الأمم المتحدة، التي تعاني أجزاء من ترابها الوطني من مخلفات العهد الاستعماري، في إطار إشكالية “الحدود الموروثة عن الاستعمار”، كما هو حال الوضع الذي كانت عليه أقاليم المغرب الجنوبية منذ سنة 1956، فإن اعتماد مبدأ “تقرير المصير” في تحرير واستعادة الأجزاء المغتصبة من ترابها الوطني، لا يستقيم حقوقياً وقانونياً، ولا يتجاوب مع مقتضيات ومتطلبات السياق التاريخي للنزاع، بل إنه يتنافى مع مقتضيات الفقرة السادسة من نص القرار الأممي ذاته، حول مبدأ “تقرير مصير الشعوب المستعمرة”(3).
ويتعين التذكير في هذا الصدد، بأن المغرب لم يتوقف عن المطالبة بتحرير واستعادة أقاليمه الصحراوية منذ إعلان استقلاله سنة 1956، بل لم يتوقف عن الكفاح، في سبيل ذلك، على المستويات كافة، الميدانية (1956-1958) والسياسية-الدبلوماسية (1958-1975).
ثالثها: أن رأي “المحكمة الدولية” لم يكن “رأياً” قانونياً صرفاً، بل انساق مع اعتبارات سياسية، متأثراً في ذلك بالمناخ السياسي العام، تحت تأثير “صدى” “الاستقلالات الوطنية” في العالم الثالث، وتأثيرات “الحرب الباردة”،وهو المناخ الذي ساد في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين(1).
وقد زج هذا المنزلق السياسي في صياغة “رأي استشاري” قانوني حول النزاع المفتعل بجهود الأمم المتحدة في محاولات عقيمة لتفعيل منهجية “الاستفتاء”، عملاً بمبدأ “تقرير المصير”، في سياق العديد من المخططات الأممية، ابتداء من “مخطط التسوية” (1991) وانتهاء بـ”خطة السلام” (2001)، مروراً بـ”اتفاق الإطار” (2000).
II . وقد استغل دعاة الانفصال، الضالعون في تغذية النزاع المفتعل، المتربصون بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، هذا المنزلق في مقاربة تسوية النزاع من طرف “المحكمة”، في تمديد عمر النزاع لما يزيد عن أربعة عقود (1975-2018)، وفي تلبيد سماء الفضاء المغاربي بسحب كثيفة من التوترات والأزمات التي ما انفكت تهدد شعوبها في ذات أمنها، واستقرارها، وتطلعاتها نحو الازدهار الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي…
ولقد أدركت الأمم المتحدة – بعدما آلت جهودها الحثيثة لتسوية النزاع في إطار منهجية لا تتناسب وطبيعته وسياقه، إلى نفق مسدود – أن لا بديل عن الحل السياسي، التفاوضي، في إنهاء النزاع الذي طال أمده، وذلك منذ سنة 2004، فسارع المغرب، في سياق تعاونه الدؤوب مع الجهود الأممية، لاقتراح صيغة “جدية”، “واقعية” وبناءة للحل السياسي، وهي الصيغة القائمة على تمتيع الأقاليم الصحراوية، موضوع النزاع المفتعل، بـ”حكم ذاتي” في إطار السيادة المغربية والوحدة الترابية للبلاد. وهو التوجه الرصين الذي حظي بانخراط وسند القوى الديمقراطية، والحقوقية على الصعيد الأممي، والدولي، والإقليمي.
III. ولعل ما يمكن استخلاصه من دروس هذا المسار المتعرج للنزاع المفتعل حول ما يسمى بـ”الصحراء الغربية” أن المرجعية التاريخية في مقاربة ومعالجة الإشكاليات القانونية التي تطرحها النزاعات الترابية الموروثة عن العهد الاستعماري، تظل مستنداً محورياً في استبطان عقدة النزاع، واستشراف آفاق تسويته.
كما يتأكد، من جديد، أن التاريخ ليس “مكراً” على الدوام بالنسبة لقانون التقدم في المسار البشري، بل هو كذلك رافعة عدل وإنصاف، وأداة تقويم وترشيد.
وتلک هي الرسالة التي ينبغي أن يستوعبها أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية، الذين لم يستيقظوا بعد من نومة “أهل الكهف”، ولم يتخلصوا من ذهنية “الحرب الباردة” التي طُويت صفحتها إلى غير رجعة.
ولعلَّ إفلاس أطروحة “الاحتلال”، كما تسوق إعلامياً ودبلوماسياً، للتغطية والتعمية على مخطط الانفصال، أن يكون حافزاً على “عودة الروح” للمسار الصحيح للعلاقات الجزائرية-المغربية، روح التفاهم والوئام، كما أرادها، وناضل من أجلها رواد حركات التحرير المغاربية، وفي طليعتهم جلالة المغفور له محمد الخامس، وخلفه جلالة المغفور له الحسن الثاني.
إن صمود المغرب في مواجهة مناورات، ومؤامرات أعداء وحدته الترابية، وذلك بفضل متانة الشرعية التي تسند قضيته، وقوة المشروعية التي تعزز موقفه – جعلته اليوم على بعد مسافة قريبة من محطة إنهاء النزاع المفتعل الذي طال أمده.
وإن عبور هذا الشوط الأخير المتبقي في مسار كفاح المغرب المرير من أجل تمنيع وحدته الترابية وحماية كيانه الوطني، ليقتضي منا جميعاً، دولة وشعباً ومجتمعاً مدنياً، مواصلة معركة التوضيح والتبليغ، لوضع الرأي العام الدولي والأممي والعالمي في صورة المناورات والافتراءات التي قامت على تزييف حقائق التاريخ، وعلى تحريف مبادئ القانون الدولي، بغية تسويق مطامع جيو-سياسية، متنكرة في عباءة “حقوقية”.
وفي هذا الاتجاه، تكتسي المنهجية البيداغوجية في الخطاب، والمقاربة الرصينة في التبليغ، أهمية بالغة، على طريق تعميق وترسيخ الوعي العالمي بحيثيات ومحددات وخلفيات النزاع المفتعل.
وفي هـــذا الصــدد، فإن التركيز على المحـــاور التوضيحية الخمس التاليـــة، ينبغـــي أن تكون – في نظرنا – دليل خطاب الحقيقة، ومناط نهج التبليغ:
I/ المحور الأول:
يتعلق بحقيقة النزاع المفتعل: إن الأمر يتعلق، حقاً وحقيقة، بنزاع مصطنع يروم معاكسة وتقويض الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ولا علاقة له بمسألة “تصفية الاستعمار”! من قريب أو بعيد. فالمنازعة الناشبة انطلقت بعد إنجاز عملية نزع الاستعمار من الصحراء المغربية (14 نونبر 1975)، في غضون كفاح تحريري مرير، ومفاوضات سياسية عسيرة، تُوجت بإبرام اتفاقية دولية، معتمدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، هي “اتفاقية مدريد”.
II/ المحور الثاني:
وينصب على هوية أطراف النزاع: إن الطرف الأصلي، الأساسي، المستمر في نشأة النزاع وتغذية حلقاته السياسية والدبلوماسية والعسكرية، منذ شتاء عام 1974، هو النخبة الحاكمة بالجزائر التي تورطت في موقف عدائي لاستعادة المغرب لأقاليمه الصحراوية، ولم تجد من سبيل للتستر على البواعث الحقيقية، ذات الطابع الجيو-سياسي، سوى تزييف حقائق التاريخ، وتحريف مدلولات مبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها مبدأ “تقرير المصير”، فاقترفت بذلك جريمتين: أولاهما: جريمة انتهاك مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، وهو مبدأ “عدم التدخل في الشأن الداخلي للغير”؛ ثانيهما: جريمة تحريف مدلول قرار هام من قرارات “الجمعية العمومية” للأمم المتحدة، هو القرار الصادر في دجنبر 1960 ((XV) 1514)، في مادته السادسة، كما ألمحنا إلى ذلك فيما سبق.
أما البوليساريو، فهي لا تعدو أن تكون واجهة مرتبة للتعمية على جوهر النزاع وحقيقته.
إذ يعلم الجميع، مغاربة وجزائريين ورأي عام، وفي مقدمته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، أن دور هذه المجموعة التي تأسست في نهاية أبريل 1973، بمدينة الزوايرات، شمال موريتانيا، كَـ”حركة تحرير”، ضمن كوكبة معروفة من حركات التحرير المغربية التي انتفضت ضد الوضع الاستعماري بالصحراء المغربية منذ بداية السبعينات (1970) من القرن الماضي – أن هذه المجموعة البوليسارية لم يُعمّر طابعُها “التحريري” سوى سنة ونصف السنة (ماي 1973-شتاء 1974)، إذ تحولت، بقدرة قادر شيطاني إلى أداة دعائية، مكرسة سياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً لخدمة الأجندة الجيو-سياسية الجزائرية…
ومنذ ذلك التاريخ – شتاء 1974 – فقدت مجموعة البوليساريو هويتها “التحريرية”(1)، واستقلالية قرارها السياسي، ثم ما لبثت أن فقدت ما تبقى لها من اعتبارية، بالتحاق النخب المؤسسة لها بوطنهم الأم.
وقد عبرت شهادة مؤطرها الأمني والعسكري، الراحل، العقيد سليمان هوفمان، اليد اليمنى للراحل، الرئيس هواري بومدين، في الشق العسكري لملف البوليساريو، أبلغ تعبير عن تبعية البوليساريو لهيأة الاستخبارات الجزائرية.
فقد صرح لنا، في ربيع 1978، شهوراً قلائل قبل وفاة الراحل، الرئيس هواري بومدين، في حديث بأثينا، على هامش انعقاد مؤتمر الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية لبلدان الحوض الغربي للمتوسط، حول ما قال إنه اقتراح من الرئيس الجزائري الراحل، يتعلق بـ”مقايضة” واقعية، «تَرْفَعُ الجزائر بمقتضاها يدها عن ملف “الصحراء الغربية” مقابل أن يصادق المغرب على اتفاقية الحدود الشرقية (يونيو 1972)»! وعندما لاحظنا أن رفع يد الجزائر عن ملف الصحراء المغربية أصبح عسيراً، في ظل وجود ميليشيا مسلحة تضم آلافاً من المسلحين، هي ميليشيا البوليساريو، أجاب، في لهجة حادة: «البوليساريو من صنع يدي، وفي استطاعة الجزائر حلها في أربع وعشرين ساعة!».
III/ المحور الثالث:
ويرتبط بإطار تسوية النزاع: لقد أقر مجلس الأمن الدولي، منذ سنة 2004 (القرار 1570/أكتوبر 2004) بأن تسوية النزاع لا يمكن أن تتأتى إلا في إطار حل سياسي، واقعي، عملي، وذلك بعد فشل جهود الأمم المتحدة في إطار “مخطط التسوية” (1991) وفي إطار “اتفاق الإطار” (2001)، وفي إطار “خطة السلام” (2003)، وهي صيغ التسوية التي جربتها الأمم المتحدة تباعاً، مسايرة في ذلك “الاجتهاد” الخاطئ الذي تبنته “محكمة العدل الدولية”، والقاضي بإدراج التسوية في إطار مسطرة “تقرير المصير”، متجاوزة بذلك حدود الأسئلة المطروحة عليها بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة (رقم 2318/دجنبر 1974).
IV/ المحور الرابع:
وينصب على مسلسل تفعيل الحل السياسي: يتعلق الأمر في هذا الصدد، بطبيعة المسلسل الذي ينبغي أن يؤطر عملية أجرأة الحل السياسي، إذ أن فعالية وإنتاجية الأخير (=الحل السياسي) باتت مرتبطة بطبيعة المسلسل المفعل له.
وفي هذا الإطار، فإن تفعيل مسئولية الطرف الأصيل في النزاع، الجزائر، في عملية التسوية السياسية له من جهة، وإرساءها من جهة أخرى على أرضية المقترح الذي تقدم به المغرب، لجهة “حكم ذاتي” (Autonomie) في أقاليمنا الصحراوية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، وذلك تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة – لتشكل الأرضية السياسية الوحيدة الممكنة لتسوية النزاع.
ولقد كرس، من جديد، قرار مجلس الأمن الدولي الأخير (2414/أبريل 2018) هذه الصيغة الواقعية، الرشيدة لتسوية النزاع، إذ أكدت الفقرة الثانية من منطوقه أن الغرض من المقاربة السياسية للنزاع هو التوصل إلى “حل سياسي، واقعي، عملي ومستدام لقضية الصحراء، تقوم على التوافق”؛ وبذلك فقد جدد القرار الأممي الأخير وجاهة المبادرة المغربية لجهة “الحكم الذاتي” كحل “واقعي، جدي وذي مصداقية” من جهة، كما شدد تلميحاً، إن لم يكن تصريحاً، على ضرورة الانخراط الفعلي والجدي للطرف الأصيل في النزاع: الجزائر، من جهة أخرى.
V/ المحور الخامس:
تعزيز مقومات العمل الوطني لإنهاء النزاع:
ويتعلق الأمر، في هذا الصدد، بالتشديد على أربعة مرتكزات:
أولها: ترسيخ الوحدة الوطنية حول وخلف جلالة الملك محمد السادس، حامل لواء معركة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وقائد مسيرة التنمية والتقدم للبلاد، وضامن استقرارها وطمأنينتها؛
ثانيها: مواصلة جهود التنمية الشاملة بأقاليم الصحراء المغربية، في إطار النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه جلالته، سنة 2015، بميزانية معتبرة (أزيد من 81 مليار درهم/8ملايير دولار أمريكي)، وهو النموذج الذي يروم بناء اقتصاد جهوي، قادر على تحويل الصحراء المغربية إلى قطب تنموي، إقليمي للتعاون والازدهار في منطقة تمتد من شمال إفريقيا إلى جنوبها؛
ثالثها: مواصلة النضال السياسي والدبلوماسي لفك الحصار العسكري المضروب على إخواننا المحتجزين بمخيمات تندوف، وتشديد مطالبة الأمم المتحدة، و”المندوبية السامية لشؤون اللاجئين”، وكافة القوى الدولية المحبة للحرية والعدالة والسلام، بفرض إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، وتمكينهم من حقوقهم القانونية، طبقاً لمقتضيات معاهدة 1953 حول “اللاجئين”؛
رابعها: تفعيل مسئولية المجتمع المدني المغربي في مراقبة وتعزيز الجهود الحثيثة، السياسية والدبلوماسية والإعلامية التي تقوم بها الدولة، حكومةً وبرلماناً، من أجل تنوير الرأي العام الدولي بحقائق وخلفيات النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
الرباط في 20 يونيه 2018