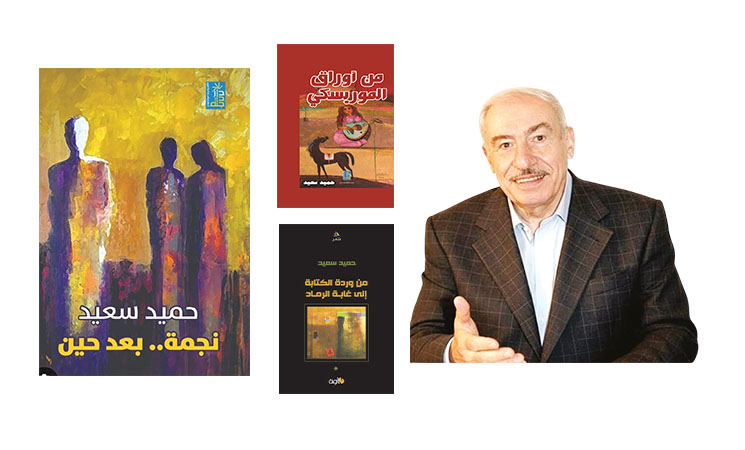عالم السحر عالم مليء بأشياء قليلة نعتبرها حقيقة وفيه كثير من الأساطير والخزعبلات ، اختلط فيه الديني (الإيماني) بالأسطوري والخرافي. وخيارنا للخوض فيه ليس من باب الترف الثقافي، ولكن، لكوني شخصيا ـ أريد أن أفهم ـ قبل أن أحاول الإجابة عن تساؤلات الطلبة أولا، وثانيا، لكوننا ـ نحن المغاربة عموما ـ غالبا ما ننعت من طرف المشارقة بالسحر، وننعت كمغاربة1 ـ مغاربة المغرب الأقصى خصوصاـ بهذه الظاهرة. وفي المغرب ينعت به أهل منطقة سوس من المغرب الجنوبي المتاخم للصحراء ويشار إليهم في هذا الصدد بالبنان.
وأنا بطبعي أحب أن أبسط الأمور، وأقتحم المجالات غير المعروفة لديّ، أحاول استقراء النصوص بمنهج أهل التخصص (في التاريخ والدين والأنثربولوجيا والأدب والثقافة الشعبية عموما .. ) لكي أنوّر نفسي أولا، ولأجل تقريب الموضوع و تبسيطه للمتعلم، ولكل من أراد البحث في المجال، ثانيا.
هدفي دائما ـ إن كان ممكنا ـ هو إجلاء الغامض من الأمور عن طريق معرفة رأي المتدخلين في موضوع معين بمختلف مشاربهم و اختلاف تخصصاتهم، حسب ما أراه .. و ليصحح لي ذوو الاختصاص ، كلٌّ في مجاله حسب رأيه و رؤيته ..
و لأصدقكم القول ، فقد جاءتني الفكرة عندما شاهدت إعلانا تلفازيا عن الشيخ المغربي (الذي يسترد الحبيب ويرُدّ المطلقة (والناشز) ويزوج العانس .. و ربما يُجمّد الماء ) و تساءلت عن تلك النظرة المشرقية عموما لمواطني المغارب (جلهم) بكونهم مهووسون بالسحر و السحرة، وهو الأمر الذي لم أتقبله ولم أستسغه، فما أعلمه هو أن السحر ارتبط ببابل فما الذي جعل المغرب يشتهر به . وبالرغم من أننيمغربي وأعيش بينهم بصفة دائمة ، ولأصولي السوسية، لم أر يوما من يذهب إلى ساحر أو دجال إلا من باب التداوي بالأعشاب أو ما يسميه البعض الطب النبوي ويسميه آخرون الطب البديل. و كباقي البشر ـ الذين أعتبرهم عاديين ـ فإني أسمع فقط عن بعض الناس(وربما هناك من يفع لذلك ـ حتى من معارفي ـ إلا أنهم يتحاشون الحديث عنه) فلا(أنا) ذهبت، ولاذهب أحد معارفي ـ على حد علمي ـ و إنما ـ كما الجميع ـ سمعت، أو قيل وقال، وحدثني فلان عن فلان عن علان .. دون مشاهدة عينية أو حضور. اللهم معاينتي الشخصية لليالي كناوة (والشوافات) أحيانا، وزيارتي لبعضهن للوقوف عن كثب بما يقمن به (وهن غير سوسيات، كما صرحن، إلا واحدة) ، ورؤية المواد المعتمدة في إطار علمي محض. (و كم من مرة طردت طردا).
إذا كان ماركس صاحب مقولة « الدين أفيون الشعوب» يرى الدين كحالة اغتراب تتقاطع معه الرأسمالية ـ كمادية جدلية ـ فهذا انطلاقا من فلسفة التنوير التي عاش وَسَطَها ومنهج فويرباخ الذي يحلل فيه الاغتراب الديني، حيث رأى ماركس في الدين أداة استخدمتها الطبقة المسيطرة من أجل إضفاء الشرعية على سلطتها لكبح جماح أي تمرد ممكن من جانب المسيطَر عليه (باعتباره بنية فوقية).
من هنا جاءت فكرة : الدين أفيون الشعوب»، فالتركيز ـ إذن ـ في النقد عند ماركس ليس على الدين نفسه بل على المجتمع الذي ينتهج الوهم الديني (التقاليد عوض الدين)، ولا يكون الدين أفيونا(نوع من المخدر) إلا إذا كان تقليدا غير واع، فالمجتمع يبحث عن سعادة وهمية في تقاليدَ يعتقد أنها من صلب الدين. ومن ثمة فالتراث الديني ـ سياسيا كان أو اجتماعياـ ليس ثابتا ونهائيا ، بل هو متحكم وفق الظروف والسياقات الاجتماعية والسياسية المصاحبة له، وهو ما يضفي المشروعية عليه فيما يسمى القانون الإلهي(الأخلاقي) ، ليضع حدا لكل تمرد أو حراك أو انتفاضة .. كما نادى به رجال الكنيسة إبان الثورة الصناعية في أوربا.
والدين كأيديولوجيا (موجود سلفا، وليس نظرية بشرية تم التوصل إليها عبر إعمال العقل لقرون) قد يُجيب عن أسئلة الراهن البشري .
لقد بحث أولئك الذين وُكِّلوا للدفاع عن السلطة ومؤسساتها ـ أو نَدبوا أنفسهم فقط ـ للإجابة عن أسئلة الراهن تحت ظل سلطة ما ،وكلما كان واقع الناس مزريا ورأوه سلبيا، لفقوا التهم إلى قوة خارجية، وغالبا تكون غير مرئية، لتكون كبش فداء وتتحمل سوداوية الواقع الذي ليس للدولة دور في انتكاسته، وهذا شيء عادي مادام « سلطة الدين هي دين السلطة «.
حاولت الأنظمة ـ المسماة حديثة ـ التملص من هذا العبء، انطلاقا من تبني العلمانية، فحولت الحق العام إلى حق خاص بحيث يصير الاعتقاد الديني شيئا شخصيا (حقا فرديا) ، فالعلمانية ـ إذا تبنتها الدولة كمبدأ ـ لا تعطي لهذه الدولة و(هذا المواطن الفرد ) حرية أكبر، عبر قبول الآخر والإيمان بالمشترك الإنساني فقط ، وإنما يفيدها في التنصل من شيء مقِضّ اسمه الدين والانتماء العقدي الذي سيُعقّد مهمتها (كدول تحاول جمع الشتات البشري لكياناتها) بوضع مشاريع قوانين.وكل من خرج عن هذه القوانين يعتبر خارجا عن الكيان.
نعم، إن الدين يقدم بعض الإجابات وتكون في الغالب واضحة، تتسم بالمشاعة و يؤمن بها العديد من الناس، بل يكون ـ في نظر المجموعة التي تؤمن به ـ الدين الصحيح ويؤمنون ـ بيقينيةـ أنهم على صواب، وكل من يخالفهم يعتبرونه زائغا عن الحق وبعيدا عن الحقيقة (وكل بما لديهم فرحون).
وكلما كانت الدولة تتبنى دينا معينا ، كانت سلطة هذا الدين تتعاظم ظاهريا فقط ـ كما يقول صاحبا (السوسيولجيا والدين ) ـ ولكنه ـ في الحقيقة ـ يضعف واقعيا . وبالعكس فكلما فُصِلَ الدين عن الدولة، اشتدت أكثر سلطة الدين واقعيا ، نظرا لكون أن روح الدين وروح الحرية يتعايشان في وفاق تام كما يرى توكفيل ـ حين عايش المجتمع الأمريكي ودرسه ـ إذ لا يرى بعض الأفراد في الدولة وفي كل ما يمثلها جبروتا سوى جبروت ذلك الأب الظالم أو الصارم بالمعنى الفرويدي . والفصل إذن بين الدين والدولة يضعف من قوة هذا الدين ظاهريا، ولكنه يقويه واقعيا أكثر. هكذا تكون اللائكية(ويسميها البعض علمانية) قوة للدين دون أن تدري، لأن الدين متجذر في التجربة الفردية، بما أن الشك ليس إلا حالة طارئة في مرحلة ظرفية (قد تكون عمرية أو نفسية .. أي حين يشك المرء في أفكاره المكتسبة في مرحلة ما ويطرح أسئلة وجودية..) ، بينما الإيمان حالة دائمة للإنسان.
وإذا كانت العلاقة بين الدين والدولة ملتبسة دائما وغامضة، فإن هذا الالتباس يتجسد في الصراع الدائر بين الأحزاب في عصرنا هذا .. بين حزب يعتبر الدين شيئا أساسيا في أي مجتمع (وينطلق منه لكي يجمع المناضلين) وبين حزب (ليبرالي) يناصب العداء الدائم لكل حزب ينطلق من خلفية دينيةـو لو ظاهرياـ ، لدرجة أنه كلما اقترب حزب (ذو خلفية دينية) من مركز النفوذ إلا واعتبر سياسيوه (أو من يسميهم مناضلين) أعداء الوطن والشعب، من طرف الأحزاب الأخرى(المُنافِسة)، بغض النظر عن وطنيتهم، على اعتبار، أنهم يمثلون الدولة، من جهة، ولديهم خلفية مشتركة مع الجميع من جهة ثانية وهم لا يتخذون الدين إلا ذريعة لبلوغ السلطة من أجل التحكم في البلاد وفي رقاب العباد.
والمسألة قد تزداد تعقيدا بل تكون أكثر غلوا، حين نمر من الدين (كمعتقد) إلى فكر يقدس الإنسان انطلاقا من خلفيته الدينية أو العرقية، لتصير شخصية السياسي مقدسة بالإيمان، لأنها فقط تنتمي لهذا الدين أو ذاك، أو هذه الإثنية أو تلك، ولا نستغرب حين يتحول السياسي من رجل عادي إلى شخص مقدس لا لشيء إلا لأن خلفيته العقدية ذات طبيعة مقدسة لدى البعض.
كم من مفكر لا نفهم عمله إلا انطلاقا من خلفيتنا (نحن) الدينية والأخلاقية وليس العلمية المتجردة من خلفياتنا تلك تحليلا وفهما كما سنرى مع فيبر .. فهذا الأخير لا يتناول الدين كنسق من « نظم المعتقدات « بل هو « أنساق من تنظيم الحياة «. وفي كتابه يرى أن الأشكال الأكثر أولوية للسلوك الذي تحركه عوامل وبواعث دينية أو سحرية يتوجه نحو هذه الدنيا على الأفعال المكتوبة (المقدرة) مقدمَة من قبل الدين أو بواسطة السحر حتى يمكننا الحصول على السعادة والعمر الطويل على هذه الأرض ..
أي نعم، الدين مراقب للأخلاق، فهو لا يسمح بتجاوز الحدود في مواطن معينة (كالبحوث الجذعية مثلا) ويستعمل مكابح الحرية المسيجة بالخطوط الحمر للدين بفضل القانون الوضعي (البشري) الذي اكتسب شرعيته بفضل الدين كقانون إلهي ـ قانون الإجهاض وما يثيره من خلافات أخلاقية ـ ، مما لا يسمح للدولة أن تطلق العنان للحرية انطلاقا مما يحدده هذا الدين أو ذاك ـ على الأقل حياتيا ـ لأن الحياة الأخرى ـ أي بعد الموت ـ حرية فردية وشيء شخصي، شرط أن لا يظهره الفرد في ما يتعلق بالحياة الدنيا. و أظن أن هنا مربط الفرس، والاختلاف الحاصل بين المسيحية الأوربية / الأمريكية من جهة والإسلام من جهة ثانية ، لأن هذا الأخير يعتبره أصحابه (دين حياة). فإذا كان قساوسة العصر الوسيط يتحدثون فقط عن الدين الفردي (كإيمان بحياة أخرى بعد الموت )، فإن علماء المسلمين يتحدثون عنه كدين للدنيا والآخرة في نفس الوقت، ففي منظورهم يعتبر دينا ودنيا (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا ). فالإسلام عَلّم الأمة (التجمعات البشرية)، حتى كيف يدخلون الكنيف (أعزكم الله).
في حين يرى آخرون أن مبادئ الثورة الفرنسية هي النموذج ، وهم ينظرون إلى الأشياء ـ في نظر الفقهاءـ بعين قاصرة ، إذ هم يرونها (أفكار الثورة الفرنسية ) نوعا من الدين الجديد. وكما يرى بعض منظري علم الاجتماع ، فقد شوش هؤلاء بفكرهم على العقول قبل القلوب لأن الثورة الفرنسية كانت ثورة على الموروث السياسي والديني أي على الموروث الثقافي ككل، ومن ثمة كان كل من تبنى اللائكية يدعو إلى نظام شمولي يتحكم فيه العقل ـ فقط ـ وهو أمر لا يمكن ان يسكت عنه المتدينون بوعي (وليس الفقهاء فقط )، لأن الدين جزء من (الطبيعة البشرية)، وعليه يجب أن يشكل قطب الرحى في كل تفكير ديمقراطي مادام يوفر للأغلبية نوعا من الراحة النفسية قبل الروحية.