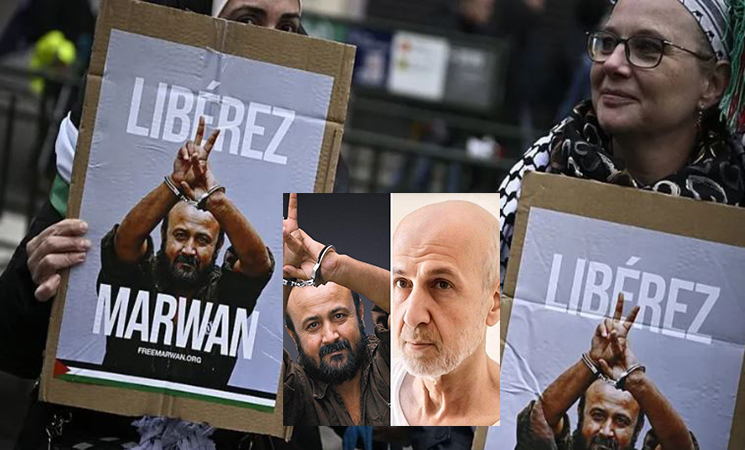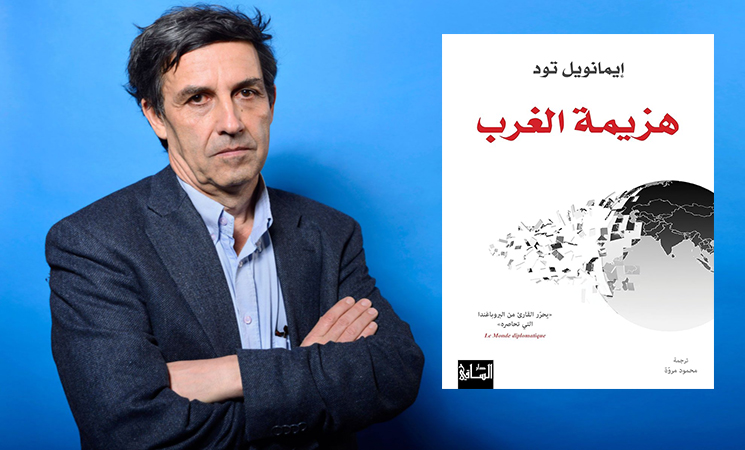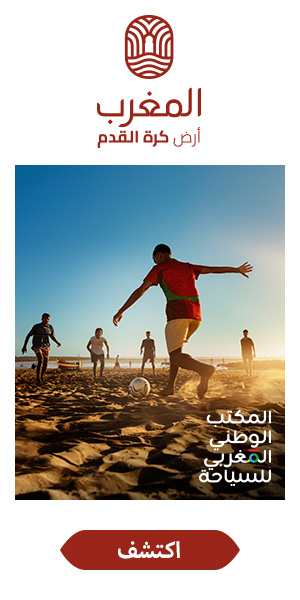نعود مجددا إلى «حياكة الزمن السياسي في المغرب، خيال الدولة في العصر النيوليبرالي»، هذا الكتاب السياسي الرفيع، الذي ألفه الباحث المتخصص في الانتروبولوجيا السياسية والبحث في شوون الدولة والاسلام السياسي، محمد الطوزي، وسلخ فيه، رفقة الباحثة اليزابيت هيبو ثلاثين سنة من البحث والتنقيب والتراكم.
وهو كتاب كل فصل فيه يشكل بنيانا قائم الذات، يسعى الباحثان من خلاله الى الدفاع عن اطروحة لم تكن بدهية حول الدولة، والبرهنة على تعايش الدولة ـ الامبراطورية والدولة ـ الأمة، بسجلَّيْهما المادي التاريخي و الروحي الرمزي، في راهن المغرب.
وهي عودة إرادية، لما لمسنا فيه من قدرة على تسليط الأضواء على فهم المسار الفيبيري (نسبة الى السيكولوجي الأمريكي ماكس فيبر) للدولة، وفهم الكثير من تحولاتها الراهنة.
وهوكتاب يمنح قارئه كما قد يمنح رجال السياسية في مراكز القرار والمناضلين أدوات التحليل الضرورية لفهم تحولات المغرب الحديث، وفهم الكثير من موضوعات الراهن السياسي والإعلامي المغربي (كما هو الحال في دستور 2011 وقدرة النخب السياسية والحاملين لمشاريع الليبرالية الجدد وتعالق شرعية الانتخاب مع شرعية التعيين في دولة تجمع سجلين ، واحد امبراطوري والاخر ينتمي الى الدولة ـ الأمة الي غير ذلك من المواضيع الراهنة).
إن العنف النموذجي، البالغ في وحشيته، لم يتخذ الشكل الوطني للدولة الموصوف أعلاه فيما يتصل بسنوات الرصاص فحسب، بل اتخذ أيضاً مظهراً إمبراطورياً من خلال تحويل «الجناة» إلى سجناء شخصيين للملك. وهذا يأخذ شكلا، محدد الهدف دوما، من خلال أماكن احتجاز سرية تتسم بالعنف غير المتناسب. ودون الخوض في التفاصيل، يجدر التذكير بوجود تازمامارت، مركز الاحتجاز غير القانوني الأكثر رمزية، وعملية «اختفاء» «أفراد الكوماندوز» المتورطين في محاولات الاستيلاء على الدولة – والذين غالبًا ما يقدمون أنفسهم كضحايا لرؤسائهم. واتخذ هذا البعد الإمبراطوري للعنف الأقصى، وجهًا آخر، ليس فقط باستهداف «المجرمين»، بل أيضًا بتأثيره على أسرهم بأكملها، كما يتضح من المعاملة التي تعرض لها أفراد من عائلة الجنرال أوفقير، سواء في السجن وإجبارهم على النفي أو الموت الاجتماعي. وأخيرًا، اتخذ العنف شكل توسيع نطاق العقوبة ليشمل المجتمع بأكمله الذي ينتمي إليه «الأعداء»( السجين باعتباره مجموعة بشرية وليس فردا). وبالتالي، ليس عاديا، المهم أن هيئة الإنصاف والمصالحة حددت أراضٍ بأكملها كانت هدفًا للَّعنات أو للنسيان، باسم الثورات أو الأحداث السياسية التي تورط فيها أفراد محددون.
إن استغلال العدالة وتسخيرها هو واقع مألوف في كافة الأوضاع الاستبدادية. وما يميز العنف الإمبراطوري، على الأقل في عهد الحسن الثاني وحتى منتصف تسعينيات القرن العشرين، هو الطابع الظاهر والمعترف به لهذا الاستغلال؛ وتشير فقرات عديدة من تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة إلى المشاركة المباشرة للقضاة في بعض الأحيان، وغير المباشرة في كثير من الأحيان( الحالة الخاصة باغتيال الشهيد عمر بنجلون ) . وهكذا، فإن ظهير 1935 (الذي كان يهدف إلى قمع الحركة الوطنية، ولا سيما بعد المظاهرات ضد الظهير البربري) وظهير 1936 (الذي حظر أي نشر أو توزيع «منشورات هدامة») ، الصادرين في فترة الاستعمار أُعيد العمل بعقوباتها رسميًا، ولاسيما منذ عام 1965، لقمع الأنشطة الحزبية والجمعوية، على الرغم من طبيعتها المخالفة لقانون العقوبات وقانون الصحافة. ولقد كانت تعديلات قانون المسطرة الجنائية في عامي 1962 و1974 تهدف صراحةً إلى تقييد التعبير عن الحريات الفردية وإجراء محاكمات عادلة.. .
إن «الهيبة» التي ذكرناها أعلاه هي في الوقت نفسه سمةٌ من سمات المخزن وأداءٌ من أعماله. إنه عنف رادع لا يقتصر على علاقات القوة في العالم السياسي. وفي عهد الحسن الثاني، كان يتم ممارسته بشكل يومي. وكان هذا الموقف، الذي يقترب من الخوف، منتشراً للغاية في ثمانينيات القرن العشرين. نصادفه في عيون الأم التي كانت تترقب عودة ابنها من النادي السينمائي، وهو نشاط يعتبر محفوفاً بالمخاطر، وفي عيون الأب المرعوب من أبسط الانتقادات التي يوجهها ابنه لكيفية اشتغال حكم الدولة، ولا يتوقف أبداً عن تذكيره بهذه المقولة: «ضع نفسك بين الآخرين، واطلب من الجلاد قطع كل الرؤوس(دير راك بين الريوس وعيط اقطَّاع الريوس)». هذا الخوف من المخزن لا علاقة له بالخوف من نظام بوليسي، بل هو أقرب إلى الشعور الذي ينتاب المرء عند الاحتكاك بالمقدس: فبدون فهم طبيعة الخطر، يشعر المرء في أعماقه بوجوده!
انتشار العنف في صورة هيبة مشتركة، كان مبنيا على قناعة كانت تحذو الحسن الثاني بقدرته على التحكم في المجتمع نفسه، لأنه، وكما قال هو ذلك، كانت في داخله، وعليه يمكنه أن يتجاوز وجهة نظر المجتمع لأنه كان يعرف كل شيء، غريزيا!. ولا نعدم الأمثلة على ذلك. رأينا سابقًا أن الحسن الثاني كان مقتنعًا بـأنه يملك الحقيقة عن الإيقاعات الموسيقية، كما عن الكوريغرافيا، وهي القناعة التي كلفت نقمة وعزلة طويلة للفنان الراقص لحسن زينون…