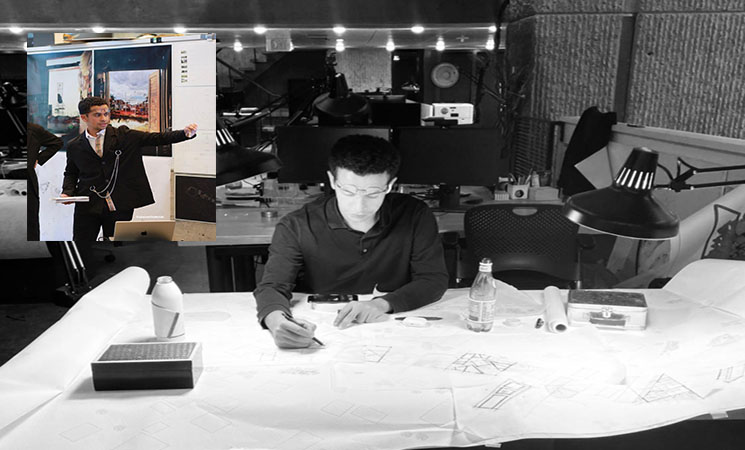نعود مجددا إلى «حياكة الزمن السياسي في المغرب، خيال الدولة في العصر النيوليبرالي»، هذا الكتاب السياسي الرفيع، الذي ألفه الباحث المتخصص في الانتروبولوجيا السياسية والبحث في شوون الدولة والاسلام السياسي، محمد الطوزي، وسلخ فيه، رفقة الباحثة اليزابيت هيبو ثلاثين سنة من البحث والتنقيب والتراكم.
وهو كتاب كل فصل فيه يشكل بنيانا قائم الذات، يسعى الباحثان من خلاله الى الدفاع عن اطروحة لم تكن بدهية حول الدولة، والبرهنة على تعايش الدولة ـ الامبراطورية والدولة ـ الأمة، بسجلَّيْهما المادي التاريخي و الروحي الرمزي، في راهن المغرب.
وهي عودة إرادية، لما لمسنا فيه من قدرة على تسليط الأضواء على فهم المسار الفيبيري (نسبة الى السيكولوجي الأمريكي ماكس فيبر) للدولة، وفهم الكثير من تحولاتها الراهنة.
وهوكتاب يمنح قارئه كما قد يمنح رجال السياسية في مراكز القرار والمناضلين أدوات التحليل الضرورية لفهم تحولات المغرب الحديث، وفهم الكثير من موضوعات الراهن السياسي والإعلامي المغربي (كما هو الحال في دستور 2011 وقدرة النخب السياسية والحاملين لمشاريع الليبرالية الجدد وتعالق شرعية الانتخاب مع شرعية التعيين في دولة تجمع سجلين ، واحد امبراطوري والاخر ينتمي الى الدولة ـ الأمة الي غير ذلك من المواضيع الراهنة).
لقد رأينا أن الحسن الثاني كان مقتنعاً بأنه يمتلك الحقيقة بشأن إيقاع الموسيقى وكذلك بشأن تصميم الرقصات، وهي القناعة التي جرت النقمة على فنان الباليه لحسن زينون و«عبورا طويلا للصحراء» . إن هذه الثقة بمعرفة كل شيء عن كل شيء، كانت في كثير من الأحيان تثير مواقف تراجيدوـ كوميدية على وجه التحديد بسبب تشابك السجلات: ففي حين كانت روح هذا العنف مسألة ذات صلة بالدولة الأمة، فإن إخراجه وتلقيه كانا من صميم الإمبراطورية . وينطبق هذا بشكل خاص على العمارة والفنون الزخرفية. هنا لا يتم ممارسة العنف بشكل مباشر على جسد الضحية.( في 14 يناير 2018، بمناسبة حفل افتتاح ترميم بوابة في مدينة فاس العتيقة الذي نظمته وزارة إعداد التراب الوطني والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين (خلالها احتفى الملك محمد السادس بذكرى خطاب والده الراحل 14( يناير 1985) باعتباره ”يوم المهندس المعماري”. يأتي هذا الحفل، الذي ترأسه الوزير، إحياءً للذكرى الثانية والثلاثين للخطاب الذي ألقاه الراحل الحسن الثاني أمام المهندسين والذكرى 12 للرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المهندسين في 18 يناير 2006 )
أي لا على المهندسين المعماريين، باعتبارهم مهندسين، ولا على المجتمع بحد ذاته، بل يمر عبر هؤلاء الوسطاء المعتمدين الذين يعيدون تفسير كلمة الملك وتكريسها، من خلال اختزالها في قاعدة عمل!.كما هو الحال في الخطاب الشهير لـ 14 يناير 1986، والذي يدل على حساسية جمالية حقيقية. فقد قال الحسن الثاني إنه يشعر بقلق بالغ إزاء قبح المدن المغربية. وأوضح للمهندسين المعماريين المجتمعين في الملتقى أن لديهم مسؤولية الاهتمام بتاريخ العمارة المغربية ورقي ذخيرتها الحرفية الجمالية، ودعاهم، في عقودهم الخاصة مع عملائهم، ودون فرض نموذج معماري عليهم، بل إلى جعلهم، من خلال العمل البيداغوجي، بما في ذلك الابتكار، يأخذون في الاعتبار هذا البعد التراثي. وقد اختزل إدريس البصري، وزير الداخلية آنذاك، والمسؤول في ذلك الوقت أيضا عن التخطيط الحضري والوكالات الحضرية، هذا الخطاب ذي الدلالة الخاصة في مطلب وحيد هو دمج القرمود الأخضر لمدينتي فاس ومكناس في جميع المشاريع العامة كعلامة على العمارة المغربية الأصيلة. وفي الوقت نفسه، كان حوالي خمسين أستاذاً من كلية الحقوق بجامعة الدار البيضاء، منظمين داخل تعاونية سكنية، ينفذون، فوق بقعة أرضية ممنوحة من الدولة بثمن معقول، مشروعاً صممه المهندس المعماري الطليعي عبد الرحيم السجلماسي. وكانت المدينة ـ الحديقة التي تصورها هذا الأخير تنتمي إلى حداثة بعيدة كل البعد عن الطراز المغربي: لا زليج ولا قرمود أخضر. ولكن العقيدة الحضرية الجديدة لم تَعْدم فتح نقاش داخل التعاونية ـ بمبادرة من إدريس البصري نفسه، الذي كان عضواً فيها ـ حول ضرورة التوافق مع ”المعيار الجمالي الوطني” وذلك بتغطية أسطح المنازل بالقرمود الأخضر.وبالإضافة إلى تردد المهندس المعماري، الذي رأى إبداعه مشوهاً على هذا النحو، كانت هناك مشكلة التكلفة. ذلك أن تكلفة تركيب قرمود على الفيلات كان يقدر بـ 10% من إجمالي تكلفتها، مما جعلها غير متاحة للأساتذة. كان الجميع مقتنعا بأن هذا المطلب غير مناسب، حتى لا نقول غبيا، ولكن كان من الضروري الخضوع له: ذلك أن الفرضية بأن الملك يمكنه، وهو يمر بهاته الطريق المؤدية إلى المطار، طرح السؤال عن غياب القرمود، فرضية غير واردة كثيرا لكنها لم تكن مستحيلة . ونرى هنا الهيبة وهي تشتغل في المجتمع بما في ذلك في وسط النخبة المتنورة، فلم يكن واردا المجازفة بوضع مثل هذا.