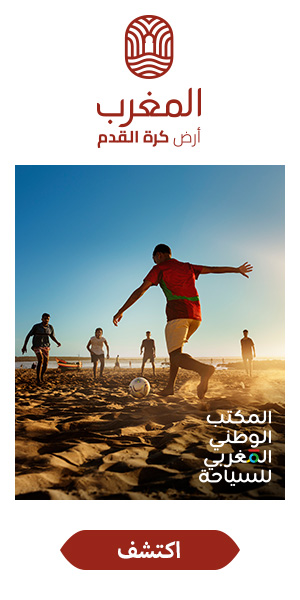نعود مجددا إلى «حياكة الزمن السياسي في المغرب، خيال الدولة في العصر النيوليبرالي»، هذا الكتاب السياسي الرفيع، الذي ألفه الباحث المتخصص في الانتروبولوجيا السياسية والبحث في شوون الدولة والاسلام السياسي، محمد الطوزي، وسلخ فيه، رفقة الباحثة اليزابيت هيبو ثلاثين سنة من البحث والتنقيب والتراكم.
وهو كتاب كل فصل فيه يشكل بنيانا قائم الذات، يسعى الباحثان من خلاله الى الدفاع عن اطروحة لم تكن بدهية حول الدولة، والبرهنة على تعايش الدولة ـ الامبراطورية والدولة ـ الأمة، بسجلَّيْهما المادي التاريخي و الروحي الرمزي، في راهن المغرب.
وهي عودة إرادية، لما لمسنا فيه من قدرة على تسليط الأضواء على فهم المسار الفيبيري (نسبة الى السيكولوجي الأمريكي ماكس فيبر) للدولة، وفهم الكثير من تحولاتها الراهنة.
وهوكتاب يمنح قارئه كما قد يمنح رجال السياسية في مراكز القرار والمناضلين أدوات التحليل الضرورية لفهم تحولات المغرب الحديث، وفهم الكثير من موضوعات الراهن السياسي والإعلامي المغربي (كما هو الحال في دستور 2011 وقدرة النخب السياسية والحاملين لمشاريع الليبرالية الجدد وتعالق شرعية الانتخاب مع شرعية التعيين في دولة تجمع سجلين ، واحد امبراطوري والاخر ينتمي الى الدولة ـ الأمة الي غير ذلك من المواضيع الراهنة).
إن إمكانية أن يطرح الملك، وهو يمر على هذا الطريق المؤدي إلى المطار، مسألة عدم وجود الآجر الأخضر، أمر غير محتمل، ولكنه ليس مستحيلاً. وهنا نرى الهيبة تعمل في المجتمع، بما في ذلك داخل النخبة المستنيرة المفترضة: لم يكن هناك أي معنى في المخاطرة بمثل هذا الوضع! وبعد نقاش طويل، تم التوصل إلى خدعة: تقاسم المخاطر وتجهيز بعض المنازل، التي يمكن رؤيتها من الطريق، دون المساس بالمنازل الأخرى. وتم إجراء قرعة لاختيار الأساتذة الذين سيقع عليهم وضع الآجر الأخضر.
في مجال العمارة، لم يمس العنف الإمبريالي الطراز المغربي فحسب، بل اتخذ أيضًا شكل التخطيط الحضري الاستبدادي، الذي وقعت الدار البيضاء ضحية له في أعقاب أحداث عام 1981، حيث تم تقسيم المدينة إلى خمسة كيانات، كل منها يديرها عامل يشغل عمالة، بناء إداري هائل من حيث الحجم والهندسة المعمارية.
وفي موضوع ذي صلة، رافق مخطط “بينسو”، الذي سُميَ على اسم المهندس المعماري الذي وضعها، بناء مسجد الحسن الثاني، الذي شكّل لحظة عنف شديد، جمع بين المعرفة الإمبريالية ومعرفة الدولة الأمة، واتخذت المساهمة المالية للجميع في بنائه شكل خصم إجباري من المصدر من رواتب الموظفين العموميين، واستخلاص من القطاع الخاص مقابل الحصول على دبلوم في صيغة ظهير التوقير والاحترام.
وظلت هذه الهيبة المنتشرة التي تسري في الجسم الاجتماعي بأكمله ظاهرة للعيان حتى وقت قريب في العلاقة التي حافظ عليها المغاربة مع إدارات معينة، مثل تلك التابعة لوزارة الداخلية. إن هندسة الأماكن، مثل تجديد هذه الإدارات لألقاب القائد والباشا، ووجود المخزني داخل مبانيها، وهو إرث إمبراطوري ورثته عن الحماية، منحاها مظهر دار مخزن مهيب، إن لم يكن مخيفًا.
يجمع هذا الشكل الثالث للعنف، وهو سمة مميزة للفترة الأخيرة من حكم الحسن الثاني، بين منطق الدولة الوطنية والإخراج الإمبراطوري. وبالتالي، فهو يضفي على العنف طابعًا “غرائبيا”، بينما يُخففه جزئيًا، على الأقل، في بُعده المادي والفردي، وهي ليست أقل قوة من الناحية الرمزية والاجتماعية والجماعية. وبمجرد ما تم ترسيخ سلطة الحسن الثاني، لم يعد اللجوء إلى العنف ضرورياً، وتم توظيف الهيبة في خدمة تعزيز الدولة القومية.