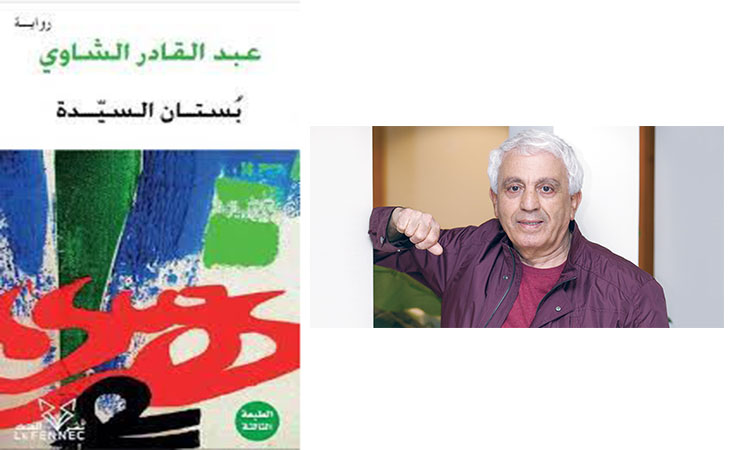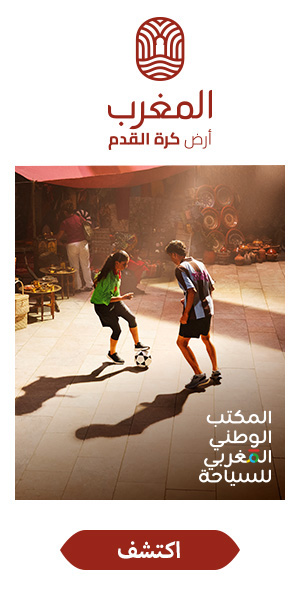بعد أن نشر عبد القادر الشاوي روايته الأولى «كان وأخواتها» بأقل من أسبوع، صدر قرارٌ بمنعها من التداول في المكتبات والأكشاك؛ وهو القرار الذي أسهم في زيادة الإقبال عليها من لدن القراء والمهتمين بالأدب، إن على مستوى اقتنائها خفية خوفا من البوليس السري أو استعارتها من صديق في زمن كان الكتاب سيّد العلاقات الطلابية والتعليمية بشكل عام.
دَشَّنَتْ هذه الرواية (أقصد «كان وأخواتها») الكتابة ضد الصمت الذي يعيشه المعتقل السياسي في المغرب؛ وهي إشارة تعوّدنا على قراءتها في الكتب والروايات العربية في المشرق.
إنها كتابة مضادة للظلم، ومعلنة بصوت عَالٍ الحرية والحلم. ثمّة أعمال أخرى تسير في هذا المضمار؛ كأعمال عبد اللطيف اللعبي مثلا، وغيرها من الأعمال التي تدفقت بانفجار فارق في تسعينيات القرن العشرين. ونحن، هنا، لسنا في مقام الكتابة السجنية كما تعوَّدَ النقاد على تسميتها بقدر ما نحن أمام رواية «بستان السيدة»(*)؛ وهو عمل يفترض من قارئه الفطنة والنباهة حتى يسلم حين انتهائه من القراءة، وهي القضية المائزة في هذا النص.
لا تدخل هذه الرواية ـ كما يعتقد البعض ـ ضمن ما يشتغل عليه الأستاذ عبد القادر الشاوي في دراساته البحثية المتعددة (الذاكرة) بقدر ما تكون الذاكرة خلفية عرضية في النص ككل.
صحيح أن قراء هذه الرواية يخلصون إلى تطابق الكاتب لاهتماماته المتعددة في موضوعات الذاكرة، وهذا النص الروائي، كما لو كان شرط الرواية يرتبط جدلا بالذاكرة من حيث هي موضوعة بحثية. في هذا التنازع المثمر يبني الكاتب نصه الروائي من خلال أربعة شخوص. شخصان يظهران بكامل حضورهما، وآخران يظهران ويختفيان بين الواقعي والمجال الافتراضي. السارد في هذه الخلفية يقوم بتطريز الوقائع والأحداث بين مدريد والأندلس والرباط وباريس وتونس والبيضاء، وهي أمكنة تحيل على مرجعها الثقافي، وما تمثله في العقود الأخيرة من زمننا؛ زمن الكاتب والسارد معا.
كيف يمكننا قراءة هذا النص المتشابك كمتاهة العجيب؟ وهل تكون هذه السلسلة من «بستان السيدة» ومقاماتها مفتاحا لتقريب حلقاتها المتعارضة والمتباعدة إلى سلسلة واحدة. قد يكون هذا السؤال الماكر طريقا لخدعة النص وشخوصه والقارئ معا، وكأني -أنا القارئ- أحاول عبثا إيجاد الفوارق والتعارض والبحث عن الجداول والمربعات لإدخال هذه الشخصية أو تلك. هذه طريقة ممكنة يقدمها لنا النص الروائي لعبد القادر الشاوي؛ ولكن قبل هذا وذاك نبدأ من هذا العنوان من حيث هو عتبة رئيسة في النص.
«بستان السيدة» هو العنوان الذي وُسمت به هذه الرواية، والمكون من كلمتين: «بستان» و»السيدة» بين ظاهر متعدد، وواحد يحمل تعدده في دواخله. عادة ما تكون البساتين ساحة تأمل وبوح، وعادة ما يحمل في مظهره تعدد نباتاته وأزهاره وأشجاره….، قد يكون معتنى به، وقد يعيش في فوضاه الموحشة. في الجهة الأخرى يرتبط بالسيدة كما لو كانت صاحبته. إن البستان يروم اللذة من حيث هي لازمته؛ وهذا مرتبط بعدد من العناوين الصغيرة والكبيرة في الكتابات العربية، قديمها وحديثها، وبالضبط في النصوص الكلاسيكية الإيروتيكية تكون اللذة والمتعة لصيقتين بالبستان، وكأن هذا الأخير بدون تاء التأنيث خراب.
ما العلاقة بين هذا ورواية عبد القادر الشاوي؟ صحيح أن الكاتب لم ينتبه إلى حد كبير إلى مكر قرائه في تناولهم لعنوانه، وقد يكون كما عودتنا الدراسات الأدبية واللسانية أن التسمية اعتباطية. وهي تسمية تفيد الأصل والنسخة، وتفيد المعنى والوجود كأن يكون ارتباط العنوان دليل صاحبه ينتظم في ملكيته الخاصة. إلا أن هذا العنوان يشي إلى إمتاع شخوص الرواية والقراء معا ما دام هؤلاء ضيوفا- وجب أن يكونوا مرحين – مرحبا بهم في بستان السيدة. لنفترض أننا من هذا النوع من الضيوف سندخل الرواية متجاوزين الصورة التي تم لصقها بالكاتب.
إن أول فكرة يخرج بها قارئ الرواية هو كونها تنتمي إلى الفضاء الرمزي للكاتب (كيفما كان هذا الكاتب) أنه دال على بعض الأسئلة الحارقة التي تطرحها «بستان السيدة» من قبيل: الانتحار – الكتابة – الذاكرة- المجال الافتراضي – الاعتقال السياسي – الاحتجاجات في الميادين العامة – القراءة – روايات – التواصل الاجتماعي…
فهذه الموضوعات التي تتخصب على طول وعرض النص تنتمي إلى مرجع اهتمام صاحبها. من هنا، نحاول – بقليل من المكر- الوقوف على نقطتين رئيستين في الرواية؛ وهما:
– تداخل الشخوص والأدوار:
لا نريد الانشغال بأدوات تحليل نفسية لضبط هذا التداخل حتى وإن كانت العلاقات المرآوية نَاظِمَتُهاَ الأساس بين سعد السارد وكريم السعداني، وبين مريم البدري وحنان الداودي. يحاول السارد بإبداعية بديعة خلق هذا الغموض الموجود بين شخوصه، وتفكيكه إلى ذرة صغيرة، إلى حد وضعه (أي الغموض) مسارا أساسا في العمل الروائي، كما لو كان هو الذي يعطي للنص الألق والمعنى حتى وإن كان يذكر قارئه – وباستمرار – أنه لم يلتقِ بحنان الداودي قط، وأن العلاقة بينهما افتراضية وأنه يتحرق لرؤيتها وممارسة الحب معها. «حلمت بأن اللقاء الباريزي ربما كان في شهر فبراير، ولعلي أردت من خلاله، في الحلم، التعرف عليها هناك بعد أن لم يتيسر اللقاء بها في أي مكان آخر إلا على «وجه» الرسائل الإلكترونية الكثيرة، المتدافعة في بعض الأحيان التي كانت تصلني منها. وكنت بدوري أبعث بها إليها تماشيا مع الإيقاع الذي فرضه غموض العلاقة « (ص63).
ثمة الكثير من الأمثلة الدالة على ذلك (ص: 53، 55،59) وهي تشير إلى نوع العلاقة التي تربط السارد بحنان الداودي؛ علاقة لا تلتبس في فضائها الافتراضي بقدر ما تكونه كامرأة أخرى بينما المرأة الأولى تم سترها وحجبها في الذاكرة. المرأة الأخرى هي المرغوب فيها لا شعوريا، وهي بذلك تظهر في الحلم باعتباره تجليا لا شعوريا. أما المرأة الأولى التي ارتبط بها في الرباط، والتي غرق في عرقها في لحظات متقاربة إلى حد الفراق. في (ص12) «أنت إلى العلاقة الأخرى أو الزواج الآخر، وأنا إلى مدريد، أنت إلى الأولاد والعمل المزعج، وأنا إلى شيء من الأحزان التي كانت تراودني عن نفسي في الوحدة الإسبانية الثقيلة».
إذا كان تبرير المفارقة والفراق بين السارد ومريم، فإنها مع ذلك هي العارفة وضابطة إيقاع سعد؛ أي هي التي تحمله إلى المرأة الأخرى للعمل معا على ترجمة كتاب من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية. إذن، السارد سيتواصل مع حنان الداودي للتداول حول شروط التعاقد وما إلى ذلك، وهي شاعرة تفيض بالأحاسيس… إنها شخصية مأساوية، بتعبير السارد. هذه الشخصية زوبعت كيانه الذي يرغب فيها، ويقوم بين الفينة والأخرى بتأويل رسائلها، والوقوف على بعض العبارات. في الجهة الأخرى من الصورة يوجد كريم السعداني هذا المناضل السياسي المريض بالسرطان الذي انتشر في جسده، والذي سيموت في إحدى المصحات بباريس. حنان عشقته بشكل أضحت خاضعة له كما لو كان سلب حريتها ووجودها إلى حد اليأس القاتم. ستنتحر حنان الداودي. هي الإشارة الأولى التي تبتدئ بها الرواية «حسبت دوما أن المنتحر يملك من الأسباب ما لا يملكه غيره حين تحمله حملا على القيام بفعل لا يمكن أن يقدر عليه سواه».
هذا الهاجس الوجودي هو ملح الرواية، أو هو النار التي هيأتها (أي الرواية لنا).
هذا ما يتضح لنا في عدد كثير من الأمثلة الدالة؛ من قبيل: سؤال الذات وعلاقته بآخرها، الانتحار كاختيار، الكتابة، الذكريات، المتعة، وقضايا أخرى تستقيم وفق هذا الشرط الوجودي الفارق.
لقد برع الأستاذ الشاوي بوضع هذه الشخوص وسط قاعة بها مرايا، كما لو كان يريد تقديم بُورتريه شخصية ما بمثيلتها؛ فسعد لم يعد بإمكانه رؤية ذاته إلا من خلال تراسله مع حنان، ومريم البدوي هي الأخرى ترغب في استعادة صاحبها من خلال حنان؛ بينما في الجهة الأخرى كريم السعداني الذي يعيش ألمه الوجودي يفكر في الموت ولا يجد في حنان إلا صفحة من صفحات حياته. إن براعة الكاتب في هذه العلائق المرآوية بين شخوص روايته، والتي يجد في شخصية الناصري شاهدا على كل ما يحدث. هذا الأخير يقترح على سعد قراءة رواية «الوداع الأخير» لسيلبيا جويس. وكأن هذه الأخيرة هي خلفية مرآوية لرواية سعد.
الذاكرة ـ الكتابة:
هذه العلاقة الشرطية بين الكتابة والذاكرة هي الموضوعة التي ينتظم فيها هذا النص. لا يتعلق الأمر بحكاية الذاكرة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه منها حتى لا ينجرف في النسيان، وكأن الكتابة هي التي تعطي المعنى للذاكرة وقد يكون العكس صحيحا تماما؛ بل إن الذاكرة هي ملح الكتابة. إذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أن الكاتب يسجل كل ما يجده ممتعا في ذاكرته أو بالأحرى في ذاكرة حاسوبه، ليستثمرها أسئلة وكتابة. صحيح أن السارد يبحث في ذاكرته عن المرأة المرغوب فيها، والتي انتحرت في الأخير، هذا الانتحار هو الذي سيؤسس عليه كتابته. وفي صيغة أخرى يعود الكاتب إلى ذاكرته الإلكترونية ليجد تعليق صديقه أحمد الناصري على روايته، ومفادها هو تحريض على قراءة رواية «الوداع الأخير» كما لو كانت هذه الأخيرة ذاكرة رواية السارد. في هذه الخلفية الأدبية في الكتابة تكون الذاكرة معينا رئيسا تعطي للأحداث ومكوناتها المعنى. صحيح أن كاتبنا اشتغل علميا على الذاكرة الوطنية والأدبية والسياسية، وهو بذلك يجد فيها علبة أسرار يومئ إلى فضحها، حتى وإن كان – في عمقه- يود حجبها ونسيانها.
بين الذاكرة والنسيان نقرأ في الصفحة الثالثة والعشرين: «… هذا ما رأيته في الذاكرة وأرتني إياه ذاكرتي، ذاكرتي عنها. ورأيت ورأيت حتى اعتليت ذاكرتي… تلك الذاكرة، فجاء الانتحار للختم». في هذه العلاقة الفارقة تنكمش الذاكرة في انتحار المرأة التي تسقيها كي تحيا وتعيش. نعني بذلك أن المرأة هي الخبيرة الممتازة بالصور والذكريات، أي أنها هي التي تنعش الذاكرة، وتعطيها الحياة. نحن إذن أمام مفارقة غريبة بين ذاكرة السارد والمرأة التي تعطيها الحياة، وهي بطريقة أخرى تمنح الحياة لساردها. المرأة بهذا المعنى منبع الأسرار والحياة؛ إنها الأرض التي تمت بستنتها حتى أضحت «بستان السيدة».
على سبيل الختم، ثمة قضايا أثارتني في هذا العمل الروائي أشرت إلى بعضها، وتركت غالبيتها لقراء آخرين، أو ربما سأعود إليها إذا كنت ضيفا خفيفا على «بستان السيدة». أما إذا كنت غير ذلك فما علي إلا الوقوف هنا دون العودة إلى السطر.
صحيح أن الرواية إضافة نوعية في المكتبة المغربية، وإن كان اختيارها البدئي سؤالا وجوديا بالمعنى الفلسفي العميق. سؤال ما انفك يحضر ويغيب بين الذاكرة والنسيان بين الكتاب الورقي وكتابة الرسائل الإلكترونية، بين الهاتف والرغبة في الاتصال المباشر، بين الكتابة والمحو؛ فالكاتب حاول مصارعة التقنية باعتبارها لا تفكر – حسب تعبير هايدجر. هذه أو تلك الرسائل التي يتواصل بها سعد مع حنان الداودي سرعان ما تنمحي. لهذا، يسجلها في ذاكرة الحاسوب. هذه الأخيرة تتوقف حين انتحار حنان. من هنا، يكون المحو نسخة أخرى في الكتابة. الأستاذ الشاوي أبدع في هندسة هذه العلاقات المتشابكة والمترابطة.
(*) عبد القادر الشاوي
«بستان السيدة» نشر الفنك،
الدار البيضاء، ط 3، 2022