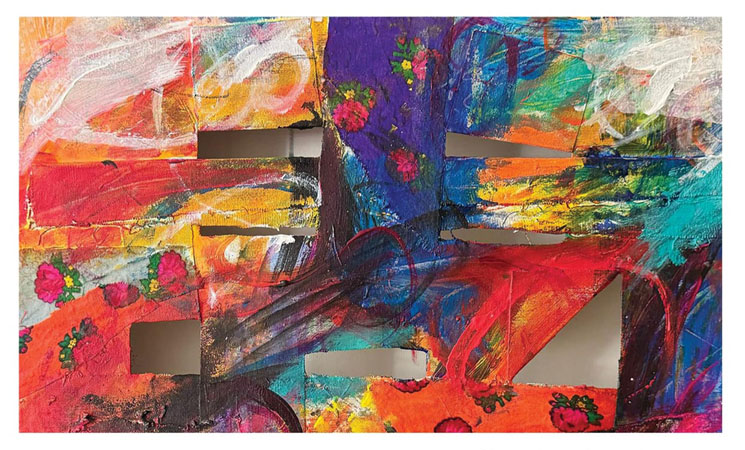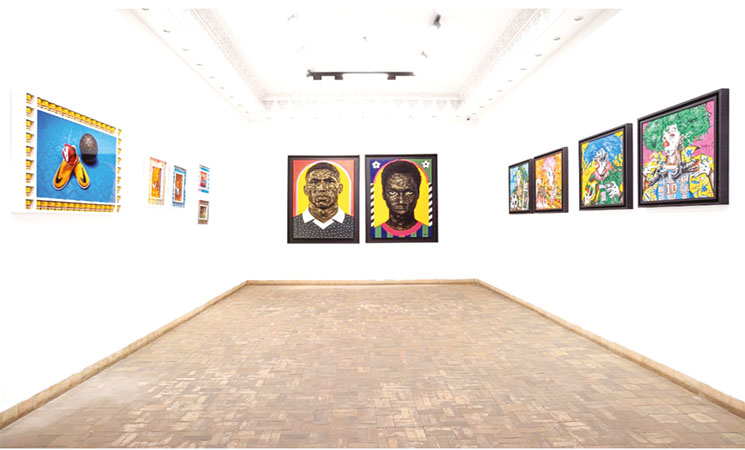يُلاحظُ فِي الأَعمالِ السِينمائيةِ التِي تَناولت فِكرة «الزُومبي»، وَهي أَعمال مُستندة إِلى دِينامياتِ الصُورةِ التِلفزيونيةِ الثلاثةِ: التَذكِير(التَفحيل)/ العُنف/ الجِنس، أَنها تَعامَلت مَع «الزُومبي» باِعتبارِه نَتيجةً لحالةٍ مَرضيةٍ عَامة، تُفقِد الجَسدَ الإِنسانيَ عَقلهُ المُتحضر(!) (وَلعلَهُ هُنا وَجبت الإشارةُ إلى آَلياتِ هَندسةِ الجُنون مُجتمعيًا بِحسبِ مَبحث المُفكر الفَرنسِي مِيشيل فُوكو «تاريخ الجُنون»)، تَاركةً لفَضاءِ المَعرفة الحُريةَ في تنفيذِ حَقلِ قُوتِها الغَير بَريء. (لاتُجيب ولا تَتعرض الأعمال السِينمائيِة عامةً عَن سببِ تَفشي هَذا المرض أو ذَاك، أو خلقِ بطلٍ نَتيجةً لِتعرُضِهِ لحادثٍ مهندسٍ جينياً مِثلَ الرجُل العَنكبوت، ولا الغَرض مِن هَندسةِ هَكذا مَرض، تاركةً حقلَ القُوةِ العُنفية للمَعرفةِ بعيدًا عَن المُساءلةِ أو حتى التَخيُل، تماماً مِثلما هُو الأمرُ بشأنِ الأَسلحةِ الكِيماوية /أو الجُرثومِية، فَيسهُل عَلى المَعرفةِ التَضحيةُ بالجَسدِ، بمَنحِ الحياة أو مَنعِها دون مُساءلة).
كَما يُلاحظ كَذلكَ أنَ كُلَ التَناولات السِينمائِية للـ»زُومبي» حَصرت البُطولة فِي بَوتقةِ مُزاوجةٍ حصريةٍ للذُكورةِ والبَشرةِ البَيضاء، إِذ لا يُمكنُنا مُلاحظة دُور بُطولة أُنثوي مُباشِر، وَكذلكَ الأُمرُ بالنسبةِ لبطلٍ أَسمرِ البَشرة، وَهُو ما يضمنُ غَسِيلاً أَبيضاً لإرثِ الرَجلِ الأَبيض مِن اِستغلال «الزُومبي» لِصَالحه.
++++++
الزُومبي» هُوَ جَسدٌ/ نَصٌ مَابعدَ كُولُونياليِ، يُمكنُ التَضحيةُ بِه لِحمايةِ الحَداثةِ الرَأسماليةِ – وَموارِدها الثَقافِيةِ وَالإِنسانيةِ وَالجَسديةِ – التي كَانتِ الكُولُونيالةٌ إِحدى تِجلِياتها. هُو جَسَدٌ يُستدَعى مَتى أَرادَ الرَجلُ الأَبيضُ تَوظيفَ ذَلكَ الجَسدْ فِي خِدمةِ إِرثهِ إِتجاهَ الإِنسانيةِ وَدَورُه كمُخلصٍ لها، فَنَرى قَتلَ الأَجسادِ الإِنسانيةِ فِي فِلسطين(غَزة) والعِراق وغَيرهُم لَم يَمس حَمِية الرَجلِ الأَبيض إِتجَاه الإِنسانيةِ، كَما بَات يَفعلُ الآنَ بَشأنِ الحَدثِ السُوريِ، لِيَظل الرَجُل الأَبيضُ هُو المُخَلص طَالَما ظَلت عُقولُنا بِيدِه يُعقلِن بِها أَجسَادَنا.
لجسدُ البَشري يُشحنُ بدلالاتٍ متغيرةٍ وغَير مستقرةٍ، على مَدى تاريخِه في جَانِبيه المُطلق/ المَعنوي والنِسبي/ المَادي؛ كَما في دلالةِ زمنيةِ أَكل التُفاحةِ من شجرةِ المَعرفة. وبالتَالي فَالنتيجةُ منذُ تِلك اللحظةِ الوجوديةِ الهًامة والمُعبرة في الوَعي الإِنساني أَنتجت الحاجة لـ»ترويض الجسد الإنساني» –في اللغةِ والخطابِ والمادةِ-، وبَاتَ ذلكَ «الترويضُ» أَساسياً فِي الحفاظِ على المُواجهاتِ وبينةِ الأَدوار الإجتماعيةِ والعلاقاتِ الإجتماعية وعَلاقاتِ القُوى والسيطرة، بل وحتى إنتاج المعرفة (أنظر دور الجسد في زمنية دفن قابيل لهابيل، و»الحجاب» وتحويراته في الأديان التوحيدية، وطقوس القرابين في الأديان الوضعية والثقافات البدائية، وطهارة الجسد في الطقوس التعبدية، وكلها تمظهرات لـ»ترويض الجسد»)، بِإعتِبار الجَسد يتوَّسط العَلاقةَ بين هُوية الفردِ الذَاتية بمختلفِ تمظهراتها، والهُوية الإجتمَاعية من نَاحية، ومابينَ الذات/الأَنا والهُوية الفَردية بمختلف صِراعاتها، من ناحيةٍ أُخرى.
الجَسد هُو «حَامل» للقِيمة (فَردياً ومُجتمعياً)، حيثُ تُدمج تِلكَ القِيمة فِي تَحليلِ الجَسد كَظاهرةٍ مَاديةٍ تُشكل وتَتشَكل بِفعلِ قُوى المُجتمع وآَليات الخِطاب. وَلذا فَمع الحَداثة والثَورةِ الصِناعية حَدث تغَيير في هَدف الخِطاب (بِاعتبار «الخطاب» فِئة مِن المَباديء التَحتِية المُستبطَّنة، المُدمَجة في شَبكةِ دلالاتٍ تُؤسسُ وتُنتجُ وتُكرس و/ أو تُضعفُ العَلاقات بين القَول والفِعل أوالفِكرةِ والإِنتاجِ أوالذَاتِ و المَوضُوع). حيثُ أَفسحَ الجَسدُ المُكون مِن لحمٍ ودمٍ الطريقَ أَمامَ العَقلِ بوَصفه مَركز الإِنشغالِ والإهتمامِ الحَداثي الأَسمى. (أنظر عمليات نقلِ الأَعضاء وزِراعتها والإِستِنساخ والهَندسةِ الوِراثيةِ و غَيرها). وعليه باتَ الجَسدُ الإِنساني مُعرضاً بِشكلٍ أَكثرَ تَكثفًا للعُنفِ الحَداثيِ، إذ لا تَبدأُ صِناعةُ العُنف بالتَسميةِ، وإِنما تَتكاثفُ بمُمارساتِ التَصنيف، التِي تَحتوي «التسميةَ» كفرعٍ مِنها. فَالعُنف –صِناعةً و مُمارسةً- هُو فِي أَساسِ كلِ نظامٍ إجتماعيٍ، أَي أَنهُ فِي أَساسِ كُل إسمٍ، والمَجازُ الأَساسيُ المُكون للعُنفِ، كَمُحاولةٍ أَدّاتيةٍ لفَرضِ «النِظام» يَحتوي حَالتَينِ كَيانيَتينِ:
الأُولى أَن المَجموعات البَشرية المُختلفة تَعيش حَالةً ماقَبل إِجتماعية، أو كَما إصطُلحَ على تَسمِيته (حالةً طبيعيةً)، يَجب نَقلُها إلى الحَالةِ الثانيةِ وهِي الحَالة الإِجتماعية. وَفي الانتِقالِ بينَ الكَيانِينِ جَرى تَرتيبُ الوُجودِ كَكلٍ، مِن خلالِ هَندسةٍ حديةٍ لثُنائيةٍ أنيقةٍ تُعيدُ صِياغةَ الوُجودِ الإِنسانيِ فِي مُعسكَرينِّ غيرِ قَابلينِ للتَعايشُ المُتشاركِ (إما/ أو)، فبَاتت الحَالةُ الأُولى (الطَبيعِية) بشِقَيها الفَردِي والجَمعِي تُفهم كحَالةِ عُنفٍ، وبالتَالي وَلكي تَتوائم تِلك الحالةُ مَع ما هُو «أَرقى حضاريًا» (!)، بَات توجيهُ العُنفِ واستحواذِه بِأشكالهِ المُمأسسة والدلالية ضَرورياً لِحمايةِ «قداسة المُجتمع».
نجدُ أَن المُقدسَ الحدَاثِي قد أَعادَ إِنتاجَ نَفسِه في العَديدِ منَ الصُورِ، بهندسةٍ ذاتيةٍ، وأُخرى مُقابلةٍ للآخر المُدنس. فَأزاحَ ذَاتهُ مِن نطاقِ الدِينيِ إلى الحَيزِ الإِجتمَاعي (أنظر مثالاً لتَغيرِ لونِ بَشرةِ السَيدِ المَسيح فيِ أِفريقِيا)، ذلكَ الحَيز الإِجتمَاعِي المُكوِن لعَلاقَاتِ الإِنتاج والمِلكيةِ الخَاصة والمُتكَون من خِلالِهما، فنرَى أَن إنشاءَ المَصانعِ جَرى محايِثاً لإِنشاءِ دُورِ صِناعةِ العُنفِ والمُقدس. (أُنظر كَيفَ استغلَ الإِسبان «المُقدس» في ثَقافات حَضاراتِ أَمريكا اللاَتيِنية لتقديمِ الرَجُلِ الأَبيض وكَأنهُ بشعره الأصفر المشابه لأشعةِ الشَمسِ، وعَيناهُ الزَرقاوانِ المُشابَهان للون المَوجِ، ابنُ إلهِ الشَمس/ رَسولُ الشَمسِ، ليُبررَ نهبَ ثرواتِ تِلكَ الشُعوبِ وأَيديها العاملة لصَالحِ إِسبانيا).
++++++
فِي أَكثرِ الصُور تَعبيرًا عن وَضعيةِ الجَسدِ الإِنساني فِي العَلاقةِ الإِجتماعيةِ العُنفية وعَلاقات القُوى النَاتجةِ من تَلاقحِ الإِجتماعِي والمُقدس، يَظهرُ لَنا «الزُومبِي» مِثالًا شَارحًا، بِما يُؤسسُ لَه مِن «حَقِ قَتل الجسد/إِلغاؤُه». وَهيَ المرحلةُ الأَعلى مِن آلياتِ السَيطرةِ الحَداثيةِ: الهَندسةِ والرَقابةِ والعِقابِ – بالمنطقِ الفُوكوي – عَلى الجَسد، بِما يُحققُ مَقولة جوديث باتلر: «لا جَسد لا سِياسة».
إذ يَتم تَوظيفُ فِكرة «الزُومبي» في الثَقافةِ المُعولمةِ ضِمنَ ما أَسماهُ الراحِل إِدوارد سَعيد «إرثْ الرَجل الأَبيض» وواجبه التَخليصي – نسبة لفكرة «المُخلص» – اِتجَاه الحَضارةِ الإِنسانيةِ كَكل. وَهُو ما أُريد له أن يَكونَ المَعنى الظَاهر للخِطاب، في حِين أَن ذَلك التوظِيف يُغفل مُتقصدًا تارِيخَانية الجَسدِ الزُومبيي، وبالتَالي يَضمن عَملية «غسيلٍ بيضاءَ» لجَرائمِ الرَجُلِ الأَبيض الحدّاثية الإِستعمَارية، وهُو ما يَستدعي إِضاءاتٍ على الزُومبي/ الجسد كَنصٍ تَاريخِيٍ مَابعد كُولونيالي.
يتمُ تَقديم «الزومبي» باِعتبارهِ «جِسدًا ماديًا خاليًا منَ الروحٍ والعقلٍ»، وبالتَالي فَهو كيانٌ بيولوجيٌ لا يَحوزُ عَقلاً بالمَفهومِ الإِجتماعيِ. لذا، فغيابُ ذَلكَ العقلِ، وعدمِ قُدرته على تَحليلِ المُؤثر الخارِجي بِشكلٍ أكبرَ مِن الإِستجابةِ الجَسديةِ المُوجهةِ للقتلِ، يجعلُ من ذلكَ «الجسدِ» جَسداً «غيرَ معقلنٍ» (إذ لا يحوزُ على «وعيٍ ذاتيٍ»، نظرًا لحَركتِه الغيرِ مدركةٍ لذاتِها وكميةِ التَشوهِ الوَاقعِ عَليهِ دونَما أي تأثر. ولا «مقصدٍ» إذ أن وُجودَه وجودٌ سلبيٌ فقط، ولا «لغةً»، فَهو لا يَتفهمُ أيَّ محاولةٍ لغويةٍ – بالمنطق السيميولوجي حتى! – للتَواصلِ مَعه) أي أنه «جَسدٌ بهيمي». مما يُسقطُ عنه قِيميَّته الأَكثر بدائيةً: المادية الجَسدية، بالمَنطقِ التَطوري الدَاروِيني – على الأَقل – ويَجعل قَتلهُ فعلًا مُبرراً ومَشروعاً مَهما كانت عَمليةُ القتلِ في ذَاتِها دَمويةً، ومهما كانَ عددُ القَتلى.
+++++++
«الزُومبي» كمُصطلح/ مُسمى – وتلكَ تَسمية لَيسَت عَربية ولم تُعَّرْب، بَعد – يَعودُ إلى فَترةِ الإِستعمار الكُولونيالي الفَرنسي فِي هَايتي، إبان القَرنِ الـ17-18، حَيثُ كَانت زِراعةُ السُكر قَائمةً على «العَبيد» مِن السُكانِ الأصلييِن، الذِينَ كَانوا يَذوقونَ سُوءَ المُعاملةِ والِاستغلالِ الجَسدي والتَعذيبِ والقَمع لاستغلالهم ضِمنَ تِجارة الرَجلِ الأَبيض. فَكانَ مِن المَنطقيِ أَن يُمثلَ «المَوتُ/ الإنتحارُ» لهؤلاءِ المُستعبَدين رَاحتَهم وطريقَ عَودِتهم إِلى «الجَنة/ غِينيا الجَديدة/ إِفريقيا الأُم»، بِكلِ ما يَحملُه ذَلكَ مِن خوفٍ إنسانيٍ طبيعيٍ، إلا أَنه مَهربٌ ناجع لمعادلةِ الحياةِ الصَعبةِ. بَينما كانَ الموتُ إنتحارًا بِالنسبةِ للمُستَعِمر الفَرنسي خسارةً فادحةً، ليسَ فقط لأنه يَخسر يداً عَاملةً، ولكنهُ يَخسر أَيضاً فرداً/ إنسانًا/ جسداً مِن ثروته من العبيد، عن طريق إِنتزاعِ مِلكيةِ الجَسدِ (المُستَعمَر) عن الفرنسي (المُستَعمِر).
كُل ذلكَ استَلزمَ تَواطؤًا بَين علاقاتِ القُوى والإِنتاجِ في بينةِ النظامِ الإِجتماعيِ وبِنية المُقدس. يُدارُ بِعقليةِ «العَالمِ الجَديد» الكولونيالية الرأسمالية، لِخلقِ مانعٍ يَحولُ دونَ هَذا النَوعِ من الهدرِ فِي العَبيدِ كَرأس مالٍ وليسَ كبشرٍ حُريتُهم حقٌ مكفولٌ. فكانَ تَخليقُ حالةِ «الزُومبي»، وَهوَ الشَخص الذي تَرفض الجَنة/ إفريقيا/ غِينيا الجَديدةُ استقبَالهُ لشَنيعِ صنيعه، ليسَ «الإنتحار» إِنما الخُروجُ عن طاعةِ الرَبِ الأبيضِ المُستَعمِر، صاحبِ العقلِ الأَسمى والأَقوى. وَهُو ما يُعطي الحَداثةَ في صُورتِها الكُولونياَلية صفةً من صِفاتِ الأُلوهةِ والقداسةِ، بمنحِ الحَقِ فِي الجَنةِ أو النَار والسيطرةِ على الحَياة المتجاوزةِ بعد السَيطرة عَلى الحياةِ الآَنيةِ وأَجسادِ من فِيها، وبالتالي فَيكونُ عِقابُ هَذا «الزُومبي» هُو إنتزاعُ رُوحِه وعقلهِ من جسدهِ الذِي ظنَ بِه خَلاصهُ، وتركِهِ هَائمًا على غَيرِ وُصولٍ للجنةِ، المَتروكةِ بيدِ ربهِ الأَبيض.
+++++++
يَظلُ فِيلم WORLD WAR Z بُطولة النَجم الأَمرِيكي براد بيت وإِخراج ريدلي سكوت (2013) النَقلة الأَكثر صَلفًا فِي بِناءِ الخِطابِ الثَقافِي للرَجلِ الأَبيض الكُولونيالي بشأن «الزُومبي»، إِذ يُمكن القولُ مِن التَسمِية أَن القَصد هُو آَخرُ حُروبِ العَالِم الأَبيض، بِاعتِبار أَن اللُغة هِي أَساس التَسمية، والتَسمِية أَولُ أَدواتِ العُنفِ الحَداثي، وَأن الحَرف (زِد/Z) هُو آخِرُ حُروفِ اللُغةِ، واللُغةُ –في عُمومِها، والإِنجليزية لَيسَت اِستثناءًا- هِي مُؤسسة ذُكوريةٌ، واللُغةُ الإِنجليزية لُغةٌ بَيضاء.
لَيسَ ما سَبق فَقط هُو مَا يُميزُ السَردَ الثَقافِي للفِيلم/ الصُورة عَن غَيره، وَلكن اِستحضَاره لِبنيةٍ كُولُونياليةٍ لَم يَتم إستحضُارها سَابقاً فِي هَذا النَوعِ مِن الأَفلام وَهِي : التَهجِين/ Hybridity، فَالتهجينُ هُو مرحلةٌ مِن مَراحل الإِنتاج البَينيِةِ بَين المُستَعِمر والمُستَعمَر، حَيثُ أَن المُستَعمِر يُعرِّف نَفسهُ رَأسِيًا بآخَرِهِ المُستَعمَر، فَلا يُمكن بِحالٍ مِن الأَحوالِ أَن يَقبَلَ بِوجودِ تَرادفٍ بَين النَموذَجينِ، وإِلا انهَارت مَنظومةُ التَعريفِ السَلبيِ الخَاصِة بالسَيطرة. وَعَليهِ فَقد ظَهرت الحَاجةُ لِخلقِ (بِطَانةٍ وُسطَى، لَها درجةٌ من دَرجاتِ الرَخاوةِ بين المُستَعمِر والمُستَعمَر) بحسبِ فرانز فانون، وَهيَ عبارةٌ عن مَنظومةٍ مِن آلياتِ الإِنتاجِ وَالقُوى المُؤسسَاتِيةِ/الأداتّية الخَارجةِ مِن وَسطِ بِينة المُستَعمَر الثَقافِية والإِجتماعِيةِ والوَطنيةِ، إلا أَنها تَدينُ فِي بِنيتِها الحَاكمةِ إلى النَموذجِ الحَداثيِ الكُولونيالِي الرَأسمَاليِ ولِذا فوُجودُها من وُجوده عُضويًا، فَتعمل على خَلقِ كَيانٍ وَسطيٍ بينَ «عِرقينِ» غير متمازجين (بالتَعبيرِ الفِيكتُوري اليَميني)، وَظيفةُ ذَلكَ الكَيانِ «الوَسطي/الهَجينِ» هُو شَرعنةُ وُجُودِ المُحتَل خِطابيًا ومُؤسساتيًا فِي داخلِ فَضاءِ البِنية المَحلية المُستعمَرة (أو مايُعرَف بـ»المَكانْ» بالمَنطق المُتجاوز). وهُو مَا يُمكن تَعيينُه عَلى مَدى التَاريخِ الكُولونيالي. ولَنا في فرانسوا دُوفالييه الدِكتاتُور الذيِ كَان رئيسًا لهَايتِي بَعد زوالِ الإِستعمار الفَرنسِي، والذِي كَان وجهًا أسمراً لسياسياتٍ بَيضاءَ كُولونيالِية ضَمِنت عن طَريقِه إِستمرارَ علاقاتِ السَيطرةِ والإنتاجِ فِيها، حَتى بَعد الزَوالِ المُباشرِ للبِنيةِ الكُولونياليةِ البَيضاءَ («الكولونيالية الجديدة» كما أَسماها سَارتر) خَيرَ مثال. كَما يُمكن مُماهاة ذلكَ مع النَموذجِ الفِلسطينيِ تَحتَ الإِحتلالِ الإِسرائيليِ، فِي مَابعدَ «إتفاقيةِ أوسلو» التِي خَلقت تَلك الطَبقةَ المُهجنةِ إِسرائيليًا، وَزرعْتها فِي دَاخلِ الفَضاءِ المَعرفي والسياسيِ والثَقافيِ الفِلسطيني، كوَسيطٍ للسِياسَات الإِحتِلالية، وَلعلَ أَبرزَ تَجلِياتها الوَاضحةِ هو»التَنسيقِ الأَمنيِ» معَ الإِحتلال، فَبات الإحتلال مُدبلجاً للفلسطينيةِ، إسماً ورسماً.
تلكَ الطبقةُ المُهجنةُ هِي التِي يُراهنُ عَليها المَعنى المُستَبطن للسَردِ الثَقافيِ للفِيلمِ مُستفيدًا مِن الطُغيانِ والسَطوةِ الحَاصلَينِ حَاليًا للمَعرفةِ الصُوريةِ التِليفِزيُونيةِ (نسبة إلى الصورة)، وَالتِي تَنبَنِي على الصور كخِطاب وَتَراكُمَاتِها ولَيسَ عَلى الوَاقِع، مؤسسةً للحُكم المَعرفِي على الصُور وَليسَ عَلى الواقِع، فيُقدم الفِيلمُ الجَدارَ العَازل الإِسرائِيلي باِعتبارهِ حَاميًا للحَضارةِ البَيضاءَ فِي حَربِها الأَخيرةِ ضدَ الوَحشيةِ بِتعاونٍ مُثمرٍ بينَ الرَجلِ الأَبيضِ المُحتل وطبقتِةِ الهجينةِ مِنَ المُستَعمَر، تِلكَ الطَبقة التِي تُشفِقُ عَلى قَومِها مِن غِيابِ العَقلِ فِي مواجهةِ الحَضارةِ البَيضاءَ (فلنَنظُر لتَصريحَاتِ قَادةِ التَنسيقِ الأَمنيِ وَسلطةِ أُوسلُو عَن عَبَثِيةِ «المًقاومةِ» وَلامَنطقِية فِكرة العَودةِ – صَفَدْ مِثالاً -).
وَأَن سُقوطَ الجِدارِ لَم يَأتِ نَتيجةً لِسقُوطهِ الإِنسانيِ وَالقِيميِ، باعتبارِ صَيرورةِ –أَغلِبِ – النُظمِ الكُولُونيالية، وَلكنْ يَسقط نَتيجةَ تَدافُع أَعدادٍ غَفيرةٍ مِمن فَقَدوا عَقلَهُم وبَاتُوا فِي حَالةٍ بَيهيميةٍ دُونيةٍ، إِستلزَمت تَخليصَ العَالمِ المُتحضرِ الأَبيضَ مِنهُم.
(بتصرف)