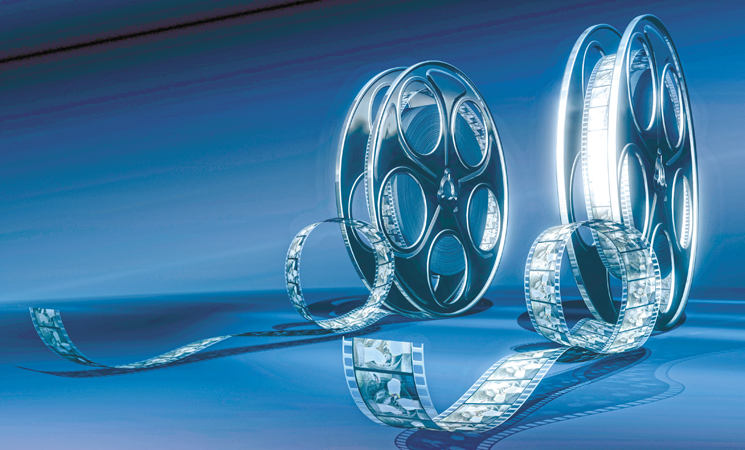لم تجعل التكنولوجيات الجديدة السينما قريبة منا بشكل مدهش فقط، بل قدمت لها إمكاناتٍ هائلة على مستوى الإضاءة والتصوير والتوهيم والعرض، أي على مستوى الإنتاج. فإلى حدود الأمس القريب، كان متلقي السينما مطالبا بالذهاب إلى قاعة السينما لمشاهدة الأفلام. أما الآن، فإن التكنولوجيات والوسائط الجديدة مكنت من استقبال الأفلام السينمائية في البيوت، حتى أصبح بعض الباحثين (أمثال فرانسوا جوست وبيير بورديو) يتحدث عن «التلقي المنزلي» للأفلام. وهذا ما بات يطرح إشكالا كبيرا على مستوى الاستغلال (القاعة السينمائية)، بل يطرح مشكلة التكنولوجيات الجديدة وعلاقتها بالسينما والحلم. بيد أن أعمالاً سينمائية كبرى باتت تقوم على تقنيات تكنولوجية، على غرار الأفلام التي أنجزها المخرج الأمريكي ستيفان سبيلبيرغ: الحديقة الجوارسية1. بل أصبح التقدم التكنولوجي حقيقة لا يمكن تجاوزها على مستوى كل ما يتعلق بالفن السابع، وليس فقط على مستوى الأفلام التي تقوم أساسا على التوهيم والمؤثرات الخاصة، بمعنى أنها لا تهم فقط أفلام «الفانطاستيك» أو العجيب .
لم تجعل التكنولوجيات الجديدة السينما قريبة منا بشكل مدهش فقط، بل قدمت لها إمكاناتٍ هائلة على مستوى الإضاءة والتصوير والتوهيم والعرض، أي على مستوى الإنتاج. فإلى حدود الأمس القريب، كان متلقي السينما مطالبا بالذهاب إلى قاعة السينما لمشاهدة الأفلام. أما الآن، فإن التكنولوجيات والوسائط الجديدة مكنت من استقبال الأفلام السينمائية في البيوت، حتى أصبح بعض الباحثين (أمثال فرانسوا جوست وبيير بورديو) يتحدث عن «التلقي المنزلي» للأفلام. وهذا ما بات يطرح إشكالا كبيرا على مستوى الاستغلال (القاعة السينمائية)، بل يطرح مشكلة التكنولوجيات الجديدة وعلاقتها بالسينما والحلم. بيد أن أعمالاً سينمائية كبرى باتت تقوم على تقنيات تكنولوجية، على غرار الأفلام التي أنجزها المخرج الأمريكي ستيفان سبيلبيرغ: الحديقة الجوارسية1. بل أصبح التقدم التكنولوجي حقيقة لا يمكن تجاوزها على مستوى كل ما يتعلق بالفن السابع، وليس فقط على مستوى الأفلام التي تقوم أساسا على التوهيم والمؤثرات الخاصة، بمعنى أنها لا تهم فقط أفلام «الفانطاستيك» أو العجيب .
فهل معنى ذلك أن التكنولوجيات الحديثة تنتهك خصوصية الفن السينمائي، وأنها تختصر مساحة الفنية فيه؟ وبتعبير آخر هل هذا المتغير الجديد يسمح لنا بالحديث عن سينما قديمة أو عن «موت السينما»، كما ذهب إلى ذلك مدير مهرجان فن الفيديو بمارسيليا مارك ميرسي، حيث ذهب إلى أنه منذ اللحظة التي أصبحت السينما تغتني بسلطات الفن الحديث، فإنها التحقت بالأزمة الشاملة لهذا الفن، وهذا ما يقرب السينما من موتها، وفي الوقت نفسه من حريتها، أي من دليل عدم اكتمالها؟
وإذا كانت هناك سينما قديمة يمكن اختزالها مع المخرج السينمائي الكندي ومدير مدرسة السينما «ميل هوبينهايم» بجامعة كونكورديا، ريشارد كير، في مصطلحات بسيطة ونقية: الإضاءة، الزمن والفضاء: الإيقاع حيث يلتقي الزمن المنحوت مع الإضاءة المبثوثة4، فإن السينما الجديدة (الرقمية، الديجيتال…) تطرح إشكالات عدة ترتبط بعلاقة التكنولوجيا عموما بالفن. وهذا ما جعل الباحث الجمالي موليم العروسي يبدي ملاحظات أساسية حول هذا الموضوع:
– أولا: ليس هناك فصل بين الإبداع والصناعة، إذ أن الإبداع في نسخته الفريدة، يمكن أن يستنسخ إلى ما لا نهاية ليصبح صناعة.
– ثانيا: إن الفنان منتج، وسواء تعلق الأمر بالإنتاج الفني أو النافع، فإن المنتج يبقى واحدا.
– ثالثا: إن التكنولوجيا الحديثة، بما فيها الكمبيوتر والسكانير والإنترنيت هي وسائل تحتاج إلى إحساس وإبداع. فالعلاقة مع الذكاء الاصطناعي والفضاء الافتراضي تعطي إمكانيات لا حصر لها للممارس.
p ولكن إلى أي حد يمكننا أن نتعامل مع التكنولوجيات (الفيديو، الكاميرات الرقمية، الهواتف الذكية، اللوائح الإلكترونية…) كأدوات لا تمس جوهر السينما، ولا تغيرها؟ وهل صحيح أن المنتج (الصورة المتحركة) يبقى واحدا، ولا تخترقه متغيرات؟
قبل رحيله، كان المؤرخ الفني «روني بايانت» (من الكيبيك، ولد في 19 ماي (1949 قد شرع في وضع تصور لظاهرة الفيديو وتحدث عن تغير جذري لإدراك الصورة المتحركة. فلم يعد ينظر إلى الصورة كسطح متحرك يستعير عمقه من تصور الفن التشكيلي التقليدي، بل كظهور يبرز من عمق عتمة ما قبل الصورة. لقد خيبت تكونولوجيا الفيديو في تلك المرحلة، والتي تم استبدالها في الوقت الراهن بالتشفير الرقمي، في وقت سريع، هذا الأمل المتعلق باعتماد نظرة جديدة. أما التكنولوجيا الرقمية فتأتي بالصورة إلى السطح لتدفعها نحو منطقة محدودة، حيث تهدد بالتحلل كما لو أن الأمر يتعلق بانعكاس واقعي في طور تشظ مستمر. وبهذا المعنى، فإن الصورة الرقمية بمثابة الصورة ? الانتحار، التي تبدو، لو أمعنا التفكير، متلائمة بشكل جيد مع اليأس الذي ميز حقبتنا. بيد أن هذا التغيير في الإدراك يكون خاضعا للأحكام الجمالية وفق ما اقترحه السوسيولوجي الراحل بيير بورديو في مؤلفه «التمييز» Distinction، حيث ذهب إلى أن «الحاجات الثقافية هي نتاج للتربية وأن كل الممارسات الثقافية، مثل زيارة المتاحف والمعارض الفنية وقاعات السينما والقراءة وكذلك الاختيارات في مجال الأدب والتشكيل والموسيقى والسينما، مرتبطة بشكل وثيق بالمستوى الدراسي وبالأصول الاجتماعية، ومعنى ذلك أن التكنولوجيات الحديثة التي تتسارع كل يوم باتت تقترح على المتلقين تربية جديدة وممارسات ثقافية متصلة بالافتراض.
إنَّ تجاوز المنطق الطبيعي، أو ما نعتبره منطقا طبيعيا، في بعض الأحيان، على مستوى الوصول إلى المنتوج السينمائي، يبدو واضحاً في مقومات التكنولوجيا. ذلك أن نقرة أو لمسة واحدة تتيح لنا امتلاك ما يحتاج مجهوداً ومالاً كبيرين، وهذا يحدث الآن على أوسع نطاق في السينما، رغم أنه يتم على حساب حقوق الملكية. وبطبيعة الحال، يمكننا طرح السؤال التالي: هل التكنولوجيا، التي أدت إلى ارتفاع وتيرة القرصنة على نحو متسارع، يسرت للمتلقي الطريق نحو السينما أم أنها على العكس من ذلك ساهمت في تقويض خصوصية هذا الفن، وساهمت في انهيار قاعات السينما باعتبارها دعامة أساسية لاستمراريته؟
لقد رأينا سابقا كيف مس انهيار القاعات السينمائية صيغ تلقي الفيلم السينمائي، وكيف ساهمت التكنولوجيات في تعزيز هذا الانهيار. وهو ما دفع باتريك لوغيت وفابيان ماهو، صاحبا كتاب «السينما(ت) والتكنولوجيات الجديدة»، إلى الترحيب بالممارسة الجديدة التي يقترحها «الفيديو العارض» Video projection في المتاحف أو في أي مكان آخر، متى كانت هذه التكنولوجيا التي تعرض الصور الرقمية (أو مرقمنة) تحاكي العرض السينمائي، حسب قولهما.
فهل معنى ذلك، أنها دعوة ينبغي معها الإذعان للمتغيرات التي تطرحها التكنولوجيات الجديدة؟ هل الصيغة المنزلية للتلقي السينمائي أصبحت ضرورة لا يمكن تجاوزها؟ هل بإمكان التلقي السينمائي المنزلي أن يعوض الشاشة الكبيرة التي ينعكس عليها الضوء القادم من الخلف داخل قاعة العرض المظلمة؟
اقتصادياً، يبدو التلقي المنزلي للسينما معوقاً لمسار الحركة السينمائية؛ فـــ«صناعة» السينما تحتاج إلى رأس المال، وتقوم عليه كما رأينا سابقا، وهذا معناه أن اختفاء «القاعة السينمائية» (الاستغلال) يعتبر بمثابة تدمير لرأس المال ما دام يعمل على تعطيل طاقات إنتاجية ليس بوسع السينما أن تستمر بدونها. بيد أن التكنولوجيات الجديدة، في الجهة المعاكسة للاستهلاك السينمائي، استطاعت أن تخدم السينما على مستوى الإنتاج والإخراج والتوضيب والعرض، ويتعلق الأمر ب:
– الالتقاط الرقمي للرؤية والصوت (الكاميرا، الكاميسكوب، آلة التصوير، المسجل الرقمي…).
– التقاط حركة الممثلين عبر أرتيكات Artecarts إلكترونية مرتبطة بالحاسوب (آخر مثال يعتبر الأكثر رواجا على المستوى الإعلامي هو فيلم «أفاتار» لجيمس كاميرون).
– الأنفوغرافيا، ابتكار الصور المركبة الألغومترية (في أفلام التحريك، من قبيلToy Story، Final Fantasy،Shrek ، ولقد أوردنا الأفلام المعروفة أكثر).
– ما بعد الإنتاج (التوضيب، التوهيم، المؤثرات الخاصة، المعالجة الرقمية للصور والأصوات).
– التخزين على المحور الرقمي (القرص الصلب، قرص الفيديو الرقمي «DVD»، بطاقة الذاكرة، الناقل التسلسلي العالمي «USB»…).
– البث عبر القنوات الرقمية (شبكات معلوماتية، التي إن تي، قنوات الأقمار الصناعية…).
– العرض أو العرض الاسترجاعي الرقمي للصور (على التلفاز، الحاسوب، في قاعة سينمائية مجهزة…).
تأسيسا على ذلك، يتضح أن التكنولوجيات الجديدة سهلت عملية الإخراج مادامت المؤثرات، التي كان يتطلب إنجازها في مكان التصوير أموالا باهظة (تتفاوت بين هذا الفيلم أو ذاك)، يمكن الآن إنجازها بيسر عبر الحاسوب. كما مكنت الكاميرات الرقمية التي يزداد أداؤها جودة يوماً بعد يوم، بموازاة مع التطور المطرد لتقنيات الكومبيوتر وبرامج المونتاج أيضاً، من تحقيق الفارق، لا سيما وأنه في الإمكان تحويل فيلم الديجتال المنجز إلى شريط سينمائي وعرضه على شاشة السينما العادية، وهذا ما قامت به العديد من التجارب في الغرب التي استفادت من التقنية الجديدة على صعيد خفض التكلفة أكثر من أصحاب السينما الأكثر تأزماً، وهو ما ساعد في إفراز توجهات فنية استطاعت الاستفادة من الطروحات التي يمكن للتقنية الرقمية أن تقدمها للوصول إلى أشكال فنية جديدة للفن السينمائي، وهذا ما شاهدناه جلياً في تجارب مثل سينما الدوغما 95 ومؤسسها المخرج «لارس فون تراير» التي وضعت على رأس أولوياتها صناعة أفلام غير مكلفة، حيث أصبح بإمكانها الاستفادة هنا من التقنية الرخيصة. ويمكن القول إن هذا التيسير الذي وفرته التكنولوجيا يمتد إلى مجموع الإبداع السينمائي، على مستوى الإنتاج والعرض داخل القاعة السينمائية، خاصة إذا كانت القاعة مرقمنة.
صحيح أن التكنولوجيات الجديدة أتاحت للسينمائيين الشباب إمكانات مهمة على مستوى تحقيق مشاريعهم السينمائية، بل ساهمت في تأمين إنتاج أعمال سينمائية أكثر استقلالية عن المنتج، وأيضا عن المركز السينمائي المغربي، حيث استطاع مخرجون شباب إنتاج أعمال تستحق الاحترام بمفردهم أو على الأقل بتحفيز من التسهيل الذي تقدمه التقنية الجديدة. ولعل أبرز مثال على هذا النوع من الأفلام فيلم «ميلوديا المورفين» الذي أنتجه وأخرجه هشام أمل.
وفي المحصلة، ينبغي أمام هذا التدفق التكنولوجي أن نتساءل: هل حان الوقت لإعادة النظر في هوية السينما، وفي نقاوتها الأسطورية التي نظر لها أندري بازان، خاصة أمام التهجين المتعدد الذي حملته إليها التكنولوجيات الجديدة13، إلى درجة أصبحت معها الكاميرا تقوم «بكل شيء» عوضاً عن السينمائي المأخوذ بالقدرات السحرية للكاميرات الرقمية والتكنولوجيات الأخرى المرتبطة بالمونطاج، دون التفكير كفايةً في تفاصيل التكوين السينمائي وأبعاده الجمالية والثقافية والفكرية؟ وتأسيسا على ذلك، نطرح السؤال التالي: هل تحولت التكنولوجيات الجديدة إلى قانون يتعالى على رغبات الفاعلين في الصناعة السينمائية؟ وهل انتهى ذلك الزمن الذي يخرج الناس إلى قاعات السينما والالتجاء إليها للتمتع جماعات أو أزواجا أو فرادى؟ وهل تحول الناس كمتلقين إلى فضاء جديد يشبه الخلوة التي يفرضها الجلوس في وضعية «وجها لوجه» مع الحواسب أو الألواح الإلكترونية أو الهواتف الذكية؟
لقد أخذت السينما جمهور المسرح وجمهور الموسيقى، أي جمهور الحفل الفني بصفة عامة. ولقد رأينا أنها اعتمدت أولا على جمهور شعبي بعيد عن الحفلات الفنية الخاصة بالنخب الاجتماعية، ومرتبط بالسيرك والمسرح الشعبي. فهل معنى ذلك أن التكنولوجيات الحديثة خلقت جمهورها الخاص على حساب جمهور السينما، أي ذلك الجمهور الذي سبق أن أخذته السينما من المسرح والموسيقى؟