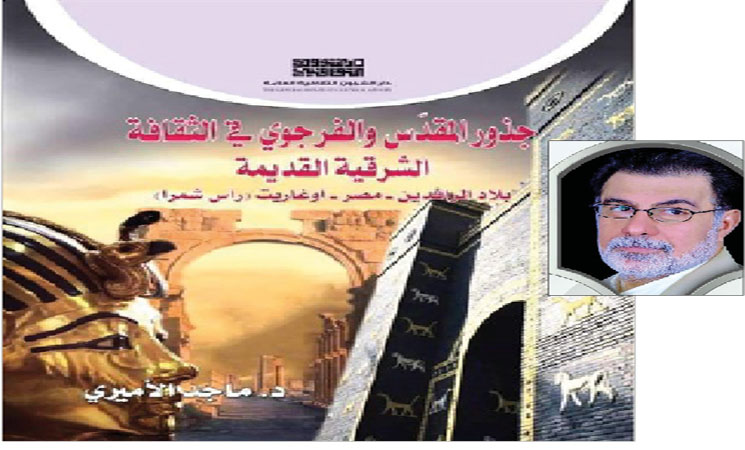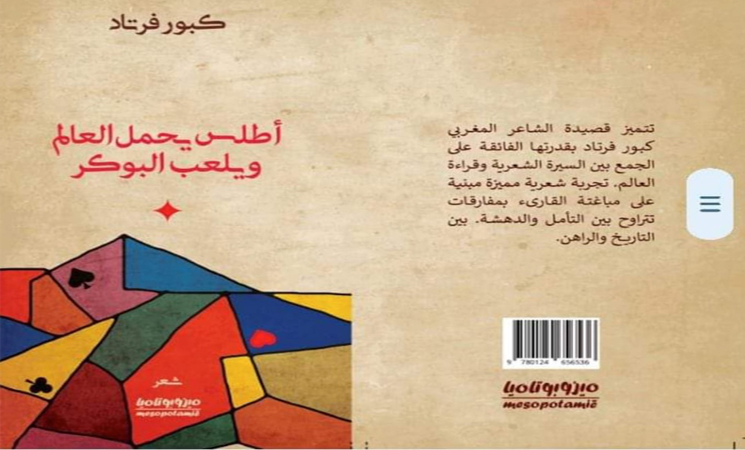محمد العرابي شاعر ومترجم مغربي، أصدر لحد الآن أربعة دواوين شعرية، وخمسة كتب في الترجمة. جرَّب كتابة القصيدة الطويلة والقصيرة. أين يجد محمد العرابي نفَسه الإبداعي أكثر؟
ارتباطا بسؤالك، التجريب في الكتابة الإبداعية تحكمه الرغبة في تقديم منتوج مختلف عما قدمناه من قبل، كي لا نتحول إلى آلة تكرر ما سبق وتعيد إنتاجه بطريقة أخرى. وبهذا الصدد اشتغلت في مجموعتي «تجربة الليل»، و»محرك الدمى»، على نمط الكتابة الملحمية حيث يشكل الكتاب نصا شعريا واحدا يحركه خيط سردي يعطي للمجموع نوعا من الانسجام ويضمن تلاحم الأجزاء. لكني انتقلت بعد ذلك إلى صنف الكتابة الخاطفة التي تجعل النص يظهر في صفحة واحدة أو أقل، وتتخلص الجملة الشعرية من طولها وحشوها السردي، لقناعتي أن القارئ لم يعد هو نفسُه، وأن تحولات طرأت عليه، أو أنه تحوَّل عن الكتاب والقراءة لوسائط أخرى أكثر ابتذالا، لكنها أكثر جاذبية. فاقتضى الأمر مراعاة هذه الاعتبارات، كما أنه، من جهة أخرى، مرتبط بتغير وتطور مفهومنا عن الشعر الذي ينحو إلى التقشُّف في اللغة والصياغة، وجعل الجملة الشعرية أكثر إيجازا، وخالية من اللعب اللغوي غير المجدي ومن النثرية المضرَّة بالشعر.
من المعلوم أن الشعر الحديث ليس له جمهور يقرأه، فهل ترون الخلل في القارئ المحدود الثقافة، أم في الشاعر نفسه الذي حلَّق في فضاءات غير مسبوقة؟
خلل هذه الوضعية مركَّب، ساهمت فيه عناصر متعددة من قبيل تعددية الوسائط الإلكترونية وسهولة استعمالها، ووصولها إلى كل الأيادي والفضاءات، فضلا عن عناصر مرتبطة بالكتاب والكتابة نفسها، حيث ابتعد الشعر عن الغناء، واشتغل كثيرا على اللغة وغدا عبارة عن طلاسم وأحجيات لا يعرف القراء كيف يتعاملون معها. كما أن النقد تخلى عن وظيفته التنويرية التي ترقى بذوق المتلقي، من خلال إضاءة الجوانب الجمالية للشعر وجعل القارئ يستمتع بالنص، عندما تحوَّل إلى ممارسة تقنية ترهق النص بدل أن تجعله يضيء. وهو أيضا مرتبط بفقدان الشعر لمركزيته في الإبداع الفني، عموما، لصالح أنماط وأجناس إبداعية أخرى، من قبيل فنون الصورة كالسنيما، وفنون السرد كالرواية. لذلك فالمسؤولية مشتركة بين الجميع، فلا القارئ أعد نفسه ليرتقيَ إلى مستوى الشعر، مثلما أراد أبو تمام، ولا المنظومة التربوية أدمجت الشعر المعاصر ضمن برامجها التعليمية للتعرف على آليات اشتغاله والتعود على قراءته، ولا الشاعر استطاع أن يخلق شعرا يصل إلى القلوب والعقول مثلما تصل إليها الوسائط التكنولوجية وفنون الترفيه.
هل النقد الأكاديمي الجامعي قادر على الإحاطة النقدية بكل المنجز الشعري في الساحة المغربية؟
مسألة المتابعة النقدية وخصوصا الجامعية هي إحدى المعضلات الأساسية التي تحدُّ من تلقي الشعر، حيث تكرس جهودها لمتابعة أسماء مكرَّسة بعينها، ولا تبذل أي جهد ملحوظ لمتابعة ونقد الفسيفساء الشعرية المغربية المترامية الأطراف والمتنوعة في مسيرة الشعر المغربي والعربي، وحتى إذا تناولت بعض الأصوات فهي تقوم بذلك بشكل انتقائي تحكمه المحاباة، وليس انتصارا للإبداع وللإضافة الجمالية المحض.
يشتغل محمد العرابي أكثر على استيعاب نصوص معقدة من الخزانة الفرنسية خصوصا، كنصوص باطاي، وأرطو، ودو ساد، وفيليب سوليرس. ما الذي تجدونه في هؤلاء دون غيرهم؟
بداية وجدت هوى في التجربة الإيروتيكية الغنية لهؤلاء الشعراء والكتاب، لكن مع الوقت لم يعد هذا الجانب يثير اهتمامي بقدر الأسئلة الوجودية العميقة التي تثيرها، إذ تضع كل القضايا على المحك، وخصوصا العلاقة الملتبسة بين الدنيوي والمقدس، بين الكتابة والحياة، بين دعوى الحرية والعبودية الجديدة التي صار الإنسان المعاصر أسيرا لها.
في مسيرتكم الإبداعية تأثرتم بداية بشعراء حداثيين عرب. هل نجحتم في تمثلهم وهضمهم فصار لديكم أسلوبكم الخاص، أم من الصعوبة التخلص من المقروء والموسوعة؟
الكتابة في أثر مبدعين عرب أو غربيين مسألة طبيعية للغاية خصوصا في بدايات كل مبدع أو شاعر، لكن مع الزمن تصير هذه الأسماء بمثابة كابوس يقض مضجعه، لعل الأمر يعود إلى عقدة أوديب في التخلص من الأب، لكن في الحقيقة، يأتي اليوم الذي نصبح فيه أكثر وعيا بوضعنا وأكثر انفتاحا واطلاعا على تجارب إبداعية غنية تجعل مسألة الانبهار بنموذج معين وراء ظهورنا. كما أن الرغبة في إثبات الذات تقتضي أن نتحرر من النموذج وأن نكتب انطلاقا من تجاربنا الخاصة وليس من الكتب ومن المقروء. وأعتقد أنني أقع في دائرة القلق الإبداعي الذي يعني البحث عن أسلوب خاص في الكتابة، يميزك عن الآخرين الذين يكتبون الآن، وإلا ما فائدة أن نكتب؟ كان إميل سيوران الفيلسوف الوجودي المعاصر يقول: «شِعُّوا بأضوائكم الخاصة ولو كانت باهتة».
تشتغل مؤخرا على الترجمة من نصوص صخرية يتحاشى الكثيرون الاشتغال عليها. فهل ترون الترجمة أقرب إلى المهنة والممارسة التقنية أم هي مكملة للممارسة الإبداعية والشعرية خصوصا؟ ولماذا تختلف مع الجاحظ في فكرته الشهيرة القائلة باستحالة ترجمة الشعر؟
الترجمة بالنسبة إلي كانت ولا تزال فعل قراءة بامتياز. وهي ثانيا مجرد شغف وهواية. لذلك فأنا أقتنص النصوص التي تروق لي وأحاول من خلال ترجمتها أن أتقاسم هذا الشغف مع عدد معين من الشغوفين. ولأن النصوص التي أشتغل عليها هي نصوص إبداعية أكثر من كونها نصوصا فكرية وفلسفية، فإن شغف الاشتغال عليها يكون مضاعفا. إنني بدل أن أقرأ كتابا بمفردي، وأنا في عزلتي كمسافر منزلي casanier، أحاول أن أجعل القراءة فعلا جماعيا، وأنا لا أقصد ب «جماعي»، على أنه «جماهيري» بل أن يكون فعلا متعديا إلى أكثر من واحد، وكلما زادت هذه التعدية كانت أدعى للسعادة. أما بخصوص مسألة استحالة ترجمة الشعر، فالمسألة خلافية كان لها ما يبررها في الماضي على اعتبار أن الشعر كان غير منفصم عن إيقاعه وموسيقاه، ولذلك كانت استحالة الجاحظ تعني أننا إذا نزعنا الرداء الموسيقي عن الشعر، بطُل. وفي نفس المعنى نجد من المعاصرين من مازال يعتقد بفكرة الجاحظ، فهذا بيار ليريس، المترجم الفرنسي للأعمال الكاملة لشعراء الإنجليزية الكبار يقول: «ترجمة الشعر أمرٌ مستحيل»، ويستدرك «والامتناع عن ترجمته أمرٌ مستحيل»، وضمن هذا الشق الثاني أعتقد أن ما نربحه من ترجمة الشعر أعظم مما نخسره في هذا العبور من اللغات والثقافات الأخرى. فإذا كنا سنخسر العنصر الصوتي والموسيقي في الشعر فإن كل الأشياء الأخرى لن تكون إلا في صالح الشعر، وخصوصا حدوسه الأساسية. ولقد أدركنا، مع الوقت، أن هذه الترجمة كانت تخصيبا للشعر وفتحا له على إمكانات لم تكن أبدا في الحسبان، وأن الامتناع عنها بدعوى الاستحالة كان سيضيع على الشعر العربي الكثير من بريقه الذي يشع به الآن.