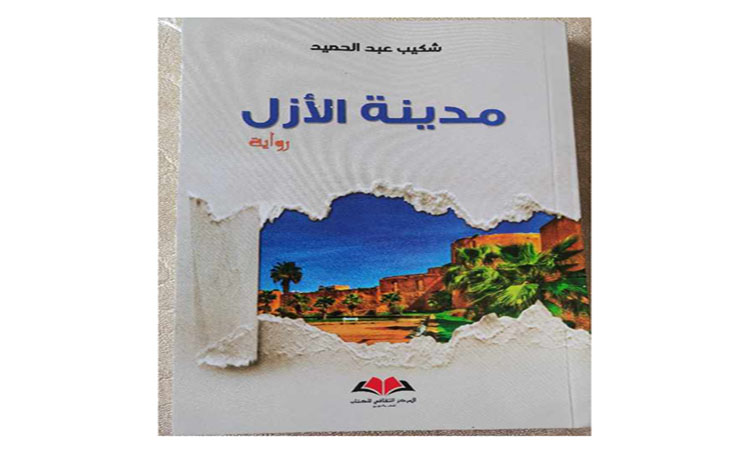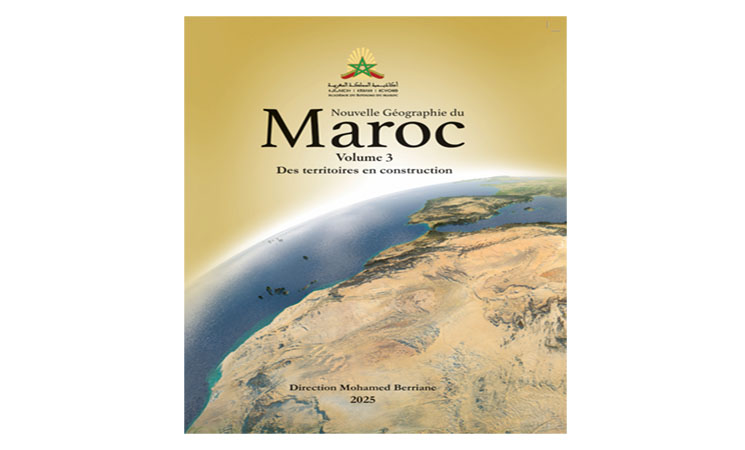يُفرط بعض شعراء قصيدة النثر في استنساخ ما جربه شعراء آخرون قبلهم، فيجنحون بقصائدهم نحو استنزاف مياه لم يحفروا آبارها، فلا يتركونها إلا وقد جفت أو انحسر شاربوها، توهما منهم أن تلك المياه جوفية، ولا يعرف مساراتها الباطنية سوى الراسخين في الاهتبال، أو هؤلاء القلة الذين يعرفون بخبرتهم وأدواتهم العلمية أن تلك المياه قريبة من سطح الأرض، وأنها تعرضت للشفط المبرح.
نعم، قد نقرأ لهؤلاء شعرا جميلا، لكنه صيد يقع خارج «الذات». إنهم يصممون أنيابهم على النحو الذي يسمح لهم بافتراس ما صاده الأسد، فيتوهمون أنهم سادة موائد يعرفون جيدا أن أندادا آخرين سبقوهم إليها. وهنا تطرح قضية غاية في الأهمية: هل «الجمال» في الشعر إبداع على أنقاض أثر سابق أم حرفة تتكرر حلقاتها في سلسلة لا تنتهي؟ هل يمكن للشعر الذي لا يكتفي بالمعارضة الإيقاعية، فيتجاوزها إلى المعنى والصور والتراكيب والمعجم، أن يسمى شعرا «إبداعيا» من حقنا الاحتفاء به والاطمئنان إلى مقترفيه وصانعيه وقرائه؟
إن الشاعر حين لا يكون «ثوريا» ينتهي به الأمر إلى أن يصبح ديكتاتورا أو بيروقراطيا، خائنا لأحلامه ذاتها، كما يقول مانويل سكورزا. ولهذا أزعم أن الشاعر هو الذي لا يهتم إلا بما لم تستطعه الأوائل، كما يقول المعري. الشاعر في العمق أَوَّل دائما، لا يقتفي إلا نفسه، ولا يقتفي نفسه إلا ليتجاوزها باستمرار، في سلسلة دائمة من التحول الجيني على مستوى الموضوعات والأشكال. وهذا ما يجعله «كائنا ثوريا»، يتمرد على المفردة والجملة والاتساق النحوي والتركيبي، ويخوض في أكوان لا يشعر بها سواه. إنه الشاعر الذي تشعر أن له حكاية غير مستقرة يسردها شعريا، وأنه ينتسب إلى حد كبير إلى حياة مصطخبة وسائلة ومتغيرة.
إنني أشعر بسعادة غامرة لما أقرأ شعرا مختلفا، يزرع الارتباك في ما عداه، ويجعل الآخرين يعيدون النظر في ما يعرفونه عن الشعر، على مستوى اللغة والفكر والرؤية إلى العالم. ذلك الشعر مولود من الحياة، وليس من الكتب أو المختبرات، يستقطره الشاعر بوعي حاد وقلق- وأحيانا مبتهج- باغترابه الكثيف، وبخفته غير المحتملة التي تتعارض مع «المرح» اللازم توفره في حياة. إنني هنا أفكر في الشعراء الحكواتيين الذين يقدمون لنا حالات شعرية يتقاطع فيها التخييلي بالتاريخي والشخصي، فتضج قصائدهم بالتوتر والمفارقة. قد نعتقد بأنهم «ينفذون» قولهم بطريقة معقدة للغاية، وقد نشتبك ضدهم بخصوص «التشكيل الشعري»، وقد نتوهم أنهم ركيكون أو منحرفون، غير أنهم في العمق شعراء مضادون للرسكلة (التدوير) بحيوية فائقة.
إن الرسكلة، في اعتقادي، هي سم قصيدة النثر، فيصبح الشعر في آلتها مجرد «إنجاز نصي»، بينما الحياة تقع في مكان آخر. وبتعبير آخر، ليس بإمكان الرسكلة أن تقدم لنا، في أجمل صورها، إلا «الميتاشعري»، وبطريقة مواربة. بينما الشعر قوة حيوية وغريزية لا يمكن كبتها إطلاقا، حتى وإن كانت تشتغل ضد الشاعر نفسه. إنه آلة حرب ضد الاستنساخ والترجمة والاستبضاع. هنا، ينبغي ربما إعادة النظر في قضية «الاختفاء الخطابي للشاعر» التي أثارها ستيفان مالارمي، من خلال الابتعاد عن تحقير الصيغ الغنائية أو نبذها.
لقد أدرك ملارمي، مثلا، أنه لا يوجد شيء خارج ذاته يجب «استخدامه» ليقوده نحو سحر الفعل الشعري، وأن الوهم هو ما يوفر الخيال، بما في ذلك المتعاليات الميتافيزيقية والدينية والخرافية التي تتراكم في مياهنا الجوفية؛ فإذا أضفنا إليها «ألم الوجود» و»الحكاية الشخصية» و»الأسلوب غير المثالي»، سنكون أمام قطع شعرية أصيلة وشديدة الخصوصية، على النحو الذي يجعلها تخترع، تدريجيا، اتساقها الخاص، ليس على مستوى التكوين التركيبي والنحوي والإيقاعي، بل أيضا على مستوى استخدام الصورة الشعرية التي تلعب دورًا حاسمًا في خلق تفردات تخرج عن ترتيب التجربة التقليدية المشتركة. ولا ينبغي أن يُفهم من ذلك أن الصورة الشعرية هي الحصان، وأن المكونات الأخرى مجرد عربة. فالصورة المذهلة لا تقع خارج صيغتها اللغوية، معجما ونحوا وتركيبا. كما أن كل صورة تخلق نموذجها الخاص، وهذا ما يمكن أن نجده لدى الشعراء السرياليين أو الدادائيين. لذلك لا يوجد تناقض بين «تناسق» التكوين الذي يُفهم عادة على أنه قانون الجماليات، وبين التوقيع الفردي على مستوى التفاعل والتجربة.
هذا المستوى من الفهم هو الذي يجعلنا نقول مع مارسيل شوب إن الشعر، بصرف النظر عن تعبيريته الجمالية، تفسير خاص لوجودنا الإنساني، ووجهة نظر تنافسية، وأن وزن الصور يخلق فرقا في الجهد، واختلافا في الحساسية، وتعددية في الأصوات والتفسيرات. بل إن ناقدا مثل بيرنار بيفيرت يشبه الشاعر، تأسيسا على هذا الفهم، بـ «صانع الأواني الزجاجية الناطقة»، لا بد من النفخ والتطعيم والحفر والترصيع، خارج القوالب، وخارج العجين الجاهز.
هذا هو معنى أن تكون شاعرا «ثوريا» ساعيا إلى الفن الكلي الأصيل، ما دام الشعر ليس «رسما إيضاحيا» ينبغي اقتفاؤه، وليس استمارة ينبغي ملؤها بنظام لغوي جرى تقعيده وتفخيخه بالمسكوكات. غير أن الثورة على النزوع البيروقراطي في الشعر لا تتحقق، مع ذلك، بإغلاق النوافذ على ما يجري في الخارج. فإذا كان رامبو يقول «ينبغي أن نعثر على لغة شعرية جديدة. ينبغي أن نطالب الشعراء بأن يأتوا بشيء آخر جديد، شكلا ومضمونا، ذلك أن اختراع المجاهيل أو (اكتشاف المجاهيل بالأحرى) يتطلب منا استخدام أشكال لغوية جديدة»، فهذا لا يعني الانطلاق من الصفر وغض الطرف عن التجارب الأخرى التي قد تعمق علاقتنا بالشعر، وتسمح لنا بتقويض المتاح والمألوف. إن حقيقة الشعر هو أن يعمد الشاعر إلى أن «يزرع التمرد في قلب ما يريد هدمه»، كما يقول فارغاس يوسا.
لقد وصف ويليام بتلر ييتس الشاعر إزرباوند بـ»البركان المتوحد بنفسه»، بينما قال عنه جيمس جويس إنه «معجزة من الغليان ومن الحيوية، وحزمة كهربائيّة غير متوقّعة التفريغ». أما يانيس ريتسوس، فيوضح أن الشعر «منطقة شاسعة وغير محددة، ولا نهاية لها. كما الحياة تماما». ومعنى ذلك أن الشاعر لا ينبغي له أن ينشد الاستقرار في ظل شاعر آخر، أو في حيز آهل ومغلق، كما ينبغي له أن يغادر «الأرشيف»، ويضرب في الأرض باحثا لخطوه الشعري عن سبل لم يسبق طرقها، لا يهمه الوصول بقدر ما تستهويه الطريق التي عليه أن يستكشف مجاهلها دون الاعتماد على أي تجربة مشي سابقة. ولذلك، فإن الشعر، في عمقه، تراجيدي، ما دام قدر الشاعر أن يمشي وحيدا، وأن يتحمل عواقب صراعه مع ذلك المعنى التي لا تملك حتى الآلهة تفسيرا له.
إن الشعر هو هذا الكون الفسيح الذي ينتظر من يميط اللثام عن ممكناته اللانهائية على نحو لا يقيني، بينما المأزق الذي تعيشه القصيدة الآن يكمن في انعدام الجسارة للخروج عن «الأخلاقيات» التي يكرسها الشعراء السابقون، فيلبسها طوعا اللاحقون، ويحولونها إلى حقيقة لا تقبل السقوط، ثم يشرعون في تدويرها وتحويلها إلى مؤسسة بيروقراطية لا تقبل الدحض.
أيها الشعراء، إن القصيدة ليست توهجا لغويا فقط، بل روحا من صميم الهاوية، لا يمكن اقتراضها أو نسخها، ولا يمكن طرقها بأقدام مستعارة!