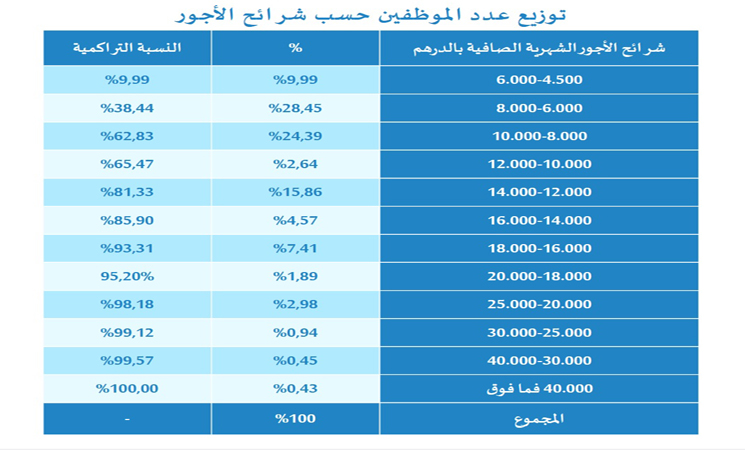حينما نمعن النظر في طبيعة العلاقة بين الفلسفة والعلم المعاصر، يستوقفنا الحديث عن تحديد كل من مهمة الفلسفة وماهيتها ومهمة العلم. و هذا التحديد، لن يكون مجديا إلا بالوقوف عند دلالة كل منهما.
فالفلسفة منذ نشأتها كانت بحثا في الوجود بشكل عام والوجود الإنساني بشكل خاص، كما أن للفلسفة ثلاثة مباحث، الوجود، المعرفة، ثم القيم، ومنها الأخلاقية والجمالية. ومن بين ما تهتم به الفلسفة السؤال.
فإذا رجعنا إلى الفلسفة اليونانية الكلاسيكية، نجد السؤال السقراطي الذي لازال يتردد صداه إلى يومنا هذا ( إعرف نفسك بنفسك أيها الإنسان ؟). فقد اعتمد سقراط منهجا توليديا وهو يطرح أسئلته الفحصية على محاوريه بغاية إنتاج المعرفة الفلسفية من خلال استجلاء الحقيقة بإعمال العقل في قضايا وجودية مختلفة، لذلك، كانت أسئلته تتشعب وتطول.
إن الفلسفة عبر تاريخها الطويل ومن خلال الفلاسفة وما خلفوا من متون فلسفية وأنساق حَدّدَت أهميتَها ومكانتها الهامة بالنسبة للإنسان بما لا يدع مجالا للشك والتشكيك، حيث يقول ديكارت في هذا الصدد: ” وكنت أبغي بعد ذلك أن أوجه النظر إلى منفعة الفلسفة، وأن أبين أنها ما دامت تهتم بكل ما ينبغي للذهن الإنساني أن يعرفه، فيلزَمُنا أن نعتقد أنها وحدها تميزنا عن الأقوام المتوحشين والهمجيين، إن ثقافة الشعوب والأمم، لم تعرف تطورا إلا بعد شيوع التفلسف فيها.” فلما كانت الفلسفة قد أخرجتنا من دائرة الهمج والتوحش عبر آلية التفكير، فقد أنجبت من خيرة أبنائها العلم، واعتبرته ابنها البار الذي اتخذ الفكر طريقة له في الصنع والإبتكار، ما يجعل الفلسفة والعلم وجهين لعملة واحدة وهي الفكر.
فإذا كانت الفلسفة تهتم بطرح السؤال وإثارة الإشكالات على كثرتها، فإن العلم يهتم بالواقع وما يرتبط بمنفعة وحاجات الإنسان المباشرة، وإسعاده ماديا، فإن لكل منهما منهجه الخاص، فكلما نغادر أرض العلم نلج عالم الفلسفة الفسيح، وبينهما مناطق التخوم والحدود، وهي ما نسميه في نظرية المعرفة بالإبستيمولوجيا؛ أي الدراسة النقدية للمعرفة في أصولها ومبادئها ونتائجها. لذلك، فالعلاقة بين الفلسفة والعلم علاقة تكامل وتناغم. لكن لكي نتبين ذلك بوضوح تام، نطرح التساؤلات التالية:
* ما الفلسفة؟ وما العلم؟ وما العلاقة بينهما؟
* هل يمكننا إلغاء الفلسفة في ظل تطور العلم وانفصاله عنها؟ بتعبير آخر، هل نحن في حاجة إلى الفلسفة اليوم؟
* ما الذي يعطي للفلسفة أهميتها ومكانتها في الوقت الراهن؟
إن التحديد الاشتقاقي لكلمة فلسفة يقودنا إلى مفهوم فيلوصوفيا، حيث؛ إن فيلو تعني محبة، وصوفيا تعني الحكمة، لتجمع الكلمة في معنى واحد هو: محبة الحكمة. والمعنى الاصطلاحي لكلمة فلسفة يتحدد بتعاريف لا حصر لها، بحيث إن لكل فيلسوف تعريفَه الخاص به، لكننا سنقتصر على بعض التعاريف لتقريب المعنى للمتلقي. فالفلسفة كما عرفها سقراط هي البحث العقليّ عن حقائق الأشياء المؤدّي إلى الخير وإنّها تبحث عن الكائنات الطبيعيّة وجمال نظامها ومبادئها وعلّتها الأولى. ” أما أرسطو فعرف الفلسفة بأنها علم الوجود بما هو موجود. وهي أيضا، علم بالكليات. أما ديكارت فيعرفها بأنها شجرة جذورها الميتافيزيقا، وجذعها العلم الطبيعي وباقي الأغصان المتفرعة عن هذا الجذع، هي الميكانيكا والأخلاق والطب..
أما إيمانويل كانط فيعرف الفلسفة أنها علم العلاقة بين كل المعارف والغايات العظمى للعقل البشري.
ويتحدد العلم في اللغة بأنه عكس الجهل، وهو إدراك الأمور كما هي بشكل جازم.
أما في الاصطلاح، العِلم هو النشاط الإنساني الذي يهدف إلى زيادة قُدرة الإنسان في السيطرة على الطبيعة، والكشف عن القوانين التي تحكمها ويدرس ظواهرها ويحدد العلاقات الثابتة بينها ويعمل على التنبؤ بحدوثها مستقبلا. ويصل العلم إلى وضع النظريات العلمية، إما على أساس تجريبي أمبريقي، أو عقلاني حديث أو أكسيومي معاصر. كما يعمل العلم على ضبط شروط النجاح العلمي من خلال البرهان والاستدلال أو التجربة والتجريب العلميين، ويُخضع العلم النظريات إلى معاييرها العلمية.
وتبقى العلاقة بين العلم والفلسفة علاقة تكاملية على الدوام، بالرغم من بعض الخطابات التي تريد إلغاء الفلسفة بالنيل منها وشيطنتها على حساب العلم، لما قدم من منافع مادية ونتائج يقينية أبهرت الإنسان المعاصر، وهذا الرأي المتطرف تجاه الفلسفة مصدره بالأساس، الجهل بمباحثها الواسعة ومضامينها المعرفية المتشابكة والصعبة المراس.
سوف لن أنصب نفسي مدافعا عن الفلسفة بارتداء عباءة المحامي، فالفلسفة تبلغ من العمر آلاف السنين ومن الشهرة ما تكفيها لتكون معروفة، ونظرا لساقيها الطويلتين تبدو شامخة تطل علينا برأسها مرتدية أسمالا جميلة تم نشلها على مقربة من الأرض من طرف المتحاملين عليها دون أن ينالوا منها سوى قطعةِ قُمَاش علقت بأيديهم، لكن النيل من الفلسفة يبقى عملا دون جدوى نظرا لشموخها وأصالتها وآلتها التي تتمثل في أورغانونها المنطق، والذي يعد آلة العقل. العلم لا يفكر في الماضي، فهو يتجه برأسه نحو المستقبل على الدوام ولا يكثرت لما ينتج، فقد يبتكر ما يدمر الإنسان ويفتك به. لذلك يقال: إن العلم أعمى، ففي كثير من الأحيان تتدخل الفلسفة لمساءلة الجدوى والغاية من مبتكرات العلم، فتضع العلم ومنتجاته على سكة الأخلاق.
فهُناك فئة من الذين يهتمون بالعِلم ونتاجاتهِ بِدهشة وانبهار، فيميلون إلى السُخريّة من الفلسفة أو الانتقاص من مكانتها المرموقة، ودائماً ما يشيدون بالعِلم المعاصر وما قدمَّهُ في مجالات عديدة أسعدت الإنسان وأنقذته من مُعضلات كبيرة كانت تعصف به على مر التاريخ. بالتأكيد وبكل فخر واعتزاز وبهجة وامتنان، أعترف وأُقر شخصيّاً بِما قدمهُ وَيُقدِّمهُ العِلم والعُلماء والمنظومة العِلميّة برمتها، ولا يُنكر ذلك إلا من فقد عقلهُ وأصيب بسعار حاد أفقده القدرة على التحليل والضبط.
وحسب رأيي المتواضع الذي قد يتفق معه البعض وقد يكون محط نقد من طرف البعض الآخر الذي يمتلك كامل الشرعية في ممارسته لآلية النقد هذه، شريطة أن يكون مشروعا ومدعما بحجج دامغة وإلا حاد عن منزلة النقد. هُناك سوء فهم أو إلتباس على الأقل في المُقارنة المُجحفة بين الفلسفة والعِلم. وكما يقول الفيلسوف الوجودي المعاصر جون بول سارتر:” إن الذي لا يكتب لا يفكر.” فكيف يمكن للشخص أن يمارس نوعا من النقد دون كتابة أو تفكير.؟
إن إلغاء الفلسفة حق مشروع من زاوية تجاوز الميتافيزيقا، والإقرار بالتغيير الإجتماعي من خلال العمل الثوري بتفعيل قوانين الجدل، بالمرور من جدل الطبيعة إلى جدل المجتمع. وهو العمل الذي أنجزه الفيلسوف الألماني كارل ماركس حينما جعل النواة الهيجيلية تمشي على رجليها بعدما كانت تسير على رأسها، وأسس للمادية الجدلية والمادية التاريخية رفقة رفيق دربه فريدريك إنجلز. وما يؤكد ذلك، هو قول ماركس التالي: ” إن الفلاسفة قبلي فسروا ونَظَّرُوا للعالَم، لكن هذا الأخير يجب تغييره.” وأضاف في نفس السياق، ” ليس الوعي هو الذي يحدد الحياة المادية الإجتماعية، بل إن الحياة المادية الإجتماعية هي التي تحدد الوعي.” في إشارة إلى أن البنية التحتية متمثلة في النسيج الإجتماعي عبر آلية الصراع الطبقي باعتباره محركا للتاريخ، هي التي تحدد كل أشكال البنية الفوفية من وعي وأخلاق وقانون وميتافيزيقا. تأسيسا على ما سبق، أستطيع القول إنه لا تضاد أو تنافر بين الفلسفة والعِلم حتى نعمل على إزاحة العِلم أو الفلسفة أو العكس، بل هناك اتصال وتواصل وثيق بين الفلسفة كأُمٍّ للعُلوم و ولدِها البار مُتمثلاً بِالعِلم من خلال المُنتجات التي نستفيد منها عبر التظافر والتقدّم في العُلوم بأصنافها وتفرُّعاتها الكثيرة، وما الوقت الراهن إلا تعبير عن كل أشكال التخصصات الأكثرَ دِقةً، سواءٌ تعلق الأمر بالعلم الدقيق، أم بالعلوم الإنسانية برمتها.
أستغرب كثيراً عندما أسمع بقول أحدهم ما دَور الفلسفة اليوم ونحن نعيش في ظل ثورة تكنولوجية وصناعية عظيمة؟ وما الحاجة إلى الفلسفة اليوم لما بلغنا درجاتٍ من الكمال والرقي مع تطور العلم من خلال نتائجه التي أبهرت الإنسان المُعاصر اليوم فوق الكوكب الأرضي وعلياء السماء وسديمها؟ وماذا تبقى للفلسفة بعد أن استقل عنها العلم؟ تبقى للفلسفة كل شيء، فبغض النظر عن الأمور الميتافيزيقية، فإن الفلسفة من خلال الإبستيمولوجيا أضحت فلسفة للعلم، أو بتعبير أدق فلسفة تاريخ العلم، فالإبستيمولوجي عالم و فيلسوف بالضرورة، وهنا، يمكننا استحضار رواد حلقة فيينا أو كما يسمون أنفسهم الوضعيين المناطقة ويأتي على رأسهم المؤسس الأول، موريس شيليك والرواد و منهم، لودفيج فتجنشتاين، ردولف كارناب، هانز رايشنباخ، ناهيك عن الذي جمع بين العقلانية والتجريبية الإبستيمولوجي الفرنسي المعاصر المدعو غاستون باشلار من خلال كتابه الشهير، العقلانية المطبقة.
ومقولته الشهيرة، ” لا وجود لعقلانية فارغة كما أن لا وجود لتجريبية عمياء.” في إشارة إلى ذلك الحوار الجدلي والدائم بين العقل والتجربة. حيث أضحت الذات الإنسانية منفتحة على الطبيعة ولازمت النسبية العلم المعاصر بعدما كانت ذات الإنسان في الفلسفة الحديثة قارئة للطبيعة بتعبير غاليلي، حينما قال: ” إن الطبيعة تتكلم مثلثاث ومربعات، و أنها كتاب مكتوب بلغة رياضية.”
وعليه، لا ولن نستطيع أن نكف عن التفلسف، لأن الحياة عِبارة عن سلاسل مُتصلة من الفكر عبر التأمل والشك والسؤال. لأن ذلك سيكون عملاً مُضاداً للطبيعة البشريّة التي تمتاز بالتَفَكُّر. فالفلسفة ضروريّة لفهم طبيعة الإنسان، وتبرز أهميتُها في قيامها بِمَهمة الربط بين نتاجات العُلوم المُختلفة في سبيل اكتشاف الحقائق الكُليّة في الكون والتي لا يُمكن للعلوم الجُزئية بلوغُها بِمفردها. والعلم مهما يبلغْ من التقدم، فلن يخرج عن دائرة الوعي الذي هو صناعة فلسفية بشكل دقيق، حيث مع رونيه ديكارت تشكلت معالم المثالية الذاتية من خلال فكرة الكوجيطو ( الأنا المفكر) ومع كانط المثالية النقدية ومع مجيء هيجل تحددت معالم الفكرة المطلقة، ومع كارل ماركس أضحت الفلسفة إلغاء للميتافيزيا وتجاوزا لها وتغييرا للمجتمع من خلال إلغاء الملكية الفردية لوسائل الإنتاج وانتفاء المجتمع الطبقي في أفق تحقيق أقتصاد الوفرة الكيفي وإلغاء اقتصاد الاحتكار الرأسمالي. أما في الفكر المعاصر فقد تعددت أبعاد الإنسان فلم يعد من المُستساغ اختزاله في البعد الاستهلاكي، بل بات الوجود الإنساني مطبوعا بالتنوع والتعدد، وهذا ما تحدث عنه هربرت ماركيوز الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني الذي اتخذ الجنسية الأمريكية فيما بعد، في كتابه ” الإنسان ذو البعد الواحد.”
الفلسفة والعلم المعاصر، أية علاقة؟
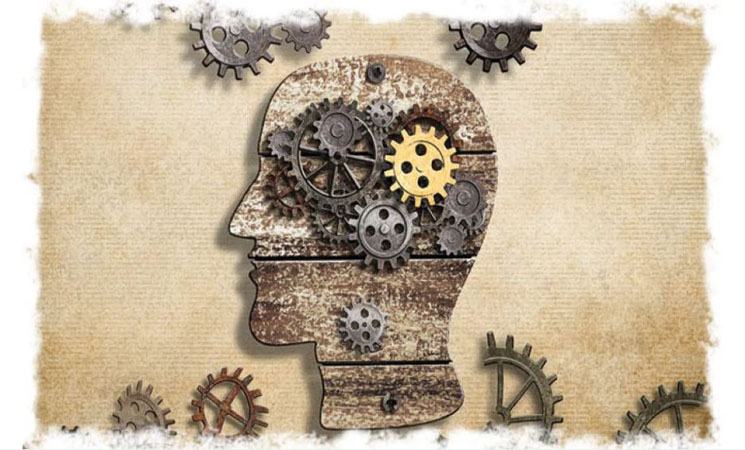
الكاتب : المعانيد الشرقي ناجي
بتاريخ : 23/07/2025