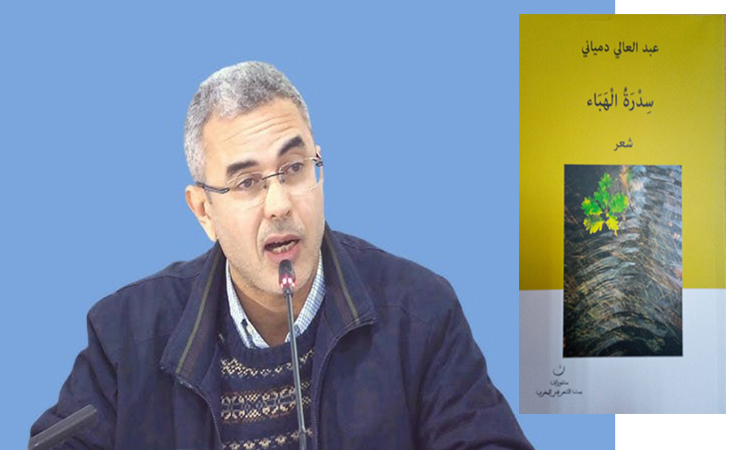يبدو عنوان من قبيل»القصيدة في خدمة المدينة»في غاية العمومية لأن القصيدة وإن وردت بصيغة المفرد فهي تدل على الجمع.فهل المقصود بالقصيدة:القصيدة العمودية أو قصيدة التفعيلة أو قصيدة النثر؟وهل القصد بالقصيدة الشعر وهما متمايزان تماما..وهل المقصود بالمدينة، المدينة الحلم أم المدينة الواقع؟ولماذا لا تكون المدينة في خدمة القصيدة بفضاءاتها وبرامجها أو على الأقل تبادل الخدمات بين حدي المعادلة؟لكن قبل الاشتباك مع هذه الأسئلة المركبة ، نرى لزاما التوقف عند المفهومين بكثير من الدقة.
1-تحديد مفهوم القصيدة
جاء في معجم المعاني الجامع القصيدة»هي التي تبدأ من سبعة أبيات شعرية فما فوق وتوحدها القافية والروي والوزن.»مقياس التحديد هنا الكم والتشابه في نهاية البيت الشعري. المعجم الوسيط ركز بدوره على العدد ،سبعة أبيات شعرية وصعودا.السؤال المحير هنا لماذا الرقم سبعة وليس أكثر أو أقل؟
يبدو هذا الرقم مقدسا في السياق الإسلامي. يكفي أن نعلم أن القرآن الكريم يتحدث عن خلق الله للكون في ستة أيام واستوائه على العرش في اليوم السابع.بل إن فاتحة القرآن نفسها بها سبع آيات.كما أن شهادة التوحيد تتكون من سبع كلمات(لا اله إلا الله محمد رسول الله) دون أن ننسى أن الطواف حول الكعبة يكون في سبع مرات وهكذا.نخلص بداية إلى أنه من المحتمل جدا أن الخلفية البعيدة لتحديد القصيدة خلفية دينية وإن كانت الخلفية الجمالية المحدد لها تركز على التشابه وتشجب الاختلاف.
إن منطقا كميا مماثلا يسقط من حسبانه الرباعيات وشعر الهايكو والنتف الشعرية، وهنا يتضح أن القصيدة غير الشعر الذي حددته المعاجم الغربية..جاء تحديد الشعر في المعاجم التالي(oxford/petit robert/larousse) على هذه الشاكلة:»الشعر خطاب يتأسس على المتخيل الحساس والمشاعر.هو فن لغوي بواسطته يصوغ الشاعر عوالمه من الكلمات والجمل ويحمل اللغة على قول ما لم تتعود على قوله وذلك بواسطة غنى الصور الشعرية.الشاعر بهذا الأسلوب ينقل لنا رؤيته للعالم ..وإذا سلمنا بأن لكل شاعر أسلوبه ، فهناك أشعار متعددة بتعدد الشعراء.»
الخلاصة الأولى:إن الثقافة العربية تنتصر للامتلاء وتشجب البياض لأنها تحدثت عن القصيدة العمودية التي تملأ الورقة بتقابل الصدر والعجز وهذه خلفية كمية لا تضع في حسبانها قصيدة النثر مثلا، مع وجوب التشديد هنا على أن بياض قصيدة النثر ليس صدقة تتكرم به الورقة فهو آلية تتضافر مع الحبر لإيصال صوت الشاعر.
الخلاصة الثانية: تركيز المعاجم الغربية في تحديد مفهوم القصيدة على الإحساس المرهف بالذات وبالعالم والعلاقة بينهما، والتركيز على الإحساس أريد به رد الاعتبار للمتخيل الذي عانى تبخيسا أمام سلطة العقل.وإرجاء هذه المعاجم لمكونات من قبيل الروي والقافية خلق تمثلا جديدا للفوضى الخلاقة والنظام الجائر خلافا لتعريف للسان العرب، حيث قال (الشعر منظوم القول) القصيدة بالنتيجة شكل والشعر نفس وجودي يلون اللغة والخطاب.
الخلاصة الثالثة وهي أن الشعر أكبر من القصيدة وأوسع انتشارا منها ولذلك هو موزع على باقي الأجناس الأدبية، ومن ثمة يصعب رهنه بزمن كما ذهب إلى ذلك جابر عصفور بداية الثمانينات من القرن الماضي بقوله: دخلنا زمن الرواية وانتهى زمن الشعر.إن قولا مماثلا يعني أن الشعر في أزمة.لكن ما نسيه جابر عصفور هو أن الوعي بالأزمة هو الضامن لاستمرار الشعر إذا افترضنا جدلا صحة قولته.
2 – في تحديد مفهوم المدينة:
اعتبرت المدينة على امتداد تاريخ الحضارة البشرية معيارا للتحضر والرقي ولذلك وضعت مقابل التوحش والهمجية ،وهذا تحديد غير دقيق إذ أين يمكننا وضع الجريمة والانتحار المنتشرين في المدينة مثلا؟يقال عادة إذا كانت البادية من صنع الله، فإن المدينة من صنع الإنسان.وهذا يعني أن كل الشرور والفواجع التي عرفها الإنسان هي من صنعه الخاص.جاء في معجم المعاني الجامع:»تضم المدينة عددا من السكان يفوق تجمعات القرية التي تسيرها أنظمة عشائرية خلافا للمدينة التي يحكمها نظام إداري.»تعريف هذا المعجم يحتكم مرة ثانية للكم ثم يضع العفوية مقابل العقل والنظام كاستعارة للفلسفة. وهنا نختلف مع التحديد أعلاه لأنه يحدد المدينة بمعيار إحصائي كمي وليس بمعيار قيمي ومعرفي وخدماتي وهذه شروط ضرورية لتأسيس المدينة بالمعنى لحضاري كمسعى يتواجد فيه الشاعر كطرف معني بخلق وعي مديني.
وبالعودة إلى المشاريع الفكرية المؤسسة التي تطرقت لمفهوم المدينة، نتوقف عند مصدر «الجمهورية» لأفلاطون حيث نجده في حديثه عن المدينة الفاضلة يحددها كفضاء يربي المواطن على حب الحياة والقيم النبيلة.وهو مآل يلتقي مع الشعر باعتباره خطابا يتأسس على الدهشة وينتصر للجمال.وإن كان أفلاطون قد ضحى بالشعراء باعتبارهم منتجي فن الوهم وهو المراهن على العقل كآلية لحيازة الحقيقة.عند هذا المستوى من التحليل يلزمنا التمييز بين المدينة la cite وبين الحاضرة la ville. فإذا كانت الحاضرة مكانا معماريا خاصا معروفا ببناياته وعدد سكانه ،فإن المدينة مكان حضاري معروف بقيمه المروجة بواسطة المواطن وهو هنا الفرد الذي يستوطن مجالا حضاريا ويساهم في إنتاج قيمه بما في ذلك الذوق والمعنى والحقيقة.بالنتيجة المسافة الفاصلة بين الحاضرة والمدينة هي نفسها المسافة بين الحلم والواقع..المدينة بهذا المعنى طموح يعسى إلى تأسيسه الشاعر والمفكر ولذلك وجدا معا في حالة خصام دائم مع الحاضرة. يكفي أن نستحضر العلاقة المتوترة بين سقراط وأثينا لأنه كان يبحث عن أثيناه الخالصة من السفسطة والدغمائية والتلاعب بالعقول .غربة الفيلسوف مماثلة لغربة الشاعر عن مدينته المحلوم بها وإن قدما في العمق متناقضين يكفي أن نعلم أن فكرة أفلاطون عن المدينة الفاضلة كانت سبب نفيه مرتين من أثينا.نفي إلى جزيرة صقلية من طرف ديونزوس الأكبر بحجة تآمره على السلطة والمرة الثانية نفي إلى إسبارطا وكاد يباع بيعة العبيد لو لا تدخل أحد أصدقائه في سوق النخاسة وعاد إلى الأكاديمية ليكتفي بالتدريس والكتابة مراهنا على الزمن والوعي لتحقق مدينته الفاضلة.بهذا المعنى تقف المدينة خلف غربة الفيلسوف والشاعر معا فحتى عندما اعترفت المدينة بشعر هوميروس قبل سقراط وأفلاطون اعترفت به كمؤرخ يمجد صوت الجماعة وملاحم الانتصار لا كشاعر يتحدث عن الذات في بعدها المفرد..بالنتيجة المدينة الحلم أو المدينة في الشعر ستبقى الحاجة إليها مدى الحياة لأنها بكل بساطة تمثل المدخل الضروري للتغيير فهي مدفئة الفيلسوف وبوصلة الشاعر.
3 – الشاعر والمدينة الغربية
اعتبر حضور المدينة في الشعر أحد مظاهر الحداثة منذ القرن(18).حضرت كفضاء منتج للقيم ومكان مفارق فهي عند الشاعر الرومانسي معادل موضوعي للضياع والوجع والفجيعة.وبالنسبة للشاعر الملتزم حلبة للصراع الطبقي.أما عند الشاعر الرمزي فهي قناع جماعي للتحول.في هذا السياق يمكن فهم قصيدة «أرض الخراب» لتوماس إليوت التي ترجمة متقززة من الموت على هامش جرائم الحرب العالمية الأولى دون أن تسقط في أدب الدموع ومرثية الضعاف، محولا الألم إلى أثر جمالي وهنا تكمن قوة هذا الشاعر مصورا أزمة العقل الغربي الذي ادعى التمدن في لحظة حضارية معطاة، متوقفا بشكل جمالي عند القيم التي هيمنت بداية القرن(20):الفردانية، المجهولية، النفعية..
تبدو المدينة باهتة الحضور في أشعار إليوت لأن حجم الجرح وهول حدث الحرب غطى على الكل، علما بأنه قضى عشرة سنوات بلندن بين 1915/1925 حيث تعرف على ازراباوند الذي وضع تجاربه تحت الضوء وعرف به.ونفس التبرم الذي استشعره توماس إليوت مع لندن، عاشه أرتر رامبو مع باريس حيث غادر برودتها غير عابئ بزيفها في اتجاه الحبشة والقاهرة.باريس التي امتدحها بشكل لافت أحمد شوقي في الكثير من قصائده.وخلافا لهذا الانبهار بمدينة الأنوار حضرت باريس في «أزهار الشر» لشارل بودلير كفضاء للموت والحتف والمنية ، إذ أنه على خلفية مغامراته العاطفية أصيب بالسفليس وبات تصويره لشوارعها استعارة على سواد قلوب ساكنها.إن تجربة هذا الشاعر بالذات تطرح علينا سؤالا مزلزلا:ترى هل من الضروري أن نفشل في الحياة العامة كي ننتج أدبا رفيعا؟وهل يمكن اعتبار ضياعه في زحمة باريس وتسكعاته المجانية في حواريها مصدرا من مصادر أشعاره الفارقة.ربما كانت المعاناة كنزا لا ثمن له فقط يلزم معرفة كيفية تحويل الألم إلى أثر جمالي.في الواقع شارل بودلير فعل كل شيء بباريس لكي يفشل ويصبح مرفوضا ومنبوذا من قبل مجتمع الزيف والتباهي.عاش حياته بالعرض وليس بالطول وخصوصا في الحي اللاتيني.. بحث عن الحياة بجنون الشاعر فصادف الموت.بالمدينة جرب الإدمان على الأفيون والجنس الذي أوصله للمرض الخبيث.مارس الدنجوانية بكل تلويناتها إذ يصعب عد خليلاته في مقاربة كهذه، علما بأن ديوان»أزهار الشر»كله تمحور حول فكرة أساسية وهي:كيف للإنسان أن يوفق بين تحقيق الرغبة التي تبدو بألف رأس والامتثال للأخلاق؟ رغبته أوصلته إلى أن أضواء المدينة وبريقها جارح بل إن الألم تشخصن في هيأة قائمة الذات وكان يكتبه بحرف ملكيDouleur وكأني به شخصية درامية أو كائن بشري وغالبا ما أسبقه بحرف تعجبOh. Douleur تقنيات كتابية جعلت من قصائد شارل بودلير شهادة صادقة على تمزقات الفرد بين القوة والضعف بمدينة تأخذ أكثر مما تعطي.
4 – الشاعر والمدينة العربية.
بدا الشعر في السياق العربي بدويا بدليل هيمنة الوقوف على الأطلال في مستهل القصائد المؤسسة لعمود الشعر العربي..والأمر طبيعي إذا اعتبرنا أن البادية هي الأصل والمدينة شيء طارئ على الحضارة.في القرن الثاني الهجري مع ظهور مدن عربية هنا وهناك، استبدلت المقدمة الطللية بالمقدمة الخمرية وظهرت أغراض جديدة ارتبطت بالحاضرة ولا أقول المدينة منها التشبب بالغلمان وكلها مواضيع زادت من عزلة الشاعر الذي تطابق عند العموم بالغواية:خمريات أبو نواس وغزليات عمر ابن أبي ربيعة وما شابه ذلك..في القرن التاسع الهجري عرف الشعر الأندلسي رثاء المدن بدل رثاء الأشخاص وكأني بالشعرية العربية لا تهتم بحواضرها إلا لحظة غيابها، وهو ذات الشيء الذي وقع مع شعراء المهجر الذين استحضروا حواضر الصبا والطفولة وهم في بلاد الغربة.في الشعر الحديث والمعاصر كانت المدينة فضاء في غاية القسوة ومكان للتيه والضآلة ومجال للإحساس بالوحشة. أتحدث عن القاهرة في أشعار عبد المعطي حجازي في ديوانه»مدينة بلا قلب»وصلاح عبد الصبور في ديوانه»الناس في بلادي»، وذات الشيء يقال عن سندباد الشعر المعاصر عبد الوهاب البياتي في ديوانه «سفر الفقر والثورة»حيث القصائد في مجملها مؤطرة برؤية درامية للمدينة، إذ يكفي استحضارها لتفجير أحزان اجتماعية وأخرى تاريخية توجع الشاعر.فإذا كانت القاهرة مدينة جارحة بقسوتها عند عبد المعطي حجازي، فإن بغداد البياتي رغم الحنين لها لا تقل عنفا عن القاهرة..ويبدو أن المدينة العربية ليست وحدها مصدر هذا الانسحاق ولكن حتى الشاعر لم يكن مؤهلا للتعايش مع قيمها الجديدة وإن كان لا يستطيع عنها فكاكا وهنا يتولد وعيه الشقي شعريا بالمدينة فلا هو توفق في الاندماج فيها ولا هو استطاع العودة للبادية ليصبح الضياع قدره.هذا بخلاف الشعراء الفلسطينيين (توفيق زياد،سميح القاسم،محمود درويش..)الذين بدت عندهم المدينة خافتة الظهور ربما لأنهم انشغلوا بنزيف الوطن المحتل أكثر من المدينة ، إذ أن القدس مثلا في ديوان «أحبك أو لا أحبك» لمحمود درويش لا تحضر إلا لماما.غير أن اللافت للانتباه هو الحديث المفارق لأحمد شوقي عن باريس بنغمة الحب وهي التي كانت تعادل في «أزهار الشر» الموت والوجع والفجيعة.وخلافا لأحمد شوقي يحسب لسعدي يوسف أنه تحدث شعريا عن باريس باعتبارها مدينة للقتل في إشارة لاغتيال المهدي بن بركة.التفاتة تحسب لهذا الشاعر وإن كان قد أخلف الموعد في اعتباره أن الشعر مشرقي المنبت والمنتهى.تبقى بيروت هي المدينة المشاعة بين كل الشعراء على اعتبار أنها مدينة الثقافة والإبداع رغم الدمار الذي لحقها بسبب الحروب المتتالية..
5-الشاعر والمدينة المغربية.
تنبع خصوصية المدينة المغربية من شرط تاريخي وآخر سياسي، إذ أن المدينة ارتبطت في ذاكرة العموم برجل السياسة أكثر من ارتباطها بالمبدع والمثقف.فإذا قلنا مدينة أصيلا نستحضر وزير ثقافة سابق وإذا ذكرنا سطات نفكر مباشرة في وزير داخلية سابق وهكذا.. ونادرا ما نتذكر القصر الكبير بمحمد الخمار الكنوني أو علاقة عبد الكريم الطبال بالشاون مثلا إلا من داخل أهل الاختصاص.لكن إلى حدود الستينات من القرن العشرين كانت هوية الشاعر المغربي مزدوجة. فإما هو فقيه وشاعر أفكر في المختار السوسي ومحمد بن إبراهيم أو هو رجل سياسة وشاعر علال الفاسي نموذجا.. وبالتالي يصعب أن نظفر ببروفيل لشاعر مثل المتنبي ندر حياته للشعر حصرا.
دخول الجامعة المغربية على خط التاريخ الحديث حسم في صورة الشاعر المغربي..والمبدع المغربي عموما هو زبون الجامعة بامتياز وكل استثناء يؤكد القاعدة ولا يلغيها.وإن كانت الجامعة المغربية بدءا من التسعينات فصعودا، بدأت في تخريج المتمدرس لا المبدع وتنتج التقنوقراط والخبير المنفذ لا المثقف ..خبير بلا خلفية إيديولوجية وبهذا الأفق النفعي أصبحت صناعة صورة وصوت الشاعر موكولة لذاته في تفاعله مع الجمعيات الثقافية…موقع المغرب الجغرافي كذلك تدخل في رسم صورة الشاعر إذ أن البعد المجالي عن الأرض المنتجة للكتاب المقدس تحول لبعد نفسي ضاغط.وكان وقع جمل من قبيل»والشعراء يتبعهم الغاوون»مزلزلا فكانت ردت فعل الشاعر المغربي جمعه بين الفقه والشعر مثلا ليثبت انتسابه للإسلام، دفعا للصورة التي تكرست عن الشاعر في وجدان المغاربة..وينبغي هنا ألا ننسى السلطة الفعلية والرمزية التي مارسها المشرق على الغرب الإسلامي بدءا بفعل القتل الفعلي لإدريس الأول لأنه فكر في شق عصا الطاعة عن الخلافة المركزية، فضلا عن القتل الرمزي الذي روجه المشارقة على شعر الموشحات بقولهم «هذه بضاعتنا ردت إلينا».في التاريخ الحديث للمغرب نظرت الحركة الوطنية للثقافة والإبداع كدرع تابع للسياسة وترف زائد، بل إن تصورها للثقافة كان اختزاليا حيث أسقطت كل ما هو شفوي واحتفظت بالمكتوب ولهذا جاء اهتمام الأحزاب السياسية في ما بعد بالثقافة عرضيا ونعيش اليوم تبعات هذا الاختزال وهذا الاقصاء، ونفهم لماذا يسهل على رجل السياسة أن يقتحم مهرجانا خطابيا في ساحة عمومية ويصعب، إن لم يكن مستحيلا، على الشاعر فعل ذلك.سياسة النخبة السياسية بالمغرب جعلت من مجتمعنا يكرس عزلة المبدع والمثقف ولا يشجعه على التعاطي مع القيم الجمالية ولذلك تغيب عن أغلب مدننا المتاحف والمسارح وقاعات إنشاد الشعر..وما زاد الطين بلة أن هوية الشاعر ضاعت في زمن تشابه الشعارات حيث الكل ينتصر حلقيا للجمال والحرية والتعدد والانفتاح..وغدت اللبرالية مرجعية موحدة وشبه ديانة للعصر.
وإذا كانت هذه هي حالة الشعر، فإن حالة المدينة لا تقل التباسا يكفي أن نعلم بدل رهانها على التكامل مع البادية دخلت معها في صراع وسمتها ببلاد السيبة لأنها كانت معقل الكفاح المسلح(أحمد الهيبة،موحى وحمو الزياني، وعبدالكريم الخطابي..)ومصدر مزعج للسلطة المركزية ولذلك همشت البادية. والغريب في الأمر أن النخبة السياسية المدينية التي همشت البادية هي التي تنادي اليوم بتنمية العالم القروي.
سياق تاريخي وسياسي وجغرافي تضافرت مكوناته لتجعل من الشعر فعلا نخبويا وليس حقا للجميع.نتيجة تكرست بطرد الثقافة من المدرسة والجامعة المغربيتين فضلا عن إدارة الإعلام الظهر للمعرفة والإبداع فباتت جمعيات المجتمع لمدني هي الملاذ وإن كانت بدورها ارتكبت أخطاء في إسماع صوت المدينة الثقافي باختزاله في الأدب دونا عن سؤال الفكر والتأمل الفلسفي على سبيل التمثيل.
إن عزلة الشعر وعدم قدرته على التجذر في قاعدة المجتمع يجعل من المدينة الفاضلة مطلبا متجددا ومدخلا للتغيير بل وحاجة ملحة هنا والآن.فإذا كان الشاعر معنيا بسؤال الذوق والمعنى والجمال، فإن المدينة تبقى من صميم انشغالاته لأن دوره في خلق وعي مديني لا مناص منه.بالنتيجة المدينة والشعر المغربيان تلونا باللحظة التاريخية التي عبراها.فبدءا من ستينيات القرن العشرين وصعودا تأثر الشعر المغربي بتبخر أحلام الاستقلال وتراجع فكرة القومية العربية لاحقا وعاد سريعا للاحتفاء بالذات وتوطينها في الامكنة والمدن.فإذا كانت المدن لا تتذكر زوارها العابرين، فإن الشعر يخلد زيارة الشعراء لها أكثر مما تفعله صور السياح السريعة التلف.تتحول اللغة الشعرية من أداة للتواصل إلى مضيفة للمكان وزائره.بواسطة الشعر امتلكت القصيدة سلطة رمزية على المكان والزمان راسمة أمامنا نفس المدينة بعدد الشعراء الذين ارتادوها أو ولدوا بها.ففاس محمد السرغيني ليست هي فاس محمد بنطلحة ولا فاس محمد الاشعري.ومراكش مليكة العاصمي ليست هي مراكش أيت ورهام ولا مراكش الجواهري..واختلاف نفس المكان أمر طبيعي جدا لأن الذاكرة البصرية لكل شاعر تختلف باختلاف الحساسية والمؤثرات الموازية التي صاحبت شغله للمجال.
بالنتيجة المدينة المغربية في علاقتها بالشاعر تأخذ وتعطي.تأخذ منه السكينة بسبب خطاها المتسارعة وأحداثها الإجرامية وفي لحظات صفائه الذهني يترك لنا لوحات مدينته مرسومة بالكلمات إذ لا يمكن للدارس أن يقفز مثلا عن شفشاون الطبال بزرقة أفقها وبياض متوسطها وتفاصيل حواريها وأزقتها، علما بأن هناك شعراء وشواعر انفتحوا على مدن عربية كما هو حال وفاء العمراني مع بيروت في نص»بيروت لو تستطعين»حيث بدت الشاعرة في علاقة عشق بالمدينة وحالة اشتياق لا قرار لها.بانكتاب المدن في أشعار الشعراء، يتلون المكان بعبق الكلمة ونتعرف على حساسية كل شاعر في شغله للفضاء وتوثيقه لتغيرات المكان. لهذا فأهم مبررات وجود المدينة هو الأثر الفني والمنتوج الثقافي الذي يدون ذاكرة المكان من خلال خصوصية الخطاب الأدبي تحديدا..
(*)نص المداخلة التي تقدم بها الباحث بالمهرجان العربي للشعر في نسخته 13 بطتجة يوم 6 أبريل 2018.