أنوار الأنوار- معروفة باسم أنوار أيوب سرحان ، من مواليد قرية نحف الجليلية، أم لخمسة أطفال ، كاتبة ومترجمة فلسطينية ، تجربة إذاعية ، واسم بارز كصوت نائي وإنساني، من أبرز مؤسسي اتحاد الكتّاب الفلسطينيين 48، شغلت منصب أمينته العامة في المرحلة التأسيسية، صدرت لها
مجموعة قصصية «الأفعى والتفاح» مطلع 2010- وشدّت أنظار القراء والنقاد ومزجت فيها الهمّ الفلسطينيّ بالأنثويّ، واستوحت قصصها من خصوصيات المرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة.
ثم مجموعة رسائل «في حضن التوت» عام 2016 تناولت الهمّ الإنسانيّ.
هجرت الكتابة لسنوات ، عادت غيومها كي تنهمر في صحراء روحها ، وكي تكتب تكتبت سنواتها بدمها. لأن الكتابة شقيقة النزيف والاحتراق ، تتبادل وإياها المراوغة ، كي تكون في يد القارئ نصوصا مستوية
في هذا الحوار نقترب من أنوار الأنوار ، إنسانة وكاتبة مكتظة بالحياة ومصابة بلعن الكتابة الجميلة :
– دعينا نرجع بالذاكرة إلى البدايات التي كانت حاسمةً في ذهابك إلى الكتابة ؟
– طفلةً في التاسعة كنتُ، لمّا كتبتُ قصيدةً لفلسطين، فيما أتأمّل إنصات أبي إلى نشرة الأخبار العبرية وتعليقاته المنفعلة عليها. أذكر دفترًا صغيرًا في يدي، إذ أطلعتُ إخوتي على القصيدة، فسخروا مني. قالوا إني لا شكّ سرقتُها من أحد الكتب التي أواظب على الاختلاء بها باستمرار أو من دفاتر أخي الأكبر، الشاعر الشابّ حينها.
صمتُّ وأختبأتُ بحروفي وخبأتها. صارت سرّي، رغم أنّي كنت نجمة الاحتفالات في إلقاء القصائد والأغاني في القرية، إضافةً إلى تمثيل المشاهد المسرحية التي غالبًا ما أكون مؤلّفتها دون أن ينتبه الكبار أني أفعل. كتبتُ سنواتٍ عن جارنا الذي يصرخ ليلًا ونهارًا، عن صديقتي التي تصرّ أن تضرب زميلاتنا الضعيفات «فأتخانق» معها ثمّ تغلبني لأعودَ مهزومةً بشعرٍ منفوش، عن معلّمتي التي تحبّني وأخافها وتراني طالبةً مثاليّةً بينما لا تسمع صوت خيالاتي، عن خناقات أبي وأمّي التي تنقلب غزلًا في حضور الضيوف، كتبتُ عن أحلامي التي أدسّها في مستودع أسراري كونها لا تشبه أحلام زميلاتي بشيء، عن خوفي الذي أخجل أن أبوح به، ثمّ عن السيّدة العجوز التي لا تخلع السّوادَ مذ مات ابنها شابًّا، وتصرّ أنّ كلّ خميس هو خميس الأموات..
لكني إذ كبرتُ هجرتني الكتابة سنواتٍ أو هجرتُها، إذ حاولتُ أن أكون الأكاديمية الناجحةَ والزوجة العاشقة، والجارة التي تسعى للاندماج في البيئات المحيطة، وتخشى الإفصاح عن مكنوناتها وإزعاج المحيطين باختلافها عنهم.
ويوم تكسّرَت سماواتي واهتزّت بي أرضي وأيقنتُ أني لن أجيد الانسجامَ أبدًا، عادت غيوم الكتابة تنهمر في صحراء روحي فتُنبتها من جديد. وعادت سماوات الكتابة وطنًا وملاذًا من الجنون أو الانتحار، وسبيلًا لإطلاق الصرخات الملجومة أو المكبوتة، ثمّ طريقًا لإطلاق كلّ الشخوص المكبوحة والتمرّد على العالم برسم عالمٍ لا يشبهه أبدًا، تكون أفكاري فيه دومًا منتصرة.
الشاعر المغربي عمر نانسا « لايؤمن بكتابة لا تترك دما ؛ دم كاتبها ودم من يقرؤها» .. بالمناسبة، ما الكتابة التي تؤمن بها أنوار الأنوار؟
كل نص يمنحني الدهشة صورةً ومعنىً ونسجًا للكلمات يعنيني. كل ما تعوزه الدهشة بالنسبة لي كتابة ميتة. قد نكتب عن الموت نصوصًا حية نابضة، وقد نكتب عن معاني الحياة بحروف باردة تفتقر لانسياب الحياة. فأما ما يختزن الدهشة وينسج حياة وحيوية فيظل قادرًا أن يحفر في ذاكرتنا لنبحث عنه في لحظاتٍ ما. كأننا نلوذ بالذاكرة ننبشها لانتشاله يسعفنا لأننا جربنا لذّته وتذوّقنا مكوثه في الروح.
كتبت سنوات بدمي. كانت الكتابة رديف نزيفي واحتراقي. في نصي نخب صليبي كنت أكتب عن ذاك النزف وأسيل حروفًا وكلمات وصورًا من احتراق يتوهج. وحين منحني طبيب نفسيٌّ عقار سيبراليكس لتخفيف حدّة اكتئاب غلبني، كتبت نصي سيبراليكس.. كنت من عمق كآبتي أنشد الحب والحياة.
الكتابة الحقيقية عندي هي تلك المنبعثة من صدق للحالة والمنسكبة ابتكارًا يغرس الدهشة ويخصبها فتتوالد ثبوتًا في ذاكرة القارئ يرى فيها مراياه الواضحة أو الخفية.. ثبوتًا يظل قادراً في ذات الوقت على التدفق والتجدد.. فكلما أعدنا قراءته نكاد نحسبها المرة الأولى.. ونقول :الله..
– من أيّ مشتلٍ جئتِ بهذه الثريّات المعلقة في سقوف إصداراتك: في الأفعى والتفاح وسيناريوهات الجرائم، وفي حضن التوت ورسائله؟
– لعلّ في كلّ كتابٍ توثيقًا لمرحلةٍ قد نحياها واقعًا ماديّا أو ذهنيًّا أو فكريًّا. في كلّ مجموعةٍ يلملم أحدنا إحدى ذواته التي كانها، بسؤالاتها، بأحلامها، باهتماماتها، بآلام وآمال من يسكنها من شخوص، يجمعها ويثنيها بين دفّتَي غلاف. كأنما في النصوص صورة تقولنا نتخلّص منها إذ نضعها في الإطار.
في «الأفعى والتفّاح» جمعتُ سؤال هويّتي كامرأةٍ فلسطينية تحمل جواز سفر إسرائيليًّا، وتجتمع عليها كلّ أسباب الجريمة المحتملة كلّ ثانية. غنّيتُ أصوات مَن سكنتني أوجاعهنّ أو أحلامهنّ من نساء شعبي. في كلّ سيناريو لجريمةٍ محتملةٍ كنتُ كأنني أهتف للعالم أن انتبهوا! كلّ لحظةٍ تحياها أنثى فلسطينية على هذه الأرض هي جريمةٌ مهما بدت غير ذلك، جريمةٌ تختبئ وراء ستار أو تنتظر انفلات شريط لتندلع براكينها.
لكني في حضن التوت كنتُ أخرى. كنتُ تلك المتجاوزة لانتماءاتها توثّق مسيرتها الفكرية نحو التقاط روحها الكاملة وسؤال إنسانيّتها الأرحب. كنت أوثّق همومًا أكثر فداحةً وعمقًا، عاشتها أنواتي الفكرية التي لم تعُد تجد ذاتها في دين ولا قومية ولا شعب ولا أرض أو مكان أو حتى زمان: ما الله؟؟ ما الديانات التي يُفترض أنها سبُلنا إليه؟ ما الموت؟ ما الحياة؟ ما الحبّ؟ ما المعاني التي تُسلَب منا لحظة انزلاقنا إلى هذا العالم لنفجّرها بصرخة إعلان القدوم؟
ربّما لهذا جاءت نصوص «الأفعى والتفاح» على شكل سيناريوهات قصصيةٍ تنبعث منها روائح وأصوات ومشاهد تكتمل جرائم جاهزةً للانفجار، بينما «في حضن التوت» انسكبت «رسائل خانها البريد»، في معظمها تنبعث إلى حبيبٍ ميّت ليس له عنوان، لكنه الأكثر حياةً في الروح من كلّ مَن يتحركون حولنا ويموتون فينا. كأنني في الأولى هتفتُ بأصوات مَن حولي انتماءً لهنّ، وفي الثانية غنّيتُ غربتي فيهنّ وفيهم.. غربة السؤال والانتماء والوحدة التي تحملك إلى ذاتٍ جديدة تمزّقت كثيرًا في طريقها وخلعت كثيرًا من الحجب، فرأت نواة إله صوفيّ لا يتجلى في الركوع والسجود، إنما في إرادة خلق داخلية فينا. لكن الجامع الواحد لكل نصّ في المجموعتين هو ذاك الإنسان الذي يحلم بعالم أصفى ويؤمن بالحب سبيلا إليه، إن لم يجده خلقه.
– نجيب محفوظ كان لا يكتب إلا فجرًا، الرّابعة صباحًا، وهو حافي القدمين ويرتدي البيجاما، فهل من عاداتٍ وطقوس لأنوار وهي في معبد الكتابة؟
– تراوغني الكتابة أو أراوغها، تتملّص مني ثمّ تعود لتباغتني دون انتظار، كأنّ بيني وبينها عقدًا خفيًّا ألا تستعبدني طقوسٌ لها أيًّا تكن. فهي مساحة التحليق والحرّية والتجلّي الذي لا يعرف حدًّا ولا شرطًا، وهي الأفق الممتدّ بلا نهايات ولا حدود ولا أسقفٍ وجدران.
قد أكتب في المطبخ كما قد أكتب في السرير. قد أكتب في القطار، أو أوقف سيّارتي عند أقرب محطة بنزين كي أعانق نصًّا انسكب من سماءٍ انفتحت فجأةً وأخشى أن تغلق دوني أبوابها قبل أن أستجيب. وقد أكتب لأنّ روحًا جميلةً استفزّتني بسؤال أو ملاحظة فحملتني إلى عالم الحروف.
بيد أنّ نوع الكتابة يؤثّر بالتأكيد على عوالمها وطقوسها، فأمّا الكتابة «البَوح»، فتلحّ بذاتها حدّ مباغتتي في أيّ مكانٍ وزمان، وأمّا الكتابة «الحلم»، فكأنّما هي سرٌّ لا ينبعث إلا بخلوةٍ مطلقة، في غرفةٍ مغلقة ومقعدٍ منفرد في العتمة، وبين يديّ دفترٌ أو حاسوب. وأما الكتابة «الفكر»، والمتسللة عادةً عبر المقالات، فموعدها المساءات، بعد صولاتٍ وجولاتٍ تتحاور فيها شخوصي داخل ذهني، وتنتصر إحداها لفكرةٍ ما فتنسكب مقالةً.
وكما أنّ الكتابة لا تستعبدني طقوسًا، فأنا لا أستعبدها حضورًا، لذا قد تغيب عني أحيانًا دون أن ألحّ، مبرّرةً لنفسي أني لا أحترف الكتابة ولا الصحافة، وأنّ الكتابة كانت وتبقى صديقة روحي وذهني التي ألوذ بها إذا ما خشيتُ أن يهزمني العالم.
كل محاولة لقول حكاياتك هي بحث كله تجريب وتحصين لها من التكرار؛ بالمناسبة أسألك عن قصة هذه التشظية وهذا التكسير لضلوع الحكاية في مدوّناتك الأخيرة؟
لعلنا نكتب أساسًا لقارئ يسكن أعماقنا، وهو ذكيٌّ لا يبحث عن وجبةٍ جاهزة، بل يجيد قراءة الحكايات التي تبدو منفردةً ومكتملةً، ليحيك ما بينها من خيوطٍ فتتكامل كلوحة كولاج تلملم شظايا الحكاية، أو ك «بازل» في كل جزء منه بعض من حكاية أكبر. أو لعلها رؤية شمولية للحياة المركبة إذ لا تكتفي بتمييز أطراف المشاهد بل تنتسج فيها الخصوصيات لتبلور الصورة العامة. أو لعلي أكتب تشظيّ الذاتي أيضًا.. تشظي امرأةٍ تعمل في التربية وتحمل رؤيةً تحلم أن ترفع بها مجتمعها، وتجوب البلاد شمالا وجنوبًا فتطلّ إلى خفايا ما يختبئ وراء المشاهد إذ تسكنها نظرات نساءٍ وأطفالٍ وعيون رجال يختزنون ذاكرة وثقافة وتكوينًا ينسكب من مواقفهم.. ثم توزع ذاتها في محاضراتٍ وملفّاتٍ وورشات كتابة إبداعية وتنشئة خمسة أبناءٍ تصرّ أن يؤثثوا مستقبلهم بذكرياتٍ من الضحكات والجمال، وبزادٍ من الوعي والحكمة وبسلاح من الحبّ الكثير.. وتشظي من تتأمل التاريخ ماضيًا ومستقبلاً، وتسعى أن تدرك شمولية الحقيقة.. ولأني مسكونة بالسؤال ويوجعني أنّ شعبي ما زال منذ عقود يجترّ نكباته وماضيَه دون تأسيسٍ لمستقبل وأمل.. ولأني أحلم بعالم أجمل.. كلّ ذاك التشظي في توزّعي ما بين ذاتي الفردية والجمعية، ما بين التزاماتي كأم ومربية وكامرأة تواجه مجتمعًا ما زال يجيد قهر بناته وأبنائه وقمع الفردانية في أيٍّ منهنّ/م. ثم ّبحثي عن ملاذٍ في الكتابة التي كانت دومًا دوائي من كل نزف..ربما كان لا بدّ من تقنية التشظية في احترام لقارئ واعٍ يحيا معي ذاك التشظي وكلما لملم أطراف الحكايات خلقَ حكايتَه الجديدة..
– في بعض من نصوصك ما يحيل إلى التابو .. فهل هو تجاوز للخطوط الحمراء ..أم أن من طبيعة الكتابة تجاوز الألوان كي تؤسس لونها الخاص ؟
-كأنك في الشق الثاني من سؤالك أشرت إلى بعض الجواب. فالكتابة هي العالم الحرّ الذي لا ينتظر خطوطًا من خارج النص او الفكرة. وحده النص يحدّد تابوهاته برفض ابتذال لغة أو مشهد، ورفض إقحام ما ليس له مكان. أما التابوهات المعهودة فهي حدود في تفكير أصحابها ممّن اعتنقوا الخوف وأسّسوا رؤاهم على مجاملة الواقع.
شخصيًّا دفعت أثمانًا باهظة في حياتي كي أكون نفسي وكي أتجاوز كلَّ القوالب في دماغي ليحلق فكري حرًّا من برمجات الآخرين. وكانت وما زالت غايتي الأسمى هي ألا أخون فكري. والتابو الوحيد الذي ألتزم فيه هو ألا ابتذل حرفا لا تطرحه الحالة من ذاتها.
-كتاباتك قصص قصيرة؛ نصوص مفتوحة؛ ومقالات متعددة ومتنوعة؛ فأين تبني أنوار خيمتها وتستريح ؟
– كلّ كتابةٍ هي حالةٌ تتلبّسني، وتفرض ثوبها الأنسب لها. لكنّ قليلًا من التنبّه يكشف بعض أسرارها. فأما القصة القصيرة فمعشوقةٌ تبيح لي المراوغة والتخفّي، بسَكب الأفكار دون عُري البوح، سواء كانت أفكارًا أعتنقها أو حتى أرفضها لكنها تحكّ في ذهني مساحات السّؤال. في القصة متّسعٌ لتقول عالمًا كاملًا في صفحاتٍ قليلة، وتنسج من رؤاك شخوصًا تحمل أفكارها وأحاسيسها وترسم عوالمها. وأما المقالة فهي حوار بيني وبين القارئ (لا قارئ الأدب وحسب، إنما أيّ قارئ)، بما يتيح لي سكب أفكاري الذهنية ورؤاي العقلية ومواقفي من قضايا تلحّ عليّ وتحتلّ مكانًا في دماغي. لعلّ المقالة مساحة انسكاب عقلي ومساعيّ للحوار مع العالم وتوسيع مكانٍ لرؤاي.
وأما معشوقي الأكبر فهو النص المفتوح العصيّ على التبويب والتصنيف، القادر أن ينتسج بخيوط الشعر والنثر والفكر دون قوالب تحبسه، وإن كنتُ انتبهتُ أنني أكثرتُ من اعتناقه أسلوبًا أيام معاناتي الكبرى، حين كنت أقاوم سجنَ روحي وأسعى للتفلّت من قيود حياةٍ أنهكَتني وأدخلتني في كآباتٍ كادت تغلبني. كأني في سنوات السجن واللجّة لم أكتب إلا نصوصًا مفتوحةً، بل كأني كنت -بوعيٍ أو بغير وعي- أكثر حرصًا أن يبقى النصّ سبيلًا للحرية والتحرر حتى من قواعد فرضها ناقدٌ أو كاتبٌ أو قارئ.. ولعلّ في هذا ما يبرّر عدم عودتي إلى القصّة إلا بعد استقرار روحي الجديدة. وبين كل هذا ومواكبةً لأيّ السبُل تظلّ الشذرات والومضات والقصص القصيرة جدًّا رفيقة أيام الزحام الذي يسرقني فيه الوقت وأضطرّ لقول ذاتي في أقلّ الكلمات وأكثرها تكثيفًا.
– الغارق في كتاباتك السردية؛ يلاحظ حضورا منبها وملفتا لرائحة الموت .. فما القصة؟
– لعلّ السبب في ما أحياه كفلسطينيةٍ في إسرائيل، يذبحني مجتمعي المقموع من كلّ شيء، أو ربما ما عشتُ حين اخترتُ الحبّ ركيزةً لحياتي فنبتت له أسنانٌ تنهش، وأذرُعٌ تخنق، ودفعتُ ثمنه حياةً من سنوات عذابٍ ومعاناة، ولعلّها ما عرفتُ من معانٍ كثيرةٍ ومتعددةٍ للموت أفدح من مغادرة الروح للجسد.
أذكر أنّ صديقًا قرأ مخطوطة «رسائل خانها البريد»، فاقترح أن أسمّيها «حوار مع الموت المعلن»، كونها تحاور معاني الموت المطروحة بعين من أدرك معانيَ أخرى، فالموت ليس قبرًا وحسب، إنما حياةٌ تغيب منها الإرادة، أو تحتلّها العتمة، وروحٌ مهشّمة تختبئ في جسدٍ متجمّل، وصرخاتٌ مكبوحةٌ وأحلامٌ موءودةٌ وأفكارٌ مقموعة، والموت مجتمعٌ يصرّ أن يخنق أفراده باسم أخلاقٍ عارية من الأخلاق، ودينٌ يقتل الحياة باسم أخرى موعودةٍ أو متخيَّلة، ومشاهدُ تدّعي قيَمًا وترسّخ لنقيض معانيها، والموت ضحكةٌ ترتسم بين الشفاه وتغيب من العيون والقلوب، ضحكةٌ تشحّ بها روحٌ كبّلتها الأصفاد وعقلٌ مسكونٌ بالسؤال، سيّجوه بالقوالب كي يضيق، وقلبٌ كلما انفتح ليتنفّس أغرقوه بالكربون..
وإنّ من ذاقت كلّ تلك المعاني ورأتها في شخصها أو شخوص من حولها، لا ريب ستتجلّى في نصوصها.
في معظم كتاباتي التي حضرت فيها ثيمة الموت، تجسّدت إما حبيبًا غائبًا أبثّه أوجاعي (باعتبار اغتيال معاني الحبّ وجهًا آخر للموت)، وإمّا وطنًا مسلوبًا أحاول نفخ الروح فيه، وإمّا ماضيًا ما زال يصرّ الكثيرون على اعتناقه مهيمنًا ومسيطرًا يسلبنا الحاضر والمستقبل. وإمّا أناسًا يتحرّكون ويمارسون طقوسهم، متوهّمين أنهم أحياء، أراهم أمواتًا لأنهم افتقروا لمعاني الحياة الحقيقية. هي في كل الأحوال، محاولاتٌ لانتشال رغبةٍ بالحياة، وتمسّك بورقة التوت الأخيرة من فضح كل القيم التي آمنّا بها فقتلها المتوحشون ثم انتحلوا جثتها. ربما لهذا اقترنت عندي الكتابة عن الموت بوجهٍ آخر يمجّد الحبّ ويعتنقه قيمةً تتشبث بالإنسانية كيلا ننهزم.
– لنفترض أني فتحت نافذة ورشتك؛ فما الذي أجدك تنجزينه وتحبرينه للقارئ من جديدك؟
– لعلّي في عودةٍ إلى عوالم القصّة القصيرة من جديد. أعمل الآن على كتابة مجموعةٍ قصصيةٍ باتت ملامحها تتشكّل، إضافةً إلى تحضير كتاب مختاراتٍ من كتاباتي ينبغي أن يصدر قريبًا في بلدٍ عربيّ، كون كتابي الأول لم يوزَّع خارج فلسطين. وأظنّ أني في مرحلة غربلةٍ لإنتاجي القديم، الذي يحتوي كتبًا كاملةً لم أُصدرها ورقيًّا لانشغالاتي الخاصّة، لكن معظمها منشورٌ في الصحف والمجلات، وأفكّر في جمعه بين أغلفةٍ ورقيّة.
– من زاويتك كمبدعة كيف تقرئين المشهد الأدبي المحلي الراهن في فلسطين 48؟
– لعلّ مشهدنا الثقافيّ يشبه إلى حدّ كبيرٍ ما يجري في العالم العربيّ، فالمجانية في الألقاب والمنصّات تجعل كثيرًا من المبدعين ينأون بأنفسهم عن المشهد ليتصدّره متوسطو الموهبة أو أصحاب العلاقات . ثمة مبدعون ومبدعات حقيقيون يحفرون بصمتٍ مواهبهم غير باحثين عن الشهرة لكنهم يعززون مشروعهم بالمعرفة والثقافة والعمق كصالح حبيب وعلي قادري وعلاء مهنا ونمر سعدي وناريمان كروم وشيخة حليوي ونظام أيوب وغيرهم، بينما يحتكر المشهد ناشطون أبرز مواهبهم هي العلاقات. من جهة اخرى ما زلنا نشهد فجوةً بين النقد والكتابة، فكثيرٌ مما يُكتب لا يجد من يواكبه نقدًا حقيقيّا، في مشهد يكاد يغيب منه النقاد إلا القليل النادر. بالمقابل، نرى نورًا وأملًا في بعض المبادرات الأدبية التي تعمل بشكلٍ مبتكر وجديد، وتهدف للتلاحم مع المشهد المجتمعي بأبهى صورةٍ خاصةً تلك التي يقودها الشاعران علي مواسي وأسماء عزايزة، وما تقوم به الأديبة شيخة حليوي بمبادراتها للترجمة، ونسب حسين في أنشطتها المقدسية، ومؤسسة الأفق في مشاريعها التثقيفية. باختصار، اختلاط المشاهد كثيرٌ ووجود المواهب والطاقات بارز، لكنه ممتزج بما يسود من ثقافة شعبوية ومنتديات آخر ما يعنيها هو النص.
– وأخيرا ، بم تتهم أنوار الأنوار، أنوار الأنوار ؟
– أمارس الحياةَ بشغفٍ ومسؤوليةٍ، أعمل كثيرًا وأحيا أمومتي وبنوّتي، وعشقي للطبيعة والموسيقى والكتب، إضافةً إلى مزاجيّتي التي تغلبني أحيانًا. كلّ هذا يجعلني أقصّر في التواصل وفي الحوارات. أعترف أني مدينةٌ لك بتحيةٍ خاصّةٍ لصبرك الطويل على الحوار. خاصةً أنك واحدٌ من قلّةٍ قليلةٍ ممّن لم يخاصموني ويعتبروا الأمر إساءةً أو تجاهلًا حين تأخرتُ في الاستجابة إلى دعوةٍ للكتابة. فتحية لك ولكلّ من امتلك صبرك ليقرأ الحوار أيضًا.


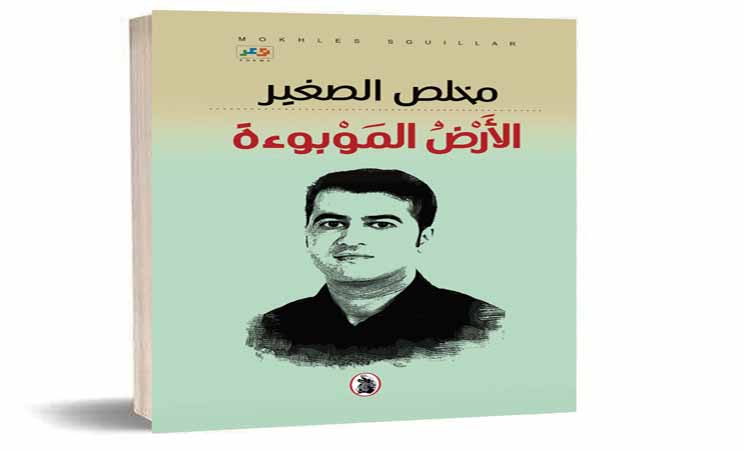



اترك تعليقاً