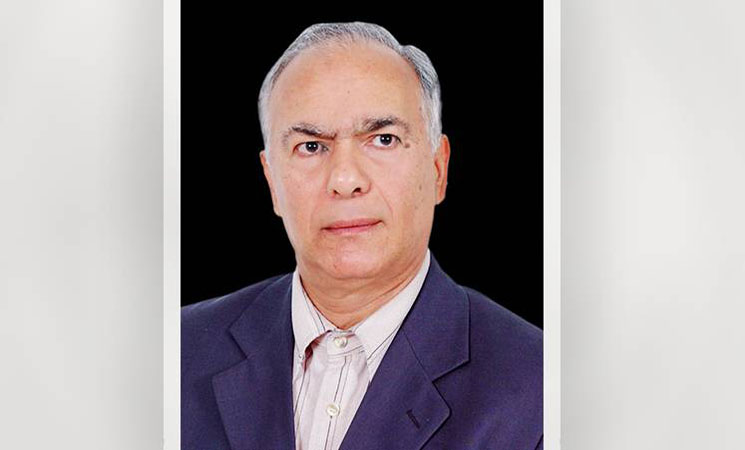من المؤكد أن الممارسة الاستحواذية على العالم، هي التجسيد المضاد للرؤية الحالمة واليوتوبية التي تتطلع ولو على سبيل الاستيهام إلى الإقامة في بيت مشترك، حميمي اسمه العالم. ولربما تكون فكرة فلاسفة الحداثة حول الإقامة فيه، تنطلق من فكرة تعميم الحق في تملك مشترك وعادل له، عبر الانفلات من ربقة الاغتراب بكل مستوياته،
فعلا، هذا هو العالم كما تقدمه الخريطة ذات الهندسة البيضاوية المثبتة أمامك، بمجموع قاراتها وقطبيها اللذين كانا من قبل متجمدين، وأيضا ببحارها التي يتخبط بعضها في الظلمات، فيما يحاول بعضها الآخر استشراف ضوء فجر، قد يطل أو لا يطل. وهي البحار ذاتها الغارقة في أسرار غرقاها. ثم كذا هو العالم ذاته المرسوم بعناية على الجدار المنتصب ببرودة أمامك، وقدا بدا مدثرا بغابات كثيفة من الأعلام المتدافعة بالمناكب كي لا يرى علم عداه. أعلام دول، و دويلات، وأشباه هذه وتلك، يحاول بعضها التهام البعض، تماما كما يحدث بين الحيتان التي مرت للتو بك في اتجاه البحار القريبة والبعيدة على السواء. لكن خارج هذا العالم، وفي أقل تقدير،على مقربة منه، ثمة مفهومه الرمزي، المدثر بغلالته اليوتوبية، المندسة بعناية فائقة في قلب الفضاءات المتعالية، حيث تنسحب مؤقتا حمى التضاد، ويحتجب جبروت المفارقات، كي يظل الباب مفتوحا أمام تمنيات الكائن بالانعتاق من ضراوة العالم الجغرافيا، الذي ليس بإمكاننا تجاهل وجوده، باعتباره جُماع فضاءات معلَّمةٍ بأسمائها ورموزها، مرسمة وموزعة بشكل تنظيمي عشوائي أو استبدادي، غير أن المفهوم الرمزي للعالم والذي يتداخل مع المفهوم الرمزي للشعر-الشعر مسكن الكائن- يظل على درجة كبيرة من الغموض حينما نخضعه لبعض الاستفسارات التي تبدو أحيانا على درجة كبيرة من السذاجة، خاصة حينما يتعلق الأمر بأبعاده الوظيفية. أي علاقة معناه ودلالته بأسئلة حياتنا ، ومن المؤكد أن طرحنا لهذه الأبعاد، ينطلق من واقع إلحاح الخطابات الحداثية على تكريس دلالة الألفة والحميمية مع هذا العالم، أي بوصفه معطىً من أجل إشباع كل متطلبات ذواتنا المادية والرمزية، بغاية تملكه، أو بالأحرى من منطلق الحق في تملكه، كما هو معبر عنه في الكثير من النصوص الإبداعية بمختلف توجهاتها، كل حسب منهجية رؤيته لذاته في علاقته بعالمه المحلوم به، والذي هو موضوع تملُّك آسر وماحِق في تعاليه وفي سوقيته، فما من ذات شعرية إلا وتسعى إلى التحرر من سلطة حدود تلزمها بالإقامة الجبرية، والمقننة في مكان مخصوص، والذي يمكن أن يكون على سبيل المثال وطنا مرفوضا وملعونا، أو مرغوبا فيه، تبعا لتوافر شروط الإقامة أو انتفائها، من أجل توسيع مساحة الإقامة التي يمكن اعتبارها خاصية أساسية، تترجم الذات عبرها رغبتها في الانفلات من قيد المعلوم، باتجاه مجهول متميز باتساع وانتشار أبعاده، خارج كل حدود ثابتة.
والمعلوم هنا، يحيل على فضاء منتجٍ للملل والرتابة، ولكل ما هو سكوني، لهذا السبب تحديدا، اعتُبِر السجن بمثابة تحجيم تعسفي ولا إنساني، لكل ما يمكن أن تتطلع إليه الذات من آفاق جديدة ومغايرة. وبالتالي فإن الإلقاء بالجسد في زنزانة ضيقة، وخانقة يعتبر أكبر إذلال لرغبات المتأصلة فيه، والتي تنزع بشكل طبيعي إلى توسيع حدود حركيتها وتفاعلها. كما أن الزنزانة المنفردة لا تختلف في شيء عن محبس كبير، يضم مئات الأجساد المعتقلة، حيث يتحقق شرط انتزاع الحق في القيام بالحد الأدنى من التحرك، في ظل انعدام الحيز الذي يمكن أن يسمح بذلك. هذا البعد الرمزي لشَلِّ إمكانية الحركة لدى الكائن، قد يشمل وطنا كاملا، يتسم بالاتساع الشاسع لجغرافيته، كلما أمسى طرفا مباشرا في التضييق على حركية الكائن، وفي حرمانه من حق التفاعل الحر والمتعدد الأبعاد، لذلك يمكن القول بأن فكرة حضور العالم، والحلم بتملكه في مختلف النصوص الإبداعية، يعكس رغبة الذات في الانعتاق من ربقة الحدود الثابتة التي ليس للجسد مغادرتها، رومانسية أو واقعية، أو حداثية، باعتبار أن الحركة ليست أحادية البعد، كما أن الوعي بها لا يكون أبدا أحاديا، وهو ما يجعل علاقة الذوات بالعالم مختلفة ومتباينة، وغير محددة، كما يضعنا أمام عوالم عدة، وليس أمام عالم واحد. مع التذكير بذلك التملك الرهيب للعالم والمضاد لأية نوستالجيا ذات بعد جمالي أو إنساني، وهو المتمثل في السيطرة العسكرية ذات الطابع الاستعماري المندرجة ضمن إطار الرغبة العمياء والهيمنية، في توسيع المساحة المستحوذ عليها، كي تستجيب شساعة مساحاتها لهوس الآفاق المتحركة، التي يحلم المستعمر ببسط يده النارية عليها، وهو بالمناسبة تملك متضمن لعدوانية جمع لا حدود لجشعه الهيمني.
ومن المؤكد أن الممارسة الاستحواذية على العالم، هي التجسيد المضاد للرؤية الحالمة واليوتوبية التي تتطلع ولوعلى سبيل الاستيهام إلى الإقامة في بيت مشترك، حميمي اسمه العالم. ولربما تكون فكرة فلاسفة الحداثة حول الإقامة فيه، تنطلق من فكرة تعميم الحق في تملك مشترك وعادل له، عبر الانفلات من ربقة الاغتراب بكل مستوياته، خاصة الهوياتي منه، أملا في التخلص من سلطة الحد المحَجِّم لحركية الكائن، بذريعة الإقامة في الوطن الأم، الذي ليس في الواقع سوى نوع من الإيهام بإسكانك في جنة مغلقة لا حق لك بمغادرتها إلى غيرها من الأوطان، وليست القوانين المنظمة لعلاقة الأفراد والجماعات بأوطانها، وبغيرها من الأوطان، سوى نوع من الممارسة الردعية الأنيقة، التي من شأنها تقييد حركية الكائن، كي يظل إيقاعه مراوحا في رقعة جغرافية، حيث كل مغادرة لهذه الرقعة تظل هي أيضا مشروطة بقوانينها. ولا شك أن مقولة قهر الاغتراب بأبعاده المتعددة في الفلسفة الحديثة، من خلال التوصل إلى إشاعة حالة ملتبسة من الألفة مع العالم، تظل بحاجة دائمة للنقاش، ما دامت هذه الألفة شبيهة في نسبة كبيرة من دلالتها بحجاب يحول دون رؤية ما يتوارى خلفه من حقائق صادمة. لأن تلافي بؤس الاغتراب ومأساويته، يعني أيضا تلافي مجموع الأسئلة النظرية العالقة به، حيث مهما تمكنا من رفع الحجاب، بغاية تحقيق الألفة، فإن تملكها لا يعدو أن يكون حدثا مؤقتا، باعتبار أن الألفة ليست في واقع الأمر سوى حل ظرفي وآني لإشكاليات محددة.
وكما هو معلوم، فإن الكائن لا يعيش أبد الدهر بذات الإشكاليات، سواء كانت منتمية إلى عالم الألفة الحالم، أو إلى عالم الاغتراب المتوحش، وذلك هو مصدر المكابدة البشرية التي تجد ذاتها باستمرار في مواجهة إشكاليات لا بداية لها ولا نهاية، قد تبدو ثابتة من حيث الظاهر للعين التبسيطية، إلا أنها من حيث الجوهر، دائمة التحول ودائمة التغير حيث تحتاج مواجهتها إلى نوع من الاستعداد للمخاطرة، وإلى نوع من القدرة على التحمل، وفضلا عن ذلك، إلى حضور نوع من الفضول الاستثنائي، الذي لا يتورع عن تحمل مشاق خوض مغامرة الاغتراب، بحثا عن حقائق العالم، عن ظواهره، وآفاقه المنسية في سماء السؤال. وبالتالي يمكن القول، إن تلافي الخوض في الاغتراب أمام حقائق الكون المعتمة والقاسية، وخاصة منها حقيقة مفهوم العالم، قد تؤدي إلى إغلاق أبواب كثير من الإشكاليات العلمية والفكرية والفلسفية، التي تظل مؤجلة باستمرار.
وتبعا لذلك فإن الرؤية المستقبلية تتمثل في ذلك العناد الذي يسكن الذوات المخاطرة بوجودها، من أجل فك أسرار مختلف مستويات الاغتراب، لأن الارتهان إلى حالة ألفة بعينها داخل فضاء استيهامي اسمه العالم المؤنسن، قد يدجن الذات، ويقلم حيوية عنادها. علما بأن التراكمات الحضارية، هي خلاصة اجتراحات تاريخية لسبب ثقافي ومعرفي، وأيضا وجودي، من أسباب الاغتراب، بما يجعل من الظرفية الاغترابية طاقة مولدة، ونواة منتجة، خاصة على المستوى الإبداعي، وأيضا رحما يعِد بتظهير وتوضيح ما كان من قبل غامضا،وملتبسا، ومؤثرا في إنتاج حالة الاغتراب الكوني. بهذا المعنى تكون المخاطرة بتفكيك مقولة العالم، بوصفه فضاء نموذجيا للألفة والحميمية، بمثابة هامش حياتي، له متعته وسلطته المستندة على جماليات قوانينه، والتي تقتضي تنمية وإغناء الخبرة الشخصية والذاتية والفكرية، إنها تلعب دورا أساسيا في تقوية ملكات مناوئة، تمتلك الذات بموجبها أبعادا استثنائية ونوعا من الممانعة، التي يساهم توظيفها في إشاعة طقس مضاد ومغاير من الحميمية المركبة مع إشكاليات العالم .
لذا، فإن الاغتراب في دروب العالم، سيظل حالة ملحة ومحتفظة براهنيتها المأساوية في المجتمعات التقليدية، حيث ما من إمكانية لعقد أي تصالح بين الخطابات الفكرية المسكونة بحرقة هذه الإشكاليات، وبين القطاعات العريضة، التي هي في غياب تام عن كل ما له علاقة بها، حيث يختلف الأمر بالنسبة للعوالم الحداثية التي تتقلص فيها عدوانية هذا الاغتراب، من خلال تصالح الذوات مع عوالمها،على ضوء وعيها بالتفاصيل الدنيا التي على أساسها تتشكل علاقتها بالعالم .