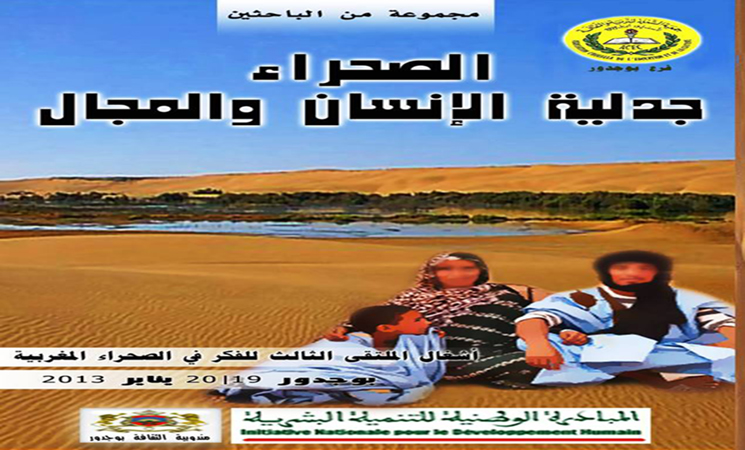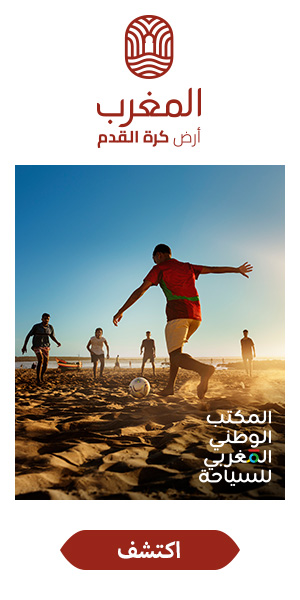ماهي العلاقة بين الكتابة والصحراء؟ وكيف تلازمتا منذ زمن بعيد؟ ألم تكن الكتابة مرتبطة بالصحراء، هل هناك حدود للكتابة في الصحراء أم لا حدود لها مثل كثبان الرمال؟ وأيهما أقرب إلى ثقافة الصحراء: الكتابة أم الشفاهية؟
إنها تساؤلات عميقة تنبعث ونحن نتأمل المتون والمؤلفات التي اتخذت من الصحراء تيمة لها. فلقد شكلت الصحراء دوما فضاء غنيا بامتياز وباعثا على الإبداع والتدوين. بإرثها التاريخي العميق ،وبتنوع تضاريسها، وغنى مواردها الطبيعية التي تجمع البحر والبر في التحام وتناسق جميلين ،كما شكلت ملتقى للحضارات المتعاقبة على المغرب ، لذلك نبغ منها شعراء عديدون ومفكرون كانوا من رموز زمانهم ، ومثقفون ألفوا وأنتجوا كتبا ما يزال بعضها رهين خزانة المخطوطات ينتظر التنقيح وإخراجه من ركام الأتربة ليستفيد منه الأحفاد بعدما أنتجه الأجداد منذ زمن غابر
يعتبر هذا الكتاب الإصدار الثالث من نوعه في منشورات جمعية الشعلة للتربية والثقافة فرع بوجدور وهو حصيلة لأشغال الملتقى الثالث للفكر في الصحراء المغربية الذي نظم يومي 19/20 يناير 2013 ببوجدور .
وقد توزع الكتاب الذي يمتد على 360 صفحة على خمسة محاور أهمها:
المحور الأول :وهو الوحدة الترابية الراهن والآفاق لمحمد اليازغي قدم فيه رصدا كرونولوجيا لمسار قضية الصحراء منذ استقلال المغرب، وتصورات لتجاوز المأزق الحالي والذي حدده في تنزيل مشروع الجهوية الموسعة.
المحو ر الثاني:الصحراء:حقوق الإنسان وتدبير المجال وتضمن أربع مداخلات:
الأولى :حفظ الذاكرة في تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب من التوصيات إلى الأجرأة لمحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أبرز فيها قيمة الذاكرة كعنصر محوري في كل تجارب العدالة الانتقالية الدولية نظرا للطابع الرمزي الكبير الذي تحمله في مسلسل المصالحة داخل أي بلد.كما رصد وبشكل تسلسلي مسارها في المغرب انطلاقا من عمل هيئة الإنصاف والمصالحة التي عملت على إعداد قراءة مشتركة تساعد على امتلاك مفاتيح فهم ما جرى من انتهاكات واختلالات و خروقات، مبرزا عنايتها بالأرشيف الوطني، وميدان البحث العلمي.كما جرد خلاصات تفعيل توصيات هيئة الإنصاف في مجال حفظ الذاكرة خاصة في مجالات الأرشيف و ذاكرة مراكز الاعتقال السري ،وتهيئة وبناء المدافن وفي مجال التاريخ مختتما بجرد أبرز التحديات والمكتسبات المحققة وبعض الإكراهات الراهنة مقترحا توصيات التي يجب الاشتغال عليها مستقبلا.
الثانية :بطاقة تقنية لشريط : ” رواد المجهول ” ذ عبد المالك ليدربي وهو فيلم وثائقي يؤرخ لمرحلة زمن الجمر والرصاص ، أنجزته جمعية الشعلة للتربية و الثقافة- فرع طانطان في إطار برامج جبر الضرر الجماعي الذي يشرف عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقد جسد هذا الفيلم معاناة المعتقلين الذين قضوا أزيد من 16 سنة من الاعتقال التعسفي في معتقلات سرية بكل من أكدز وقلعة مكونة حيث حكى المعتقلون الفظاعات التي تعرضوا لها والتعذيب الجسدي والنفسي الذي كانوا يلاقونه من طرف المشرفين على هذه المعتقلات .
الثالثة:الحقوق الثقافية في الصحراء:بين واقع الاعتراف و آفاق المساواة لعبد الله الحيرش أبرز فيه أهمية العمل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. كما توقف عند التنوع الثقافي الصحراوي الحساني في أفق المساواة بين المكونات الثقافية الوطنية ،مسلطا الضوء على ما تعانيه الثقافة الحسانية من تهميش و من طمس لبعض مكوناتها الهامة.
الرابعة :أي تدبير للمجال الترابي بالصحراء؟ لسعيد ولد مولود بوشاك وحيث توقف عند دراسة المجال الترابي التي تعتبر مدخلا أساسيا وجوهريا للتنظيم والضبط والبناء المؤسساتي والهيكلي داخل الدولة. كما قدم تقييما وحصيلة للسياسات العمومية بالصحراء على ضوء سياسة إعداد التراب الوطني ؟ ولتدبير المجال الترابي بالصحراء ورهاناته التنموية من منظور التدبير الجهوي ومستلزمات التنمية الترابية.
المحور الثالث :انثروبولوجيا الصحراء :المقدس والقبيلة وتضمن خمسة أبحاث:
الأول :الرحلة إلى الصحراء : الواقع و المثال. لإدريس الناقوري عبر قراءة أناسية/ إنتربولوجية لنماذج من الرحلات التي قام بها أصحابها إلى الصحراء خاصة رحلة الشيخ سيدي أحمد لعروسي .
الثاني :الساقية الحمراء: أرض الأولياء لرحال بوبريك، مدير مركز الدراسات الصحراوية تناول فيه البعد التاريخي و الميثولوجي للساقية الحمراء مبرزا مكانتها وإشعاعها الذي تجاوز حدود المغرب ليصدع في أرجاء شمال إفريقيا حتى تونس كأصل للأولياء الذين تملأ أضرحتهم هذا المجال. فمنطقة الساقية الحمراء يؤكد الباحث لا تنحصر في حدود مجرى الوادي، بل هي تشمل مجالا يتجاوز حوض وادي الساقية الحمراء إلى مناطق شمالا و جنوبا أبعد من ذلك قد تصل مئات الكيلومترات .
د عبد الرحيم العطري في بحثه *من القبيلة إلى الدولة عُسْر القطيعة أو الانتقال المعاق في المجتمع المغربي* حاول أن يجيب عن تساؤلات عميقة مثل :هل الدولة الحديثة التي تعلن أنها جاءت لتكسير الأساس العرقي القبلي و استبداله بالأساس الترابي الإداري المواطناتي، هل تمكنت من بلوغ هذا المقصد؟ هل أسست فعلا لخيار الولاء للوطن بدل الولاء للقبيلة؟ أم أنها أسهمت بقسط وافر، عن طريق ممارساتها و تدخلاتها، في إعادة تشكيل البنيات و التصورات القبلية، وفق ما تؤطره و تدعمه الخطاطة التالية: “مؤسسات عصرية بممارسات وتمثلات تقليدية”؟ فهل ما زالت القبيلة حاضرة كإطار اقتصادي و سياسي؟ أم أنها توجد فقط كتصور و كسلطة رمزية تحدد السلوكات و الانتماءات؟
و إلى أي حد يبدو هذا “الانتقال” المشار إليه في العنوان ممكنا؟ فهل تأتى هذا الانتقال، في المجتمع المغربي،من سجل القبيلة إلى سجل الدولة؟ و هل تحقق فعلا هذا الانتقال في مستوى التصورات و التمثلات الفردية و الجمعية؟ أم أن “عُسْر الانتقال” يجعل من الدولة الحديثة مجرد قبيلة في “نسخة مزيدة وغير منقحة”؟