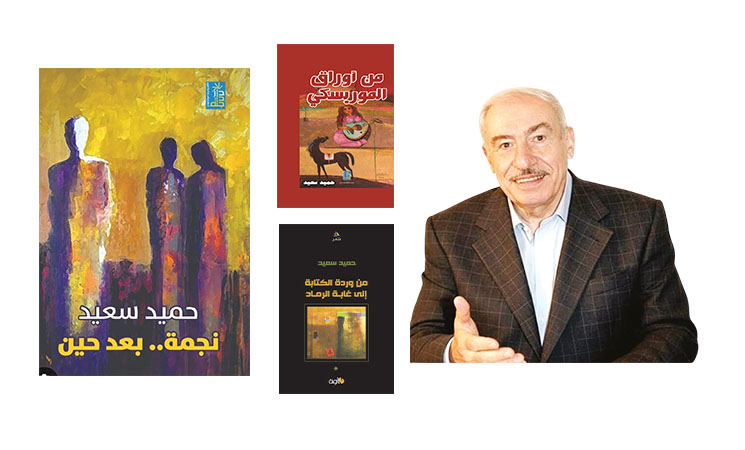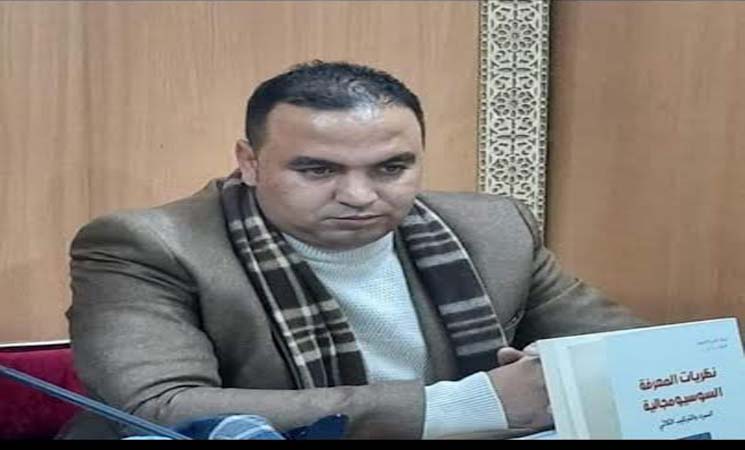تُعدّ الكتابة في رواية «كرمة الصبار»* للروائي المغربي محمد عناني، بحثاحثيتا عن جواهر الموجودات، وغوصاعسيرانحو مخبوءات النّفس البشرية، وتشريحا دؤوبا ومتواصلا للذات بمقصدية تشي بالرغبة في إدراك علاقات الذات الشقية بما يحيط بها وبالرغبة في تبرير وجودها، وفهم حدود تفاعلها مع الفضاءات والأمكنة والأحداث والذاكرة،جاعلة من فعلِاسترجاعِ الذاكرة ممارسةًتتجاوز تأّمل الماضي وتذكّره بحياد، لتنشغل بتفكيكه وإعادة تشكيله، في ضوء الحوار المستمر بين الحاضر والماضيوفقا للتصور الباختيني، كما أنها ممارسة تنتج من خلال استعادة التاريخ والذاكرة والماضيعملا إبداعيا مكتملا، إذ أن الماضي لا يُروى كما حدث، بل كما نحتاج إلى فهمه، وفقا للتصور النيتشوي.
كما تعد الكتابة فيهذه الرواية، وفي بعض أعماله الأخرى ومن أبرزها رواية «الهضبة»، انشغالا بأسئلة وجودية وفلسفية تعكس رؤية مختلفة نابعة من اهتمام الكاتب بالفلسفة قراءة وتدريسا،وفي سيرورة السرد تنتعش الأسئلة وتتوالد من رحم السؤال الكبيرالمقيم في فِكر السّارد، وهو «ما السر؟»، ذلك السّر الذي يحنّ إلى سرّه مولّداالمزيد من الأحداث، فتنمو على نبضهالذي يُجلّل بغموضه أمكنة الرواية وفضاءاتها وأحداثها وشخصياتها، فكما يقول: «كان جدي سرا، وكان الله سرا، وكان العالم سرا، وكنت أنا أغرب الأسرار».
في مدخل فضاءات الرواية التي تكتنفها الأسرار، تنتصب كرمة الصبار «فريدة شامخة وراسخة في مكانها»، قديمة قدم الذاكرة ومتجددة بتجدد تفاصيلها وفصولها، ومن مكانها المزمن، الملتبس بالخيال، ولسبب تجهله الذات الساردة «كانت تنبعث في نفسي أسئلة تتعلق بوجودي لا بوجودها، وفي أوقات القيلولة كما في عزّ الليل كانت توحي لي بالزمن … وكنت أركز قلبي وجوارحي وأنا أنظر إليها، ربما كنت أكلّمها في بعض الأوقات … ولم تكن تبخل بالرد»، تتحول الكرمة من شجرة عادية تنمو وتموت، إلى عنصر طبيعي يتحدى الزمن، وينقل الحكمة عبر امتداده، وفضاء متكامل يُتخذّ محرابالتأمل عناصر الوجود، وركنا ركينا يُحتمى بظله من هجير الحياة عندما تكفهر سنينها، وبالصورة الممزوجة بالجلال التي رسمت للكرمة،تنظر الذات الساردة إلى بقية فضاءات الحكي كلها تقريبا، متجاوزة التحقق المادي السطحي الذي يقف عنده الآخرون، لتراها من موقعها المتأمل ذاك مختلفة «حتى تصير ألغازه (الكون) أليفة لدينا، لأنها منا، ولأن على الله أن يتولى البقية» كما يقول السارد.
تشكلت الشخصياتبالعمق نفسه الذي أسس فضاءات السرد، وتميزت شخصية الجدبوصفها الأبرز بينهابوصفها شخصية تستعير بعض صفات الكرمة، لتتشكلعظيمة، متصالحة تماما مع هويتها، محاطة بالتقديس والإجلال، حانية يُهرَع إليها في لحظات الشدّة والقنوط، خالدة تتمرد حتى على تدابير الموت والنسيان، فهي كما يقدمها: «صورته (الجد) المنبثقة من غبار الأيام، وصوته المفعم بحنين عارم وغامض وهو يعلو منشدا ومهللا بذكر الله»، وقد أثرت شخصية الجد بشكل كبير في السارد، فعوّضت غياب الأب، وأكملت ما نقص في وجود بقية الشخصيات، بل كانت مدخله الأول والأخير نحو العوالم الروحية، الموازية للعالم المشهود. وبتشعّب أحداث الروايةيتم استدعاءشخصيات متعدّدة أبرزها الأمّ، الأب، أولاد الخطابية، الشيخ، مواقف السلطان المغربي، قصص النصارى مع المسلمين سامي، سلمى… إلخ، وكلها شخصيات تُنشيء إلى جانب قصة السارد بوصفها الحكاية المؤطرة، حكايات متضمنة، ويمتزج في تشكيلها التخييلي بالواقعي.
يمارس السارد من خلال فعل الحكي ترتيبا لأجزاء من ذاكرته القريبة والبعيدة، تلك الذاكرة التي «لا تسعى إلى توثيق الماضي بل إلى إنقاذه من النسيان عبر السّرد الذي يمنحه حياة جديدة» كما يرى فالتر بنيامين. ومن حيث ينطلق فيها الحكي يبدو الزمن المؤطرلما يُروى شاسعا جدا، يعود إلى خمسين سنة في بعض المقاطع ويغوص إلى أبعد من ذلك بكثير في مقاطع أخرى دون أن يفرّط في لحظة الحكي بوصفها البؤرة التي تلملم شتات تلك الأجزاء، وكأنّه باستعادة الزمن الماضي يحاول إعادة إدراك زمنه الحاضر، زمن يمتزج فيه لواقعي والخيالي، والديني بالدنيوي، والسامي بالمدنس.
في سياق الحكي، تبرزقدرة الرؤى على تفسير المستقبل، وتحديد ملامحه بوصفها معطى ثابتا في تأويل الواقع، وتبرز أيضا بوصفها آلية لاستدعاء شخصيات مؤثّرة في مسار الحكي،فبعد الرؤيا التي شغلت بل السارد لسنين، يُطلب التأويل لأن «ما يوحي به الحلم من جزم لا يمكن نفيه، كما لا يمكن الاكتفاء بما يوحى به، بل لابد من العبور إلى المجاهيل البعيدة، إلى ما وراء الصور والأفكار»، وفي مرحلة تأويلالرؤيا التي حلم فيها السارد أنه رأى الإله يزورهم في بيتهم ويحنو على أمه، يعثر بالصدفة، أو بمكر الأقدار ومعاونتهاعلى «شيخ ضليع في أمور النفس، وما يتصل بها من أحلام وأوهام تتخذ شكل وقائع» كما يصفه، يأتي اللقاء به متأخرا بأربعين سنة عن حادثة الرؤيا الكبيرة، لكنه مع ذلك لا يفك غموض تلك الرؤيا، ولم يستطع حضوره المجلّل بالغموض أن يقدم له شيئا كبيرا باستثناء إعادة توجيهه إلى البحث في الأصول، أصوله وأصول عائلته،ومجتمعه عن الأجوبة التي يسعى خلفها في السحاب.
تقدّم الرواية في الجانب المعرفي منها، شهادات عن نمط الحياة في فترات ماضية من تاريخ المغرب، مستغلة تقنية الوصف على جانب السرد، لعرض أنماط عيش البدو المغاربة في نهايات القرن ما قبل الماضي وبدايات القرن المنصرم، وتتخذ من صوت الجدّ وسيلة لتحقيق ذلك الوصف، حيث تُبرز قصته مع زوجته مليكة، جوانب من حياة المغاربة زمن السيبة حيث عاشوا تحت رحمة القواد ومعاونيهم، وبما ميزها أيضا من تماسك القبيلة والجماعة والعائلة لحماية المثل العليا، وصولا إلى فترة الحماية حيث ستبدأ ملامح التغير العميق تظهر على المجتمع المغربي مع مستعمر جاء رافعا شعار «لقد تغير العالم وأنتم أنتم لم تتغيروا … وغننا سنفعل باسم الجمهورية الفرنسية كل ما في وسعنا كي نلحقكم بركب الحضارة وننقذكم من الجهل والتخلف»، ووصولا أيضا إلى انطلاق شرارة المقاومة الشعبية لهذا الخطاب الكولونيالي المرفوض شعبيا، كما يروي السارد : «بعد أيام، ومن أرض العلوة انطلقت حركة الكوفة من اجل هدف واحد وحيد، القضاء على المقاومة الشجاعة لقبائل خريبكة ووادي زم وأبي الجعد وتادلة … واتجهت صوب الجبال الخالدة»، وابتدأ مع تلك المقومة الفطرية لمخططات طمس الهوية المغربية «وابتدأ تاريخ آخر لا عهد لسكان الجبال الخالدة به … واستمر فيما بعد واستمر بعد ان مضت فرنسا لحال سبيلها».
يولد الوطن من جديد بعد تحريره، وتولد معه ذات السارد من جديد، بعد أن عبرت مراحل التحول العسيرة، وتنتقل أثناء ذلك العائلة إلى منطقة «الميلس» نواحي سطات، بعد أن فقدت جزءا من ممتلكاتها لصالح الفرنسيين، وهناك سيستبدل السارد حبه القديم لأرضهم القديمة بحب جديد لأرض العلوة التي يقول فيها: «أحببتها كما يحب الرضيع ثدي مرضعته، وكما يحب الشاعر العذراء التي هام بها فمنحها قلبه وشعره»، حبا كبيرا سيجعله يتقبلها في حالاتها كلها، وصولا إلى حب نقائصها ومظاهر الانحراف فيها، إذ يقول «أحببت مجانينها، كم كان مجانين العلوة يضفون عليها من جمال»
يموت الجد، موتا مختلفا عن الذي كان يحلم به، هو الذي كان يحلم بالموت في معركة من المعارك «لكن مشيئة الله قضت أن يمتد به العمر، وأن يخرج من جميع المعارك التي خاضها منتصرا أو أسيرا …» لكن حيا يرزق في الأحوال جميعها، ويخلف موته فراغا كبيرا في حياة السارد الذي ينعيه قائلا: «عشت سعيدا بوجود جدي، بإيحاءاته ومجازاته، كان العالم في عرفه استعارة ومجازا»، وفي موته يبرز اثر الرحيل على الأحياء، ذلك الحدث الذي يفكك الذوات ويعيد تركيبها.
تحتفي «كرمة الصبار» بالرحيل احتفالا رمزيا، ولو أن أحداثها ركّزت على لحظات اللقاء، والولادة، والآن والهنا، إلا أن أغلب الأحداث كان المحرك الأول لها هو رحيل عزيز ما، أو الرغبة في تجنب رحيله، أو عودته بعد غياب طويل، ويستمر تأثير فعل الرحيل على الأحداث والشخصيات وصولا إلى تجسده البليغ في النهاية حين ترحل الذات الساردة ويخفت الوميض الذي يربطها بوهج الحياة، وتتلاشى، لتخلد حكايتها، ومن العجيب أن تفطن تلك الذات في الأنفاس الأخيرة من سردها المشبع بالتفاصيلوالمليء بالأحداث الكثيرة، إلى أن «الجهد الّذي يبدله الإنسان في نسج الحكايات ورسم اللوحات وتأليف الألحان … كل هذا إنّما يحدث بسبب وعيه الشقي: وشك الرحيل … إنّ الحياة حكاية … إنّها هكذا … ابتدأت برجّة معرفة، ولم تكن هذه المعرفة في كنهها إلا سقوطا».
على سبيل الرحيل
تعدّ الكتابة، في رواية «كرمة الصبار»-قبل كل ما سبق ذكره-التزاما بتنفيذ وصية قديمة، «عندما يأتي الحصاد(…) أكتب بعد أن تسلك سبلا وشعابا وتقطع الأودية السلع حتى إذا بلغت التخوم القصوى وترى ما لا يراه غيرك عندها خذ القلم واكتب فما في العالم غير الكلمات»، كما يقول السارد.
* كرمة الصبار، محمد عناني، عن دار أبي رقراق للنشر، ط1.