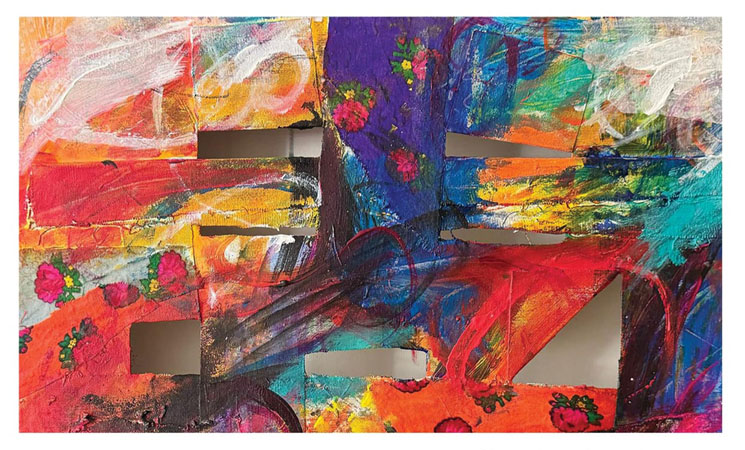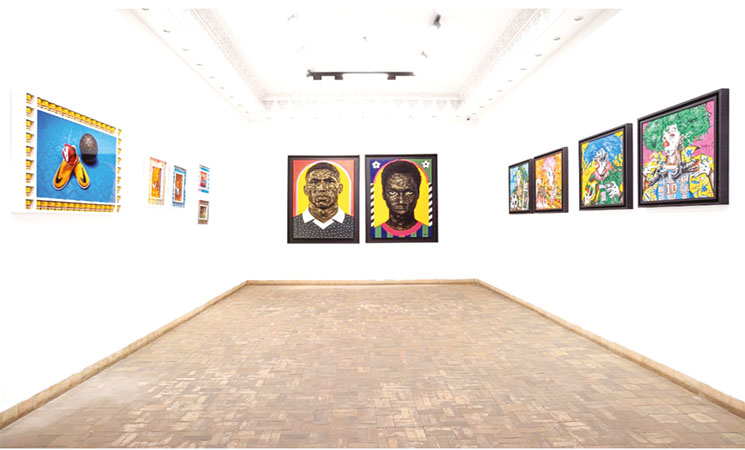جاءت مسرحية المركبة في سياق الاحتفاء باليوم الأممي للمرأة لتنعش ذاكرة المتلقين-الجمهور وتوكد لهم بأن طعم الحدث لم يتغير رغم مرور الأعوام؛ مرارة الحدث لم يغيرها ولم ينقص حدتها الجوري الذي يتصدر قائمة الهدايا التي تقدم للبعض من النساء هذا اليوم-الذكرى: ثامن مارس من كل سنة. المركبة عرض مسرحي تراجيدي بامتياز، لكن لماذا الاحتفاء بمأساة إنسانية بصيغة هي أكثر مأساوية؟؟ لا حيز فيها للفرح؛ وإن كان عايش (الفنان محمد اللوزيني) يقذف، بين الفينة والأخرى، في وجوهنا نحن المتفرجين ببعض العبارات من صلب تساؤلاته الذاتية بشكل ساخر يقحم به المتفرج في العرض وحثه على تحمل مسؤولية واقع القهر المعيش.
بأسلوب حواري دراماتيكي تنقلنا المركبة إلى كوكب غريب في زمن أكثر غرابة.. هي رحلة من الذات إلى خارجها المشترك الذي تجسده علاقة عايش بعايشة (الفنانة نسيمة عنان) والمقصود هنا هو علاقة الرجل بالمرأة من خلال ما ينقله حوار مشحون باللوم الذي توجهه عايشة لعايش. لوم تجرد به عايشة تاريخ الخضوع والخنوع لذكورة منفلتة من عقال الرجل-عايش، فنحن نسمعه يعلق على ذلك مستفهما :
– «هيه .. هيه ومالي أنا ؟ ماشي راجل؟ ثم يلتفت جهة المشاهدين ويضيف : وأنا شكون؟؟»
يستنكر عايش يقينا بشك؛ فهل يعمل على استبدال الواقع الفعلي بآخر بقوة الإنكار والسخرية. لكن عايشة تقطع أوصال الإنكار بتذكيره بلحظات تضييقه على حريتها؛ فما يلبت يرد عليها بنبرة تصور بوضوح هذا الانفصام التراجيدي :
– «ومعايا شحال خرجتي وتساريتي و…»
– «بغيت نكون مستقلة ونتنفس الحرية»
– «إيه ولكن أنا راجل وكنغير»
إذا كان هذا المقتطف من الحوار يقربنا من تاريخ الخضوع والخنوع الضاربة جذوره في وحل الفصام الثاوي في عقلية كل فرد موزع بين ذكورة التقليدانية المقيتة ورجولة الحداثة الزائفة أو المزيفة؛ فإن السفر الذي تمنحنا إياه المركبة الفضائية في بعده الرمزي ليزيح النقاب عن الواقع المأزوم للعلآقة بين الرجل والمرأة، علاقة صدئة بانحباسها في بؤرة السؤال الوجودي-الأبدي : من بيده الأمر من قبل (عندما كان عايش وعايشة في كوكب الأرض) ومن بعد (زمن تواجد عايش وعايشة في كوكب آخر)؟
من بيده الأمر؟ سؤال يقاربه النص المسرحي بصيغة أكثر مرارة حينما ينقلب الأمر على صاحبه؛ فأمام إصرار عايش على العودة إلى الأرض يتجذر رفض عايشة ليحسم الأمر بينهما فيما بعد بالطريقة التي قلت عنها سابقا بأنها أكثر مرارة لأنها ستزيد الطين بلة في مسار تلك العلاقة، إنه ما يطلق عليه مصطفى حجازي في مؤلفه «سيكولوجية التخلف/الانسان المقهور» مسلكيات التماهي؛ أي تماهي المتسلط عليه بالمتسلط. فالجمهور يشاهد عايشة التي تشكو ‹عيشة› القهر والاستلاب تكيد كيدا بعايش عندما تسحبه وهو في غفلة من أمره(عايش في حالة سكر ولا يدري عن حاله شيئا) وتنزل به في كوكب لا يدري كلاهما عن أمره أي شيء.
ويستفيق عايش مستغربا مصيره، ويستفيق معه الجمهور على صدى صوت عايشة تختلط فيه نبرة متحسرة بنبرة آمرة:
– «شحال قاسيت معاك… ودابا بغيت نكون حرة… اعطيني ساروت الحكام»
هل هو صدى الرغبة الفعلية في التحرر والانعتاق من قيود العبودية والسلط التحكمية أم هو صدى رغبة جامحة في الانتقام ورد الاعتبار الموؤود؟؟؟
لا هذا ولا ذاك، عندما يظهر أن الخيط الناظم لمجريات الأحداث متأصل في يد أخرى لا تمت للإرادة البشرية بصلة.. يد الشيطان (الفنان هشام شوكي). هو «الزار» الذي يسير بالأحداث نحو التحقق وفق مشيئته مستخدما سلاحه الأبدي والفتاك : الوسوسة. ونحن لا ننسى هنا ان الكينونة الإنسانية السائرة إلى العدم تتكشف فقط ببعدها التاريخي بالمعنى الذي يؤكده الفيلسوف هيدغر من خلال اشارته الى ارتباط الحقيقة بالتاريخ ومن تم كون الحقيقة هي الأثر الذي يخلفه الفعل البشري على روزنامة الوجود؛ لكل حقيقة نواة زمانية. لهذا يصبح حضور الشيطان مؤشرا على عجز كل من عايش وعايشة عن الإمساك بالحقيقة البدئية، ويصبح السؤال الجوهري لكل يوم وليس فقط لذكرى ما عبر هو : متى بدأ القهر والاستلاب؟
لعل بعث هذا الحاضر -المتخفي في مسرحية المركبة وجعله يركح في كل ارجاء خشبة المسرح لم يكن لملء ثمة فراغ؛ بل اني اعتقد ان الأمر ليسحب المتفرجين خارج ذواتهم وحيث تندحر على مرأى منهم الثنائية الازلية ذكر/انثى فيتكونن الجمع المتعدد واحدا لا ثاني له، صوت من كل زوايا الوجود هو الذي يدب في سراديب البشر مسوغا لهم كل ابجديات الفعل تارة باسم المجتمع وتارة باسم المعتقد، وفي كل حين يمنحهم مسمى ما كان في الحسبان، فكم جميل هو هذا التصوير على خشبة المسرح، وكم هو بشع على ارض الواقع اضطهاد الانسان للإنسان امتثالا لوسوسة / صوت ذاك «الزار» بمسميات شتى:
– هيه، راك انت الراجل…
– وانت، وا المراة…
في واقع معيش موسوم بالتشظي بين ما هو كائن وماينبغي أن يكون :
-وا عايشة يالاه نرجعو لارضنا…وترجعي كيف كنتي…
-لا… بغيت نكون حرة…
يتكشف عايش وكذلك عايشة أمام نفسهما فيتبدى لهما عجزهما أمام وجود لامتناه يسير فيه كل منهما صوب نهايته، فلا يجدان من بد سوى العود الابدي إلى الذات-إلى داخلها والسكن معا في صوت واحد لا جنس له في انتظار أن يسدل الوجود الستارة على كل مسرحية لا يتملك فيها الممثلون جرأة القول..
وفجأة تنير المصابيح المكان ويتكونن كل من عايش وعايشة صوتا لا تفاوت فيه بين نبرتين من جنس أزلي:
نحن الانسان… نحن من سيملأ فراغات الروح ونصنع حيزا من الوقت للقادمين.
«المركبة» تمثيل خارج التوقيت..

الكاتب : فاطمة حلمي
بتاريخ : 18/03/2023