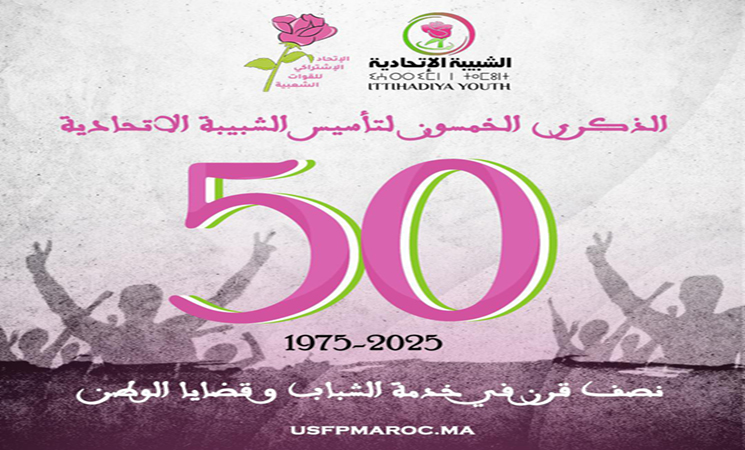أسوأ ما حدث لمصر كان ثورة الضباط الأحرار
عملي الحقوقي كان بدافع إحراج الدولة للوفاء بالتزاماتها الدولية
شكل اللقاء التقديمي لكتاب “علي أومليل سيرة وحوار”، لحظة لاستعادة الذاكرة الثقافية والسياسية لمغرب ما قبل الاستقلال ومغرب اللحظات الحاسمة بين مسار البناء الديمقراطي واستشكالاته التي طرحتها أنذاك مسألة تنازع الشرعيات والتي كانت سببا في تعطيل هذا المسارات لعقود، قبل تصحيح المسار في نهاية التسعينات. استعادة تروم التفكيك من أجل البناء الذي يأخذ بعين الاعتبار أسئلة الراهن الوطني والدولي واشتراطاته.
أعاد المفكر والسفير السابق والحقوقي علي أومليل، لحظة تقديم كتابه، الحضور إلى فورة وحماسة النضال الذي عاشه وجيلَه في مراحل حاسمة من تاريخ المغرب السياسي، عاش فيها شخصيا لحظات انتقال مفصلية أهمها العبور من الحماية إلى الاستقلال، معتبرا أن 80 بالمائة من المغاربة لم يعيشوا هذا الحدث وبالتالي لن يختبروا هذا الشعور، لكنه توقف عند هذه الفترة الانتقالية بشيء من الأسى وهو يستحضر كيف لم تستثمر تلك اللحظة في بناء مغرب جديد، وهي اللحظة التي أشار إلى أنها اتسمت بصراع الشرعيات: الشرعية الملكية وهي تاريخية ووطنية وشرعية الحركة الوطنية التي دعمت الملكية، ثم شرعية ثالثة خرجت من رحم هذه الحركة وتتعلق بشرعية المقاومة التي وجدت نفسها خارج معادلة البناء هاته، فتحولت إلى معارضة راديكالية “اتجهت إلى بناء حزب جديد يستوعب أحلامها وأحلام شعب خاب أمله في الاستقلال”. واعتبر أومليل أن هذا الصراع هو ما ضيع على المغرب سنوات طوال من البناء لسببين أوجزهما في: المغامرة الانقلابية من جهة وانغلاق النظام على ذاته من جهة أخرى. وبين السببين، ضاعت النخبة إلى أن تم تصحيح المسار في أواخر التسعينات مع حكومة التناوب التوافقي.
أما عن تجربته في المشرق العربي، وخاصة بمصر ، فقد اعتبر في تصريح مثير عن مفكر ارتبط وجدانيا وفكريا بحضارتها ورموز ثقافتها، أن “من سوء حظ مصر أن ثورة الضباط حدثت بها، ولو لم تقع، لكان مستقبل مصر أفضل بكثير”. شهادة لم تأت محض صدفة أو تحليل عابر بل من عين متابعة وقريبة من مطبخ الأحداث حينها، وهو يشاهد كيف “ترسخ حكم استبدادي تسنده صورة الأسطورة، حكم منع الأحزاب وصنع الحزب والوحيد والإعلام التابع وحوّل الجامعات الى ملحقات للمخابرات”، لكنه هادن “جماعة الإخوان” التي خرج من رحمها، ورهن المعادلة السياسية بمصر إلى اليوم بين هاتين القوتين “العسكر والإخوان”.
حقوقيا،اعترف المفكر أومليل بأن التوجه إلى البوابة الحقوقية عبر تأسيس الجمعية المغربية الحقوق الإنسان وبعدها المنظمة المغربية، تم بعد أن “ضاق أفق العمل السياسي، ولتقوية جبهة هذا الأخير في الترافع حول مسألة حقوق الإنسان والحريات”، لكن الدافع الأساسي برأيه كان هو “إحراج الدولة التي توقع على العهود والمواثيق الدولية دون أجرأتها”، وبالتالي، يقول، “ناضلنا لنرفع السياسة الى مستوى حقوق الإنسان “.
في تقديمه للكتاب/ الحوار، عاد حسن طارق، السفير السابق ورئيس مؤسسة الوسيط إلى بدايات تشكل الوعي السياسي والثقافي للطفل علي أومليل الذي عبر في الزمن البيولوجي، وهو في 14 من عمره، ” المسافة الملتبسة بين الطفولة والشباب، لكنه في الزمن السياسي كان طفلا شرعيا مكتملا للحركة الوطنية ليس فقط كخريج إحدى مدرارسها الحرة لكنه، وهذا هو الأهم، خريج زمنها الثقافي والسياسي” وهما معا شكلا الزمن التأسيسي الذي “سيطبع المفكر والمثقف والسياسي علي أومليل طيلة مساراته المتقاطعة وحيواته المتعددة
بدوره استحضر حسن طارق حضور الشرق العربي في سيرة الرجل بكل ما يمثله من أفق ثقافي وحضاري وقيمي “في المسار الشخصي للطفل / الشاب، وفي الأفق العام للمرحلة بشروطها الثقافية والسياسية والرمزية”
اللقاء بالشرق العربي والحركة الوطنية سيتعزز بعد ذلك باللقاء مع الغرب، غرب الحداثة والأنوار وحقوق الإنسان والفلسفة
لحظة الوعي الكتابي شكلت أيضا محطة فارقة في مسار السفير والحقوقي والمفكر أومليل، عبر نصه السردي “مرايا الذاكرة” الذي ساهم في تكثيف التقاطع بين المسار الشخصي والمسار العام، أي ذاك اللقاء بين الذاكرة والتاريخ في بلورة شخصية مفكر وكاتب استطاع في هذا النص تدوين “نتف من سيرته تظهر معها المرجعيات الأخرى التي أنضجت هذه القامة الفارهة لمفكر من طراز خاص”، وهو السياق الذي يأتي فيه إصدار يأتي هذا الكتاب /الحوار لكي يروم، يضيف طارق، “زيارة الذاكرة المتقدة له لاستنطاق ما تحتفظ به من شخوص وأمكنة وتحولات وأحداث طبعت جميعها مسارات المفكر والجامعي والحقوقي والسياسي وهي تتقاطع لتنتج المعنى النبيل لسيرة ملهمة في العطاء والالتزام” سيرة ومسار حافظ فيها دائما بصرامته الفكرية على أفق
ناظم لمشروعه في الفكر،مشتبكا مع أسئلة جديدة حول التنمية والمجتمع المدني ومآلات الدولة الوطني، دون أن يحصر نفسه في خندق واحد، فهو الفيلسوف والحقوقي والمفكر.
بدوره اعتبر المفكر عبد السلام طويل أن هذا الكتاب، الذي شارك فيه محاوِرا ” يشكل تكثيفا نوعيا بالغ الأهمية لمسار حياتي رباعي الأبعاد مسار الحياة الطبيعية، ثم المسار الفكري والتحولات الكبرى التي مر منها، فالمسار السياسي لأومليل ثم المسار الحقوقي
وأكد طويل أن الحرص على هذا الحوار الثلاثي كان بدافع الصورة الرمزية التي كونها عن الرجل، صورة من أبعادها البعد التأسيسي في شخصياته، معتبرا أنه “إن لم يكن المؤسس الأول فهو من المؤسسين الأساسيين للخطاب الفلسفي في المغرب والعالم العربي، ثم من المؤسسين للخطاب الحقوقي مغربيا وعربيا”.
هذا الدور التأسيسي قد يغيب عن الكثيرين ومنه أنه درّس مفكرين أعلام كأحمد التوفيق، محمد سبيلا وطه عبد الرحمان، رغم فارق السن الضئيل بينهم، بالإضافة طفولته الاستثنائية التي جعلته يخوض مغامرة مغادرة الوطن، وفي ظروف الاستعمار، من خلال مهرب للحشيش ليستقر بإسبانيا ثم يسافر إلى مصر التي كانت تعيش مخاض تحول نوعي لبلد تحول من الملكية الليبرالية بعد الثورة الناصرية ” كل هذا رصده بطريقة متميزة، بالإضافة إلى معايشته لثورة 1968 بفرنسا وما ترتب عنها على المستوى المعرفي والإيديولوجي
المحاوِر الثالث في الكتاب، الباحث في الانتروبولوجيا السياسية محمد المعزوز، اعتبر أن الحديث عن هذه السيرة /الحوار لا يتعلق بالخفي في التاريخ والممارسة السياسية أو النظر الفكري، وإنما “بكيفية تشكل عملية البناء بين المتجلي في السياسة والتاريخ وهذا الخفي”، وعملية البناء هاته كانت أساسية في هذا الكتاب، لافتا إلى أنه رغم التراكم الكمي في هذا النوع من الكتابات السير ذاتية إلا أننا “لم نرتق بعد إلى جعل الجملة أو الملفوظ في الحديث عن السيرة مكثفا، ومتناولا فلسفيا بما يقتضيه النظر التخييلي”.
المعزوز أكد أن هذا الكتاب الحوار لم يكن من صنف الاستجوابات التي تعتمد تقنية الجواب الذي يقول ما قاله التاريخ أو الفلسفة، لكنه “اعتمد طرح الأسئلة المستفزة التي تعيد بنية التاريخ والفلسفة وبنية السياسة، انطلاقا من المستحدَث اليومي، أسئلة لا تنتظر جوابا بقدر ما تنتظر من المستجوَب تدمير الذاكرة من زاوية إعادة بنائها وفق التحدي الراهن الذي يعيشه المستجوَب في اللحظة ذاتها.
وأضاف المعزوز أن إجابة المفكر أومليل في هذا الكتاب “لا تقدم وصفا باردا أو تقريرا تاريخيا ولا تقدم نظرا فلسفيا عابرا، وإنما تستفز المستجوِب من خلال حدث ماض ليبني سؤاله من زاوية: ما حدث وكيف وهل سيحدث مستقبلا؟”.