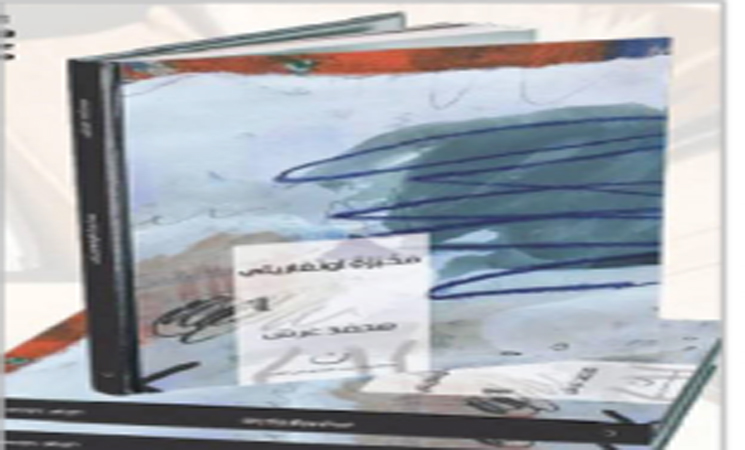تتيح إمكانية قراءة ديوان «مخبزة أونجاريتي» للشاعر محمد عرش والصادرة عن بيت الشعر في المغرب (2018)، إمكانية فك التمازج المقصود وغير المشروط بين المتحقق الشعري والمعطيات الفلسفية، وكأن المقام الشعري يفرض هذا الوعي الذي تحقق، وهو يلامس وعيا تاما وكاملا في اعتبار الحكمة ليست نفيا ولا رفضا للخيال، وأنّ الشرط الكتابي لا يرفض أسئلة الذات، بقدر ما ينفتح على مرجعيته.
يلتفت الشاعر محمد عرش إلى خلفية فلسفية، قد يتعذر تبينها خلال الإنصات الأول، لأن الشرط القرائي يستلزم فك العديد من تشابكات معانيها دون اللجوء إلى الظل الفلسفي في مرحلة متقدمة، لأن المسار الكتابي قد زواج بين الذات والعالم عن طريق الشعر. وهذا الرصد الأولي فتح كوات قرائية يمكن تبين هويتها الفكرية منذ مقام الإهداء وهي مقتبسة لـ»جوسيبيه أونغاريتي»، من «حصة الغريب»، ومنطوقه: «بين وردة تُقطفُ والأخرى التي تُهدى عدمٌ لا يُعبّرُ عنه». إنها المسافة التي تُمثّل شرط الوعي بالوجود بين الوجود والغياب، هذا الأخير الذي لا يمكن الجزم باعتباره عدما ما لم يتحقق في الذاكرة، الذاكرة التي هي امتداد الشعور في الزمان والمكان: الذاكرة التي من شأنها وحدها أن تفضل بين الوجود والعدم!
هل الرؤية الشعرية عند محمد عرش محددة سلفا بأنها ضرب من «الوجودية الشعرية»؟ ثم، من يبيح لنا القول بذلك في ظل وجود أسئلة حول الذاكرة والنسيان، والحنين؟ أو لنتساءل بصورة أخرى: هل تكمن «الوجودية الشعرية» في مساءلة الذات التي تورّطت بين أقطاب الوجدان: الذاكرة، النسيان، والحنين؟ وهل يمكن أن يتجلى الفهم الشعري في أعمق نقطة فلسفية منه في البحث عن النهايات في كل شيء [موت الإنسان، موت الإله، نهاية التاريخ، نهاية القيم…نهاية العالم!]؟ وهل يؤمن الشاعر بالنهايات أكثر من البدايات؟
عود على بدء، ولنجعل من مسار البحث في «النفس الفلسفي في شعر محمد عرش» منطلقاً لفهم أواصر العلاقة بين الفلسفة والشعر، بين الوجدان والعقل، بين الخيال والفكر. يقول هانز جورج غادامير: «ليس للفلسفة بداية واحدة، وإنما لها بدايات متعددة» [بداية الفلسفة-Au commencement de la philosophie]، ولكل بداية نقطة انطلاق خاصّة، وكان الشعر ذا بداية عظيمة ومختلفة؛ إذْ الاندهاش أمام العالم والسؤال عن أصله، أكبر من اللغة التي يمكن أن يبلغها الفكر. فكان جلّ ما أنتجه بارمينيدس وأرسطوفان وهومروس… وغيرهم محاولة لفهم العالم بمنأى عن الأسطورة لكن بشكل أكثر قربا من هذا الجوهر الذي يتوارى ويحجب معه حقيقة الوجود. إنّ ما يصنعه الخطاب الشعري أبلغ وأوقع في النفس والعقل مما قد تُقدّمه الحسابات المنطقية والعلمية؛ ذلك أنّ مساءلة الوجود بما هو موجود تكون باستنطاق المسكوت عنه في الذات وفي رمزية الأشياء، وبتوسيع مدارك اللفظ ليحتوي ما فاض من المعنى خارج حدود العقل. إنّ أول خطاب حمل أفق التفكير بشكل فلسفي هو الشعر في تأملاته الوجدانية للذات والعالم.
تتخذ الرؤية الشعرية لدى محمد عرش منحنيات عدة تتلاقى عند نقطة اتقاد دفقة شعورية تزاوج بين الذاكرة والنسيان. إنها إرادة مزدوجة تخترق اللاوعي الإبداعي الموجه لقلم الشاعر. وليست الذاكرة في مقام التأمل سوى فعالية للنسيان! وبالتالي فلن تكون الثنائية المتقابلة سوى تناص إيقاعي يعكس تضاد الدلالة والمعنى؛ فحين يقول عرش:
«من يمرُّ بأقصى،
بأقسى سرعة،
القطارُ
أم الحقول؟
أم الأمكنة؟
أم الذكريات؟»
فإنّه بذلك يربط الزمن بمستوييه: النفسي، حين يتعلق الأمر بالبعد والنأي (الأقصى)، وما يستتبع ذلك من تحرّق وتشوق. والفيزيائي، حين يعود البُعد والحنين ليكون على الذات أمرَّ و»أقسى». وفي التذكّر استرجاع بصيغة الجمع اللامتناهي من المشاعر والتجارب والأحداث: إنها «أحواض الذكريات، التي لا تعود لتطمئننا بقدر ما تستفز الأفق لكي لا يصل وعلى ملامح الشاعر علامات الاستشراف المبهج. ليس الماضي زمنا عاديا عند محمد عرش، وليس الرجوع إليه فضيلة تجر من ورائها، بكل انتقائية معهودة، المرجع والأصل والأيقونة الأولية للجميل، بل هي خيانة للذات التي تتخلى عن حاضرها، من حيث يُفترض أن يكون النسيان مبدأ لخيانة الذاكرة التي تقهرنا بما تريده تفاهة القدر، وصرامة الحتمية المحيطة بنا قبل أن نولد، وتنسحب حين نموت:
«في أحواض الذكريات،
هناكَ يمرُّ بأقصى،
وأقسى عبرَ المحطّاتِ»
لا يخالج الماضي ذاكرة الشاعر عبر قضايا ووقائع بعينها، يمكن تصنيفها موضوعاتيا، بل تأتي مجتمعة؛ تتفاوض في حوضها المتناقضات وتأتلف، وتترافق على طريق الزمن الماضي، نحو الحاضر، ذكريات السياسة وأحلامها، وهزائم الحب وانتصارات الحرب، وبقايا اعتقادات سابقة، لا أحسبُ أنَّ الشاعر صار يرغب في رجوعها. يحضر «ذئبِ هوبز» لينوب عن مواقف الرفض والممانعة، وعن نقد بنية دقيقة أرهقت النُّخب باختلاف مواقعهم من الفكر والعلم والأدب والفن. ولا يزال «التنين الأسطوري» ذو الأرجل اللامعدودة واللامحدودة يخترق أرصفة الأزقّة الضيقة للسكان، إلى أنْ يعبر من نافذة أو فوّهة حميمية ينفذُ إليها الهواء بغرفة نوم ليختطف آمال الغد المشرق، والمهدي المنتظر. ليس التذكر فضيلة للشاعر، ولا يمكن في نظره أنْ يطبخ قصيدة بطعم الفرح، ما لم تفح من بقاياه رائحة «سنوات الرصاص»، أو في أحسن الأحوال عطر عابرة لم تلتفت قط لتتلقى شكرا على تلطيف الأجواء، وتهذيب، ما بقي للشاعر، من أجزاء، على «مسافاتٍ ما بين كفِّ السماء، وخِصْرِ التُّراب». ليشرع بذلك الفكر، في استنباط ثنائية، وسط «تعنيف الذاكرة» للشاعر، «الوجود والعدم»!؟
لم تكن إشكالية «الوجود والعدم» سوى قضية معنى هذا العالم ودلالة ما يجري فيه من أحداث؟ وما كان بمكنة الشعر أنْ يبلغ مقامه الفريد لولا خوضه، الأوّل، في شأن أعمّ مما يعني كل البشر. غير أنّ تجربة محمد عرش الشاعر تضيف إلى هذه الثنائية العتيقة، عنصرا ثالثا يُضفي على مدلولها معالم الأمل، وهو «الخلاص». هذه التيمة التي تشدنا شداًّ إلى لاهوت مسيحي عريق، ونقاشات بيزنطية لا يفهمها سوى مبتكروها، تُستثمر وظيفيا بين ثنايا الأسطر الشعرية بكل رشاقة ودقّة، وتجعل «العدم» معنى في حد ذاته، حين يكون عنوانا لنقد الواقع وتفاهته، وتحليل عوامل النكبات وخيباتها. ليس «العدم» فراغا وجوديا عند الشاعر، إنّه اللفظ الأصدق حين تعتصر القريحة ألماً من جرّاء النّظم، من حيث تريد أنْ تبوح بالكلِّ لصالح حقيقة يفهمها الجميع، وحين تعزم على فضح مزاعم من يعبثون بأقدار الأوطان، ليتساءل الشاعر، مُضمراً الجواب، في قوله:
«من يصنع السُّفنَ من نور الله،
بحجم كل البحار؟
كم غابات تكفي خشباً؟
إذن يختنق الإنسان،
وتختنق الأقلام حيثُ لا أوراقُ
لتصبَّ جام الغضب،
ولا حطّاب يلوم الفأسَ، وقدْ جرحتِ الخشب
ولا عشبُ، ولا ماء»
لم تكن التجربة التعبيرية الشعرية لمحمد عرش مجرّد امتثال لجود القريحة في مستواها العشوائي، بقدر ما هي انضباط لتماثلات دلالية تعكس التطابق الرمزي للمعاني والإحالات التي تنحدر من سلالة معجمية طبيعية، لترتقي إلى أفق هموم الإنسان، سعيا إلى رسم صورة واضحة عن أزمة المثقف العربي بين سندان المجتمع ومطرقة السلطة وأشكال مراقبتها ومعاقبتها. الكلمات في شعر محمد عرش ليست كالكلمات، ولا تحيل على أشياء كما نعرفها ونتمثلها، ولكنها إرادة بلاغية غنية بالانزياحات والرموز التي تحكي عن مسار تجربة في الواقع أغنت، بأحداثها ووقائعها، مخيال الشاعر. لا يكافئ أزمة الطبيعة وانتهاك حرمة الغابات والأشجار من قبل الجشع الاستثماري على حساب الجمال والشاعرية، إلا أزمة التعبير؛ إذْ ما دور الورق إنْ وُجِدَ إذا غابت القدرة على البوح. ما يقوله لسان الوجدان أكبر من أنْ تخطّه الأنامل نظمًا على شاكلة الشعر! إننا هنا أمام دائرة أفلاطونية-فيتاغورية مغلقة، تستجيب لمعيارية الفضيلة ولقانون كوسمولوجيا الكون، ولكل شيء يتصف بالكمال: يبدأ من نقطة وينتهي إليها. وهذا ما يُظهره قول الشاعر:
«وما بين اليدِ
وعروق الدّم
ما كان للقلم هذا الألم،
وأحياناً يقود إلى السّجن،
كعكّازة تقود الأعمى
إلى بئر يوسف.»
«مخبزة أونغاريتي» إحالة على شاعر إيطالي صاحب ديوان «(الإحساس بالزمن)»: اقتضى وضْعُهُ سلسلة بيبليوغرافية ذات آفاق متعددة الاختصاصات، ساهمت في إغناء مكتبات العالم على مستوى الفكر والفن والشعر والتاريخ؛ فمن ديوان الإيطالي، رواية المغربي محمد شكري «إلى «الخبز الحافي»»، وقبله ««رسالة الغفران»» لأبي العلاء المعرّي، ثم استرجاع «شارَبٌ نيتشويٌّ» محيلا على صاحب مطرقة نقد التراث الإنساني الغربي فريديريك نيتشه، فالعودة مرة أخرى إلى مزجة أبي نصر «الفارابي» بين «الشعر والموسيقا»، وبنيوية «ميشيل فوكو» في «الكلمات والأشياء»، ومنطقية خطاب «سقراط»، ومقالب «امبرتو إيكو» للسرديين والأدباء والسيميائيين، و«مقدّمة ابن خلدون»، و«أشجار كلية الآداب»، واسم مدرّجها لصاحب ديوان: «سلاما وليشربوا البحار» (الشاعر عبد الله راجع) (كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك-جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء).
هذه البنية الإحالية، التي تستحضر أبرز لحظات تشكل الفكر والإبداع الإنسانيين، من مختلف القرون والعصور، هي انتقاء مقصود ودقيق يوظفه الشاعر محمد عرش بناءً على اطلاعه الحصيف على مجريات الساحة الفكرية والثقافية بمختلف مجالاتها. ولم يكن استثمار هذه البيبلوغرافيا من باب الحشو أو البذخ، بل هو استعراض أمام القارئ المتخصص للرجوع إلى نقط الانعراج الكبرى للعقل الإنساني الكلي والمشترك؛ حيثُ بدأت كبرى منجزات الابتكار الذي أطر الفعل الإبداعي إلى حدود اليوم. وقد يبدو للمتأمل أنّ ورود هذه الإحالات البيبلوغرافية غير منضبط للخط الكرونولوجي، لكنه، ومع ذلك، ينضبط لإرادة الشاعر في تبليغ محتوى قضوي ما، يتصل برؤيته النقدية للوضع الثقافي والحضاري العربي وعلاقته بالتراث، ولأزمات الإنسانية المشتركة عالميا. هذه الكفاية التبليغية لدى محمد عرش، لا يكافئها لدى القارئ لشعره سوى كفاية تأويلية؛ إذْ لا رهان على فهم التماثلات الرمزية لإحالات الشاعر دون التسلح بخلاصات الإنتاجات الإنسانية، وعلى رأسها ما أُلِّفَ في مجال الفكر والفلسفة. لقد أدرك محمد عرش أنّ القطيعة الإجرائية التي راهنت عليها النزعات المدرسية بين التخصصات ليست سوى وهم يفصل الإبداع عن بيئته الطبيعية، وعلى رأي هذه القطيعة تلك التي تسعى إلى فصل النّفس الفلسفي عن الدفقة الشعورية لكل من ينظم الشعر. فحين يقول الشاعر:
«حين تجفُّ الخمرة،
وتبقى الكؤوس بدون نبيذ
تتعب الراقصات
وترتخي أنامل زرياب،
ألم تتعبي؟»
فإنه بذلك يؤكّد على أنّ ملح بنات العقل أفكار منذ البدء، ويليها ما يجود به الإبداع وحسن النظم، الذي ليس في جوهره، أكثر من إعادة ترتيب الكلمات في علاقتها بالأشياء، ولا يتجاوز ترويض الوجدان لينصت إلى صوت الوجود المحمول على نغمات ثنائية الصوت والصمت. والظاهر أنّ محمد عرش شاعر السؤال، ومؤلف يُبدع حين يُفكر، وحين تختمر الأطروحة في مَلَكَتِهِ النقدية والجمالية. إنّه قلمٌ يكتب برأسين اثنين: أحدهما، عقلاني منطقي صرف، والثاني، وجداني عاطفي شاعري محض. وما بين هاتين التجربتين يتيه بنا محمد عرش وسط تجربته الوجودية والوجدانية، ووسط ضياع وشك وحيرة، ترسم لخريطته الشعرية منحنيات كلما انعرجت وابتعدت، عادت لتتراجع وتستحيل دائرة تقودها إلى نقطة البداية، التي يُفترض أنْ تكون هي نفسها النهاية.
هذا السعي الحثيث إلى جعل الأضداد أزواجا متماثلة، ومتطابقة المعاني، ليس أكثر من رهان فاضل سعت إليه الفلسفات منذ نشأتها عبر قرون عدة؛ حينما انشغلت بوضع معنى ونظام لهذا الكون الفسيح، من خلال إرجاع التعدد إلى الوحدة، والتنافر إلى تقارب، والتفاهة إلى جدية وصرامة، والخطأ إلى صواب، والضياع إلى تأمل ناضج منتج. لكن، وفي الأخير، كما يقول الشاعر محمد عرش، يبقى:
«كل شيء سؤال:
القبلة، والشمس،
والطفل، والزمان،»
وسواء كانت «القِبلة» وجهة لليقين والمطلق والمتعالي، أو صارت «القُبلة» مقصداً لمجانين العشق والحب والجمال، فكلاهما سؤال؟ منضافة إليهما «أنوار» هذه «الشمس»، التي نفسها يؤولها الجميع حتى لم تعد واحدة بالمعنى، و»الطفل» الذي لم ننتبه إليه فينا حتى تركناه وراءنا دون رجعة، و»الزمان» الذي يتقدمنا ويتأخرنا، ونحن نعدّه، خطأً، بالساعات والأيام والسنين، ولا ندري أنّه لا زمن إلا ما نعيه، ونحياه، ونشعر به، وننظم الشعر فيه.