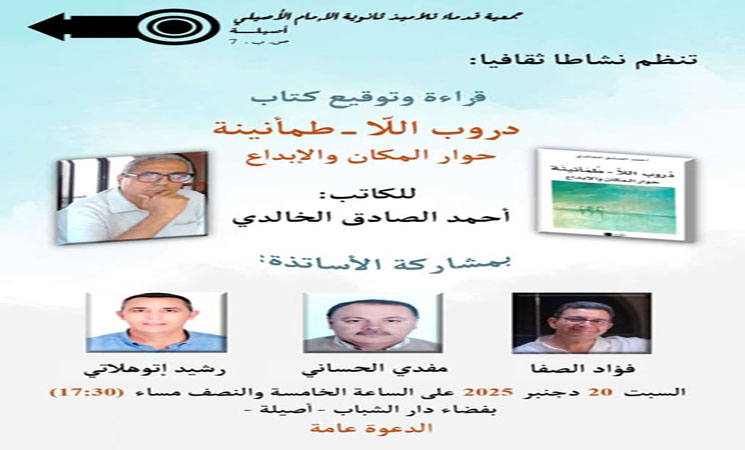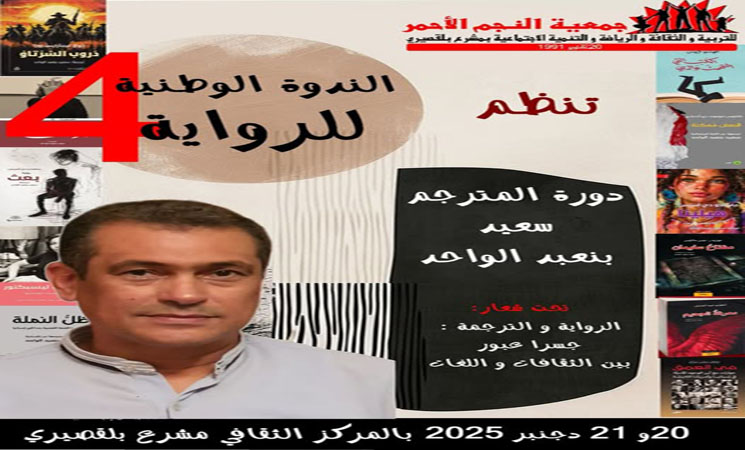ليس إيجابيا بأي وجه، إحاطة تجربة إبداعية ما، لدى هذا الشاعر أو ذاك الكاتب، بهالة قداسة من أي نوع، ومنع أي نقد ينالها بعد تنزيهها عن النقد. كما أن إخضاع أي عمل للنقد ليس تجريدا له مما يستحقه أو يزينه، أو ينال منه أو يسيء إليه.
أردت أن أقدم بكلمتي بهذه المسلمات التي يقر بها كل ذي عقل، بل كل من يتمتع بحس سليم.
ورغم هذا فأنا أقر وأنا أتناول بالقراءة ديوان (الفروسية) أنه حقا من متون الشعر الذي يحقق لبعض قرائه إمتاعا فنيًّا وإشباعا روحيّأ كافيين، وأعني تلك الفئة من قراء الشعر التي تشارك الشاعر في امتلاك إواليات كتابته، ومعرفة أسرار أساليبه ومكونات وسائله التعبيرية التي إن كان يرى أنها لم تتقدم بالشعر أو تغير من صوره ورؤاه شيئا ، فإنه سيرفض القصيدة المجاطية ، حتى وإن بح صوت المعجبين بها، والذين يذهبون في اعتباره، تلك القصيدة التي عناها المجاطي نفسه وهو يصرح في شهادة لأحد دارسيه، بأننا (لا نحتاج إلى شاعر يكتب عشرات الدواوين، ولكن إلى شاعر يكتب القصيدة الأولى)
***
ورغم الجمال الذي لا ينكره (للفروسية) إلا قارئ يعتبر نفسه قد تجاوز وتخطى أساليب التعبير التراثية التي قرأ في المقدمة أو التذييل الذي نشر مع الديوان من يعتبر ما تمَسّك الشعر العربي به بداية من سنوات الخمسينات (صورة من صور حداثة التراث) تلك الحداثة التي ليست أكثر من ( سلسلة متصلة تشكل كل حلقة منها حداثة عصرها) ليغرق هذا الناقد بعد ذلك في ما اعتاد أن يحلله من صور العواطف القومية و( الوجدان الجمعي للأمة ) مدغدغًا أحاسيس الجهة التي أشرفت على طبع الديوان، وما تلا ذلك من تركيزه على مضامين الديوان واستعراض فقرات من بعض قصائده. والناقد / كاتب تلك المقدمة أو ذاك التذييل بالأحرى، لم يخطئ في إدراك الروح التي كانت وراء اندفاعه في تلك الوجهة في التحليل، والحديث عن الشعر، مهتديًا بمنهج تاريخي قومي، في تقديم ديوان أثرت الرؤيا الأخلاقية في إقناع الشاعر أن يقبل فيبدل عنوان ديوانه من «الخمار» كما كان في النسخة التي كانت ستطبع في المغرب، إلى «الفروسية» استجابة للرؤية أو الطرح القومي العروبي للمجلس القومي للثقافة العربية، رغم أن ملامح قصيدة الفروسية كما يقدمها الديوان مغربية محلية الوجه واللسان، والحسام أيضا: ألا ترانا وقد وقفنا على دوران فقراتها حول أربع حركات تنتهي كلها بانفجار في أحشاء بارودة، كما لا يزال المغاربة يشاهدون ذلك في كل موسم فروسية إلى يومنا هذا؟
***
لكن الإعجاب بكل هذا لا يتحقق مع قراء آخرين، جاءت بهم رياح التغيير التي جاءت تياراتها بما كان من شأنه أن يدفع الناس إلى الكتابة برؤى جديدة وتغيرات متباينة، لم يكن ذوق يتوقعها منذ خمسين عاما، أو على الأقل منذ سبعينات القرن الماضي التي أشهد أن العقل الأدبي أو الذوق الفني لم يكن قد استسلم لما أصبح يعرفه آخر الدهر من أمواج رداءة وتفاهة، وضياع ملامح، وفقدان هوية. فحتى لو أقررنا حق هذه الأجيال في التجديد، والأخذ بنا تراه يناسبها، واعتماد الرأي المخالف، فهذه الأجيال تلتمس ما تلتمسه من طرق الشعر، في تجسد أو تمثيل ما تريد التعبير عنه، بغير اعتماد على علم بوسائل التعبير، بلاغية أو أدبية ، أو معرفة نقدية. ومهما كان رأي من يدعون إلى الكتابة بما يختلف مع طرق التعبير في «الفروسية» إلا أن ما يطبع ما تمارسه الأجيال الداعية إلى اختيار الشعر دون قدرة على التمييز فيه بين ما هو شعر موزون أو شعر منثور، أو قصيد نثر، أو مجرد نص ، أو كتابة عابرة للجنس أو اللون الأدبي، فإن القارئ الذي انطلق منذ زمان ممسكا بقواعد وضوابط نقدية وفنية لخير شاهد عندي، وعند صاحب «الفروسية» في جميع الأحوال. ، ولكن بعد معرفة القواعد التي لا ينبغي أن نطلب تحطيمها قبل معرفتها. وهو ما كان يرفضه في حياته الشاعر أحمد المجاطي الذي نجد لديه ثورة حقيقية على ما أنجزته القصيدة التقليدية، ويمكن أن نختلف على ما نجح في تحقيقه، فهل كان يريد أن يحطم منها ما يستحق التحطيم ،أم أن يتجاوز ذلك إلى ما يثبت بالفعل إنجازه التاريخي، الذي لا يمكن نكرانه.
***
ويهمني أن أسجل هنا : أن شعر المجاطي حقق وظائف جمالية سعى جهده لتحريرها من توظيفها التراثي، واجتهد إبداعيَّا ليقول من خلالها رؤياه الفنية للعالم والتاريخ، حين تحدث بألم عن واقعه النفسي وعن طبيعة واقع مجتمعه وهو يرى توزع مدن مغربية بين أوضاع كارثية في مجموعها: من سبتة السليبة إلى طنجة الضائعة رغم استقلال البلاد سياسيا، إلى الدار البيضاء ومعاناة إنسانها، وخضوع جهات من الوطن إلى نزوات من يزورها ، ليرى كيف تبكي جباله الشاهقة: ما بين أطلس وريف كان شامخا فيما كان ذات يوم.
إلا أن ما ينفرد به شعر المجاطي هو هذه المسحة الجمالية المؤثرة الناتجة عن صدق وجدان الشاعر من جهة، وجمالية وسائله التعبيرية الناشئة عن طول دربة وممارسة، وحسن وقوع الشاعر على اللغة المطلوبة ، تعينه على انتقاء أروع ما فيها وأقدرها على التأثر العميق في نفس القارئ، من ذلك درايته التي امتلكها باحتكاكه باللغة الشعرية المهجرية في الأمريكيتين ، وذهابه بخلاف لغة المدرسة التقليدية في مصر التي لم تستطع عصيان ما يمليه عليها النص الغائب التراثي، فلم يتحرج الشاعر التقليدي في مصر مثلا، من الاستجابة للقديم ليصبح الملمح التراثي سمة غالبة على أصحاب المعارضات من لم يتجاوزوا في أنجح نماذجهم أن يكونوا صدى لأصوات أسلافهم، لتكلم السلف من وراء حجاب، وليذكرنا ذلك بإحدى روائع قصائد «الفروسية» ألا وهي قصيدة «من كلام الأموات». ولا تسعف هذه العجالة في تحليل هذه القصيدة الرائعة للوقوف على دلالة الضمير فيها، وتمزقه بين نفَسٍ فردي، وآخر جمعي ملحمي، حتى ليصبح ضمير الأنا دالّا على أوسع مما تحتمله الذات الفردية من أحاسيس جمعية ملحمية، وتصبح صورة البلاد/ الوطن قريبة إلى روح قارئ الشعر بسعة رؤى الشاعر الفنية، سياسيًّا وفكريًّا.
***
يبقى أن أشهد: أن قصيدة المجاطي في فروسيته نوع من مصون الشعر ونموذج من أصعب القصيد، يدل على صاحبه حتى ولو ضاع توقيعه.
كما أشهد بهذه المناسبة ، والمناسبة شرط كما يقول الفقهاء: أن المجاطي تميَّز بصدق حال بينه وبين المجاملة ـ خاصة إذ دعي للشهادة في موضوع الشعرـ وقد أورث ذلك الشاعر قسوة، ظهرت في مواقفه حتى من مجايليه: كما نرى ذلك في المقدمة التي كتبها لديوان «حب»، وفي قطيعته مع جيل السبعينات: كما في موقفه المعروف من محمد بنيس وعبد الله راجع.