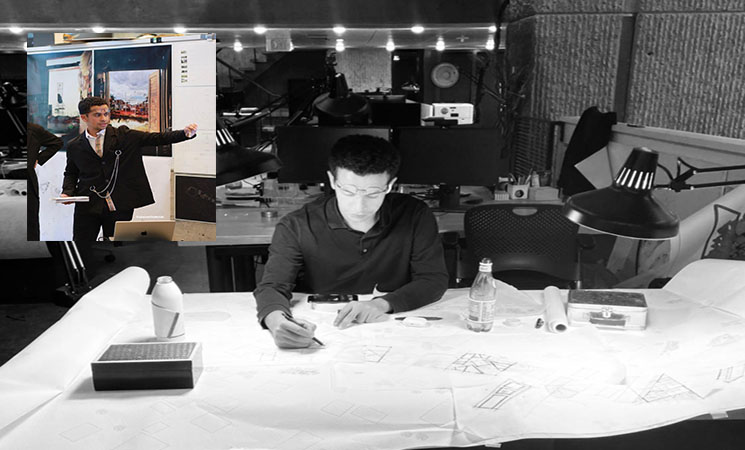بعد أن استعرضنا في الجزء الأول أهم الأفكار والأطروحات التي تأسست عليها مواقف منظمة « إلى الأمام» و « منظمة 23 مارس» و» ولنخدم الشعب»،
نستعرض في هذا الجزء أهم الأطروحات النظرية والسياسية للفقيد عبد السلام المودن، وللأستاذ علال الأزهر المنبهي بوصفهما قياديين بارزين من مؤسسي اليسار المغربي الجديد، ومن الكوادر التاريخية لمنظمة 23 مارس. وتلتقي كتابات الفقيد عبد السلام المودن، وكتابات الأستاذ علال الأزهر في دحض الأطروحات الانفصالية، في أبعادها السياسية، والوطنية، والقومية، والاشتراكية في مرحلة دقيقة من الصراع الداخلي الذي كان يتجاذب مواقف التنظيمات الثلاثة، سواء من داخل تجربة السجن ، أو خارجه. ولتيسير مقروئية هذه المواضيع سنعمل على استعراض أهم مضامينها، وخلاصاتها حسب التسلسل الوارد في المصدرين اللذين اعتمدناهما في انجاز هذا الملف.
ضمن هذا السياق يمكن القول بأن الاتفاق السري الذي أبرمته الحكومة الجزائرية المؤقتة، والحكومة المغربية سنة 1961 لم يكن سوى مناورة من الطرف الجزائري لتجميد الخلاف مع المغرب مؤقتا في وقت كانت فيه حرب التحرير قد بلغت أوجها في الجزائر. وما أن استقلت الجزائر حتى بدّأ مسلسل تدهور العلاقات بين البلدين، تحركها المناوشات العسكرية على الحدود (تندوف)، وهكذا تأزمت الأوضاع في 9 أكتوبر 1962 عندما أقدمت السلطات الجزائرية على طرد السلطات المغربية من تندوف وقد أسفرت الاشتباكات عن عديد من القتلى والجرحى.
وهكذا يبدو أن قضية الحدود بين البلدين تكتسي أهمية بالغة وتغطي مرحلة الاستقلال في اثارثها كنزاع قائم بين البلدين، فهل هي السبب الرئيسي في تشكيل الموقف الجزائري من قضية الصحراء؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون جزءا قد يكون ذا أهمية بالغة ،ولكنه يظل مجرد جزء ضمن نزاع اشمل يتمثل في الاختلاف القائم في طبيعة النظام السياسي “الاجتماعي” الاقتصادي بين البلدين النظامين؟
على مستوى الاختلاف بين النظامين القائمين بين البلدين.، يعتبرالأزهر بأن الأمر ليس جوهريا رغم المظاهر المعاكسة. بل يمس فقط شكل الحكم ودرجة النمو الاقتصادي في إطار الرأسمالية التبعية السائدة على الصعيد الدولي. وهذا الاختلاف في شكل الحكم ودرجة النمو الاقتصادي اخذ مظهرا جوهريا نتيجة الاختلاف الواضح والمثمتل في الطريقة التي تم بها زرع الاستعمار المباشر والطبقات التي قادت هذه العملية. حيث تم في المغرب عن طريق مساومة أجهضت حرب التحرير التي كانت في بداية جذريتها، وتسلمت قيادة المجتمع المستقل طبقة من الملاكين العقاريين والبرجوازيين التقليديين في تحالف مع البورجوازية الوطنية التي تم إبعادها بجميع أجنحتها المعتدلة والراديكالية عن السلطة. وهذا المنشأ للسلطة “الوطنية” في عهد الاستقلال قد طبع النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي ساد المغرب إلى الآن.في حين جاء استقلال الجزائر عن طريق مساومة نتيجة حرب تحرير شعبية دامت ثمانية أعوام، وقادت إلى السلطة برجوازية صغيرة متاثرة بقيم التحرر والاشتراكية ” الشعبوية” ارتكزت على الصيت السياسي التحرري الذي ذاع عن الثورة الجزائرية عبر العالم.
من هذه الزاوية يمكن اعتبار الفرق بين النظام الجمهوري في الجزائر والنظام الملكي في المغرب هو بين ثقل الطقوس والتقاليد المخزنية الاقطاعية الشرقية، وبين نوع من السلوك السلطوي الشعبوي في الجزائر، بينما على الصعيد الدستوري يعتبر المغرب تعددية حزبية في الدستور ومقيدة في الواقع، والجزائر ذات حزب واحد.
وما دام الإختلاف بين النظامين يمس فقط شكل الحكم، ودرجة النمو الإقتصادي والإجتماعي، فإن التناقض بين النظامين ليس جذريا بقدر ما هو تناقض يعكس طموحات قطرية ضيقة تلعب فيها عوامل تاريخية واستراتيجية واقتصادية في نهاية المطاف دورا أساسيا، وتجعل أساليب العمل “لاحتواء” هذا الطرف من قبل الطرف الآخر تتبدل وتتغير حسب الظروف الإقتصادية والسياسية.
ويتساءل الكاتب مرة أخرى:أي السببين أكثر تأثيرا في تشكيل الموقف الجزائري، الخلاف حول الحدود أم الاختلاف بين النظامين؟. يجيب علال الأزهر بأنه” لا شك أن الخلاف حول الحدود له الأسبقية في اهتمامات القيادة الجزائرية لأنه يمس إطار البناء المقام للأمة-الدولة، وهو ذو أهمية واقعية بخلاف الاختلاف بين النظامين حيث ان تغيير يطرأ على هذا الاختلاف من جهة النظام المغربي يؤدي إلى نتائج غير مرضية بالنسبة للنظام الجزائري ما دامت تتحكم فيه نزعة قطرية توسعية.
ولكن الخلاف حول الحدود أيضا قد لا يؤثر إلى حد دفع الدولة الجزائرية إلى التورط في محاصرة المغرب وتضييق الخناق عليه
ويتساءل علال الأزهر. أوليس هناك سبب آخر يدمج مشكل الحدود والاختلاف بين النظامين؟ ،ويشكل المحرك الرئيسي لسياسة الجزائر في المنطقة وتجاه المغرب على الخصوص باعتباره الطرف المرشح أكثر من غيره لمنافستها؟.
بمعنى آخر هل هناك ما يقود إلى الاعتقاد بأن القيادة الجزائرية حتى في حالة عدم وجود مشاكل ترابية، كافتراض، بينها وبين المغرب مع بقاء سائر الأوضاع والشروط الأخرى كما هي، سوف لن تتردد في التدخل في الصحراء، لا تأييدا لتقرير المصير وحسب ولكن من أجل تحجيم المغرب والبحث عن موطئ قدم، وعن أي امتياز ترابي سياسي جغرافي إضافي يمكنها من تعزيز موقعها الاستراتيجي في المنطقة، وما دام مشكل الحدود قد كان قائما في الواقع، فإن التدخل الجزائري قد اكتسى حدة وتصعيدا.
فالسمعة الوطنية التي اكتسبتها الجزائر من مخلفات حرب التحرير عبر العالم غير كافية وحدها (وقابلة للتآكل في ظل توجه مخالف) إذا لم تحز القدرة الاقتصادية والسياسية المتحولة إلى قوة فاعلة. وقد بدأت هذه الشروط في التراكم منذ نهاية الستينات، لتعرف انعطافا حاسما بعد بداية السبعينات.
ففي سنة 1974 تحققت شروط خاصة استثنائية على الصعيد الاقتصادي أغرت القيادة الجزائرية بالعمل على تحقيق طموحها في بسط الهيمنة والتوسع في المنطقة المغربية أولا والإفريقية ثانيا… فقد عرفت أسعار النفط طفرة هائلة بعد سنة 1973 تضاعف خلالها سعر البترول أربع مرات سنة 1974 ،فأعطى كل ذلك دفعة قوية للتصنيع رغم الركود الذي ساد في الإنتاج الزراعي. واستطاعت برجوازية الدولة أن تعزز سلطانها بدفق عائدات البترول، ولم تكن معارضة بعض الأجنحة الضعيفة من البرجوازية الجزائرية التقليدية ذات تأثير رغم انتقاداتها للسلطة الفردية والبيروقراطية ومطالبتها بإقرار نظام ديمقراطي…
وهكذا فمنذ سنة 1974 توفرت شروط داخلية، اقتصادية أساسا وسياسية، وعربية وعالم ثالثية مواتية، أتاحت للقيادة الجزائرية أن تحول طموحاتها في بسط النفوذ إلى فعل وتحرك سياسي، وعندما فشلت في احتلال الصحراء دعمت جبهة البوليساريو المطالبة بإنشاء دولة في الصحراء، وقيام هذه الدولة معناه من وجهة نظر جيو-سياسية الضغط على المغرب في حدوده السابقة وإبعاده عن العمق الإفريقي وتحجيم مكانته… وبالمقابل، إنشاء هذه الدولة المفترضة لتي تؤيدها الجزائر، إذا لم تكن مجرد ولاية جزائرية، فإنها ستكون تابعة للجزائر. وبالتالي، ستفتح إمكانية الوصول إلى المحيط الأطلسي وتوسيع المجال الجغرافي والسياسي الجزائري وتعميق الارتباط الجزائري بالعمق الإفريقي وتكريس فصل المغرب عن موريتانيا. كل هذه الطموحات راودت بدون شك القيادة الجزائرية وألهبت حماسها في دفع الصراع إلى حده الأقصى.