احتفاء بالتعجيب
النصوص الماثلة بين يدي ، اقترح لها مؤلفها القاص أحمد المخلوفي عنوانا به شيء من الغرابة والتغريب» بوابات محتملة « مجموعة قصصية كما دمغ بها صاحبها دفتي سفره الأول عن مطبعة الهداية سنة 2005 السعر 20 درهما من القطع المتوسط ، لوحة الغلاف مجهولة المنجز .
تعمدت الإشارة في أول مناولتي لهذا العمل لمعلومات تتعلق بالطبع والبيع وقد ساد «العرف» أن ترد تحت خط المرجعية أسفل الصفحة ،لاعتقادي أن هذا أيضا يدخل في صميم العمل النقدي، ويؤشرعلى أن عملية النقد قد بدأت فعلا .
نفتح المجموعة القصصية على أول نصوصها «بوابات محتملة».
في أعلى الصفحة تلفت انتباهنا عبارة «مجرد مدخل»، إذ منذ البداية ينصب لنا السارد شركا يوهمنا أننا بصدد الولوج في مقدمة عمل له بداية وله نهاية، أي أن خيط السر سيتناسل في خطية وما على المتلقي سوى أن يمسك برأسه حتى تنقاد له القراءة سلسة جاهزة ، تلك الجاهزية المقروئية التي تحفل بها النصوص ذات درجة الصفر للحكي ،حيث المتعة واللذة عنصران لا يدخلان في الاعتبار و بالتالي تجدنا أمام نصوص الخسران.
إن «بوابات محتملة» ربحت الرهان على مستوى التخييل واشتغاله بنجاعة قلما نجدها في عمل يعتبر باكورة صاحبه، وهو على هذا القدر من الاستواء والنضج مما سنعمل على تبيانه في حينه .
فالتخييل بالمفهوم الأرسطي ينتج انفعالات ،تفضي إلى إذعان النفس فتنقبض أو تنبسط عن أمر من الأمور،لذلك فإن الإنسان يتبع تخيلاته أكثر مما يتبع عقله أو علمه والمتلقي ضمنه، فإشارة القوة المتخيلة لديه تعني إفساح السبيل أمام عملية الإيهام ،ليمارس العمل الأدبي والفني المخيل دوره فيستفز المتلقي إلى أمر من الأمور كما يقول كل من الفارابي وابن سينا وحازم القرطاجني على حد سواء»توقع في نفوسهم محبة له،أو ميلا إليه أو طمعا فيه ،أو غضبا وسخطا على خصمه «(1)
والتعجيب بما هو خصيصة أسلوبية تنماز بها هذه الأضمومة القصصية، تدفعنا إلى ربط الخط مباشرة مع أسلوب الحكي في الثقافة العالمية التي انطلقت من إقليميتها لتذرع العالمية باستيعابها للمشترك الإنساني الفياض ،بقطع النظر عن الترسيمات الحدودية الجغرافية ونعني بهذا القول تجربة الكتابة القصصية الأمرولاتينية، بتياريها التقليدي والحداثي.
ولعلي في هذا المقام لن أركز سوى على التيار الثاني لما له من القواسم المشتركة مع التجربة القصصية في بعض البلدان العربية وعلى رأسها التجربة المغربية ، وبطبيعة الحال ،مع استحضار أئمة المجال من قبيل بوزفور، زفزاف ،عز الدين التازي، شكري تمثيلا لاحصرا.
ففي تجربة الكتاب القصصية بأمريكا اللاتينية الحداثية يمكن القول بأن هذا التيار قطع مع أسلوب الكتابة التقليدية الإقليمية التي كانت حبيسة الحياة في المناطق النائية المعزولة ،حيث السهول والأحراش وسلاسل جبال الأنديز وهي في مجملها تعد لونا من القصص التسجيلي التوثيقي DOCUMENTAL كأنها تتمم واقعية القص في القرن التاسع عشر،بما هي فضح وتعرية للظلم الاجتماعي وتشخيص لمشكلات المجتمع الناجمة عن النمو الدولي إلخ ..،فالأمر الذي عارضه الحداثيون ،الموقف الذي انشغل بالتوثيق، أو نقل رسالة على نوع من السذاجة الفنية والسطحية في معالجة الواقع ولذلك فإن ما يميز الكتابة القصصية عند كتاب أمريكا اللاتينية الحداثيين اهتمامهم بما يلي :
– الارتكاز بالأساس على «صنعة « الكاتب أو حيلته الفنية
– الإصرار على الأخلاقية fctionality ضدا على النزعة الوثائقية ، ونعطي مثالا على ذلك بالكاتب غابرييل غارسيا ماركيز في عمله الموسوم» مئة عام من العزلة».
– اتساع الخلفية الثقافية والمعرفية التي يستند إليها الكتاب الجدد، فرؤيتهم أكثر إنسانية للعالم وتدليلا على ذلك يكفي في هذا السياق الإشارة إلى سعة الاطلاع المبهرة التي تتضمنها أعمال بورخيس، أو كورتازار ،أو فوينطس مثلا .
أردت بهذا الاستطراد الموجز حول تجربة هذه المجموعة القصصية «بوابات محتملة» التي تضم بين دفتيها ستة عشر نصا قصصيا نسرد عناوينها كالآتي : بوابات محتملة ،قلت لكم ، الغاية لا تبرر الوسيلة ، ملامح موظف يتهيأ، فرص غير متكافئة، قابيل وها بيل، اللغو والدخان، الألوان تتحدث في غفلة عن الرقابة ، حدث ذات يوم، طرزان الذي كان ، بحر بلا سمك ، بلاغة السقوط ، وثائق فرح حاطوم، العنكبوت ،عودة الباتول ،العصا وتداعياتها ، فآثرت أن أركز على نصين إثنين أنموذجين يمثلان نمط الكتابة عند القاص المغربي أحمد المخلوفي وأعني ،النص الافتتاحي «بوابات محتملة» والنص الآخر «طرزان الذي كان».
ففي النص الأول وكملاحظة أولية استطاع المخلوفي أن يجعل منه البوابة الرئيسية لباقي البوابات لذلك فهي عنوان العناوين بامتياز وخميرة النصوص الباقية كلها .
في التسمية
التسمية قبض على الشيء ظاهرتيا، تقييد ضد العدم أو النسيان أثر لوجود كينوني ثمة في جهة ما من العالم ، ولذلك فإن الاسم بمجرد تلفطه أو أثناء ذلك أي أثناء تصويته يقبض على ملفوظه في الهنا والآن : بوابات محتملة. إن العلاقة الإسنادية بين مكوني العنوان بمثابة جرح .جرح لا يمس فقط الذات الكاتبة ،هاهنا المؤلف ،وإنما جسد النص/النصوص بماهو أولا، فضاء بالمعنى الوارد عند يوري لوتمان وبشلار ،وثانيا بما هو اقتراح لواقع تخييلي مفارق لواقع شخوصي عيني لكنه محتمل الكينونة ،محلوم به ،إذ جاء على لسان الراوي» كنت أسيرا لقرد الجزيرة، قرد غير مرئي أسود، شرس، أضلافه تدمي أوداجي، أراه في الأحلام دوما(…) حتى إذا أسفر الصبح وتنفس هرولت للقرطاس والقلم،لأدون فزعاتي المتكررة كان السفر ينمو بالأحلام(…) و أناأحلم بقدرتي على امتصاص الهول وحرق خيوط الظلام، وإعادة الصفوف، وتوقيع اسمي فوق رزنامة الحروف «ص1 من بوابة محتملة .
لاشك أن الحلم بماهو وجود وكينونة موازية للوجود الأصلي يخلق ارتباكا بالنسبة للمتلقي بحيث يطرح السؤال أي الوجودين الأصلي أو الواقعي ،أو وجود المؤلف الممتد من الجسدنة إلى النصية (توقيع اسمي فوق رزنامة الحروف ) أم حياة النص التي أضحت وجودا مستقلا ومحتملا وقابلا للتأويل ؟.
وإذ يتقمص السارد دور المؤلف والشخصية /الضحية وهو يبوح 🙁 والحق أني رغبت في أن أعود جهة الشمال الغربي،وهناك هالني الكثير: بقايا هنود ينتحبون، وأراضي كثر يعتصر عظمها، وأدخنة قاتلة ودروع ضخمة وطائرات ورؤوس شيطانية تتأهب للدمار، وأنين خافت في المصانع إلخ ..ص 5 و 6 .
هذه الرؤية الكارثية /القيامية تتحكم في جل قصص هذه المجموعة بنسبة معينة ،وخلفيتها الإيديولوجية المضمرة تنتصر لإيديولوجيا المستضعفين في الأرض من قبل قوى الإمبريالية والصهيونية في شتى بقاع العالم الثالث ،منذ اجتياح رعاة البقر لأراضي الهنود الحمر الأصليين وتدمير ثقافة شعوبها، مرورا بالاحتلال الصهيوني للأراضي العربية واجتياح الاستعمار الغربي لإفريقيا والعالم العربي، ووقوفا عند نكسة حرب 67 وما تلا ذلك، وصولا إلى عولمة التوحش والاستكبار التي تعمل باسم الديمقراطية وحقوق الانسان ،والقيم المزيفة بالتقدم على تبشيع العالم وإسقاطه في مزبلة التاريخ البشري.
هذا التصور الذي يصدر عنه المخلوفي قاسم من عدة قواسم مشتركة بينه و بين بعض من الكتاب العرب المرموقين ،حنا مينا وعبد الرحمن منيف وغيرهم ممن سبق ذكرهم وتجربة كتاب أمريكا اللاتينية ممن ألمعنا إليهم سالفا.
إن التعجيب بما هو قيمة جمالية متمفصلة في ثنايا «بوابات محتملة» يدفعني إلى اعتباره نحوا أسلوبيا مميزا لهذا الأثر الأدبي . فبقدر ما يؤسس التعجيب قيمة مضافة لتجربة الكتابة عند أحمد المخلوفي، بقدر ما يرسم أبعادا لعوالم وجغرافيات قائمة ليس فقط في مخيال الكاتب، وإنما تبدو شاخصة بالنسبة للمتلقي الذي يدرجه المؤلف في ورطة التسليم بهذا الوجود ليس فقط كاحتمال ورقي وإنما ككينونة بسيكولوجية لها قابلية الاستهلاك والاستيهام في الآن ذاته.لست هنا من دعاة الإسقاط المباشر للأطر التنظيرية والتفكيرية إلا بما تبوح به التجربة النصية بوصفها شرطية إبداعية جوهرية غير عرضية .
أحمد المخلوفي لم يقتصر فقط على تكتيك الكتابة من حيث الأسلوب الذي بسطنا فيه شيئا من القول ،وإنما الفكرة أيضا حظيت بنصيب من الإبداعية عن طريق المحاورة التناصية والتوظيف التضميني في قصة (طرزان الذي كان ) ص69 من المجموعة. كان أول ما استوقفني تلك اللعبة المرحة المتجسدة في المراوحة التناسخية من طرزان الأسطورة إلى طرزان الواقعي الذي بدوره سيتأسطر ليتحول إلى طرزان تخييلي ، ليعود من جديد عبر علاقة جدلية معقدة إلى طرزان يلج المعيش الاجتماعي والسياسي. جاء على لسان الراوي الأول …وحين تم المراد كانت فترة 1956 حالمة،زارته (طرزان )مغرية إياه باستثمار تناسق جسمه الخلاق في بناء أعمدة اللحظة. لا أدري كيف استسلم طرزان مثلنا تماما لشطحات السياسة وكرنفال الكلمات القاتلة…طرزان وهو يحمل المناشير وأكياس الجرائد ويهيئ الميكروفون لثعالب الوقت،كان قد نسي البهجة التي خلفها،واستمرأ دائرة المستنقع بلذتها الماكرة « ص71 .
وهي ذات الرؤية التي تحكمت في النص السابق والمتأسسة على المغادرة والخروج من عالم موبوء إلى كون أرحب و أرحم إلى المطلق الجوهر الصافي، فطرزان الذي كان مجرد أحد قاطني حي جامع مزواق (بمدينة تطوان ) العاج بالأحداث الصاخبة المنتمية إلى الأحراش السفلى من قاع المجتمع التطواني، استطاع في لحظة ما أن يغير مجرى حياته في اتجاه الانسحاب من العالم الفاسد إلى عالم الفطرة والطبيعة إذ انتبذ لنفسه مكانا من أدغال نهر المحنش وعن طريق المحاكاة بنى كوخا من ألياف الغابة واتخذ للصحبة قردة، ودوت صيحاته أرجاء الغابة كمثل طرزان الذي في خياله، هذا التماهي يجد تفسيره في التوق إلى العود الأبدي إلى البدء،إلى صرخة الحرية التي يطلقها طرزان لتقطع بين مسافتين زمنيتين: زمن أنطولوجي جارح وزمن سرمدي غير قابل للامتلاك .
زمن فكر ثابت وواقع متحرك موار على حد تعبير هنري برجسون ثم يسترسل الراوي «…تساءل مع نفسه(طرزان ) ماذا أرى أنا في الحلم أم في اليقظة ؟»ص72.
إن هذه الرغبة في عدم الاستيقاظ من الحلم تجد تؤولها الرغبة في البقاء في الرحم،أو العودة إلى الأصل مما يذكرنا بعمل ابن طفيل في «حي بن يقظان» أو قصة روبانسون كروزوي حيث الرجوع إلى الطبيعة نشيد رفعه كل من حي بن يقظان وروبانسون وطرزان.
ثم إن طرزاننا هذا ضدا على (الحضارة ) المادية ونزوعها الاستهلاكي الأهبل ،ضدا على العقلانية الباردة الاصطناعية وضحاياها ، ضدا على قبح عالم مكبل بالإسمنت ذي سماء مثقوبة يحرثها الحديد ، تلكم هي أساس الرؤيا المشتركة بين هذه الأعمال التي ذكرناها.
*باحث شاعر ومترجم

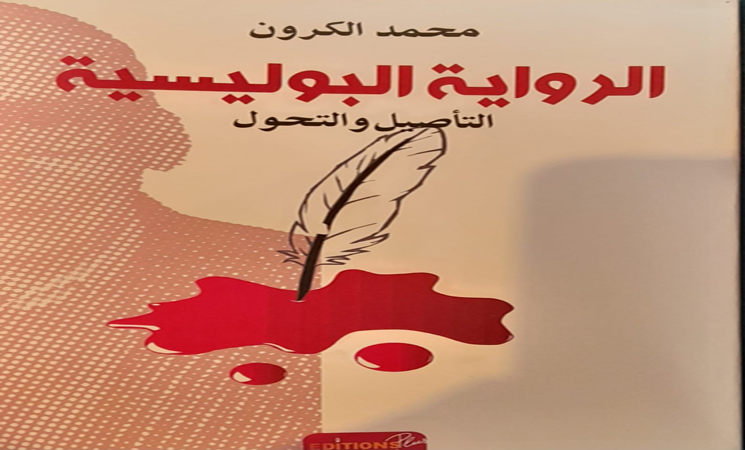
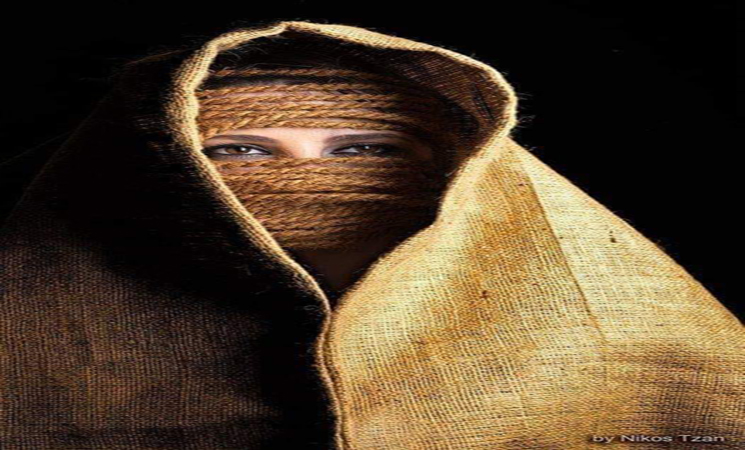




اترك تعليقاً