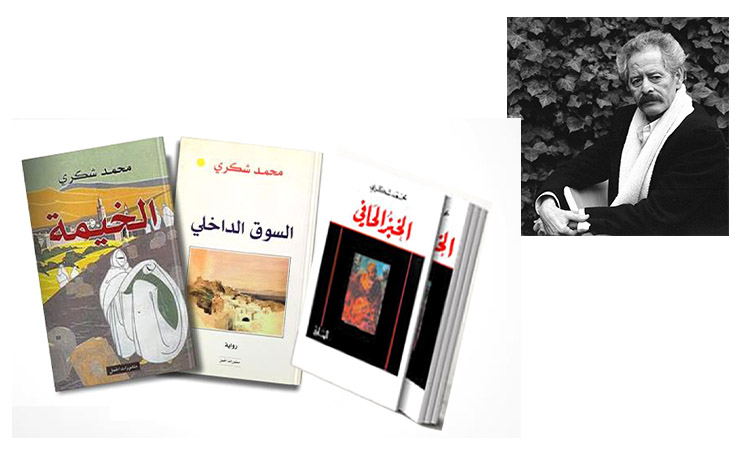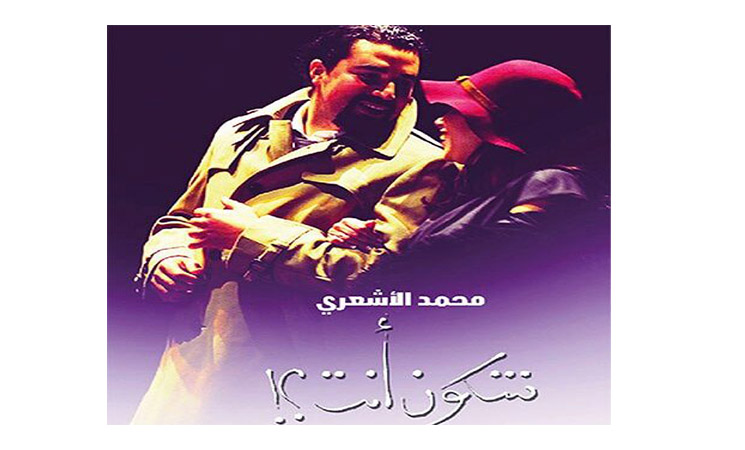اِخترْتُ وَسْم هذه المقالة بالعنوان أعلاه؛ لأمرين اثنين على الأقلّ، أولُهما أن محمد بودويك، بالفعل، مثقف متنور بامتياز، اقتحم ميدانَ الكتابة منذ زمن بعيد؛ فراكَمَ فيه مُنجَزا أدبيا وفكريا من الأهمية والدّسامة والتفرد والعُمق بمَكان، مُنطَلِقا من رؤية حداثية متحرِّرة، ومُسْتَشعِرًا عِظَم المسؤولية المُلقاة على كاهل المثقف في اللحظة الحضارية الآتية خصوصًا. فقد بدأ الدكتور بودويك مساره الأدبي شاعرا، منذ السبعينيات، ولكنه لم يُصْدِر باكورته، في هذا النطاق، إلا في 1997، عن دار البوكيلي بالقنيطرة، والمقصود أضمومتُه الشعرية “جراح دلمون”، التي تلَتْها أعمال شعرية أخرى باذخة ومائزة، على أنّ أبرز ميزاتها أنها تضمّ بين دفّاتها شعرا حداثيا، مؤطَّرا برُؤية جديدة، ومدبَّجا بلُغة كثيفة عميقة رَقْراقة، تشبه لغة شعراء الحداثة الكبار عندنا؛ ولذا، وصف الباحث محمد حماني أديبَنا المرموق بـ”أدونيس المَغرب”. ثم إنه يفتح “نافذة أنيقة على سحر القول الشعري، المنجذِب لعُمق الذات وصداقة الأشياء. وبهذا، يؤسّسُ لنفسه جغرافية شعرية خاصة به، تشْبهه في قلقه وهدوئه وزوبعته وبحثه الدؤوب عن عالم شعري، يجدُ فيه الملاذ والخَلاص”.
وكتب بودويك عددًا من الدراسات النقدية، لعل أهمها “شعر عِزّ الدين المناصرة: بنياته، إبدالاته وبُعْده الرعوي” (2006)، وجملةً أوفَرَ من المقالات الأدبية والفكرية والتربوية والسياسية، التي ظل ينشرها – وما يزال – في منابر صحافية ورقية (مثل جريدتي “الاتحاد الاشتراكي” و”القدس العربي”) وإلكترونية (كموقع “هسبريس”)، منذ مدة بعيدة، قبل أن يَعْمِد إلى تجميعها في كُتب، مُراعيا وجود رابطٍ موضوعي، وهَمٍّ جامع بين موادّها، وبؤرة دلالية عامة، تُلَمْلِمُها وتستوعبها؛ كما في كتابيْه “زيزان الغابة الزرقاء” (2014)، و”في أعطاب النُّخَب” (2021)، اللذَيْن شكّلا مُسْتَنَدَنا في إعداد هذه المقالة الوجيزة.
ويتجلى الأمر الثاني في أنه أولى المسألة الثقافية – وطنيا وعربيا – عناية خاصة؛ كما يَشِي بذلك مباشرةً كَمُّ المقالات التي كتبها عنها، والتي تدل، بجلاءٍ، على انهمام كاتبنا بتلك المسألة؛ بحيث حاول ضبط مفهوم “الثقافة”، وتحديده إجرائيا، وأبرز وظيفة المثقف ورسالته، وأكّد أهمية حضوره الفعلي في الحياة العامة، ورَصَد أعطاب المشهد الثقافي العربي، وكشَفَ العوامل والفواعل التي قادت إلى تأزيمه، وتقزيم أدوار المثقفين، وتمييع السياسة الثقافية وإضعافها في أكثر البلاد العربية، ونحو ذلك من المسائل والأمور ذات الصلة. ويمتاز حديثه، في هذا الصدد، بالصدق والغَيْرة والتألم على المصير الذي آل إليه حال المثقف والثقافة على الصعيد العربي، ويدعو إلى أن يضطلع مثقفُونا بالأدوار الطلائعية المنتَظَرة منهم، وإلى أن يكونوا فاعلين ومتنوٍّرين وملتزِمين ومندَمِجين في مَعْمَعان الواقع والعصر، وإلى أن يبتعدوا عن كل أسباب الكبح والتضييق والدّعة، التي تؤثر سَلبًا في أداء المثقف؛ فتضعف مكانته ودوره وعلاقته بالجماهير، وتربطه – في المقابل – بأصحاب السلطة والمال والجاه، وقد تدفعه إلى أن يصمت ويلتزم الحياد، في الوقت الذي يكون مُطالَبًا بأنْ يتكلم، ويُدليَ برأيه في كل ما يُهِمُّ المجتمع والناس. فالمثقف – في نظر بودويك – هو الذي “يستقصي ويتقرّى، ويحلل، ويقدم رأيًا ووجهةَ نظر في القضايا والمشاكل، في مختلِف تجلياتها وتسمياتها، وبناءً نقديا منتِجا وخلاّقا للواقع في تمظْهُراته المادية المحسوسة واللامادية الروحية”. والثقافة – حَسَبَه دائمًا – هي “ما يصنع الفرق والتمَيز الهُوياتي والاكتمال والانفتاح، ويَصُوغ السؤال تِلْو السؤال، ويُضْفي الطابَع الأنثروبوموفي على الأشياء بوساطة الشفاهة والكلام، وبوساطة الكتابة والتدوين؛ صدْعًا بما يُرى حقّا، وصدْحًا بما يُتَصوَّر أنه الواقع النسْبي لا المُطْلَق بطبيعة الحال”.
فهذه هي حقيقة المثقف الأصيل الحر المسؤول، الملتزِم بقضايا المجتمع والشعْب، المندمج في أتّون الحياة اليومية، أو “المثقف العضوي” بعبارة أنطونيو غرامشي (A. Gramsci) المشهورة. وبهذا، فإننا لا يمكن أن نتصوَّرَ هذا المثقف نرجسيّا، أو تابعًا لذوي السلطان والنفوذ، أو مُعاكِسا لآمال الجماهير وتطلعاتها؛ بل الذي يُنْتَظَرُ منه أن يكون إلى جَنْبِ البسطاء الكادحين والمظلومين، وأن ينتصر لقيم العدل والحق والمساواة والخير والجمال، وأن يكون طرفا فاعلا مُسْهِمًا في البناء والنهوض والرقي. وهذا المثقفُ يُلاقي عادةً ضروبا من المقاساة والمكابدة، وهو يرى ما يعانيه مجتمعه وأمته من ألوان البؤس والترَدي والتمزق والتقهْقُر، و”ما ذلك إلا لأنه يَصيح في برية جديبة، وأرض جرداء، ووادٍ ذي قعر سحيق، وتجويفٍ عريض عميق، يردد الصدى تلو الصدى؛ فيتلاشى وينمَحي ويموت”.
وقد انتقد د. بودويك أصنافا من المثقفين المزيّفين، الذين حادُوا عن هذا المَهْيَع اللاحِب؛ كالمثقف الذي لا يتوانى في التزلف من أرباب السلطة والمال، ولو على حساب الطبقات الشعبية الفقيرة المكلومة، غايتُه تحصيل مكاسب شخصية وبلوغ مناصب مبتغاة؛ وكالمثقف المنزوي المنغلق على ذاته، الذي يتحين الفرص لكي يستفيد لنفسه وحده، ولا يسعى في سبيل تقديم خدمات – بالقَدْرِ المُمْكِن طبْعًا – للمجتمع والإنسانية؛ وكالمثقف المخادع المراوغ، ناقص الأخلاق أو عديمها، ومُوقد نيران الفِتن كالشيطان، والذي “يجمع إلى الشراسة والمُداهَنة والحِرْبائية والوُصوليةِ المَكْرَ الثعْلَبي، والذئْبِية الضارية المُعْوِلة، والأسَدِيّة المُزَمْجِرة الناهِشة”؛ وكالمثقف العَطّار، الذي يتنقل باستمرارٍ بين الأماكن والمنتديات، قاصدا الجمهور حيث هو، مستخْدِما خبراتِه ودهاءَه؛ لاستمالة المخاطَب، وترويج بضاعته المُزْجاة، ونيل مبتغاه الظرْفي والنفعي والشخصي؛ فهو أشبه بذلك العطار الجوّال، الذي كان يقصد بدابّته، في ما مضى، قُرَانا ودواويرَنا، محمَّلا بصُنوفٍ من المنْتَجات، الموجهة للنسْوة والصبيان خصوصا، ثم يحاول استعمال كافة حِيَله ومهاراته من أجل بيعها، أو مبادلة سلعته الكاسدة بأخرى…
وحتى لا يكون تناوله للأشياء نفعِيا ظرفيا لَغْويا وسياسَويا؛ على غرار ما يفعله كثير من المثقفين الجُدُد (التكنوقراط)، وبعض الجامعيين ورجال السياسة، يدعو بودويك المثقف إلى أن يكون تناوله ذاك عميقا ومنهجيا ومستنِدا إلى خلفية معرفية متينة موسّعة، وإلى أن يتجاوز القشور والسطح في اتجاه بواطن الأشياء وأغوارها، علاوة على التحلي بالجراءة والشجاعة في الفضح والكشف وقول كلمة الحق بطريقته الخاصة، التي تُعِينُه على أنْ يفعل الشيء الكثير، ها هنا، دون أن يعرّض نفسه لأي مَخاطِر أو مَهالِك. فـ”المثقف الأصيل، بالمعنى العميق؛ المعنى الحيّ الخلاق، العضوي، هو مَنْ يقول كلمته الصريحة الصادعة، إنْ عَبْرَ موقف أو فكر أو رأي، في السياسة العامة للبلاد، كما في التدبير اليومي للجماعات الترابية، وفي تدبير الشأن العام حكوميّا في القطاعات الحيوية ذات الارتباط بالشعب وفئاته المغبونة، وفي قُوتِها اليومي وعيشها الكريم”.
لقد آمَنَ بودويك برِسالِية المثقف الحقّ، وبدوره الريادي في المجتمع؛ فهو “دينامو” التنمية والنهضة، وذلك بأفكاره الخَيّرة، وتصوراته النيّرة. ولهذا، فقد ثبت، لدى كل الأمم، أن التقدم في السلم الحضاري رهينٌ بالثقافة والمعرفة والعمل والانضباط، وبالمثقف الفاعل المندمج المُبادِر، الذي يحمل همّا جماعيا ومجتمعيا، ويسعى إلى رُقي الإنسان والإنسانية، ويحرص على إشاعة قيم العدالة والمساواة والكرامة وغيرها. يقول أديبُنا الأستاذ بودويك: “لا أحد يشكّ في وظيفة ودور الثقافة، بمعناها الشامل والمركّب، في النهوض بالأفراد والمجتمعات لجهة التقدم والتطور، وسدّ الحاجات، وتلبية المطامح والتطلعات، وتحقيق المآرب المادية والمعنوية والروحية، حتى إنها – كما لا نحتاج إلى تبيين – بُعدٌ رئيسٌ من أبعاد التنمية. فالإنسان لا يعيش بالخبز وَحْدَه.. إنه يعيش بالمُثُل والأخلاق والأفكار والسلوكات المَدَنِية والخيال والروح” ويُضيف، في موضعٍ آخَرَ، أنّ “الثقافة صِنْو التقدم والديمُقراطية والحرية؛ إذ هي حاميةٌ للإثنيات والأقليات، تمجّد الإنسان كذات وكعقل، وتكرس قبول الآخر المختلِف عنْك لونا وجنسا ولغةً ودينا وجغرافيا وسُلالة وعقيدةً وطقوسا بالمعنى الأنثروبولوجي للكلمة”. فالثقافة، بهذا المفهوم، مطلب أساسٌ للمجتمع، ومُحَرك ضروري لعَجَلة النماء والرقي، و”جوهر لا مجرد قرار إجرائي وتدبيري لشأنٍ من الشؤون العارِضة”.
وما دامتْ كذلك، فلا مناصَ مِنْ أنْ تحْضُر في الحياة والواقع المَعيش، ومِنْ أن ينخرط فاعِلُها “المثقف” فيهما على نحو فعال ومستمر، و”أيّ معنى وطعْم لثقافة لا تتحرك، ولا تنتعش بالتحكيك والتّماسّ والتضايُف والتثاقُف والتصادُم، ولا تحيا باللسان واللغة والصورة والصوت والصدى، ولا تظهر وتملأ المشهد العام والمجال العمومي، متغلْغِلَةً في الإعلام، بأنماطه وأنساقه ومساقاته، كَتِفا بكَتِف، مع شؤون الخبز والماء والشّغل والصحة والتعليم؟”. ولا شك في أن هذه القناعة لدى بوديوك مرَدُّها إلى المبادئ التي تَشَبع بها طَوال حياته، وإلى مساره النضالي المنحاز إلى البسطاء والمظلومين، وإلى غيرته الصادقة على بلده وأمته، في ظل ما عَرَفَاهُ، منذ عقود كثيرة، من انكسارات وتراجعات وإخفاقات؛ فقد “عاش محمد بودويك معترَك الحياة المغربية، سياسيا واجتماعيا وثقافيا، عيشةَ الشاعر والمناضل الوظيفي المتفاعل مع اهتزازات مجتمعه”؛ كما قال عنه صديقه د. عبد السلام المُساوي.
يؤكد ما سلف أن طريقنا إلى التنمية والتقدم لا بد من أن ينطلق من محطة الثقافة، ويستصْحِبَ الثقافةَ على امتداد هذه الطريق الطويلة، ويتخذَ الثقافة وسيلة وغاية معًا. وقد أورد بودويك، في هذا السياق، كلاما جميلا لوزيرةِ ثقافةٍ جزائرية سابقة، هي خالدة التومي، قالتْه عام 2012، جاء فيه أنْ “لا خلاص لنا إلا بالثقافة، ولا مستقْبَل لنا إلا بالثقافة. وإن المسعى الواجبَ أن نسير فيه هو تدعيمُ كل ما من شأنه أن ينتصر للقيم النبيلة الموحّدة، ولمفاهيم المواطَنة والحقوق المدنية، وللممارسة الديمقراطية التي تسمح للشعوب بتحقيق العدالة التي نصبو إليها. وهذا لا يتحقق إلا بعملٍ شاقّ وطويل، تكون فيه الثقافة هي القاطرة المحرِّكة، وهي حَجرُ الأساس”.
وعلى الرغم من هذا الإجماع على مركزية الثقافة وضرورتها، على المستوى النظري، فإن واقعها عربِيّا ليس على ما يُرام؛ إذ يُنظر إليها غالبًا بوصفها شأنا ثانويا، لا ينال من صُناع القرار ما يستحق من عناية، كما أن “وضع المثقفين العرب وضع شاذّ، يبعث على الشفقة والإعجاب في آن”؛ كما ذَكَرَ بودويك، الذي وصف، كذلك، السياسة الثقافيةَ عندنا – في أكثر الأحايين – بـ”العَرْجاء”، وبافتقادها إلى تصور استراتيجي واضح، وبعدم بلورتها على النحو الواجب؛ فهي سياسة مُعَوَّمة، موسومة بالتبعيد والتسويف، مهمّشة قصديّا؛ بل إنه لم يتردد، أحيانا، في الإقرار بغياب هذه السياسة – على الطريقة التي تصاغ وَفْقَها في البلاد المتقدمة – أصْلا! إذ قال إنه “عندما نُعْلن عن غياب سياسة ثقافية متكاملة، تراهن على الشأن الثقافي، وتنظر إليه باعتباره أُسّا ومَعْبَرا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومَجْلًى ساطعًا للخصوصية والهُوية الوطنيتين، فإننا لا نعدو الصواب”.
وقد حاول الرجل أن يرصد عددًا من أعطاب الثقافة والإنتلجنسيا العربية، التي طالما وقفتْ حجر عثرةٍ في طريق المثقف، وفَرْمَلَتْ طموحاته، وأعاقت مشاريعه، ودفعت به إلى مضايِقَ وزوايا على الهامش، ألْفَى معها نفسَه مضطَرا إلى أن يكتفي بالتفرج والصمت، قبل أن ينسحب أحيانا من معترَك الحياة والمجتمع نهائيا؛ فيؤولَ دوره الطلائعي الطبيعي إلى حال الخُفوت والضآلة، وإلى الانتهاء المُرّ أو التوقف حتى، ليتجسد بذلك أقسى مآلٍ يمْكن تصوره في هذا الصدد. ولعل من أبرز أسباب تلك الأعطاب – حسب بودويك – التعصب الديني، والإسلام السياسي المتهافت على البترودولار.
ففي مجتمع محكوم ومؤطَّر بالدين، مشدود إلى الماضي، مُحافظ – إلى حدّ بعيد – في العصر الراهن، لا يُلفي المثقف الحُر المتنور مساحات كافية للتعبير والانتقاد والمشاركة الفاعلة في مفاصل الحياة، كما لا يجد الفعل الثقافي فضاءً ملائما للتأثير والتأطير وبناء مجتمع حداثي، طالما أن المعطى الديني يفرض قيودا وضوابط يتعين التزامُها والانضباط لها، ويرسم خطوطا يلزم احترامُها والانتهاء إليها. وتستتبع هذه الأصولية الدينيةُ أصوليات أخرى: فكرية وأدبية وثقافية ونحوها. والكاتب، هنا، يُقِر تماما بأهمية الدينِ وضرورته في الحياة؛ الدينِ في صفائه وطُهرانِيته وتَعاليه وسُموه، بعيدًا عن التأويلات والسلوكات التي حَفت به في أزمان متعاقبة، وانحرفت به أحيانًا عن سكته الصحيحة ومقاصده العُليا. ولذا، دعا بودويك إلى التفريق بين الأمْرين؛ فقال: “من الأوْجَب والمستعْجَل تمييزُ الدينِ عن التدين، والقرآنِ – كمصدر أساس، ودستور أسمى – عن الفقه البشري، والتآويل المختلفة؛ والنضالُ المستميتُ من أجل إعلاء الإسلام النظيف، وإبعاده عن السياسة”، التي وصفها بأنها “غَيْسٌ يلطخ ويُشوه، ويُثقل الحركة والمَشْي”؛ ومن أجل استزراع الديمقراطية الحقة في البِيئة العربية، وإرساء دعائم المجتمع الحداثي، المستنِد إلى العلم والتقنية، وتوفير أسباب النهوض والتقدم، دون التفريط طبعًا في الموروث المُضِيء، وفي مقومات الأصالة والهُوية؛ لأنه لا نهضة قوية على غير أساس، ولا يمكن بناء الحاضر، واستشراف المستقبل، ما لم ننطلق أولا من الماضي، الذي يزخر بكثير من عوامل النجاح والتفوق، التي يجب التنقيب عنها، واستيعابُها جيدا، ثم الإفادة منها فعليا في صُنْع التنمية والنهوض الحضاري، مع الإقرار بما ينطوي عليه هذا التراث المديد من نُقط مظلمة، وعوامل مُعيقة.
لذا، فهو يدعو إلى عدم النظر إلى ماضينا بوصفه جيّدا ومُشْرِقا كله، ولا بوصفه شرّا ونقائصَ كله، بقَدْر ما يشتمل على مواطن ضوء كثيرة جدا، إلى جَنْبِ نقيضتها طبعًا. ومن هنا، نراه يُلِحُّ على عدم تقديس هذا الماضي رُمَّتِهِ، وعدمِ إحاطته بطبقة سميكة من القدسية والإطلاقية؛ إذ يؤكد أن “تقديس الماضي؛ تقديس التراث؛ تقديس السلف “الصالح”، وإضفاء هالة أسطورية عليه، وتصنيم القديم، يكاد يكون وَقْفا على المجتمع العربي- الإسلامي؛ إذ إن شعوب الحضارات الكبرى، المُوغِلة في القدم؛ مثل الصينيين والهُنود واليابانيين، منخرطون في سؤال/ أسئلة الزمن الجاري وتحولاته، قدْرَ ما هُمْ مُعتزّون ومرتبطون بتراثهم المعماري والشعري والديني والتصويري والموسيقي”. فهو، إذًا، يدعو إلى التعامل مع التراث بتَيَقُظٍ، وبوعيٍ نقدي فاحص، مثلما يجب أن نتعامل كذلك مع معطيات الحداثة والعصر؛ مِن مُنطَلَق أن كلّا منهما ينطوي على ما يُفيدنا بالتأكيد، وعلى جوانبَ لَسْنا في حاجةٍ إلى أخْذِها منهما، وذلك بعيدًا عن أي نظرةِ تمجيدٍ أو تقديسٍ لأيٍّ منهما.
ويسجل بودويك أن الدين حين يختلط بالسياسة، في إطار ما بات يُعرف اليومَ بـ”الإسلام السياسي” ، يشكل عائقا أمام التنمية، وأمام عمل المثقف الحر الأصيل المُسْتنير؛ لأن المُنادِين والدّاعين إليه يحرصون على استغلال الدين لقضاء مآرب ضيقة خاصة، لا لخدمة العباد والبلاد، ويستندون إلى معطياته لإضفاء الشرعية على قراراتهم وتوجهاتهم، ولو كانت غير مسدَّدة!
وللاستبداد السياسي، الذي تعاني منه الأمة، منذ عُقود، أثر في عرقلة انطلاقتها التنموية، وفي استدامة تخلفها وتأزمها، وفي كبح حيوية نُخَبها ونشاط فئاتها المتنورة. ويذهب بودويك إلى حدِّ عَدِّ السياسة، في الوطن العربي، أكبرَ عائق أمام نهضته وتقدمه، لا الثقافة، وإن كانت مسؤولة عن ذلك، أيضا، بقَدَر؛ فالماسِكُون بزمام السلطة يملكون كل الوسائل القمينة بالفعل والتصرف، وتحقيق نتائج على المدى القصير المنظور، بخلاف الفاعلين في المجال الثقافي، الذين يمْكنهم التأثير، كذلك، ولكن بعد مدة من الزمن، قد تطول كثيرًا. فـ”السياسي هو المسؤول الأول عمّا آلتْ إليه أوضاع الجماهير الشعبية، لا المثقف. فالمثقفُ لا يملك القرار، وليست له حيلةٌ في تغيير الواقع من حال إلى حالٍ على الفور. فمسحةُ التغيير تتم على يد المثقف، ولكنْ بعد لَأْيٍ؛ بعد مديدِ السنوات؛ بعد أن تنضج الشروط الموضوعية، وتتضافرَ عوامل ثقافية وفكرية إضافية لتحقيق الحلم، وتوقيع المُتوخّى والمنشود”.
وحين “يتعاون” الديني والسياسي من أجل رسم صورة عامة للمجتمع المأمول بالنسبة إليهما، وللمشهد الثقافي فيه، فحينذاك تكون المسألةُ أشد تعقيدا، والوضعُ أكثر تضعْضُعا وضعفا؛ لأن عوامل الكبح والإعاقة تكون أوفر وأقوى.
وقد أدرك رجلُ السياسة أهمية الثقافة وخطورتُها منذ القديم؛ فحاول – بكل السُّبُل – توظيفها لتحقيق مآربه ومصالحه، واستمالة الفاعلين فيها؛ فقد “عرفت الطبقة السياسية المهيمنة ما للثقافة والفكر، والقول المسنود الصريح، من خطورة واستحواذٍ على العقول والألباب والأفئدة والوُجدان، ولنا في التراث العربي- الإسلامي نماذج عديدة لعلماء ومثقفين تعرضوا لبطش السلاطين والحكام؛ نظيرَ أفكارهم الحُرّة، وشخصياتهم المستقلة، وقناعاتهم التي لم تكن متماهيةً دائمًا مع طروحات ذوي السلطان وتوجهاتهم.
وقد أتى بودويك على ذكْر أسباب أخرى، تفسّر وضع الأنتلجنسيا العربية المتردّي في العصر الحالي، في كتابه “في أعطاب النّخب”، الذي ينتقل فيه، من خلال مقالاته، “بين موضوعات شائكة وحارقة ومستفِزّة، ذات حضور وراهنية، ناعيًا على النخب صمْتَها وانسحابَها من السوق، وحيادَها أمام قضايا اجتماعية وسياسية وتربوية وثقافية، تتطلّب الإدلاء بالرأي، والصدْع بالأفكار في ما تراه طريقا قمينًا بإخراجنا من المُعْضلات، وتنبيه الغافلين و”المَسْطُولين” والحكومات إلى خطورة الوضع، وواقع التردّي والتأخر التاريخي والثقافي عن الرّكْب الحضاري والتكنولوجي، الذي بِتْنا فيه غُرباء، لا حولَ لنا ولا قوةَ لاستدراكه، واستحقاق وُجودنا ضِمْنه وفيه”.
أعود لأُكرّرَ ما تقدّم قولُه بخصوص اهتمام الدكتور محمد بودويك بالمسألة الثقافية وطنيا وعربيا، من موقعه كباحث غَيُور، وكمثقف متنوِر، يُؤْلِمه الوضع الذي آل إليه المشهد الثقافي والمعرفي العربي، بعد أن أحاطت به كوابحُ وعواملُ وأعطابٌ فَرْمَلَتْ مساره، وأعاقته عن الاضطلاع بدوره الطلائِعِيّ في نهضة الأمة العربية وتقدّمها، مؤكِّدا أنّ “وجود المجتمع تحت ضوء الشمس، وما يسهم به من روح إنسانية، وإنجاز تنمويّ اجتماعي واقتصادي وعلمي، مشروط بحيوية الثقافة فيه؛ من حيث حضورُها المُشِعّ، ومقاتلتُها لجَحافِل الظلام، ومظاهِر التخلف، وسمات الانكفاء”؛ وأنه “أبدًا لن يتقدم شعبٌ لا يقرأ، ولن يتطور ويسموَ – روحا وعقلا ووُجدانا وحِسّا وحَدْسا – ما لم يعانقِ الحرفَ، ويجالسِ الكِتابَ، مترحِّلًا بين صفحاته ودَفّاته ممحِّصًا، وواقفًا على ما به صارت الأممُ أُمَمًا، والحضاراتُ حضاراتٍ، وما به اعتلى الإنسان…”.
ولذا، كان لا مناصَ مِنْ أنْ يوجّه دعوة تلو الأخرى من أجل تصحيح الوضع، ووضْع قطار الأمّة على سِكّته الصحيحة؛ بالأخْذِ بكلّ الأسباب الممكنة المُوصِلة إلى ذلك الشَّطّ، وبَذْلِ كل الجهْدِ من أجل تجاوز الأعطاب والإكراهات التي أوْمَأنا إليه من قَبْلُ، مُلِحًّا على أن للمدخل الثقافي دورا بارزًا في هذا السياق؛ بحيث إن المثقف مُطالَبٌ اليومَ، أكثر من أي وقت مضى، بالانخراط في المجتمع، والنزول من “بُرْجه العالي” لمُلامَسة هموم الناس وتطلّعاتهم، والإسهامِ بفعاليةٍ في نهضة الأمة وتنميتها الشاملة والمستدامة، وتبنّي مواقف صريحة وشُجاعة من كافة القضايا التي يَحْبَل بها المجتمع، بعيدا عن الحياد الذي طالما لازَمَه، واحتمى به! ومن هنا، وَجَبَ أن يُعاد النظر في “سؤال الدور والوظيفة الثقافييْن. لقد جدّ الجِدّ، واستجدّ المستجدّ، وبات لازمًا لازبًا إيكالُ التنوير والتغيير؛ تغييرِ البنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتنويرِ العقليات، إلى ضفيرة ذات جدائل وتلابيب، وأهداب وأذيال؛ أي: إلى زُمرة من المثقفين غيرِ المتداولة نعوتهم وصفاتُهم، وغير المعروفين كمنتِجي ألواح وكتب وخطابات ومقالات”.
وقد امتلك بودويك ما يكفي من الجُرأة للإقرار بأننا – نحن المثقفين – جزء أساس من الأزمة التي نعيشها، ويعيشها المشهد الثقافي عندنا، بل “إننا الأزمة نفسُها”؛ كما قال، ما دام كثيرون منّا غير مندمجين في المجتمع، وغير حاملين هَمَّه، وغيرَ آتِينَ بخُطوات عملية كاشفة عن نيّتهم في الإسهام في تنمية مجتمعهم، والارتقاء به في السّلم الحضاري والعلمي؛ بل إنهم لَيُصِرُّون أحيانًا على الاستمرار في ابتعادهم عن هذا الشأن، وفي العزوف عن المشاركة في كافة الميادين. وقد عَدَّ بودويك هذا العزوفَ عن السياسة، وعن القراءة، وعن المشاركة في مفاصل الحياة، علاوةً على “عَنْعَناتٍ” أخرى كثيرة، مِنْ أسباب الأزمة التي تتخبّط فيها مجتمعاتُنا اليوم. ولذا، فإن أول خطوة للخروج من هذا الوضع هي ترْكُ هذا العزوف، والانخراطُ بإيجابيّةٍ في المجتمع المَعيش فيه. يقول: “ما ينبغي أن يتحقق فورًا هو العزوف عن العزوف؛ فمتى عَزَفْنا عن عُزوفنا عن كل شيء، نكون قد سطّرنا بداية الانفراج والانفتاح، ووضَعْنا أقدامنا على درب الضوء والنور. فالضوءُ يُحرق اليأس، والأملُ يَقتل العزوف”.
ويبدو من قراءة أولى مقالات كتابه “في أعطاب النخب”، التي خصّها بودويك بالحديث عن المفكر المغربي الكبير عبد الله العروي، وعن مشروعه المتميز الرصين، أن ثمة أكثر من شَبَهٍ بين العروي وبودويك؛ فكلاهما مثقف متنور، ومؤمن بقيم الحداثة والتقدم، وداع إلى الانخراط في العصر والمجتمع، وناهٍ عن الانكفاء على الذات بصورة سَلبية عقيمة، ومُلِحّ على التعامل مع الأشياء بوعي يَقِظ وعقل نقدي وآلياتٍ جديدة فعالة. كما أنهما وجّهَا سهام النقد إلى الفاعلين في مجالي السياسة والثقافة، آخِذين عليهم تقصيرَهم في أداء مهامّهم المنوطة بهم، ومحدوديةَ مردودهم وأثرهم واقعيّا. و”بالإمكان القول إن نقد عبد الله العروي موجَّه – بالأساس – إلى النخبة المثقفة، بعد أن كان موجّهًا، في مفْصلٍ منه، إلى النخبة السياسية، التي لم تذهب بعيدا في رهانها على إصلاح حال البلاد والعباد في العقد السّتّيني من القرن العشرين؛ أي غداةَ الاستقلال” وعلى غرار ما رأيناه عند بودويك، تميز د. العروي أيضًا بإثارة أسئلة إشكالية شائكة، وبطَرْق مواضيع ذات راهنية، فضلا عن كتاباته الأخرى في التاريخ والأدب ونحوهما، وبعَمْدِه إلى تبْصير الأمة بأسباب ضعفها وتخلفها وإخفاقها في بلوغ مستويات أعلى في سلم التمدن والتقدم. يقول بودويك في هذا المساق: “غير خافٍ أن عبد الله العروي، في كل دروسه وحواراته ومحاضراته، يأتي بالجديد المحمول على لولب الأسئلة الشائكة المستفزّة والحارقة، ويطرح الإشكالية تلو الإشكالية، ويذكّرنا بما نسيناه – أو نتناساه – بخصوص أسباب تأخرنا التاريخي ..”
بودويـك مثقـفا متنـوّرا

الكاتب : د. فريد أمعضشو
بتاريخ : 21/11/2025