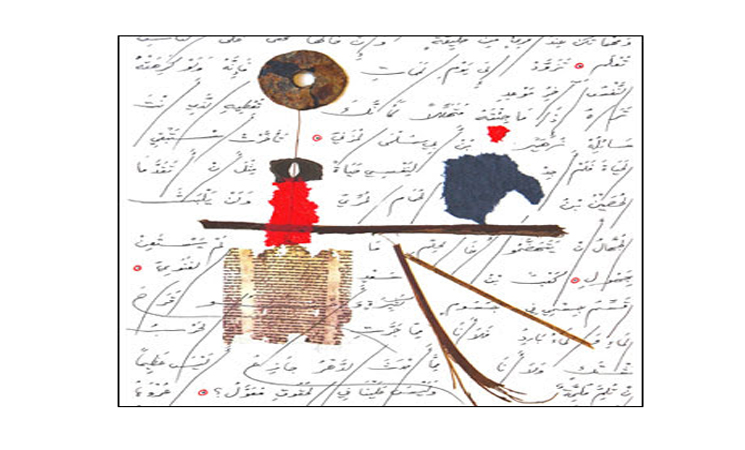(1) الشِّعْرُ وَفَخُّ الْعَادَةِ:
كلّ كتابةٍ شعريةٍ لا تتولّد من الأصل تعدّ لقيطة الهوية والانتماء، فتأتي ذات خِلْقة مشوّهة ومعتلة تجعلها خارج الشعر، لماذا؟ لأن وجودها لم يأت من هباء أو فراغ، أو سقط عنوة من السماء، بل إن وجوده مرتبط بالصلة العميقة والمتينة بينه وبين ما خلّفه الأسلاف من إبداع مُعبّر عن مرحلته ومُجسدللمعرفة القائمة، ولا غرابة في ذلك لأن حقيقة الإبداع الشعري تكمن في القدرة على الاسترفاد والامتداد، وهنا معقل الإشكال وبيت القصيد. إذ لا يعقل أن يكون الشعر أكثر إبداعية وجمالية دون أن يستمد هويته من التراث، ويسعى هو الآخر إلى تثويرها على وفق رؤية جديدة ومخالفة مع ما كان مهيمناً وملبّيا لنداء لحظة الكتابة الشعرية. من هنا نؤكّد ألا وجود لكتابة شعرية جديدة مجرّدة من الماضي، وإنما جوهرها يتمثل في الانتماء إليه دون السقوط في فخّ العادة والسير على هديه، بواسطة النسخ والمسخ.
(2)مِنْ أَجْلِ تَجْسِيرِ الْهُوَّةِ:
إنّ العودة إلى الينابيع الشعرية العربية هي حركة إيجابية تقوم بها الذات الشاعرة للوعي؛ بهذه المياه الجارية والسارية في الوعي الجمعي والحسّ المشترك، لتشكيل الهوية الشعرية. وتغيير هذا المعطى لا يقوم إلا بمحْوالذاكرة والتاريخ وتلك الأصوات الحاضرة بامتداداتها والمؤثّرة في الأفق الشعريّ. ومن تم فكل نكران للماضي إحداث لهوة عميقة تفصل بين الكائن والكينونة، وبالتالي يكون الضياع الوجه الآخر للهوية الشعرية، التي تغدو رهينة هذا المشترك، لأن الجامع بين الشاعر والماضي يكمن في القدرة على الانخراط فيه بوعي جديد، حتى يكون أكثر فاعلية فيما سيأتي من شعر قادم.
ومن الخطايا التي ارتكبها بعض الحداثيين وما بعد الحداثيي،ن في حق التراث، تتمثل في النظر إليه نظرة قدحية نتيجة التأثر السلبي بما حملته الحداثة الغربية من قيم إبداعية توهم المغلوب بقصر هذا التراث وتخلفه وعدم جدواه، متناسين أن الحداثة الغربية انطلقت من الوعي بتراثها من خلال عمليات القراءة الواعية والناقدة، التي مكنته من تجاوزه برؤية لا تحدث القطيعة بقدر ما تفتح النوافذ وتجعلها مشرعة عليه، بل يصلح طاقة للتجديد والابتكار والخرْق والخلق. غياب هذا الوعي لدى الشاعر العربي المعاصر كوّن تصورا يتسم بالنُّقصان والقصور تجاه الينابيع الأولى للشعرية العربية.
(3) التَّحَرُّرُ مِنْ عُقْدَةِ الْمَشْرِقِ:
قد يقول قائل إن الشعر المغربي ماهو إلا استعادة لما تشهده الشعرية العربية المعاصرة من مقترحات في الكتابة الشعرية، نظرا لعمره القصير، إضافة إلى أنه يفتقد لماء الشعر وانسيابيته نظراً لارتباطه بالسلفية الثقافية المهيمنة على الإبداع المغربي. ونعتقد أنه قولٌ مردود عليه، لكون هذا الشعر تحرّر من ثقافة المشرق بعد أن جسّر صلته به لعقودٍ من زمن الشعر العربي، ليؤسس صوته الخاص الذي اعترف به هذا المشرق بعد أن خُفُوت الصوت الإيديولوجي من الخطاب الشعري المعاصر، وتحوّل الشعر المغربي إلى كيانٍ له سماته الجمالية والفنية، وغدا أكثر جرأة في كتابة الشعر المتوهج بالمعرفة الكونية و المرتكز على الوعي التاريخي ودوره في تثوير هذه الكتابة، وجعلها أكثر فيضاً وابتداعاً وقادرة على ابتكار نص شعريّ مخالف ومتمرّد على أصوات المشرق، نص محفوف بخرق الكائن الشعري بغية ممكن شعريّ قادم من جهة الغامض والملتبس، والذاهب صوب تخوم اللانهائي، نصّ مُتخفّفٌ من أثقال الأشكال الثابتة المقيّدة لرغبة الذات في ابتداع عوالم بعيدة عن جلبة العالَم وقريبة من التباس الوجود، وتأسيس رؤية جديدة للأشياء والذاكرةوالإنسان.
(4) أَلْغَامُ الْحَدَاثَةِ وَمَكَائِدُهَا:
إن الشعر المغربي التسعيني شعر مخالفة لا مؤالفة، فهو لا ينتمي إلا لنفسه وذاته وهويته وأسئلته، دون إحداث القطيعة مع الجذور الممتدة في كيانه، مُشكّلاً المسافة التي لا تفقده كينونته المنتمية إلى راهنه الإبداعي بإشكالاتهوقضاياه المتفرّعة سياسياً واجتماعيّاً ومعرفيّاً. شعرٌ يؤمن بالماضي ويكفر بالتّبعية والخضوع إلى عبوديته، يشقّ طريقه من حاضرٍ ملتهب بما يمور به من ارتجاجات وتحوّلات إلى مستقبل في حاجةٍ إلى إضاءة ما يكتنفه من الغموض والالتباس والمتاهات، التي تحمل الشاعر التسعيني إلى ارتياد أفقٍ جديدٍ يستمد امتداده ومقترحاته من التراث لما يشكّله من مستند وجودي وهويّاتي حريٌّ به امتلاكه لمواجهة تحدّيات الكتابة الشعرية المنبثقة من قلق الذات وتشظيها، ومنارتكاسة واقع موسوم بالشرخ العلائقي الناتج عن غياب وعيّ معرفي بالماضي، لأن غياب هذا الوعي يفضي إلى الابتعاد عن الحاضر والارتماء في وهم الحداثة وما بعدها بدعوى الانخراط في العصر واللحظة التاريخية بما تحمله من أبعاد أخرى متعلقة بالذات والواقع والوجود. لذا اختار الشاعر التسعيني أن يكون مخالفاً من خلال خلْقنصٍّ شعريٍّ نابعٍ من جرحه النهريّ الجارف والنابض بطروحاته الذاتية والأنطولوجية. لكن الحداثة وما بعد الحداثة نصبت الفخاخ للشعراء فوقعوا رهائن طروحاتٍ شكلية وأسلوبية ( كالسوريالية والتكعيبية ) لا تتماشى مع طبيعة الثقافة العربية والأنساق الاجتماعية والسياسية والمعرفية المهيمنة، فانزلوا بوعي أو بدونه في محاكاة التصورات والرؤى الغربية المناقضة لبنية القصيدة العربية وللجوانب الموسيقية، حيث الأذن العربية ميّالة إلى الإنشاد، وهنا لا يفهم أننا ضد التحديث والتجديد، والقيام بثورة على بنية السلفية الشعرية، بل ما نودّ تبيانه هو أن الابتكار لا يأتي من خارج الذات، بل ينبغي أن يكون متخلّقا من الرحم الأم، لا عبر أنابيب التقليد الأعمى التي تخلق لنا كيّانا لغويّا معتلّاً وناقص الهوية. إن الحداثة الشعرية لا تنحصر في استيراد حداثة الآخر، وإنّما جدارتها في قدرتها على الإتيان بالجديد والمستحدث انطلاقا من رؤية الشاعر العربي ووعيه بجدوى الكتابة الشعرية الخلّاقة. وعكس هذا هو محض أوهام يعيشها الشعراء العرب المعاصرون وتحدثها حداثة شعرية معطوبة. لذا على الشاعر أخذ الحذر من السقوط في فخاخ الشعرية الغربية بالوعي بما تقترحه من ممكنات شعرية، والعمل على تكييفها مع ما تقدمه الشعرية العربية من إمكانات التحوّل والتغيير.
(5) الشِّعْرُ الْمُخَالِفُ
وَ الْعَمَى النَّقْدِيّ:
غالباً ما ينظر إلى الشعر المفارق نظرة مشوبة بنوع من الحذر والاستخفاف،والرفض نظرا لما يأتي به من فتوحات واختراقات خارج أعراف الشعرية العربية المتوارثة. وهنا لابد من التأكيد أن الشعر المفارق هو امتدادٌ منطقيّ للينابيع الأولى للقصيد العربي، ومن يرى أن منطق القطيعة هو السائد، فإن رؤيته يلتبسها نوع من الغياب والغموض والإبهام، وتشوبها شوائب الفهم والوعي بصيرورة الإبداع، فالإبداع نهر أبديّ الجريان، ومن تمّ التجدّد والتغيّر. لاوجود لحواجز بين الشعر العربي في محاتده وأصوله، وإن وجدت فهذا فيه افتعال وادّعاء لا ينبني على تصور عميق للصلة التي تربط الشعر العربي العمودي بالشعر المفارق. ونقصد بالشعر المفارق الشعر الذي يخلق وجوده من تراكم معرفيّ وإبداعي له بداياته وامتداداته في الماضي والحاضر والمستقبل، ويجدّد جلده بحلّة شعرية لها سماتها ومميزاتها المنبثقة من التجربة الذاتية والتجارب السالفة، شعر لايقول العالم بقدر ما يؤسس لعالمه الخاص والمعبّر عن هوية تختلف عمّا كان قائماً في الشعرية العربية.
شعر يغاير كل الأشكال لصناعة شكلٍ شعريّ يتعامل مع اللغة بوسائل جديدة ، تحدثُ نوعاً من الصدمة لدى المؤمنين بالذائقة المعهودة والمتداولة منذ قرون، إنه الشعر القادم من تلك التخوم المجهولة، والمُشْرَع على أفق مغايرٍ يؤسس شعريةً لا ترتضي الإقامة في أقفاص تحدّ من رغبة الشاعر في التحليق في سماواتِ متحرّرة من قضبان العمود الشعري، وفي طرق جديدة تكتب سيرة التيه والتشظي لذات الشاعر المهووس بانتهاك حرمة اللغة وافتضاض بكرتها؛ بغية إبداع نص شعريّ له إيقاعاته وهويته النابعة من صلبه، والقادرة على امتصاص الينابيع الأولى بأسلوبٍ مستحدَث يعبّر عن تلك العوالم المتخيّلة والممزوجة بهواجس الذات وانفعالاتها في سياق علاقتها بذاتها وبالعالَم، ملبّية نداء الأقاصي والمتاهات والتخوم البعيدة.
فإذا كان النقد، في محتده ووظيفته، فتح حوار مع النص الإبداعي بغاية الفهم والتحليل قراءة وتفسيرا وتشريحاً، للكشف عمّا يخفيه من أبعاد فنية وجمالية، ومن تمّ فالممارسة النقدية فعلٌ قرائي لايقف عند هامش النص الإبداعي، بقدر ما يبحر في لججه اللغوية وكوامنه العميقة، فإن الشعر التسعيني تعرّض لجوْرٍ نقديّ، حيث يعيش غبناً قرائيّا على المستوى النقديّ، فلا وجود لنقد شعريّ منشغل بالخطاب الشعري التسعيني وما يحفل به من سمات وجماليات تختلف باختلاف السياق والتحولات، فظل يتيماً محصوراً في قراءات قليلة يغلب عليها الطابع السطحي والمتسرّع، مما أفقدها العمق التحليلي والتشريح الذي بإمكانه الكشف عن غنى خطابه المخالف والمختلف.
(6) الشِّعْرُ التِّسْعِينِي وَمَتَاهَاتُ الْمَجْهُولِ:
الشعر التسعيني خارج الشهادة والكتابة داخل المغايرة، داخل الماضي وخارجه، لا يعترف بالوصاية، متحرّرٌ من قوانين الكهف ومقتحمٌ لمتاهات المجهول، منتسب إلى الهاوية لا إلىالهوية، حيث النزول إلى تلك العتمات الباطنية، التي تحقّق له وجوده الإبداليّ، وتمنحه الإقامة في التخوم قرباناً لكتابة شعرية لا تفصح عمّا تريد إلا بعد مجاهدة ومكابدة، إلا بالعصيان على كل الثوابت النصية القائمة، إلا بالنزوح صوب العزلة، خيمة الملاعين والمترعين بأناشيد الفجاج ومسارب الذاهبين إلى الغياب، ومقامات مشعةٌ بنبيذِ الصّحو والانفراد بسعة العاَلم، وهو في أضيق من خُرْم الإبرة، فالشاعر التسعيني منفرد في ميتافيزيقيته وغياباته وجبّته التي يلبسها نكاية ضدّ الجموع والجلبة. لأن الشعر يأتي من تلك الينابيع الواعدة بالآتي، والغامضة طريقها نحو البعيد القصي، ومن تلك المناطق المجهولة والمتوارية خلف اللاوعي والإدراك، على اعتبار أنه (الشعر) ذاك القبس اللامع المتوهج، أو لنقل ذاك اللهب المشعّ المضيء للدهاليز الخفية من الوجود والموجود، الماء المتحوّل المتغيّر، الذي لا يكفّ عن حفْر مجاريه ومسالكه الدائمة التجدّد والتعدّد. الشعر يلبس لبوسات منسوجة بأساليب وأشكال خارج القواعد والقوالب، بعبارة أخرى الشعر لا تحدّده الأشكال والطرائق، بقدر ما يؤسس وجوده الشكلي مما يصنعه من اللغة وباللغة دون أن نغفل الرؤية والرؤيا المنبثقتين من التجربة والمراس والدربة، من المكابدة والمجاهدة. لهذا يظل الشعر غير قابل لأي تحديد أو تعريف، فهو خارج التعاريف، وبه تكتمل اللغة باجتراح أفق كتابيّ منبته الذات في صلة جدلية مع العالَم. ودائم التجدّد والولادة، هو ضد الجاهز مقولا وشكلاً، ميزته الاختراق والخرْق، رهاناته اللايقين ومصيره البحث الأبدي عن هذا الغامض. والتجرّد من اليقينيات والسرديات الكبرى، هو منذور للشكوك والتخوم المحيّرة، لا يقول الحقيقة بقدر ما يثير السؤال والتباساته، مغالقه وارتجاجاته، لذا يعشق التوهّج بدل الأفول، وينوجد بين الجمر والرماد، بين الضوء والعتمة، بين الريب واليقين، بين السؤال والجواب، فهذه البينية تجعل الشعر أكثر قدرة على الإقامة المتاهة التي تقود إلى متاهات أكثر متاهة. ويبقى الشعر في اللانهاية ما يحطمه خدّام المستقبل.
(تخرج النار من رمادها / تأتي اللغة من لهبٍ مجهول/ تقول العالَم بلسان آخر/ وتمضي في اتجاه النهر / خرق هنا / وخلق هناك / وما بينهما تخوم ترتب للنار / وهج الخلود…)
(7) رِهَانَاتُ الشِّعْر:
اللازمنية و اللا امتداد:
الشّعر نقيض الآنية (اللحظة)، في اللحظة ينتبذ الغياب، ويهجر الحضور، لأن الآنية عابرة وفانية، بينما الشعر أثر أبدي لا تنقضي إبراقاته وبروقه، إشعاعاته واشتعاله، وبحث لا يتوقف عن كل ما يحوّل الآنية إلى أبدية / ديمومة بمجرّد ما تتخلص من رتابة الماضي وسأم الحاضر، بتعبير آخر من التاريخ والوقائع، فهو يضفي على اللحظة بعدا آخر يتجلى في تصييرها أمدا لا محدودا، الأمر الذي يقود إلى القول إنّ الشعر الخامد لا يعلي من شأن الآنية وإنما يفكر في المستقبل، فرهان الشعر رهان مستقبلي لا يرتبط بالزمن في ثبوتيته، بل في امتداداته التي تتجاوزه إلى زمن آخر خارج الثبات والجمود، بل زمن ينفلت من راهنيته ويخترق أبدية المكان والزمان، مشكّلا وجوده المنسلخ من عدمية اللحظة.
والشعر الحقيقيّ يقتله الشكل ويخمد طاقته ويشلّ استمراريته، فحياته خارج الشكل داخل التعددية والاختلاف من حيث القوالب والأساليب، ففي نبضه المفاجئ تكمن سيرته الأولى، وأبجديته الأصل التي تتخلق منها اللغة المربكة والمحبوكة على نول الدهشة والفتنة، واللامقنّن. فهو الفوضى الخلاقة التي تنظم أشياء العالَم كائناته، وتخوض في مغالق الكون وهي في أمس الحاجة لأن تكتشف من جديد، محاولا القبض عليها. والسبب في ذلك يعود إلى أن الشعر في صنعته الأولى لم يفكر في ماهية القواعد، بقدر ما أسس وجوده اللغوي دون التفكير في ذلك، وهذا ما أكسبه الاستمرارية والتجدّد الدائم.
(هكذا تولد اللغة من رحم الغامض/ تسري في دم المجاز نهرا جامح العبور / فتنبت الخيالات الجذلى / ويأتي المجهول في التباس الرؤيا…)
(8) الشِّعْرُ مِنَ الْحِسِّيّ
إِلَى الْحَدْسِيّ:
الشعر يختار الطرق البِكر، لاكتشاف مسارب أخرى بحثا عن لغة تقود الشاعر إلى جغرافيات مجهولة، تعكس رغبة الذات في جعل العالَم أكثر حيوية وحياة، أكثر إرباكا للحواس وأكثر تحفيزا للحدوس، من الحس إلى الحدس تقطع الذات رحلة شاقّة ومضنية بغاية الانتقال من الملموس إلى المجرد، والارتقاء بها من الواقع إلى الخيال، وهنا مكمن المغامرة التي يخوضها الشاعر لترتيب دواخله المنفعلة والعميقة في الحيرة والدّهشة، فهذه الرحلة بواسطتها يغدو الوجود متغيّرا ومغايرا لما هو كائن وابتداعا لممكن به نعثرُ على كينونتنا وقد بلغت أسمى مراحل الالتحام والتماهي مع عوالمها الممكنة.
هكذا كان الشاعر، منذ النبع الأول، ميّالا أن يكون ذاته ووجوده باللغة، لتجسيد الحياة والبحث عما يزيدُ عطش السؤال وحِدّة القلقفي فناءٍ يبتلع شعوره وإحساسه، ويفقده الرغبة في اقتحام الحياة بما يمتلك من قوة التحدي والمغامرة، فكان الشعر الوسيلة الأولى لتجاوز اللعنة والسأم، وما فخ الحب إلا حالة من حالات الانخطاف والانتشاء وفرار من الحسية إلى الحدسية، وهنا مكمن الغبطة الأبدية التي تدخل الشاعر في الحضور الواعي.
(لست نبيا/ أنا حارس الضوء/ أرعى اشتعال المدى / وأقود شياه الاستعارة/ إلى حيث لا أدري/تتبعني العصافير
تلعنني الأرض/ وأمضي إلى جهلي…)
(9) من أجل شعرية مفتوحة
الشعر لا يسمي، بل يجعل الأشياء تنطق بوجودها، ويشيد العالم باللغة دون جهر وبالتباس شديد
الشعر التسعيني لا يلتزم بالقواعد والقوانين، ولا يلتفت إلى الخارج، وإنما يذهب بعيدا إلى تلك النداءات الخفية في كهوف الذات والكون، لانتشالها من العدم وإخراجها إلى الوجود، حيث اللغة تتجاوز ظاهر الأشياء إلى باطنها، لإضاءة المخفي من العالم، لذا يجيء غريبا، مدهشا، نابضا بالغموض، سري، عجائبي، لكونه يسافر في الأقاصي الغابرة، للخلاص من الظاهر المبتذل والعابر والالتحام مع الهاوية المفضية إلى كشف هشاشة الكائن المطوق بلعنة الاغتراب، والمقيم في مقامات العزلة، حيث الرؤية تكون أكثر حدساً وعمقاً، هذا الحدس والعمق لا يتحققان إلا بالشعر المعبّر عن تجربة وجودية تمزج الحياتي بالفكري، وتؤسس أفقاً شعرياً يخلق علاقات جديدة بين الوجود والموجود. هذه التجربة تقترن بالتحرّر والممارسة لكونهما من مقومات الشعر التسعيني، إذ لم يبق مشدوداً إلى الماضي، خاضعاً له، محتذياً إيّاه في رؤاه وتصوره، بل متمرّداً وآخذاً المسافة الممكنة، واعيلً بالحاضر بعد تجسير الصلة بهذا التراث، باحثا عن شعر منفصل عن المرجع ومنفتح على المستقبل.
(أيتها اللغة الأخرى/ اجرحي الأرض بالحدائق/ ودعي الحرائق تنبش ذاكرة الهشيم…/غريبا كنت/ أهش على عتمتي/ بضوء الرماد/ وأرتضي نداء اللعنات…)