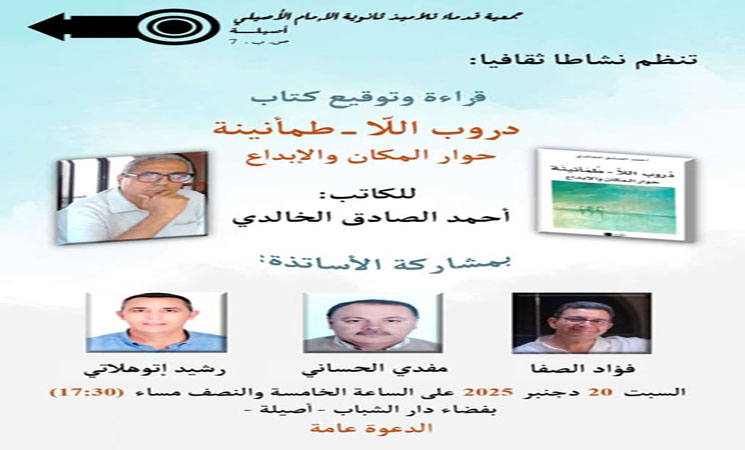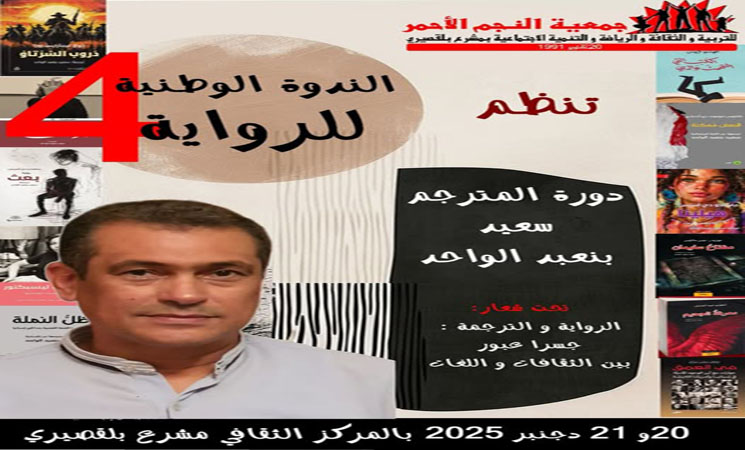1 ـ أدرك من البداية أن عنوان هذه المقالة لا يخلو من زعم ومجازفة، فالموضوع كبير والحديث فيه ذو شجون، ولأن تفكيك العنوان المقترح، وبسط مناحيه ومنازعه المختلفة، من اختصاص جماعي لا فردي، ولأن البُدَّ صعب فالموضوع ذاتُه قيد صيرورة وتبلور، نحسب جميعا أننا متفقون على أن قضية الحداثة، والتحديث قبلها، ما زالتا، وفي خريطة الأدب العربي كله، مندرجةً، أولًا، في سياق التأريخ ومسار التأسيس، وثانيًا، في مخاض التكوّن والمساءلة الاختبارية أكثر من تلك المؤسسة بحسم. لا يشفع في ذلك تراكم وجودٍ نصِّي لم نحسم بعد في قيمته، ولا أفراط الكم يعدّ مقياسًا في ميدانه، هو وتدافع بالمناكب، ولا حاجة للغط الأصوات، فالشعر كينونة الوجدان، وسكينة المتبتل في نار هواه، وهمس السريرة، وهو عملية بناء لغوي بلاغي تركيبي خطيرة من حيث تطلعها لصنع إبدالات للقول والخيال والموسيقى، فوق أبنية لتكسب رهان التعبير عن مشاعر وأحلام وقدرات في أزمنة مختلفة.
2ـ الهدف، إذن، كذلك، يقع في حدود محاولة تقديم صورة تقريبية عن مدوّنة شعرية في القسم الغربي من العالم العربي، يشترك مع القسم المشرقي في الأرومة، والعقيدة، واللغة، والثقافة الجامعة بين مكونات التراث، والنتاج الفكري والأدبي زيادة على معطيات وتحديات الزمن الحديث، طرف منها أجنبي، ثم مطامح النهضة والتقدم والتجديد. ونجده بالتحديد يشترك بكيفية عضوية في صنع النص الشعري المختلف منذ نهاية أربعينات القرن الماضي، كان للقطرين السوري والعراقي قصب السبق فيه. ليست الصورة الماثلة ما نبتغي، بل إلى جانبها وبموازاتها، تعيين الخصائص الممثلة للتجربة في مظاهر بنائها، وتمثيلها البلاغي، ورؤاها، ومصادر اهتمامها، بما يحدد بعض خصوصيتها، لأنها في صيرورة متواصلة.
3 ـ لن نقتفيَ بدقة خطى التاريخ، ولنقل مباشرة بأن تجربتنا نحن في المغرب، في القول الشعري الحديث، أحسب من جهة الأجناس الأدبية الحديثة كلها، الغلبة فيه للاتصال والتأثر بالمشرق العربي،لا عجب أن العراق ثم بلاد الشام، يتقدمان في هذا التلقيح فيهما تعلم اثنان من كبار أعلام الشعر المغربي، اللذين يعود إليهما التأسيس الناضج، والتشخيص التحديثي لما سُمّي في البداية بقصيدة التفعيلة، نهضت على التراث التليد للقصيدة العمودية: نعني محمد السرغيني، خريج جامعة بغداد (نهاية الخمسينات)، وأحمد المجاطي، (1936ـ1995) خريج جامعة دمشق (مطلع الستينات). إلى هذا الأخير بالذات، وبإجماع الدارسين، يُعزى تأسيسُ خصائص القول الشعري الحديث بأدب المغرب، حتى عُدّ في حياته، وقبل مماته (إمامًا) للشعراء، وشعره عيارًا يقيسون به قاماتهم، بعده تكاثر الشعر وتنازعوا الألقاب. لا عجب أن هذين العلمين هما من أدخل درس الشعر الحديث إلى الجامعة المغربية زمن فتوّتها، وعلى يديهما تتلمذ أغلب شعرائنا المحدثين، بدءًا من منتصف السبعينات، ومن الطريف أن يصبح نتاجُهما ملتقى شدٍّ وجذبٍ بين تجاربَ شتى، ومنعطفَ التحول الذي قاد من قصيدة التفعيلة، إلى ما بات يصطلح عليه قصيدة النثر، بحقٍّ حينًا، وباطل، أحيانًا أخرى.
4ـ ألقت المرحلة التأسيسية التي شهدت ميلاد الشعر الحديث في المشرق العربي بظلالها الفكرية والفنية بشكل متفاوت، على هذه التجربة التي حرص فيها روادُها والجيل الثاني الرديف على الارتباط بقضايا الهوية والتحرر، وبالانتماء والإيمان بقيَمٍ خلقية واجتماعية كانت في صلب شعارات ملائمة للمرحلة؛ قِيَمٌ زرعت في حقل الأدب والفكر عامةً قضيةَ فلسطين، ومعاركَ التحرر والبناء في أرجاء الوطن العربي، والعالم الثالث، كافّة. اتّسمت بالتمرد والتطلع لبناء غد ناهض، وقد تخلصت الأمة من النّير الأول للاستعمار، وسعت لتأسيس شخصية تنزع لتصفية رواسب ماضٍ جامد، والاقترانِ بأفق بنّاء لهذه الشخصية بمحتوى حاضر متغيّر، تجاوبت فيه أفعال وأحلام النضال الوطني والقومي. هذا ما عكسته بين أمانةٍ وذاتية قصائد المجّاطي، والسرغيني، ومحمد الطبال، والخمّار الكنوني، وتبدّت آثارُها في القصيدة المغربية الحديثة، على أصعدة التركيب، والمعجم، والإيقاع، والدلالة، وكلّ مكونات النص الشعري. لقد مثلت متون هؤلاء، ومن سار على هدْيهم ونهجهم، تعبيرًا إبداعيًّا ووجدانيًا خاضته فئاتٌ شعبيةٌ حيّةٌ على أكثر من واجهة، في زمن التسلط والحكم المطلق. على أن المدَّ الثوريَّ الجامحَ المشوبَ بنزعة رومانسية ومثالية طافحة، أحيانًا، لم يُفض إلى الأهداف التي سكنت أحلام الشعراء، تأجّجت صورًا ملتهبة في استعاراتهم. من هنا الإحباط الذي غشي التجربة الشعرية أو تسرّب إليها، وهو الذي صبغ مدوّنتَها في العقدين السادس والسابع بصبغة غلب عليها التشاؤم والألم والشكوى، وإن لم تخل من بصيص أمل.
5 ـ يقينًا، وقد انطوى زمن على هذه التجربة في المرحلة الموصوفة، وبغناها وتميُّزها، على كل حال، هي في حاجة إلى مراجعة تقرأ دوالّها الفنية، وحجمَ موقعها في القصيدة العربية، وما امتلكته من مدلولات وأبعاد، وقد تولت هذا بعض الدراسات الجامعية بكيفية تأريخية، وتقريرية، وواصفة، ولا تستطيع أن تتجاوز هذه المقاربة، فالأدب يحتاج إلى تباعد زمني كي تكتمل تجربتُه وترسخ بعمق، وليُقرأ متنًا ناضجًا بروافدَ ومشاربَ متعددة مكتملة، وهذا متعذرٌ بالنسبة لأدب حديث فتيّ، من المبالغة الإفراط في تقديره وتصنيفه من جميع الوجوه. وإذن، وإذ نسعى لتعيين ما لابد يساعد على القراءة والفهم للتجربة الشعرية المغربية الحديثة، نتمسك بنسبيّتها ووجودها في مرحلة التأسيس، والبحث الفردي المتعلم، بعضٌ منه خلاّق
6ـ لقد بُنيَ النصُّ الشعريُّ الحديثُ في أدبنا المغربي بناءً تدريجيًّا، وتوليفيًّا، وتركيبيًّا تفاعليًّا، لاحقًا تابعًا لسابق، ناسخًا لمثال، شأنَ جميع أشكال أدبنا الحديث، القصة القصيرة، والرواية أهمه. بمعنى أنه تخلّق من النموذج الكلاسيكي، بعَروضه وموسيقاه، وبمعجمه، وبلاغته، وكذلك بأغراضه، وسجلاته المتواترة، لينتقل إلى قصيدٍ طفق يتخفّف من سُنن النموذج، من غير أن يطلّقها، يتجه فيه الشاعر إلى التقاط مظاهر محيطه، ومنها يصنع مواضيعه، ويصوغ صورَه، وهو في ذلك يتجاوب مع ما نحتته، مثلا، تجربة مدرسة الديوان في مصر، كما له نظائر في غير قطر عربي المغرب منه (مثال محمد بن ابراهيم). في الخمسينات وما تلاها مباشرة، وفي شمال المغرب، خاصة، كان يرزح تحت نير الاحتلال الإسباني، خلافًا لوسط المملكة وجنوبها خضعا للاستعمار الفرنسي. في المنطقة الشمالية تحديدًا تهيأت الظروف وأسباب لتواصل أكبر مع البلاد العربية، في شكل بعثات وجلب منشورات، بين كتب ومجلات. من يطّلع على مجلة «الأنيس» وحدها، سيقف على أولى قصائد الشعر المرسل، لم يُسمَّ يومئذ بالشعر الحر، ويتنسّم مبكّرًا بملًمَح التأثر بالموجة الرومانسية، العربية والإسبانية معًا، بصفة خاصة أريجَ مدرسة المهجر، علاوة على النفحات الجبرانية، التي عُدّ محمد الصباغ علَمًا عليها، فيما كان محمد السرغيني، وقبل أن يرحل للدراسة إلى بغداد، قد أشرع أبوابها. هذه مدرسةٌ مهاد يقرأها بعض دارسي شعرنا الحديث كأنها منقطعة عن تحديثه والحال أنها مؤسِّسة، ربما لنشوئها في شمال المغرب، بعيدًا عن مركزية أدبية لاحقة.
7ـ يمكن بعد هذا التماس النصوص الأقرب إلى ما اعتَمد شعر التفعيلة نظامًا شعريًا، واتجه قصدًا وبوعي إلى الانسلاخ عن النموذج الكلاسيكي، بدءًا من مطلع الستينات، في محاولات متواضعة، لكنها مشبعةٌ بروح زمنِها وثقافته. لا شك تتميز بتقليدها لسابقات عليها، وهنا نحسم بالقول إن هذا التحولَ مصدرُه المقروءُ مما تغيّر في إهاب الشعر العربي في المشرق، نفسه الذي كان يتعثر،أو يتأسّس، وهو يواجه بعد في حُمّى جِدّته، وانتفاضته التحديثية سطوةَ الشعر العربي الموروث، وواقع تحت هيمنة ذائقته. لم يكن انفكاكًا منفصلًا عمّا كنا نعيشه على المستويات كافة، الأدبي بأنواعه والسيّاسي الإيديولوجي في قلبه، والثقافي التربوي. بَيْد أن السياسيّ تمثلَ الأقوى، والثقافيُّ في ركابه، لذلك عاش الشعرُ إما مواكبً للتغيير أو على هامش، وإن احتفى به ظل عليه، منفعلًا، ومصورًا، ومنشدًا. وإذ أخذ الشعراء ينتقلون إلى الشطر الواحد والتفعيلة، يتمرنون أكثر مما يجيدون، راحوا يصبّون أحاسيسهم في القالب الغنائي المنسجم أفضلَ مع نزعة التمرد ونُصرة المطالب الشعبية، دون أن يصطدموا مع الجيل السابق، الذي واصل شعراؤه عموديتهم، والغرضية في المناسبات الوطنية والدينية.
8ـ وإذن، فالشعر العربي الحديث في المغرب، ارتبط في ظهوره، وتبلوره، أولًا، بالوقوع في دائرة التأثير المشرقية، بوجود تفاوت مع هذه الجاذبية، ثانيًّا، في ارتباطه بحركة الاحتجاج والمطالبة الوطنية عامة، ثم التقدمية اليسارية، عقب الحركة الوطنية الاستقلالية، المتّصلَين بسياق تعلُّمٍ وتأثرٍ ممتدّين ومتسلسليْن، حملا إلى المشهد الأدبي، ثالثًا، شعرًا بدا للوهلة الأولى هجينًا، مستهجنا، شاذًّا عن الذائقة، بعيدًا عن تلقٍّ تربّت عليه الأجيال، ورابعًا، وهذا ذو أهمية بالغة، فإن ما وُضع من الشعر جاء قولَا حزينَا، جريحًا، لسانَ حال ذوات، حتى وهو يتحدث أو يزعم الصدور عن الجموع. لنقل إن التعبيرَ الشعريَّ هنا جمع بين انشغالَين، ففيما كان مطلوبًا من الشاعر التغني، بنقل الهمّ الجمعي، كما هو التقليد العربي، راح يبثّ أشجانَه إمّا ضمنها أو عزفًا منفردًا، لذلك لم تكن هناك رومانسيةٌ خالصة، ولا واقعية ثابتة، تقرأ صورة الوطن تتماهى بدرجات، كثيرًا أو قليلًا، مع صورة المحبوب، والنبرة الغنائية الحماسية، صدّاحةً ومشبوبةً تواتي وجدانًا هو واحد يتضامُّ ويتضامن لا يكتمل إلا حين يتعدّى إلى نصفه الثاني، ولكل طرف نسغُه وصوتُه وشكلُه وبلاغتُه في التعبير الشعري. يرجع سبب هذا، أيضًا، إلى تشتت مصادر الكتابة الشعرية، وعدم انتظامها، ومحاولة حرق المراحل؛ ظاهرة ستمتد في الأطوار اللاّحقة في الأدب المغربي الحديث بمجمله، لا الشعر وحده، تتجاور فيه التجارب، وتتداخل بغير اتّساق، لا يكفي فيه التمييز بالفصل الجيلي المتعسف، شاع شططًا.
9ـ تمثل السبعينات وما تلاها الانتقال إلى حقبة الريادة الناضجة في شعرنا الحديث، أمكن فيها، وبتفاوت بين أعلامها الكبار، مواصلة التعلم عبر قراءةٍ مواكبةٍ ما أمكن، وتشبع بالمتن الوافد من المشرق، منطبعٍ بسمات وشواغل محيطه القطري القومي فكريًّا وإيديولوجيًّا، وهذا هو السيّاق الكبير، يتعرف عليه شعراء ناشؤون، وقراءٌ طلاب فضوليون شغوفون بالتحديث بمفردهم وبتوجيه محدود جدًا، فلم تكن الجامعة المغربية الوليدة تُدرِّسه ولا تعنى به، برنامجُها الأدب العربيّ الكلاسيكي صرفًا مع جزئيات تسمى الفنون الأدبية الحديثة، ورغم هذا ظهرت إرهاصات جرّيئة لنصوص أفراد تُعدُّ كلية الآداب في فاس، من نهاية الستينات وامتدًادًا في السبعينات، مشتلًا حقيقيًا لها أعطت ثمارًا يانعة لجيل شاب نذكر منه محمد عنيبة الحمري، محمد بنيس، ومحمد بن طلحة، عبد الله راجع ، تحمل تجربتُهم ميسمَ الخصوصية. كلٌّ على حدة. والحقيقة، يصعب، إن لم يتعذر، تمييز أين تنتهي سمات المحدَثين في المشرق، وأين يبدأ ما هو ألصق بالمغاربة، اللهم من حيث عناوين، وإشارات، ومرجعيات محدودة، فيما العلامات الفنية، نظام القصيدة، وموسيقاها، وملفوظُها اللغوي، وتركيبها البلاغي، ورؤيتُها الذاتية الجمعية، تبقى شبه متماثلة، وأسماء السياب والبياتي، وصلاح عبد الصبور، وأحمد عبد المعطي حجازي، ونزار قباني، وخليل حاوي، وهم المشتهرون في المرحلة، لا أدونيس، أو أنسي الحاج بتاتًا، كانت متداولة ونصوصهم مقروءة جيدا، فضلا عن أن هناك محيطًا ثقافيًّا وقوميًّا عربيًّا كان سائدًا آنئذ، وهو ما طبع شعر حقبة كاملة. ذكرنا أن محمد السرغيني وأحمد المجاطي، هما العلمان البارزان لهذه المرحلة، والمجاطي خصوصًا، مثّل ما يشبه الإعجاز سواءً لمجايليه، أو من التحق به، وهم في الحقيقة قلة، الأخصّ بالذكر محمد الخمار الكنوني، ومحمد الطبال، ليلتحق بهم محمد بن طلحة، وغيرهم إما يدورون في فلك هؤلاء أو يقلدون ويتمرنون متنقلين متعثرين بين العمودي والتفعيلي والنثري، أيضًا .
10ـ لا عجب، فالشعر قليل، وسيبقى كذلك في أدبنا، والجيّد الصحيح منه نادر، تشهد على هذا الملاحق الثقافية للسبعينات ـ(«العلم الثقافي» جريدة العلم) و(«المحرر الثقافي» جريدة المحرر»)، ومجلات مثل «أقلام» و»الثقافة الجديدة»ـ الشعراء فيها أقلّ من عدد أصابع اليد، وأضيف إليهم القصاصين. لم يكن الشعر مستسهلًا مبذولًا كألفاظ الجاحظ على الطريق، أكاد أقول شبه مبتذل وذائع بلا رقيب. والحاصل، ستواصل التجربة الشعرية المغربية الحديثة تدريبها وتمرّسها بقصيدة التفعيلة وقد أصبحت الدواوين المشرقية متوفرة، ونصوصُها تُدرّس نسبيًّا إلى أن تظهر موجة قصيدة النثر، وتتكاثر أقلامًا، لا إبداعًا، أي منذ عقدين على الأقل، سينتقل الشعر إلى وضع آخر، أحسب أنه الحال في الآداب العربية جميعها. إنما قبل ذلك فقد تهيأ لقصيدة التفعيلة أن تستقر، وهي تتحول إلى النموذج الشعري السائد كتابةً ونشرًا وليس انتشارًا بالضرورة، أعني قابلية التلقي ومداه، فما زال هذا الجانب مضطربًا، وملتبسًا، وهو ما طرح في إبّانه. وما يزال مطروحًا سؤال النص الشعري المجنّس قصيدة نثر، في غربتها عن الذائقة الشعرية المتوارثة، والسائدة ،عموما عن شروط تلقّي نص بسُنن معروفة؛ ذائقة مرتبطة في جانب كبير منها بالتعليم، والمقررات المدرسية، ومستوى الشعر، وبالطبع بوتيرة تغيّر الذوق الأدبي. المؤكد أن تجربة التحديث الشعري وقفت على قدميها، بأمثلة مفحمة فنيًّا، ومعبّرة عن حساسية زمانها، ومفهومها بمحاولة جادة لتأصيل التحديث ب» التحرر» من الموروث وافتراض إيقاع، وتوليدِ لغة غير مسكوكة، وبموهبة وثقافة مطلوبتين
11 ـ في المقطع الأخير من هذه المقالة، نذهب إلى المباشر في العنوان: مسألة التحديث، فضّلناها على ما يُتداول شعارًا فضفاضًا معناه أجوف، ولا تاريخي، ولا نسقي، ولمّا نبلُغه. ثم إن هناك حداثات لا واحدة، والتالية لا تنسخ الأولى، تعززها، ويُفترض أن نؤمن بأهمية التراكم «الحداثي» في ثقافتنا العربية، التي لم تستقر نهائيّا في هذا المشروع وتعيش شعوبُها الفصام بين عيشها وتفكيرها. على كل لن نختلف في أن قصيدة النثر، أو باسمها منشورة، وإما يُقرأ في الملتقيات والمجالس الخاصة، ليس السائد بالضرورة، هي أغلب بضاعة الشعر عندنا، ومرتبطة بالتسليع وغيره، لنذكر أن الرواية ازدهرت في الغرب، مثلا، منتصف القرن التاسع عشر لعوامل موضوعية. لنتذكر كذلك أن قصيدة النثر ليست جديدة عندنا، وروادُها العرب يقبعون في نهاية الخمسينات (مجلة شعر) منهم أدونيس، الذي روّج لشعره لمّا كان غنائيًّا، تفعيليًّا، وحتى عموديًّا، معانقًا مهيار الدمشقي قبل الانضمام إلى مدرسة» شعر» ليوسف الخال. هذا اللون وُجد في بيئتنا الأدبية، في الخمسينات، في نصوص محمد الصباغ، المتأثر جدًّا بالأدب الإسباني لمعرفته به، وبصداقاته مع أدباء من لبنان والمهجر. لكن العبرة بالظاهرة، أي تحوّل الاستثناء إلى قاعدة، أو ما يشبهها. هذا النص المعيّن بالنثري، يبدو مفتوحًا لكل التجارب، متباينة الأسلوب وفهم الشعر. أصوات فردية، أرخبيلية، أكثر منها متحاورةٌ بخصائص مشتركة، لن يفوت قارئها أن يلاحظ استغراق أغلبها في هموم ذاتوية، وطابعها التجريدي، وغواية معجم يكتب الشعر لا الشاعر من يكتبه، من هنا التشابه والتكرار في النصوص، أضف استلهامها لرموز ومصادر ثقافية أجنبية، وغياب الدوال المشخِّصة لبيئة وجغرافية محلية، وثقافة وطنية خصوصية، خلافًا لشعر مراحل سبقتها تجد فيها نكهةَ بيئتها وبصمات لحياة وطبيعة، وانتسابًا لواقع بأسماء وأماكن ورائحة ولون، باختصار شعرًا ينتمي لزمان ومكان.
12ـ حين يقدّم سؤال الحداثة خاطئًا، مشوّهًا، وضحلًا، منفصلًا عن تاريخ الأفكار، وسياقات النشأة والتبلور الثقافية والحضارية، ولأننا لا نحب أن نثقل كاهل المدوّنة المغربية بما لا تتحمل، يُعلن بطريقة شعارية تقصد تقديم النص المقمّط جيليًّا بوصفه إبدالًا لغيره، لاغيًا له، وبوصفه وحده يجسّد براديغم الحداثة، أي ما عداه نقيض لها، وباعتباره مُنبَتَّ الصلة، مجّانيًّا كلغته وصوره، بأي واقع، وأي مرجعية، معلقًا في الفراغ أو الهواء. وإذا كانت الحداثة منظومةً من المفاهيم، والمتعاليات، والأنساق، والوقائع والتطورات التاريخية الحتمية والجدلية، وتتقدم كصيرورة تحولات متعددة البُنى، متنوعةَ الأشكال والتعبيرات، الشعرُ ضمنها، تقوم بينها روابط عضوية، أي ليست جزُرًا منفصلة؛ فإنها تؤمن بالتعدد وقابلية التأويل، بل هي التأويل الذي يبدأ من إعادة القراءة، لا المُفضية إلى الهدم وإعادة التفكيك وحدهما، بل للانتقال منهما إلى بناء جديد، وهو قديم، وهذا من معنى التاريخانية، وهي حداثة عقلانية، لأن ليبرالية الاقتصاد المفتوح أو المتوحش، لا تكفي لصنع الحداثة، كما تطليق الوزن، وهجر التفعيلة، ونبذ موسيقى الشعر والقول بالإيقاع الداخلي(كذا)، وتهجين الاستعارة على أيّ نحو؛ هذا لا يكفي ولا يؤدي بالضرورة إلى بناء القصيدة، التي عبرها يطرح اليوم السؤال المعني،على الوجه المنتج للشعر، حتى وهو في إهاب النثر، ففي الثقافة الأدبية الكلاسيكية كان كلام العرب، بمصطلح القدماء، يُبنى على نظامين: المنظوم والمنثور، وينقسم إلى جنسين كبيرين الشعر بأنواع صغرى وفروع، والنثر كذلك، وبالرغم من كل مزاعم القطيعة، فالمرجعية الأم لمعايير ونسق الشعر العربي الكلاسيكي حاضرة وكامنة، والمصطلحات البانية تحيل إلى تصانيف دراسته، وبنوع من الشك والتجاذب بين التأثيرات، مشرقية غربية، يبحث النص عن شرعيته في مدوّنات أجنبية لها تاريخها الأدبي الخاص، وجعل سوزان برنار صاحبة أول أطروحة جامعية بعنوان» قصيدة النثر من بودلير إلى يومنا»(1059) بديلًا لأبي هلال العسكري ( ولد ب بعد 395 ه) قبلة الدارسين، كأن العربية لم تنجب قبلها فهمًا للشعر البتّة.
13ـ أتساءل في الختام لماذا لا تنتج الشعرية العربية المعاصرة أو ما في شكلها وبمعناها، تسميةً جديدةً واصطلاحيةً نوعية تناسب التعبيرات التي تنضوي شرعيًّا وعسفًا في آن، في تجنيس الشعر، وبدون أن ترسم لها سياجات وحدودًا نهائية تحتاج إلى مصطلحية نقدية ومعجمية للتلقي والتقويم إذا كانت تريد الحفاظ على وجودها في النظام الضروري والنسقي للأدب، وتبعد عن ترابها الأعشاب الضّارة التي تغزوها باسم حرية مزعومة للإبداع وانفتاح الأجناس على بعضها وتنظيرات على قشرة كتابات لا تنتسب إلى شيء، والأدب نَسَب؛ بعد هذا فإن مفهوم وتجربة وبرنامج التحديث في شعر المغرب، بل في مجموع إنتاجه الأدبي والفكري يمكن أن يوصف راهنًا بأنه مختبر تجارب، تأصيلي وتحديثي وتجريبي، كان له رواد أحمد المجّاطي في صدارتهم، وأمامه طريق طويل، فالحداثة فعل تحول شمولي لا يتجزأ.
تجربة التحديث في الشعر المغربي الحديث
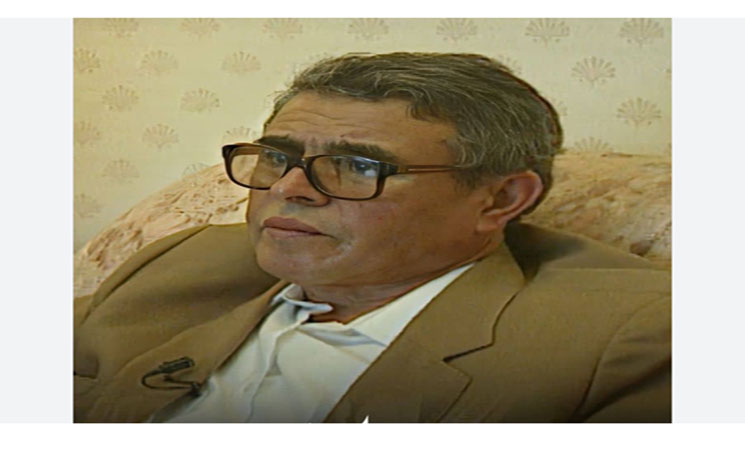
الكاتب : أحمد المديني
بتاريخ : 03/10/2025