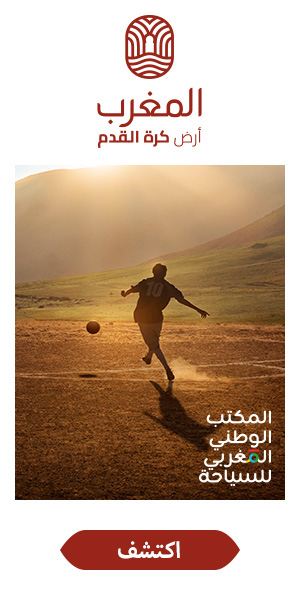التنظيم أم الهيمنة؟ قراءة دستورية ومقارنة دولية في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بالمغرب: بين استقلالية مفرغة وصلاحيات زجرية مقنّعة
في يوليو 2025 صادق مجلس النواب في قراءته الأولى على مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بعدما أثار هذا المشروع أسئلة جوهرية حول مدى احترامه للدستور المغربي والتزاماته الدولية فيما يخص حرية الصحافة والتعبير والتنظيم المهني. في هذه الورقة سنقدم تحليلًا معمقًا لمضامين المشروع على ضوء الدستور (الفصول 28 و25 و12 و1)، ونقارنها بالمعايير الدولية (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان ويندهوك، وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة). كما نستعرض مدى توافق المشروع مع أفضل الممارسات الدولية في تنظيم الصحافة (نماذج فرنسا وبريطانيا وألمانيا). مع ايلاء اهتمامًا خاصًا لمسألتي الاستقلالية والصلاحيات الزجرية في هيكلة المجلس وصلاحياته، قبل أن نختم بتوصيات عملية لضمان مواءمة المشروع مع الدستور والمعايير الدولية
أولًا: مدى احترام المشروع لفصول الدستور المغربي ذات الصلة
الفصل 28 من الدستور: يكفل الفصل 28 حرية الصحافة ويحظر الرقابة القبلية عليها. كما ينص بوضوح على حق الجميع في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بحرية، دون تقييد إلا بمقتضى قانون واضح. الأهم أنه يوجب على السلطات العمومية تشجيع تنظيم قطاع الصحافة بشكل مستقل وعلى أسس ديمقراطية، ووضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به. هذا يعني أن القانون ينبغي أن يدعم التنظيم الذاتي الديمقراطي والمستقل لمهنة الصحافة. وبمقارنة ذلك مع مشروع قانون 26.25، يبرز تناقض جوهري أشار إليه العديد من المهنيين: فالمشروع يُغيّر طريقة تشكيل المجلس عبر مزيج من الانتخاب والتعيين. فبينما يتم انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالاقتراع السري، يتم انتداب (تعيين) الناشرين وفق معايير حددها المشروع (مثل حجم المؤسسة الإعلامية من حيث عدد العاملين ورقم معاملاتها). وقد اعتُبر هذا التحول إخلالًا بالطابع الديمقراطي لتنظيم القطاع. حيث أن الآلية الجديدة تتناقض بوضوح مع الفصل 28 من الدستور الذي يدعو السلطات إلى تشجيع الصحافيين على تنظيم أنفسهم بشكل ديمقراطي ومستقل. وعليه فان الانتخاب هو التعبير الأسمى عن الاستقلالية . و أن الأصل هو الانتخاب المباشر لكل مكونات المجلس، وأن الانزياح الى اختيار جزء من الأعضاء بالتعيين يمثل نكوصًا عن فلسفة التنظيم الذاتي الديمقراطي. كما ان اعتماد معايير انتداب الناشرين حسب القوة المالية (رقم المعاملات) يضع المشروع امام اتهام بأنه يفصَّل على مقاس المؤسسات الإعلامية الكبرى ويقصي الأصوات الصغرى، مما يخالف روح التعددية التي يُفترض بالدستور حمايتها. وبالتالي يمكن القول ان المشروع لم يحترم بشكل كافٍ مقتضيات الفصل 28 فيما يتعلق بضمان استقلالية المجلس وطبيعته الديمقراطية.
الفصل 25 من الدستور: يضمن حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها. هذا المبدأ العام يقتضي ألا يفرض القانون قيودًا غير مبررة على حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافيين والإعلاميين في نشر الآراء والمعلومات. وعلى عكس ذلكً فان مشروع القانون 26.25 أثار مخاوف بشأن تراجعه عن ضمانات حرية التعبير: فقد تضمن في صيغته الأصلية عقوبات زجرية صارمة مثل إمكانية توقيف صحيفة أو موقع إلكتروني عن الصدور لمدة تصل إلى 30 يومًا في بعض الحالات. مثل هذا الإجراء يُعتبر مساسًا خطيرًا بحرية التعبير والصحافة، بل شكلًا من أشكال الرقابة اللاحقة التي يمكن أن تؤدي إلى رقابة ذاتية لدى الإعلاميين. مما يدفع إلى وصفه كتهديدًا مباشرًا لحرية التعبير. وعليه تم حذف عقوبة توقيف الصحف من المشروع أثناء مناقشته في مجلس النواب. ورغم ذلك، استُبدلت بعقوبة مالية ثقيلة (غرامة بين 300 ألف و500 ألف درهم) في حالات المخالفات المهنية الجسيمة. إن فرض غرامات ضخمة كهذه على مؤسسات إعلامية قد يُشكل أيضًا قيدًا على حرية التعبير إذا استُخدم بطريقة تعسفية، لأنه قد يهدد استمرار وسائل إعلام صغيرة أو مستقلة. وبالتالي ينبغي تقييم مدى تناسب هذه العقوبات مع متطلبات الفصل 25؛ فالدستور لا يمنع تنظيم حرية التعبير بقانون، لكنه يشترط ألا يؤدي التنظيم إلى إفراغ الحق من مضمونه. إن أي عقوبة زجرية تؤثر على ممارسة الصحافة يجب أن تخضع لاختبار الضرورة والتناسب احترامًا للفصل 25. وفي الصيغة الحالية للمشروع، ورغم إزالة عقوبة الإيقاف، ما زال هناك تخوف من الغرامات الثقيلة وسحب بطائق الصحافة كأدوات قد تُستخدم للضغط على الأصوات الناقدة، مما يستدعي ضمانات صارمة عند التطبيق.
الفصل 12 من الدستور: ينص هذا الفصل على حرية تأسيس الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وممارسة أنشطتها بحرية في نطاق القانون، ولا يمكن حلّها أو إيقافها من طرف السلطات إلا بحكم قضائي. كما يُوجب أن يكون تنظيم وتسيير الجمعيات مطابقًا للمبادئ الديمقراطية. ورغم أن المجلس الوطني للصحافة ليس جمعية مدنية بالمعنى التقليدي (بل هيئة مهنية مؤسسة بقانون)، إلا أنه يمثل تنظيمًا ذاتيًا لمهنة ويضم في عضويته منظمات مهنية (نقابات الصحافيين وجمعيات الناشرين). من هذا المنطلق، روح الفصل 12 تقتضي ضمان استقلالية هذا التنظيم المهني عن السلطة التنفيذية واحترام ديمقراطية تسييره. إن تدخل الحكومة بحلّ المجلس السابق (بعد انتهاء ولايته) بموجب مرسوم قانوني وإنشاء لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الصحافة لمدة سنتين يطرح إشكالًا دستوريا يتعلق بمبدأ عدم حلّ المنظمات الحرة إلا عبر القضاء. وهو ما يمكن وصفه ب“إجهاض” لتجربة المجلس المنتخب واستبدالها بلجنة معينة إداريًا، مما ينتقص من حق الصحافيين في تنظيم أنفسهم بحرية. وفي مشروع القانون الجديد 26.25، ورغم أنه يعيد إنشاء المجلس عبر انتخابات جزئية، فإنه يكرّس آلية الانتداب غير الديمقراطية لفئة الناشرين ويمنح السلطة التنفيذية موطئ قدم في تركيبة المجلس (مثل حضور ممثل عن الحكومة بصفة ملاحظ أو غيره). هذا يتعارض مع اشتراط الفصل 12 ديمقراطية التنظيم الداخلي. إضافة لذلك، فان طريقة الاختيار المختلطة المقترحة يمكن تأويلها باعتبارها ترسّخ التمييز بين المهنيين وتقوض مبدأ تكافؤ الفرص داخل التنظيم المهني. بناءً عليه، يمكن القول إن المشروع لم يرتقِ كليًا إلى معايير الفصل 12 فيما يخص حرية التنظيم المهني وديمقراطيته، لأن يد السلطة التنفيذية ظلت حاضرة في تشكيل المجلس وقواعد اشتغاله، بدل أن يترك الأمر برمته لخيارات المهنيين أنفسهم.
الفصل 1 من الدستور: يُقر الفصل الأول أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. يعني ذلك أن أي مؤسسة عامة أو هيئة تتمتع بسلطات يجب أن تخضع للمساءلة وألا تُترك صلاحياتها من دون ضوابط. وفي سياق المجلس الوطني للصحافة، يثير المشروع نقطتين على صلة بهذا الفصل: مساءلة المجلس نفسه ومساءلة السلطة التنفيذية في علاقتها بالمجلس. فمن جهة أولى، يمنح المشروع المجلسَ صلاحيات زجرية وتأديبية (مثل إصدار عقوبات تأديبية ضد صحافيين وناشرين، وسحب بطائق الصحافة، وفرض غرامات) مما يجعل منه هيئة تتمتع بـسلطة شبه قضائية على أهل المهنة. كي يتوافق هذا مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، يفترض أن تخضع قرارات المجلس التأديبية إلى مراجعة أو طعن أمام جهة مستقلة (القضاء) لضمان عدم التعسف. حاليًا، لم يتضح في المشروع آلية الاستئناف أو الطعن في قرارات المجلس التأديبية؛ وهذا نقص ينبغي معالجته لضمان محاسبة المجلس عن قراراته. فحق التقاضي مكفول دستوريًا (الفصل 118 والفصل 120 يكفلان حق كل شخص في محاكمة عادلة وفي صدور حكم داخل أجل معقول)؛ وبالتالي أي قرار تأديبي يمس حقوق الصحافي أو المؤسسة الإعلامية يجب أن يكون قابلًا للطعن قضائيًا. من جهة ثانية، مساءلة السلطة التنفيذية: لقد تولت الحكومة سابقًا حلّ المجلس المنتخب واستبدلته بلجنة معينة، ثم جاءت بالمشروع الحالي لإعادة هيكلته. هذا التدخل يستدعي انتقادا مباشرا مفاده كون الحكومة تسعى للسيطرة على التنظيم الذاتي للصحافة، وهو ما يستدعي فحص مشروعية هذه الخطوات في ضوء مبدأ المحاسبة. إذا كان المشروع الجديد يهدف حقًا إلى تعزيز استقلالية المجلس وتحسين أدائه كما تدعي الحكومة، فعليها أن تبرهن على ذلك بتدابير ملموسة للشفافية وإشراك المهنيين، وإلا فإن ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي محاسبة الحكومة نفسها على أي قانون يُضعف حرية الصحافة. وباختصار، يتطلب الفصل 1 بناء آليات شفافة وخاضعة للمساءلة في تشكيل المجلس وممارسة صلاحياته. وإلى أن يتحقق ذلك بشكل مقنع في نص المشروع، تبقى مدى ملاءمته للفصل 1 محل شك.
ثانيًا: مدى توافق المشروع مع التزامات المغرب الدولية
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 19 و22)
المادة 19 من العهد الدولي: تكفل هذه المادة حق كل إنسان في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي حرية التعبير بجميع الوسائل، مع السماح فقط بالقيود التي ينص عليها القانون لأغراض ضرورية ومشروعة مثل احترام حقوق الآخرين أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة والأخلاق العامة. يتعين أن يكون أي تقييد ضروريًا ومتناسبًا مع الهدف المشروع. إن مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة يثير تساؤلات في ضوء هذه المعايير. فمثلاً، منح المجلس سلطة معاقبة الصحف بالإيقاف (في صيغته الأصلية) أو فرض غرامات ثقيلة يطرح الشكوك حول مدى ضرورة وتناسب هذه التدابير. وقد اعتُبرت عقوبة إيقاف صحيفة إجراءً خطيرًا وغير ضروري يمكن أن يتم بسهولة إساءة استخدامه لقمع أصوات ناقدة، مما يجعلها غير متوافقة مع المادة 19. لكن الصيغة الحالية بعد القراءة الاولى تم فيها تدارك هذا الأمر بحذفها، أما العقوبات المالية الكبيرة التي أضيفت بدلًا منها، فهي وإن كانت أقل انتهاكًا صارخًا من الإيقاف، إلا أنها قد تشكل رادعًا مبالغًا فيه يهدد تنوع وسائل الإعلام، وخاصة إذا فُرضت على مؤسسات صغيرة ذات موارد محدودة. إن المعايير الدولية تطالب بأن تكون أي عقوبة مرتبطة بحرية التعبير منصوصًا عليها بوضوح في القانون ولها هدف مشروع وضرورية ديمقراطيًا؛ ومن ثم فإن تجريم مخالفات أخلاقية مهنية بغرامات باهظة ضمن هيئة تنظيمية ذاتية أمر غير معتاد دوليًا. عادةً، المخالفات الجسيمة (مثل التشهير أو التحريض على العنف) تُعالج عبر القضاء مع توفير كل ضمانات المحاكمة العادلة، فيما تكتفي هيئات التنظيم الذاتي بعقوبات معنوية أو تأديبية خفيفة. لذلك ينبغي إعادة النظر في ثقل العقوبات المالية في المشروع لضمان التناسب مع متطلبات المادة 19 ICCPR وعدم تحولها إلى أداة إسكات مبطنة.
المادة 22 من العهد الدولي: تقر هذه المادة بحق كل فرد في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، ولا تسمح بتقييد هذا الحق إلا في حدود ضيقة جدًا (ضرورية في مجتمع ديمقراطي ولمصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم). في الحالة المغربية، يعد المجلس الوطني للصحافة كيانًا يمثل تجمعًا مهنيًا يضم صحافيين وناشرين. ومن هذا المنطلق، يجب احترام حق هؤلاء المهنيين في تنظيم أنفسهم بحرية. تدخلات الحكومة التشريعية والإدارية في تشكيل المجلس قد تلامس نطاق المادة 22. فقيام السلطات بتمديد ولاية المجلس السابق استثنائيًا ثم حله واستبداله بلجنة معينة، وأخيرًا فرض تركيبة جديدة خليط من معينين ومنتخبين، كلها إجراءات تحد من استقلالية التنظيم المهني للصحافيين. إذا نظرنا للمسألة من زاوية حرية تكوين الجمعيات، يمكن القول إن الدولة قيدت فعليًا حق الصحافيين في إدارة شؤونهم المهنية عبر هيئتهم المنتخبة عندما حلتها قبل الأوان دون حكم قضائي، وهذا لا ينسجم مع المادة 22 التي لا تجيز حل أو تقييد تنظيمات حرة إلا في حالات قصوى ومبررة. حتى مشروع القانون 26.25 في صيغته الحالية، بتضمينه تعيينات وإقصاء لبعض المكونات المنتخبة سابقًا، قد يكون فيه انتقاص من حق التنظيم الحر. وبالتالي فهو يقوض نظام التنظيم الذاتي القائم منذ 2018 والذي ساهم في قدر من استقلالية الصحافة. وهو ما حذرت اليه مجموعة من المنظمات الحقوقية من أن هذه الأنواع من القوانين كثيرًا ما تُستغل من قبل الحكومات كأدوات للسيطرة على الإعلام بدل حمايته. بناءً عليه، قد يُعتبر المشروع خرقًا لالتزامات المغرب بموجب المادة 22 ما لم يثبت أنه لا غنى عن هذه التدخلات لضمان المصلحة العامة الديمقراطية. والطريقة الأفضل لضمان احترام المادة 22 هي إعادة أكبر قدر من الصلاحية للمهنيين لاختيار ممثليهم وإدارة شؤون مجلسهم، مع الحد من الوصاية الحكومية إلا فيما تقتضيه ضرورة قانونية واضحة.
إعلان ويندهوك حول استقلالية الإعلام (1991)
(هو وثيقة تاريخية صادرة في 3 مايو 1991 خلال ندوة لليونسكو عقدت في ويندهوك، ناميبيا، ويُعد حجر الأساس لحرية الصحافة في إفريقيا والعالم)
يُعد إعلان ويندهوك مرجعية دولية مهمة لتعزيز صحافة حرة مستقلة وتعددية. وقد أقر هذا الإعلان، الصادر في سياق أفريقي برعاية اليونسكو، جملة مبادئ تنطبق عالميًا. المبدأ الأول فيه يؤكد أن إنشاء صحافة مستقلة وتعددية وحرة هو أمر جوهري للديمقراطية والتنمية. ويُعرّف الإعلان الصحافة المستقلة بأنها تلك الحرة من السيطرة الحكومية أو السياسية أو الاقتصادية. على ضوء ذلك، يثير مشروع قانون 26.25 علامة استفهام: هل سيجعل المجلس الوطني للصحافة مستقلًا حقًا عن الحكومة والسلطة السياسية؟ المسؤولون الحكوميون يدّعون أن النص الجديد يهدف إلى تعزيز استقلالية المجلس، لكن واقع مضامينه من تدخل في تشكيل الأعضاء وتضمين ممثلين عن مجالس دستورية معينة بل وحضور مندوب حكومي يوحي بعكس ذلك. إعلان ويندهوك يحث على عدم هيمنة الحكومة على وسائل الإعلام أو أجهزة تنظيمها، بل تركها للمهنة نفسها. إن وجود قاضٍ معين وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتبارهم من مؤسسات الحكامة ضمن تركيبة المجلس يعني أن الدولة ومؤسساتها حاضرة في هيئة من المفترض أنها للتنظيم الذاتي. هذا النموذج أقرب إلى الصحافة الموجهة منه إلى الصحافة المستقلة بمعايير ويندهوك، خاصة إذا ما قارناه بتوصيات الإعلان.
كذلك شدد إعلان ويندهوك على ضرورة إنهاء أشكال الاحتكار في الصحافة وضمان التعددية. غير أن المشروع المغربي باعتماده معيار رقم المعاملات (المعيار المالي) لتمثيلية الناشرين قد يؤدي إلى هيمنة المؤسسات الإعلامية الكبرى وإقصاء الأصغر صوتًا، مما يهدد التعددية في المشهد الإعلامي. وهذا يتنافى مع روح إعلان ويندهوك الداعية إلى أوسع تعددية وآراء ممكنة وعدم السماح بسيطرة فئة قليلة ذات نفوذ مالي على الإعلام. وقد حذر خبراء إعلاميون من أن تفضيل رأس المال الإعلامي الكبير يضرب مبدأ التنوع ويُضعف استقلالية الصحافة بجعلها تحت رحمة المال.
كما يدعو إعلان ويندهوك الدولَ إلى دعم تأسيس جمعيات ونقابات صحفية مستقلة تمثل الصحافيين والناشرين. في المغرب، كان إنشاء المجلس الوطني للصحافة عام 2018 خطوة في هذا الاتجاه – أي إيجاد هيئة يقودها الصحافيون والناشرون أنفسهم لتنظيم شؤونهم المهنية. لكن المشروع الجديد عرّض هذه التجربة للخطر عبر تحجيم استقلالية تلك الهيئة. ويمكن القول إن أفضل تطبيق لمبادئ ويندهوك في الحالة المغربية هو السماح للمهنيين الصحافيين وناشري الصحف بإدارة شؤون تنظيمهم المهني بحرية مع توفير الإطار القانوني الداعم فقط، دون تدخل في تركيبة المجلس أو تجاوز لصلاحياته. أي خروج عن هذا الإطار – كتمكين المجلس من منع الصحف أو فرض قيود غير قضائية على الإعلام – يعتبر نكوصًا عن التزامات المغرب بموجب إعلان ويندهوك.
قرارات مجلس حقوق الإنسان الأممي ذات الصلة
لقد أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عدة قرارات تؤكد على حماية حرية التعبير وحرية الصحافة. هذه القرارات – والتي تحظى بتوافق ومكانة دوليين – تشدد على أن حرية التعبير هي حجر أساس في المجتمعات الديمقراطية، وعلى الدول اتخاذ التدابير لحمايتها وتعزيزها. كما تكرر التأكيد على أن أي قيود على حرية الإعلام يجب أن تلتزم بالقانون الدولي ولا تُستغل لخنق الأصوات المعارضة. في سياق مشروع قانون مجلس الصحافة المغربي، هناك مؤشرات قلق دولية تم التعبير عنها. فعلى سبيل المثال، في المراجعة الدورية الشاملة (UPR) لمجلس حقوق الإنسان، قُدمت للمغرب توصيات بخصوص وقف ملاحقة الصحافيين جنائيًا وضمان بيئة عمل حرة لهم. أي قانون محلي مناقض لهذا التوجه قد يتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجلس حقوق الإنسان.
ومن أهم القضايا التي تناولتها قرارات المجلس الأممي سلامة الصحافيين وضرورة عدم إفلات منتهكي حقوقهم من العقاب (مثل القرار 33/2 لعام 2016 والقرار 45/18 لعام 2020 بشأن سلامة الصحافيين). هذه القرارات تدعو الدول أيضًا إلى تهيئة بيئة قانونية ومؤسسية تُمكّن الإعلاميين من أداء عملهم بحرية. إن استقلالية هيئات التنظيم الذاتي للصحافة تعد جزءًا من هذه البيئة الآمنة، لأن هيمنة السلطة على تلك الهيئات قد تجعل منها أداة لقمع الصحافيين بدل حمايتهم. وقد أبدت المنظمات المهنية والحقوقية تخوفها من أن مشروع القانون 26.25 سيمكّن الحكومة من استخدام المجلس كأداة لمعاقبة الصحافة المستقلة، وهو ما يتعارض مع روح قرارات مجلس حقوق الإنسان الداعية إلى تمكين الإعلام لا تقييده.
جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد عام 2012 قرارًا هامًا حول حرية الإنترنت (HRC20/L.13) أكد فيه أن الحقوق نفسها المحمية offline يجب أن تحمى online، وندد بحجب المواقع.
بشكل عام، الاتجاه العام في قرارات الأمم المتحدة هو حث الدول على دعم آليات التنظيم الذاتي المستقلة للصحافة باعتبارها تعبيرًا عن حرية التنظيم والتعبير، بدل فرض وصاية رسمية عليها. كما تُشدد على ضمان المحاكمة العادلة لأي إجراءات ضد الصحافيين أو المؤسسات الإعلامية. وفي هذا الإطار، غياب نص صريح في المشروع حول حق الطعن القضائي في قرارات المجلس، أو وجود ممثل حكومي فيه، قد يضع المغرب في موضع مساءلة دولية إن اعتُبر ذلك خرقًا لضمانات المحاكمة العادلة أو إخلالًا بمبدأ استقلال الإعلام الذي دعت إليه قرارات مجلس حقوق الإنسان.
أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، اكدال – جامعة محمد الخامس – الرباط