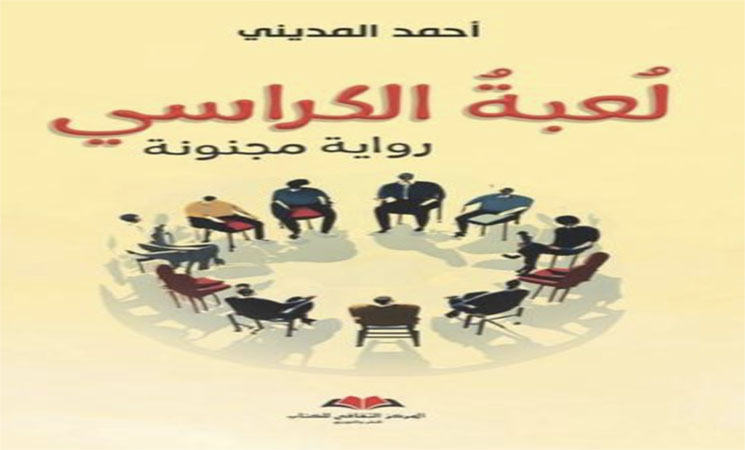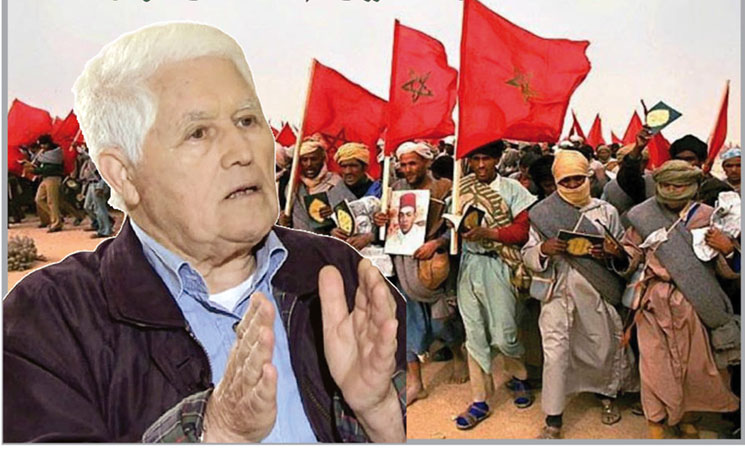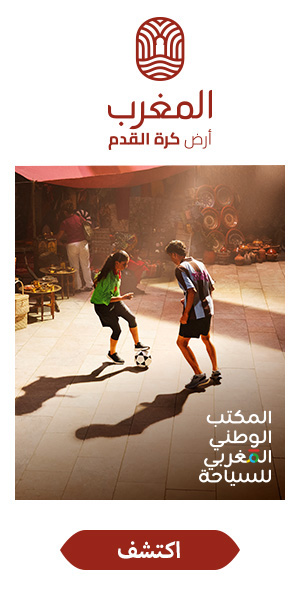هل هناك منهج نقدي بوسعه أن يشمل جلّ معاني القصيدة؟ هل بمُكنة النقد أن يحتوي الشعر؟ وحتّى حين رقّع بعضهم منهجا متكاملا ضرب البعض كفّا بكفّ، واستلقى على ظهره ضحكا.
إن ما تقوله شذرة شعرية ضائعة في تخوم قصيدة إنّما يستدعي مجلّدات نقدية يظلّ معها شيء من حتّى في جوف الناقد… وقد يموت وفي نفسه غصّة شعرية استعصت على الإحاطة، وعجزت أمامها العبارة، وترمّلت بفقدانها كلّ الكلمات، وقد لا تترجم في خياناتها غير اليسير ممّا تأتّى لها، وتظل القصيدة بركانا نائما الى حين، وحده تطوّر المعرفة النفسية يعلم ميقات استيقاظه. ألم يقل رائد التحليل النفسي باعتراف العاجز عن فهم الفنّ عموما، إن الفناّنين أساتذته في هذا الباب، وحدهم قادرون على فكّ الطلاسم الكونية بالتلميح دون التصريح. هو التلميح الشعري الذي يظلّ كامنا هناك خلفا في ناحية ما بتعبير ميلان كونديرا. إنّها ببساطة متعسفة محنة الناقد حين يهوى القصيدة المتجبّرة في تمنّعها، في زهوها، في شموخها وكبريائها، في اكتفائها بلذّتها، ويراها أوسع وأشسع من أن تحتويها النظرية النقدية مهما كانت دقّتها، وصرامة منهجيتها، بتعبير آخر قصور التفكير أمام «جبروت» القصيدة.
هو في تقديري مدار الحكاية في يتيمة الناقد/ الشاعر محمد علوط « أنامل تحت الحراسة النظرية»: صراع الشعر والنقد في التماهي الحرّ داخل الذات المترنّحة بين الفيض الشعري والجفاف النقدي، اهتزاز السهم الشعري داخل حركة الاعتماد في قوس جسد القصيدة. يقول الشاعر في فاتحة قصيدته الأولى « جسد يرتدي عريه»:
يأخذ الجسد هيأة القوس
وتأخذ القصيدة هيأة السهم (ص5)
عارية إلا من جسدها تصمد القصيدة، سلاحها فقط مجازاتها، استعاراتها الحبلى، وتشبيه حلمها اليقظ، وكناياتها العذراء، وأجنحة الملائكة التي لا تُرى بالعين المجرّدة، بالنظر النقدي المفرط في فكريته، المتبجّح بعلميته، يقول:
جناح الملاك
ورموشها المغموسة في كحل القصائد (ص6)
حينها يقف النقد مشدوها، فأيّ الاستعارات تليق به؟ وأية معرفة موضوعية قادرة على طيّ مسافات القصيدة، أيّ قياس يضيء سبيل العميان، ردّا على المنطق الديكارتي المدّعي وهم التخييل، ونقصان المعرفة الشعرية، وقصور الحدس الشعري، وحاجته الملحّة لما يكمل نصابه، يجيب الشاعر: الحقيقة أيضا جهة مائلة (ص7)، وهما في الخطأ والصواب صنوان، يقول:
الخطأ والحقيقة
صديقان
مثل كذبة بيضاء(ص7)
النقد يخطّئ القصيدة، لأن المحتمل هاجسها الأوحد،
وتكتيكها المتفرّد في استراتيجية عريها البلاغي. وكلّ تفسير إنّما هو تأويل الى حين، خصام أمام محكمة الحياة، أنامل تحت الحراسة النظرية، قصيدة بكامل عريها المقدّس تقف شامخة في جلسات محاكم التفتيش النقدية تبتغي عفوا، لعلّه ما يبرز جليا في معجم الديوان الكاشف عن مجريات الجلسات بلغة القانون (التهم – شاهد عيان- القسم بأغلظ الأيمان- الشتائم – الحارس – سارق – غير شرعي- القاتل المتسلسل …) ضوء القصيدة، وظلام التأويل، فيحتار الشاعر أيهما: شمس المعنى وقمر التأويل (ص9) حين يختصمان، وفي الآن نفسه يقترنان في الذات الشاعرة، الشاعر ناقدا، والناقد شاعرا، تلك مأساة الأنامل تحت الحراسة النظرية في السباق الذاتي المحموم لسؤال الأولوية، حيث تزداد الحدّة حين يقول:
ثمّ في الهزيع الأخير من الكأس
يتناسخان (ص9)
لأنّ الشاعر/ الناقد يعيش ازدواجية الكتابة وهو يعلم أن كلّ تأويل إنّما هو ادعاء نهاية القصيدة في لهاث نقدي. يقول الناقد في القصيدة باعتراف صارخ:
كل الحكمة التي راكمناها تحت المداد
نشف ريقها وهي تلهث كقطعان الماعز
تتسلّق سدرات شجر المجاز(ص10)
فهل تصلح مقدّمة ابن قتيبة في شعره وشعرائه أن تحتوي شجرة المجاز؟ إنّما الشاعر الحقّ هو ذاك الذي جفّف حبر النقد، وظلّت القصيدة جارية مجرى الزمن.
لم يلد كلّ هذا التأويل غير الصدأ، والغبار والعماء (ص11) لتظلّ القصيدة شامخة في عريها البلاغي تغالب كلّ تأويل. هي ذي الحقيقة الشعرية، بعد سنوات من التمرين، تصدح في ليل القصيدة، تحتفي بجبروتها الفاضح لتقول:
فانفخي
بصوتك في القصب
لعلّ أضلعي تكون نايا
يعزف ميلادك (ص13)
تمسي القصيدة سيدة البداية والنهاية في استعارة القاتل المتسلسل، تلك القادرة على التجدّد باستمرار كي تبعث الكينونة من جديد، تقتل لتحيي، وتخرج الحيّ من الميت، في صراع الأضداد لصنع تاريخها الذاتي، ففي قصيدته « حائط القيامة» يقول:
نلبس
معطف قابيل
ونغمس
أصابعنا في دم هابيل(ص19)
فقط لأنّها مصنوعة من كلمات ليست كالكلمات، كلمات حبلى ببطون لا يحتوي معناها معجم الطلّاب، يقول:
وهي فقط
كانت تقصد « لسان العرب»
حيث تحت جلد كل كلمة
تختبئ امرأة (ص22)
حينها يعجز التأويل أمام المعرفة الشعرية، ويقضي الناقد عمره يلهث خلف القصيدة، يبحث سدى عن مكان الاختباء، يقول:
سبع سنوات [رقم سحري] قضيناها نطرطق الإبهام بالوسطى
لا أحد فينا صرخ
« وجدتها» (ص24)
حينها أيضا يصير الحبر حبران، واحد للشعر، والآخر للسرد، وبينهما برزخ لا يلتقيان، لأن:
الليل ينهكه السرد
والنهار ينهكه الشعر (ص28)
ألم يقل باسكال كثرة الضوء تعمي! يموت المؤلف ويظلّ النصّ يتيما (ص 29) وتنبسط المسافة بين الدال والمدلول(ص31)، والقصيدة لا يعنيها الاستقراء والاستنباط وما بينهما من هاوية (ص ٣٢)، حيث يشكو دلو [النقد] دوما من العطش (ص٣٢)، بعيدا عن ماء القصيدة، يقول:
ثمّة بحيرة من عطش
وثمّة سقاء يقايض في عدن
ماء النهر
بملح البحر (ص٣٣)
بهذا، وبغيره الكثير في قصائد ملغومة بمرجعيات تتوسّل لمبدعيها أن يطردوا أرسطو من جمهوريتهم انتقاما لطردهم من جمهورية أفلاطون، تكون يتيمة الشاعر محمد علوط شهادة على عصر كلّ أنواع الذكاء، شهادة على العجز حتّى في إعمال العقل في الخبر على حدّ تعبير ابن خلدون، وحدها القصيدة المحمّلة بالأسرار تحتفي بجبروتها عارية الا من جسدها السحري، ليعود النقد عاضا أنامله غيظا لأنّهم:
يمشطون شعر الليل
بمشط ضوئي (51)
لذا دعا غ. باشلار مرارا الى ضرورة مجاراة الصور بدل ادعاء كبسها في الخانات ذات البيانات النارية بمنطق مبياني شكلاني يدّعي بدكتاتورية ناعمة سجن القصيدة.
حاجتنا إذن ملحاحة لنقد مبدع يساير إيقاع المعنى ولا يطرده بجرّة قلم جاف، يقول الشاعر:
كم نايا عليّ أن أنفخ فيه ريحي
لأستعيد روحي (ص81)
استعادة الروح، تلك هي المسألة يا صاحبي!