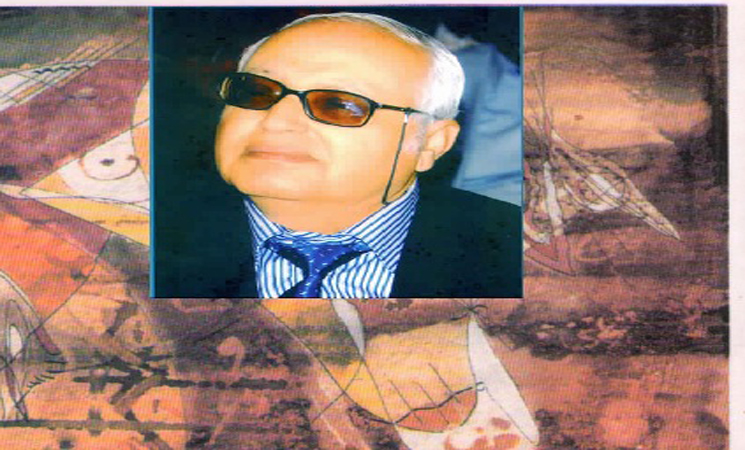عالم الاجتماع مصطفى محسن: مشروع الإصلاح التربوي الشمولي
مصطفى محسن: عالم اجتماع، كاتب ومفكر عربي بارز من المغرب، خبير في قضايا التربية والثقافة والتنمية… في المغرب والوطن العربي بشكل عام…
تقلد، منذ تخرجه سنة 1972، عدة مهام تربوية وتكوينية وتدبيرية في حقل التربية والتعليم وتكوين الأطر…
اشتغل أستاذا باحثا «في سوسيولوجيا التربية والشغل والتنمية» بمركز التوجيه والتخطيط التربوي/الرباط، وأيضا أستاذا متعاونا مع بعض الكليات ومؤسسات تكوين الأطر التربوية العليا….
عضو مؤسس، أو مشارك في أنشطة عدة هيئات ومؤتمرات ومنظمات وطنية وإقليمية ودولية، حكومية وغير حكومية، مثل: الجمعية المغربية لعلم الاجتماع /المؤتمر التأسيسي للفضاء المغاربي/ المؤتمر القومي العربي…الخ.
له العديد من الدراسات والمقالات والحوارات والأبحاث والمؤلفات الفردية أو المشتركة. وهي أعمال ينطلق فيها كلها من هدف جعلها تأسيسية متميزة. وذلك حين يحاول إقامتها على ما يسميه بـ »منظور النقد المتعدد الأبعاد« بما هو مرجعية فكرية ومنهجية مؤطرة وموجهة لمشروع الباحث برمته، وبما هو أيضا نقد إبستمولوجي وسوسيولوجي وحضاري حواري وتكاملي منفتح للذات (النحن)، وللآخر (الغربي المغاير)، وللسياق الحضاري باعتباره لحظة تاريخية لتبادلهما وتفاعلهما على كافة الصعد والمستويات. غير أنه، إذ يؤكد على نوعية واستقلالية مشروعه الفكري هذا، فإنه يلح، في نفس الآن، على ضرورة النظر إليه في شرطيته السوسيوتاريخية الشمولية، أي على أنه جزء من كل، أي كأحد روافد حركة نقد عربي فكري وثقافي وحضاري معاصر أوسع وأكثر تمايزا في الأهداف والرهانات والخلفيات والرؤى والنماذج الإرشادية الموجهة… إلا أنها تسعى كلها إلى المساهمة الفاعلة المنتجة في التأسيس الجماعي لفكر عربي حداثي ديمقراطي حواري مؤصل، وإلى تشكيل وعي وثقافة جديدين، وإلى بناء إنسان جديد ومجتمع جدارة جديد…
في هذا الحوار تفاعل السوسيولوجي مصطفى محسن مع كل الأسئلة المطروحة-رغم ظروفه الصحية الصعبة- عن مساره في الفلسفة والتربية والسوسيولوجيا دراسة وتدريسا، وعن التضييق الذي طال شعبة السوسيولوجيا والفلسفة بعدها وتداعيات ذلك على مسار السوسيولوجيين المغاربة أنفسهم. وبوصفه مربيا وفاعلا مدنيا، تطرقنا معه إلى أدوار المجتمع المدني في إشاعة قيم المواطنة والسلوك المدني في الحياة المدرسية المغربية، وكيف يتصور بناء «مدرسة المستقبل» في تشكيل المواطن/الفرد. وإذا كانت هوية مصطفى محسن سوسيولوجية فإن له إنتاجا محترما في المسألتين التربوية والفلسفية. وما يؤطر خطابه، في كل هذا، هو مشروعه النقدي الحواري المنفتح المتعدد الأبعاد.
p سأبدأ سؤالي الآتي من حيث انتهيتم، أستاذي الفاضل مصطفى محسن في جوابكم السابق. وأنوه، في هذا الصدد، بأنكم قد أصدرتم مؤخرا كتاب:” السلام والعيش المشترك: في أنسنة التربية على ثقافة السلام، المركز الثقافي للكتاب، الدارالبيضاء-بيروت، ط.1، 2020». وفيه تعودون إلى ضرورة “تنمية الإنساني” وبناء الحياة المشتركة في زمن معولم مشحون باحترابات وتقاطبات وفظاعات لا علاقة لها بقيمة ومكانة وخدمة الإنسان في العالم. غير أن التربية إذا كانت تعتبر مدخلا أساسيا لتنمية “ثقافة السلام” وتعزيز قيم واخلاقيات “العيش المشترك” فإن مدرستنا المغربية والعربية العمومية ونظيرتها الخصوصية ما زالتا مفتقدتين للكثير من فعالية أدوارهما ووظائفهما في التنشئة الثقافية والاجتماعية المتكاملة، كما أن أوضاعهما قد ظلت، على العموم، مختلة مأزومة على أكثر من صعيد…فهل ترون من آليات مستحدثة ناجعة لبناء “مدرسة للمستقبل” كفيلة بالمساهمة النوعية في بناء الإنسان/المواطن المنشود، كما رافعتم عن ذلك منذ عقد من الزمن؟
nn بداية، وقبل الإجابة المركزة الممكنة على سؤالك المركب هذا، أستسمح أخوتك قي أن أشير هنا إل حيثية أعتبرها هامة معبرة، ألا وهي أن القارئ المتفحص لجل أعمالي الفكرية والسوسيولوجية والتربوية المتواضعة سوف يجد فيها حضورا نوعيا ل “مفهوم الإنسان” بما هو «تيمة محورية ” مولدة للكثير من الأفكار والتصورات والدلالات والمعاني. ولعل في كتابي الصادر أخيرا، والمشار إليه في السؤال، ما يدعم هذا الحضور.
وللتذكير والتوضيح، فإن هذا الكتاب قد كان في الأصل عبارة عن محاضرة مطولة ساهمت بها في أشغال ندوة نظمتها بالرباط ” اللجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة” الممثلة لليونسكو وذلك حول موضوع: “دور المناهج التربوية في تعزيز ثقافة السلام” وقد عملت لاحقا على تطوير وإثراء وتوسيع نص هذه المحاضرة، وتحويلها إلى كتاب متكامل الشكل والمضمون.
ليس من المتيسر ولا المطلوب أن أستعرض هنا كل محتويات هذا المصنف، غير أني سأحاول التذكير بأهم ما عالجت فيه من إشكالات وقضايا، وبشكل مركز أود أن يكون مناسبا لمقتضى المقام، وأوجز ذلك فيما يلي:
-التأكيد المبدئي على أهمية ما يدعو إليه ويروجه “خطاب التربية الدولية”، التي مصدرها اليونسكو ومنظمات تربوية وثقافية وتنموية عالمية أخرى، من أطروحات وتوجهات ومفاهيم أساسية من قبيل: ” التربية على المواطنة وثقافة السلام، والتسامح والحوار والعيش المشترك وتقبل التعدد والتنوع والاختلاف بين الأعراق والأديان والشعوب والثقافات والحضارات…إلخ”. وذلك لما للتنشئة على هذه المبادئ والقيم من دور إيجابي في “تنمية الإنساني” بكل غنى مكوناته ومقوماته. ولا سيما في شروط “الزمن الراهن”، وفي ظل عالمية تتجه أكثر فأكثر نحو التخلي عن بهاء ووهج وجمالية ورقي ” إنسانيتنا” لتقع تحت طائلة هيمنة ” نيوليبرالية” معولمة شرسة لا يعرف جشعها المتوحش المتصاعد أي توقف أو حدود …مودية بالكثير من مظاهر “وضعنا البشري” في مهاوي أشكال خطيرة من الرداءة والتفاهة والقلق والتيه والاضطراب وتضارب القيم والتوجهات والمصالح…، لتجعل من هذه الأشكال، كما يرى بعض المفكرين النقديين، ” نظاما من الرداءة أو التفاهة Médiocrité” ما يفتأ يخترق، بتسارع وعنف، عديدا من جوانب التفكير والوجدان والذوق ومعظم المسلكيات والممارسات الاجتماعية والإنسانية المتباينة…
وإذا كانت المرامي الأساسية لمجمل القيم التربوية والثقافية المشار إليها تتبوثق في مساعي تكوين المواطن /الإنسان وإعداده فكريا وروحيا وعمليا للانخراط فيما غدا يوسم بأنه “مواطنة عالمية” جديدة، تعزز آليات تشكلها وتبلورها منظومات متكاملة متجددة من “تقانات المعلوميات ووسائل الإعلام والاتصال” المكتسحة حاليا لكل مجالات العمل والثقافة والحياة…، فإن المجتمعات الغربية نفسها، المنتجة والمسوقة لمفاهيم وأفكار وسياسات هذه ” التربية الدولية” المذكورة فيما سلف، لا تلتزم-إلا لماما- بمقتضيات ما تروجه. وإلا فمن يشعل في مختلف بؤر التوتر والتأزم في العالم أصنافا لا حصر لها من الحروب والفتن وصراعات التسلح والتموضع الجيوبوليتيكي والاستراتيجي، خدمة، بالأساس، لاغراضها المعلنة والمضمرة، ولإيديولوجياتها وسياساتها ومصالحها الذاتية الخاصة، البعيدة عن تواؤمها أو تواشجها مع المصالح الإنسانية الشاملة المشتركة. وهو واقع لا يصمد أبدا أمام أي “نقد موضوعي” وعلى أكثر من واجهة وصعيد…وهذا ما اجتهدت، في مجمل اعمالي المتواضعة، أن أساهم فيه بنوع من التجاوز والمسؤولية والانفتاح والالتزام …
-وبالمقابل، فإننا حينما ننتقل إلى أوضاع نظمنا التربوية، سواء في المغرب أو العالم العربي، أو مجتمعات العالم الثالث عموما، فإننا -كما أسلفنا، وكما تناولنا ذلك في العديد من أعمالنا السوسيولوجية والتربوية…- سنجدها، في معظم قطاعاتها العمومية والخصوصية، مأزومة متوعكة متناقضة في العديد من مرجعياتها وخططها وأنماط وآليات ومقومات وأساليب اشتغالها. مما لا يتلاءم التفصيل في عرضها ومناقشتها كلها مع طبيعة وشروط ومحدودية مثل هذا الحوار. إلا أن ما يهمنا هنا -وهذا ما ركزنا على إبرازه في الكتاب المذكور- هو أن نظمنا التربوية هذه، بل والاجتماعية عامة، لم تستفد إلا لماما مما ظلت، على امتداد عقود، “تستورده من سلع وبضائع ومفاهيم وإملاءات..” الخطاب التربوي الغربي المشار إليه، من قبيل: “التربية على ثقافة السلام، والمواطنة، والتسامح، والحوار والتعايش…” وغيرها، فبقيت بذلك “عدة نظرية وعملية” شكلية ضعيفة الفائدة فيما نقلت من أجله، ألا وهو الاستئناس بتوظيفها في تجديد وتطوير وعقلنة أنساقنا التربوية والتكوينية والثقافية والاجتماعية على العموم.
– ولعل هذا يرتد، من ضمن ما يرد إليه، إلى كوننا لم نقم، إلا في نطاق ضيق محدود، ب” نقد منهجي ابستمولوجي وسوسيوثقافي وحضاري متكامل متعدد للعدة الآنفة”. أولا، في إطار السياق المعرفي الاجتماعي الغربي، الذي يشكل الخلفية التي احتضنت ولادتها: تاريخ نشوء وتبلور وغايات توظيف نظري وعملي مشروط بخصوصيات ومواضعات سياقها الذاتي المحدد. وذلك من أجل التملك النقدي لمضامينها واستيعاب مفاهيمها ومبررات إنتاجها واستثمارها في شرطياتها السوسيوتاريخية تلك. وثانيا، نقدها أيضا في إطار الظروف والمواصفات الخاصة بالأوضاع التربوية والثقافية لمجتمعاتنا. تلك التي تم “تحويل أو نقل او تصدير” ما سبق ذكره من نظريات ومفاهيم إليها. وذلك، كما أسلفنا، بهدف إصلاحها وتجديد مقوماتها الفكرية والممارسية، وإقدارها على التوفر على ما من شأنه أن يجعلها متسمة بمستلزمات وكفايات الأهلية والجدارة والمساهمة الفاعلة المنتجة في بناء “الإنسان” والمجتمع في الآن ذاته.
أما بصدد ما من شأنه أن يساهم، من آليات ووسائل وتدابير، في التأسيس ل “مدرسة المستقبل” في مجتمعاتنا، قادرة على الانخراط، بكفاءة وفاعلية وجودة عمل ومنتوج، في سيرورات “تنمية الإنساني” كما ورد في السؤال، فإني أرى أنه من المفيد هنا تذكير قراء هذا الحوار المركز، بأنني قد عالجت، قدر الجهد والمستطاع، كثيرا مما يرتبط بهذه المسألة. وذلك في أعمال متواضعة سابقة لي، من بينها، على سبيل المثال لا الحصر: “الخطاب الإصلاحي…/ مدرسة المستقبل…/رهانات تنموية…/السلام والعيش المشترك…” وغيرها. لذا ونزولا عند بعض متطلبات المقام، فإني لن أشير هنا سوى إلى بعض أبرز الآفاق والبدائل التي يمكن الاستئناس بها في الجهود والمسارات الفكرية والعملية لبناء هذه “المدرسة الوطنية أو القومية المستقبلية” المنشودة. ومن أهمها:
– الضرورة الحضارية والفكرية لبلورة “فلسفة أو مرجعية تربوية” واضحة الأسس والمنطلقات والأهداف، موجهة لوضع سياسات وخطط ومشاريع وبرامج متناغمة لإصلاح وتجديد نظمها التربوية والتكوينية بأصنافها المتعددة. وذلك من أجل جعلها-توجهات ومضامين ثقافية، ومناهج دراسية، وحياة مدرسية جاذبة، وأطرا قيمية مرشدة، وعلاقات بيداغوجية واجتماعية، وإنسانية هادفة، وتواصلا تفاعليا وإيجابيا منتجا مع محيطها السوسيواقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي بمؤسساته ومكوناته المختلفة…-قادرة بالفعل، على المساهمة الحقيقية، لا المتخيلة، في بناء ذلك “الإنسان/المواطن/الفرد…”، الذي يراد له وينتظر منه ان يكون “مندمجا” في خصوصيات وقيم ومقومات المجتمع الذي ينتمي إليه، كما معطيات ومتغيرات ومستجدات السياق الكوني الإنساني في هذا “الزمن الراهن” المتسارع التحول والتجدد على أكثر من صعيد…
– ملحاحية جعل “مشروع الإصلاح التربوي الشمولي” المنوه به فيما سبق “نواة مركزية في صلب المشروع التنموي المجتمعي” المعتمد. ثم جعل الرهان على تكوين وتأهيل وبناء “الإنسان” بأبعاده المادية والمعرفية والرمزية المتكاملة، في صلب كل ما يضعه المجتمع من خطط وسياسات ومشاريع للتنمية والتجديد والتحديث…ولعل في نماذج من “المجتمعات البازغة حديثا”، مثل اليابان وماليزيا وسنغفورة….، فضلا عن البلدان الغربية المتقدمة، ما يقوم -على مستوى النظر والممارسة العملية- دليلا على صدقية الأطروحة الآنفة، وعلى نجاعة وجدوى تصورها للإصلاح التربوي الشمولي الفاعل المنتج.