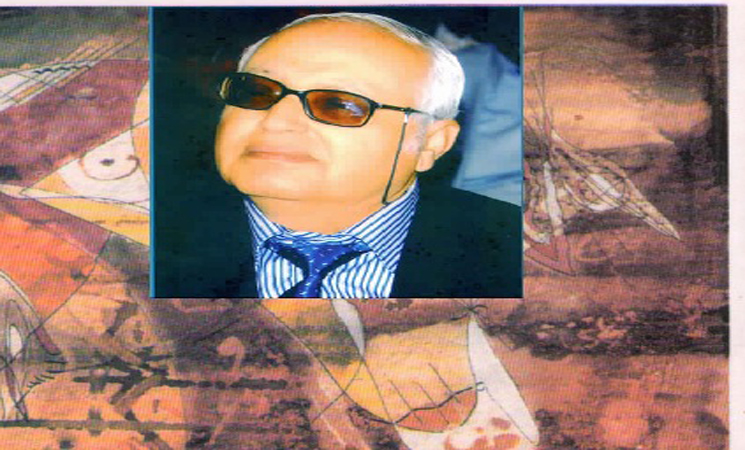مصطفى محسن: عالم اجتماع، كاتب ومفكر عربي بارز من المغرب، خبير في قضايا التربية والثقافة والتنمية… في المغرب والوطن العربي بشكل عام…
تقلد، منذ تخرجه سنة 1972، عدة مهام تربوية وتكوينية وتدبيرية في حقل التربية والتعليم وتكوين الأطر…
اشتغل أستاذا باحثا «في سوسيولوجيا التربية والشغل والتنمية» بمركز التوجيه والتخطيط التربوي/الرباط، وأيضا أستاذا متعاونا مع بعض الكليات ومؤسسات تكوين الأطر التربوية العليا….
عضو مؤسس، أو مشارك في أنشطة عدة هيئات ومؤتمرات ومنظمات وطنية وإقليمية ودولية، حكومية وغير حكومية، مثل: الجمعية المغربية لعلم الاجتماع /المؤتمر التأسيسي للفضاء المغاربي/ المؤتمر القومي العربي…الخ.
له العديد من الدراسات والمقالات والحوارات والأبحاث والمؤلفات الفردية أو المشتركة. وهي أعمال ينطلق فيها كلها من هدف جعلها تأسيسية متميزة. وذلك حين يحاول إقامتها على ما يسميه بـ »منظور النقد المتعدد الأبعاد« بما هو مرجعية فكرية ومنهجية مؤطرة وموجهة لمشروع الباحث برمته، وبما هو أيضا نقد إبستمولوجي وسوسيولوجي وحضاري حواري وتكاملي منفتح للذات (النحن)، وللآخر (الغربي المغاير)، وللسياق الحضاري باعتباره لحظة تاريخية لتبادلهما وتفاعلهما على كافة الصعد والمستويات. غير أنه، إذ يؤكد على نوعية واستقلالية مشروعه الفكري هذا، فإنه يلح، في نفس الآن، على ضرورة النظر إليه في شرطيته السوسيوتاريخية الشمولية، أي على أنه جزء من كل، أي كأحد روافد حركة نقد عربي فكري وثقافي وحضاري معاصر أوسع وأكثر تمايزا في الأهداف والرهانات والخلفيات والرؤى والنماذج الإرشادية الموجهة… إلا أنها تسعى كلها إلى المساهمة الفاعلة المنتجة في التأسيس الجماعي لفكر عربي حداثي ديمقراطي حواري مؤصل، وإلى تشكيل وعي وثقافة جديدين، وإلى بناء إنسان جديد ومجتمع جدارة جديد…
في هذا الحوار تفاعل السوسيولوجي مصطفى محسن مع كل الأسئلة المطروحة-رغم ظروفه الصحية الصعبة- عن مساره في الفلسفة والتربية والسوسيولوجيا دراسة وتدريسا، وعن التضييق الذي طال شعبة السوسيولوجيا والفلسفة بعدها وتداعيات ذلك على مسار السوسيولوجيين المغاربة أنفسهم. وبوصفه مربيا وفاعلا مدنيا، تطرقنا معه إلى أدوار المجتمع المدني في إشاعة قيم المواطنة والسلوك المدني في الحياة المدرسية المغربية، وكيف يتصور بناء «مدرسة المستقبل» في تشكيل المواطن/الفرد. وإذا كانت هوية مصطفى محسن سوسيولوجية فإن له إنتاجا محترما في المسألتين التربوية والفلسفية. وما يؤطر خطابه، في كل هذا، هو مشروعه النقدي الحواري المنفتح المتعدد الأبعاد.
– ماهي سبيل تحقيق الإصلاح التربوي الشامل؟
– يصعب أن يتحقق ذلك في مجتمعاتنا مغربيا وعربيا، إلا عندما تتوفر لدى النخب الناجزة والسلط المتنفذة والقوى السياسية والاجتماعية المعنية “إرادة جماعية تشاركية” للانخراط المعقلن والهادف في سيرورات الإصلاح التربوي والتنموي الشمولي السابق الذكر. وإلا حينما تمتلك تلك القوى “وعيا حضاريا وإيمانا أكيدا” بقيمة ومكانة ومحورية “الرأسمال الإنساني” وبأهمية الاستثمار فيه، كأثمن رأسمال، في كل مسارات وعمليات ومشاريع التنمية والدمقرطة والتحديث. ذلك أن “الإنسان” المؤهل والمعد وفق سياسات تنويرية عميقة ومناهج استحقاقية وجدارة، هو، بالتحديد هدف كل تنمية أو ديموقراطية أو حداثة “مؤصلة”، والمستفيد من ريعها ومردودها، والكافل لاستمراريتها واستدامتها المتجددة في الزمان والمكان، ولنا في الكثير من تجارب وتواريخ الدول والمجتمعات والشعوب ما ينهض دليلا على ذلك كله.
ونرى أن فيما تعانيه مجتمعاتنا العربية المنتفضة الثائرة الآن من فتن وفوضى وقلاقل واحترابات أهلية وطائفية ومذهبية متصارعة، ومن أفكار وظواهر ومسلكيات التشدد والتطرف والانغلاق والتعصب والإرهاب…، ما يمكن أن نرجع بعضه إلى فشل رؤانا وسياساتنا التربوية والثقافية في بناء “الإنسان” الممتلك لكفايات الحوار والتواصل والتعايش وفض سلمي للمنازعات والخلافات وإقامة الشراكات والتوازنات الثقافية والمعتقدية والمذهبية والسوسيوسياسية المرغوبة الممكنة… وهو واقع ساهم، كما نرى، فيما تعيشه بلادنا من مآزم وتوعكات و “استعصاءات” تحولية عديدة… مما سهل على قوى داخلية وخارجية متعددة المواقف والمصالح ” اختطافا ممنهجا متنوعا ومغرضا” لبعض الأحلام والمقاصد والتطلعات المحقة النبيلة المشروعة للشعوب الثائرة في مجتمعاتنا هذه. وذلك طلبا للتحرر من نيور القمع والقهر والاستبداد والجور والفساد والاستعباد، وسعيا إلى نيل حقوقها في التنمية والديمقراطية والعيش الضامن لمكانة وقيمة وكرامة “الإنسان” في عالمنا الراهن هذا.
ولهذا، فنحن أحوج ما نكون الآن في تقديري، ومن أجل تحطيم أو تجاوز جدران كل “جيوب مقاومة التغيير وقوى الثورات المضادة” في مجتمعاتنا العربية بالذات، إلى اجتراح الآفاق الممكنة ل”ثورة تربوية وثقافية ناعمة وهادئة” موازية لما ينمو في أحشائها من حراكات ثورية متعثرة مأزومة أو حتى مختطفة كما سلف. ثورة جديدة تضع في قلب اهتماماتها وهمومها هدف ” بناء الإنسان ” وجعله دعامة مفصلية لكل مسارات ومشاريع التنمية والتحديث والتحول الديمقراطي، والاستناد على إعداده وتأهيله ليكون مدخلا أصيلا لتشييد ” مشروع نهضوي حضاري” وطني أو قومي جديد متجدد دينامي حواري متناغم مع خصوصياته الذاتية والمحلية، ومتفاعل إيجابيا مع مشتركاته الإنسانية الكونية الشاملة المتكاملة…
– أصل معك الآن، ذ. مصطفى محسن، إلى مسألة مركزية في هذا الحوار. وتتعلق بكونك أطلقت، منذ تسعينيات القرن الماضي، مشروعا معرفيا نظريا ومنهجيا هو ” المشروع النقدي الحواري المنفتح والمتعدد الأبعاد”. ذلك الذي أطر اشتغالك على قضايا سوسيولوجية وفكرية وتربوية مختلفة، مثل: المسألة التربوية بأبعادها وجوانبها، وآليات اشتغال المؤسسة التربوية، والخطاب الإصلاحي التربوي، والمسالة اللغوية وإشكالاتها، والقضية النسائية، ومعضلات التنمية الإنسانية والسياسية، وآفاق التحول الديمقراطي في بلداننا بعد انتفاضات الربيع العربي…إلخ. في هذا السياق أريد أن أسألك، بداية، عما هي الجذور المؤسسة لاهتمامك بالنقد، ولماذا اعتمدت الممارسة النقدية بمثابة “براديغم” أي نموذج إرشادي موجه لأعمالك السوسيولوجية والتربوية والفكرية بشكل عام؟
– لعل في بعض ما قدمته سابقا من إشارات وأفكار ما يرتبط، في بعض مضامينه، مع الجواب على هذا السؤال. وأقصد بذلك، كما أسلفت، أن الكثير من ميول واختيارات واهتمامات ومشاريع فاعلي الفكر والبحث والثقافة والإبداع غالبا ما يكون مرتبطا بمجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية التي كان لها تأثير ما على تربيتهم أو تنشئتهم أو تكوينهم الفكري او تجاربهم الاجتماعية والإنسانية عامة وإذا كان سؤالك هذا يفتح أمامي فرصة سانحة للحديث عما تفاعل في مساري السوسيوثقافي مما يمكن اعتباره جذورا مؤسسة لاحتفائي بالنقد، مفهوما ومدلولا وممارسة فكرية، فإنه ليس بمستطاعي، في هذا الحوار المحدود، سوى التركيز في هذا الشأن على ما هو معبر ودال، نزولا عند شروط المناسبة ومقتضيات المقام.
ففي أواسط ستينيات القرن الماضي، وأنا أحاول تلمس المعالم الأولى لطريقي نحو عالم الثقافة والإبداع، ما زلت أذكر أنني كنت قد عثرت، في قراءاتي المبكرة لأعمال فلاسفة ونقد ومفكرين كثار، قولة معبرة عميقة لحد هؤلاء. إذا كان لا يحضرني اسمه الآن، فإن مضمون هذه القولة ما يزال حتى هذه اللحظة حيا متوهج الحضور في الفكر والذاكرة والوجدان. ومفاده هو ” أن النقد الإيجابي البناء لا يعني أبدا مجرد ذلك النقد الذي يستقصد التفنيد والدحض والتجريح والقدح والهدم وإبراز السلبيات والعيوب والمثالب… وإنما هو ذلك العمل المنتج الذي يتجه إلى الجوانب المعتمة أو الضعيفة في الموضوع المنتقد فينبرها ويبدد عتمتها لينهض بها نحو الأفضل والأحسن، وإلى الجوانب المضيئة القوية في موضوعه هذا فيزيدها بهاء وإشراقا وقيمة مضافة…”. ومن هنا كانت البداية التي تشكل بفعلها لدي ” تمثل ذهني” للنقد، بما هو فعل إيجابي مرامه وديدنه ممارسة جميلة نبيلة بانية، وتقويم تثميني للعمل او الموضوع المنتقد، رافض ولافظ كل ما عداه من أفكار وعمليات الهدم والذم والتبخيس والترذيل للقيمة والمكانة الفائدة…
وعلى المستوى الذاتي الإنساني الخاص، وغير بعيد عما سبق، زجت بي الأقدار في أزمة صحية مبرحة قاسية، عشت بحكمها تجربة المستشفى، ومعاناة التوقف عن الدراسة النظامية لأشهر عديدة، وقد كانت عشقي الأكبر وملاذي الفكري، والحضن الدافئ لتوقد أنشطتي ومشاغباتي الثقافية التي لا تعرف التوقف او الفتور. وهكذا شكل هذا المنعطف المؤثر في حياتي جسدا وروحا، وفي وعيي ولا وعيي حينذاك، انكسارا فارقا في إدراكي لانسيابة الزمن وعفوية العيش، ولعنفوان والرغاب والآمال والأحلام… وأمست هواجس التخوف والتوجس والحذر من مفاجآت الحياة وغدر الزمان الغاشم العنيد… جزءا من كينونتي المنعطبة: تفكيرا وتشكلا نفسيا ونمط فعل وسلوك… وإذا صدق القول: ” رب ضارة نافعة”، فقد كان لهذه الحادثة المؤلمة، كما أظن، بعض الوقع الإيجابي على مستوى بعض أفكاري وتصوراتي الثقافية التي لم تكن قد بلغت وقتها درجة معقولة من النضج والاستواء. وذلك رغم تفوقي المتفرد في دراستي الصفية ومناشطي التربوية والثقافية العديدة. ولا ريب في أن ذلك قد شكل لحظة تحول حاسم في وعيي الفكري الناشئ، فأصبحت أكثر تحوطا في تعاملي مع تطارح السؤال/الأسئلة مماشاة لتركيبتي الذهنية اليقظة المتسائلة المتشككة التي لازمتني منذ اللحظات المبكرة لبداية تكون إدراكي ل طبيعة “الكلمات والأشياء” من حولي. كما أمسيت أيضا ميالا إلى الحد من فورة التنطع للمجادلة والمشاكسة لأساتذتي وزملائي، حتى وإن كان لك في تأدب جم وتواضع كبير.
وضمن تأثيرات القولة المنوه بها فيما سلف، ومفاعيل ما تلاها من أزمة صحية-تواترت قوة وشدة إيلام ثلاث مرات متفارقة- أضحت “رؤيتي للنقد” وفهمي لمضمونه ووظائفه أكثر سلاسة ومرونة وانفتاحا وتفهما لحدود ومحدودية و”نسبية” العديد مما هو متداول في ميادين الفكر والحياة من معطيات وأحداث ووقائع وحقائق ومواقف وتقييمات وأحكام…
وأعتقد أن هذه “الجذور الذاتية والموضوعية” المؤسسة لرؤيتي النقدية الآنفة قد اغتنت لاحقا بانفتاحي المتنامي على مجالات الآداب والعلوم الإنسانية خلال فترة “دراستي الثانوية” كي يتوسع هذا الانفتاح التفاعلي في المرحلة الجامعية، بكل ما كانت تعج به من فوران سورة حركية فكرية وطلابية قوية الحضور والتأثير، ثم ليتواصل هذا التوسع مع ما اكتسبته من معلومات وتجارب نظرية وعملية حول بعض قضايا التعليم والتعلم والبحث العلمي والعمل الثقافي… وقد كان في لب تحولات ومنعطفات هذا المسار الذاتي قراءاتي النهمة “العاشقة” للكثير من مصنفات الفكر والإبداع شرقا وغربا، واستفادتي ومعايشتي، طالبا ومدرسا، لنخبة متميزة من أساتذتنا الرواد، أستسمح القارئ في أن أذكر منهم فقط، تلاؤما مع طبيعة السياق: د. محمد عابد الجابري، ود. عبد الله العروي، ود. عبد الكبير الخطيبي، ود. محمد جسوس، ود. رشدي فكارن ود. محمد عزيز الحبابي، ود. نجيب بلدي، ود. طيب تيزيني، ود. حسن حنفي، ود. حسين مروة… وسواهم كثير من أعلام الشرق والغرب الكبار المؤسسين…ممن تأثر بفكرهم أبناء جيلي ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
وصفوة القول أنه ، خلال تفاعلات أحداث وعوامل ومتغيرات هذه المسيرة كلها، قد نشأ وتطور وتبلور اهتمامي بالنقد مضامين ومقاصد وتوجهات لتغدو رؤيتي ل “الممارسة النقدية” في حقول الفلسفة والفكر والأدب والثقافة والسياسة والاجتماع…ضربا من التملك الناضج ل”النسبية البانية المنتجة”، الناظمة لكل مكونات وظواهر ومتغيرات العالم، والمعبرة بذلك عن “جدلية دينامية معرفية مفتوحة” على ما يطال هذه المكونات من تحول متواصل في مقومات المعارف والمرجعيات والمعتقدات والأفكار، وفي أنساق القيم والعلاقات والتبادلات المادية والرمزية… جدلية محتضة لشتى أصناف التعدد والتنوع والاختلاف، وذلك بعيدا عن أي إقصاء لا عقلاني، أو أي تصلب في المواقف والرؤى، أو أي “دوغمائية” متطرفة أو ساذجة أو جامدة معطلة لقوى وإمكانات التطور والخلق والإبداع…
س.: لقد قدمتم، في إجابتكم الآنفة، عناصر ومعطيات مهمة مفيدة حول الجذور المؤسسة لاهتماماتكم بالنقد، فكرا وممارسة، مما ينتظر منه أن يعرف أكثر ببعض خلفيات “مشروعكم النقدي المتعدد الأبعاد”. إلا أني أرى مفيدا كذلك أن أسائلكم هنا عن طبيعة هذا المشروع: فبأي معنى هو متعدد؟ وما هي أبرز الأقطاب أو المحاور أو المكونات الإبستمولوجية والسوسيولوجية الكبرى التي تجعله نقدا متعددا بالمعنى الذي تمنحونه إياه، وتوظفونه به في أعمالكم السوسيولوجية والتربوية والفكرية بشكل عام…؟
ج. : في إطار تحولات المسار التكويني والبحثي والثقافي الذي انخرطت فيه، كما سبق أن ذكرت، أدركت، منذ عقود، ولا سيما في ميادين الدراسات السوسيولوجية والتربوية، أن البعض منها يتناول الظواهر المبحوثة وفق مقاربات أحادية الجانب، سواء تعلق الأمر بالخلفية النظرية المعتمدة، أو نماذج التحليل والتفسير والتأويل…، أو بالنقد المتوتر المسكون بالتركيز على ثنائيات معينة: الذات والآخر، التراث والحداثة، التاريخ الماضي والزمن الراهن، الخصوصية والكونية، التخلف والتقدم…إلخ. كما أن هذه المقاربات قد يهتم بعضها -بمبرر أو بدونه- بجوانب معينة من الظواهر المدروسة دون سواها، فيعالجها إما بالاعتماد على مرجعية ذاتية مقصية لما عداها، أو انطلاقا من الوقوع تحت طائلة الاستناد أو الخضوع شبه التام ل “مركزية غربية” حديثة أو “استشراقية” أو “استشراقية معكوسة”…
وهكذا تبقى هذه المقاربات في معظمها-رغم تثمينها الإيجابي لجهود وفوائد بعضها- مهددة بالارتماء إما في متاهات “وثوقية” صنمية اتباعية قاصرة، وإما في رِؤى لا علمية “إسقاطية مغالية”، كثيرأ ما يحكمها منطق “اختبارية نظرية ومنهجية” ضيقة ساذجة أحيانا، مفتقدة لإبداعية أي “خيال سوسيولوجي”، ومنتجة ، على عكس ذلك،ل ” كبح منهجي ” حسب المفاهيم النقدية لرايت ميلز. وكل هذا لا يفضي، في تصورنا، سوى إلى “اختزالية تبسيطية”، سواء على صعيد مكونات ظواهر الحقل المدروس، أو على مستوى زاوية النظر، أو آليات وسيرورات البحث والاشتغال… مما لا يسهم في أغلب النماذج إلا في تفقير المعرفة العلمية التي نرمي إلى إنتاجها أو تطويرها حول الواقع المبحوث. إذ أن اختزاليتها هذه لا تشمل، كما أسلفنا سوى بعض عناصر أو جوانب هذا الواقع التي تقدمها على أنها تمثله أو تعبر عنه، بيد أن ذلك لا يتأتى لها إلا ضمن حدود ومحدودية “نسبية” كبيرة في أفضل الأحوال.
وفي محاولة متواضعة مني لتجاوز بعض الأعطاب أو العوائق الإبستمولوجية أو الإيديولوجية وغيرها مما سبق سوقه، طرقت باب الانخراط في مشروع بناء أو بلورة “رؤية نقدية شمولية متعددة الأبعاد” يمكن الاسترشاد بها في معالجة متئدة متوازنة لقضايا التربية والثقافة والفكر والاجتماع، في مجتمعنا المغربي وفي بلداننا العربية و “النامية” على العموم. وذلك في شمولية وتعددية وتفاعلية ودينامية أبعادها وجوانبها ومكوناتها من جهة، وفي تعددية وتكاملية أساليب ومناهج مقاربتها من جهة ثانية. من هنا جاء مدلول التعدد، الذي يتأسس عليه مفهوم “النقد المتعدد الأبعاد”
ومتابعة للجواب، وهذه على الشق الثاني من سؤالكم المركب، يمكن القول: إن هذا التعدد يرتبط أيضا بما يشتغل عليه من أقطاب أو مجالات أو مكونات أو محاور، وكذلك بما يشـتغل به من آليات نظرية ومنهجية، ومعرفية وسوسيوثقافية وتاريخية وحضارية متعددة…وهكذا، فإن هذا النقد يشتغل على المحاور أو المكونات أو المفاهيم التالية:
*نقد الذات/النحن/الأنا الجماعية… ماضيا وحاضرا وتوجهات نحو المستقبل، وكل ما أنتجته من “تراث”ّ علمي ومعرفي وديني وثقافي وقيمي وحضاري متنوع الخلفيات والمضامين وسيرورات التطور والتكوين والتشكل…على أن يتم هذا النقد من زوايا ابستمولوجية وسوسيوتاريخية وحضارية متواشجة. وبالاستناد في ذلك على ما هو ممكن ومتاح ومطلوب أيضا من مفاهيم ونظريات ومناهج “العلوم المعرفية” والاجتماعية والإنسانية الحديثة…، وبما أصبحت تتوفر عليه الآن من رؤى ومنظورات ونماذج تحليل ومقارنة وتفسير وتأويل متنامية التجدد والاغتناء. إنه، إذن، نقد يعمل، في هذا المستوى، على حفر وتفكيك وإعادة تركيب وبناء العناصر الغنية المتنوعة ل “تراث” الذات بما هو “منجز إنساني دينامي حي” يشترط فهمه مقاربته ضمن متغيرات ومقومات السياق المعرفي والثقافي والتاريخي الذي يشكل المهاد الاجتماعي والحضاري لنشوئه وتبلوره وتطوره، كما يشترط كذلك ربطه بمستجدات سياقنا الحديث. وذلك حتى نتملكه وعيا واستيعابا واقتدارا على “جعله معاصرا لنا” بتعبير محمد عابد الجابري، أو تحويله إلى “تاريخ راهن” على حد تعبير محمد أركون. إن الدراسة العلمية “التفهمية” لهذه “الجدلية المتواصلة ” بين ذينك السياقين هي القمينة، في تقديرنا، بإبراز القيمة التاريخية لخصوصيات التراث، وجعله متفاعلا متحاورا بشكل إيجابي منتج مع مقومات “الحداثة” بكل منظوماتها المعرفية والتقانية والقيمية المتجددة. والتي تطورت معها مضامين ومفاهيم الهوية والخصوصية والمواطنة والكونية، لا بالنسبة لمقولات وفهوم تراثنا وحسب، ولكن بالنسبة أيضا للثقافة الإنسانية الراهنة بشكل أعم وأشمل.
*نقد الآخر/الغير/الغرب/المختلف الحضاري…وذلك وفق المقاربة المنهجية التفكيكية الآنفة، وما تعتمده من آليات إبستمولوجية وسوسيولوجية وحضارية وتاريخية في النقد والتحليل والتركيب وإعادة البناء والفهم والتفهم ل “المنجز العلمي والثقافي” لهذا المكون المغاير/الغرب. وذلك بهدف استيعابه موضوعيا وعقلانيا، وفي أفق انفتاح حواري لا يقوم على أي “تبخيسية مجانية” لقيمة هذا المنجز، ولا يكرس في نفس الآن أي “اتباعية غفل” لمنتجاته المعرفية والحضارية سواء كان ذلك على مستوى النظر، أو الممارسة الاجتماعية…
ولعل أهم ما ينبغي أن يتجه نحوه النقد على هذا الصعيد، هو العمل على تشريح الإواليات المؤسسة ل “المركزية الغربية” في مجمل أبعادها وتجلياتها ونظرتها للآخر الذي هو “النحن”. وهي نظرة تعبر عنها، بشكل وبقدر أو بآخر، ما ينعت ب “الدراسات الاستشراقية”، أو “الكتابات أو الآداب الكولونيالية” وما ينحو نحوها من توجهات أو منتوجات ثقافية مختلفة. غير أن ذلك لا ينبغي أن يصدر عن نقد اعتباطي مسبق المبيتات وخلفيات الرفض أو الإقصاء بمبررات المغايرة والاختلاف، وإنما يستلزم استيعاب وتملك هذه المنتوجات الغربية كلها ضرورة “نقد منهجي حواري متعدد مفتوح”، يربطها، تكوينا وتطورا وامتدادات ومقومات اشتغال، بمجمل الشروط المعرفية والتاريخية للسياق الذي أفرزها في فضاء محدد في الزمان والمكان. كما يعمل على التمييز فيما بين ما هو”إيديولوجي وتاريخي”، وبين ما هو “علمي” مرتبط بتقدم المعرفة العلمية ومستجداتها المتطورة. هكذا يتمكن هذا النقد من إقامة “قطيعة سوسيومعرفية” في حدودها النسبية بالطبع، مع معظم الرؤى والتصورات والقراءات التقليدية واللاعلمية المتداولة والموروثة لهذا المنجز الغربي، ولتراث الذات في آن.
*نقد اللحظة التاريخية والحضارية في أبعادها الماضية، وتحولات أزمنتها، ومتغيرات وضعها الراهن، وتوجهاتها المستقبلية، وعلى المستويات المعرفية والسوسيوثقافية المنوه بها قبلا. ذلك أن “تراثات” الذات والآخر معا، وبما هي فعل إنساني، قد تولدت ونمت وتطورت واكتسبت هويتها أو خصوصيتها المتميزة في حضن لحظة تاريخية معطاة. ومن ثم فإن مقاربتها وفهم واستيعاب واستيعاء خلفياتها ومضامينها المعرفية والاجتماعية مقاصد لا يحصل تحققها إلا بواسطة ذلك “النقد المتعدد” الذي يشتغل على تحليل وتفكيك وإعادة صياغة جديدة لمكوناتها هذه. وذلك بما يقربنا منها ويقدرنا على التعامل الإيجابي مع مقتضياتها في أزمنتها المتغيرة، وليس انطلاقا من “منطق لا تاريخي” مفارق للواقع، ينظر إليها كما لو أنها معارف أو معطيات أو وقائع أو مواقف مطلقة تامة التكوين والاكتمال، الأمر الذي يبقيها، سواء على مستوى إدراكها أو التفاعل معها في تاريخيتها المتحركة أو في لحظتها الحضارية الراهنة، محنطة متكلسة جامدة، وبالتالي عاجزة عن أن تبني بينها وبين “قيم وثقافة الحداثة وما بعد الحداثة”، في سيرورة تبنينها وتجدها، “جسور” وصل وتواصل وتحاور وتبادل منتج سليم متعدد الأبعاد والجوانب المادية والروحية المتناغمة…
وأعتقد أن هذا “النقد المتعدد البعاد”، بتركيزه على المحاور السابقة: الذات/الآخر/اللحظة التاريخية…، وبالحفر المنهجي فيما يؤسسها من مرجعيات ومقولات وقيم ومقومات وممارسات…كفيل-ولو ضمن شروط نسبية بالطبع- بأن يساهم في “تحريرنا” من سجون وأوهام وأغلال وأنماط وعي وتفكير ومقولات “العقل الماضوي” بما هي، في بعض نماذجها وقناعاتها ومعتقداتها، “عوائق سوسيوإبستمولوجية” معطلة، بالمفهوم الباشلاري المتداول، كما أنه قمين أيضا بان يساعدنا على “التحرر” من إكراهات الزمن الحديث المعولم، وعلى امتلاك ما هو مطلوب وممكن من عناصر الأهلية والاستحقاقية وجدارة الانتماء إلى هذه “العالمية الجديدة”، المتسارعة التبدل والتحول على أكثر من صعيد. وهكذا تغدو، في تصوري، أكثر كفاءة وفاعلية في مسارات الارتياد العقلاني لجهود و”مشاريع التجديد النقدي” لتراثنا وفكرنا العربي الإسلامي، وكذلك لخطط وبرامج تطوير وتحديث ممارستنا الثقافية والسياسية والسوسيوحضارية. وذلك بما ينسجم مع هويتنا المفتوحة المتجددة وخصوصيتنا الذاتية، وينفتح في نفس الآن على مشتركاتنا وقيمنا الإنسانية الكونية الراهنة المتعددة…
– : إذا كان مشروعكم النقدي هذا حواريا منفتحا، يراجع وينتقد ويطور ذاته باستمرار، فأنت هنا قريب من الفلسفة في صياغة هذا المفهوم، إذا اعتبرنا أنه “إبداع مفهومي” بتعبير دولوز. فهل النقد حكر على الفلسفة تحديدا؟ وهل مشروعكم النقدي المتعدد هذا هو رؤية أم استراتيجية أم مفهوم أم منظور…؟
– : إذ لم تعد الفلسفة أما للعلوم، بالمعنى الكلاسيكي المتداول، فإنها ما تزال حية في “هوامشها” الجديدة، أي فيما تفرع واستقل عنها من علوم إنسانية وغيرها من العلوم الدقيقة كذلك. ومن ثم، فإن الفلسفة، كأفق مشرع للتفكير والسؤال والنقد، تظل دوما “محايثة” لكل جهد فكري أو علمي، وخاصة في حقول المعارف الإنسانية والاجتماعية بشتى نظرياتها ومناهجها المتعددة. ولذا فإن النقد، كآلية للحفر والنخر والتفكيك كما سبق الذكر، يبقى حاضرا في كل ممارسة علمية، وإن بشكل أو بقدر تحدده شروط وضوابط التخصص وخلفية البحث والباحث. غير أن علم الاجتماع بالذات دون غيره من العلوم الآنفة، حسب العديد من مؤسسيه وأعلامه الكبار حقلا لا يمكن “تعريفه بموضوعه”، وإنما ب “آليات اشتغاله” والمتمثلة في المضمون النقدي ل “حرفة عالم الاجتماع”، وفق لغة بيير بورديو. تلك التي تتأسس على “وظيفته النقدية” الرامية إلى كشف وتعرية وفضح وانتهاك ما يتستر أو يكمن خلف عمليات إنتاج وإعادة إنتاج الأفكار والعقديات والبنيات والمؤسسات والسلط والممارسات والمجالات المادية والرمزية المختلفة القائمة في شروط سوسيومعرفية محددة. وأزعم أنني، في صياغتي أو “نحتي” لمفهوم النقد، إذا اعتبرنا أنه “إبداع مفهومي” كما ورد في السؤال، قد استلهمت دلالته الواسعة من طبيعة حضوره وتداوله في التراث السوسيولوجي الغربي الحديث، والذي ما يزال في رأيي، ممهورا بتواشجه العميق مع التراث الفلسفي بشكل عام.
اما فيما يتعلق بالشق الثاني من سؤالكم، فإني أستحسن وسم هذا النقد بكونه، على المستوى الفكري، أقرب إلى “النموذج او الإطار الإرشادي: البراديغم” الموجه للنظر والعمل العلمي، وبكونه، على المستوى التطبيقي، “برنامج عمل وتدخل”. وبالتالي فهو أقرب على الصياغة التركيبية التكاملية بين كل ما ذكرتم. هو، إذن رؤية ومنظور ومشروع واستراتيجية فعل واشتغال. وبهذا المعمى أو المضمون الشمولي، فإن هذا النقد ينبغي أن ينظر إليه على أنه ” خارطة طريق” أقترح الاستهداء بها في بحث مجمل الظاهر والأفعال الاجتماعية المتنفذة في شرطيات تاريخية معطاة.
ويبدو هنا مفيدا أن أشير، ولو بإيجاز، المدلول الذي أريد أن يفهم من كلمة أو مفهوم “المشروع”، وبالخصوص كما وردت أحيانا في بعض أعمالي، وكما وردت أيضا في بعض الدراسات والقراءات التي أنجزت حول هذه الأعمال. فعلى المستوى الاشتقاقي/الإيثيمولوجي، تعني هذه الكلمة، من ضمن ما تعنيه في جذرها اللغوي الغربي، ما يفيد الاستباق أو التوجه أوما يشبه “الارتماء” في أحضان المستقبل أو المتوقع أو المحتمل أو الممكن…إلخ. وبهذا المعنى، فإن كل مشروع فكري أو ثقافي أو سياسي أو مجتمعي عام، لا يمكن اعتباره إنجازا مكتملا أو نهائيا أو مطلقا. وإنما ينبغي إدراكه بما هو “سيرورة” إمكانات وممكنات مفتوحة على آفاق وعمليات لا تنتهي من التطور والتغير وتجدد الانبناء والاغتناء والتبادل والتأثر في الشكل والمضمون والخلفيات وآليات الاشتغال… ومن ثم فهو كما سبق الذكر، ” استراتيجية فعل وتدخل” رؤيوي ومنهجي ضد ضروب كل النزعات اليقينية أوالدوغمائية أو الإسقاطية أو الاختبارية أو الجبرية أوالعقائدية… التي ترفض “منطق الحراك التاريخي” لتتصنم منمطة ومحنطة ضمن “سكونية/ستاتيكية” متصلبة جامدة…ولذا، فإن هذا المشروع النقدي يظل، في مجمل أعمالي -التي لا يمكن لأي منها أن يستنفد مقتضياته ومقاصده كلها- بمثابة مرجعية ضمنية إرشادية موجهة للنظر والبحث وللممارسة التاريخية المتعينة في الزمان والفضاء…
– وما دمنا في مجال النقد، فإنه يلاحظ أن ” مشروع النقد المتعدد” لدى الأستاذ مصطفى محسن تربطه بمشاريع مفكرين آخرين مثلك عبد الكبير الخطيبي، وعبد الله العروي، ومحمد عابد الجابري، وغيرهم…مجموعة من التقاطعات والتشابكات الإيجابية فعلا. فكيف تفاعلتم مع هذه المشاريع الفكرية الحداثية وسواها، ما دام النقد فيها وفي مشروعكم يعد منطلقا يتعارض مع الفكر الآحادي ويخترق الثنائيات والحدود …؟
– تعتبر الأسماء الواردة في سؤالكم، إضافة إلى من سبق أن ذكرنا من المفكرين، مرجعيات فكرية كبرى مؤسسة، بل ربما بمثابة “مدارس فكرية”، تكون وتعلم في أحضانها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، رعيل واسع من أجيال الاستقلال. ولعل من المفيد هنا أن أشير-على سبيل التمثيل والتذكير ليس إلا- إلى المشاريع النقدية للبعض من هذه النخبة من الرواد. وذلك من نجار ومستوى: “نقد العقل العربي” للجابري، و “التاريخانية النقدية” للعروي، و “النقد المزدوج” للخطيبي، و “نقد العقل الإسلامي” لأركون، و “نقد خطاب التنمية والتحديث، والتقليد والتبعية والتخلف” لمحمد جسوس، وفلسفة “الغدية” عند محمد عزيز الحبابي…هذا كي لا ننسى مشاريع نقدية أخرى مماثلة أو موازية على صعيد العالم العربي، مثل: “الرؤية النقدية للفكر العربي…” لطيب تيزيني، و “النزعات المادية …” لحسين مروة، و “نقد الفكر الديني” لصادق جلال العظم، و ” نقد الاستغراب” عند حسن حنفي، ونقد “الاستشراق” لإدوارد سعيد، و “النقد الحضاري للمجتمع العربي ” لهشام شرابي…إلخ، كي لا نورد سوى هذه النماذج البارزة.
ومن أهم ما يتضح من مضامين هذه المشاريع النقدية الكبرى، ومن جهود ومشاريع تلامذتها من أبناء جيلي، وكذلك من القراءات والبحوث الهامة التي أنجزت حول هذه المشاريع، أنها تلتقي في الكثير من التقاطعات والتواشجات والنواظم ، التي تشكل قواسم مشتركة بينهما، ليس فقط على مستوى المضامين والأهداف والأدوات النظرية والمنهجية، وإنما حتى في بعض الخلفيات الإيديولوجية والسوسيوثقافية أحيانا، مما يرتبط، كما هو معروف إبستمولوجيا، بذاتية الباحث وانتمائه الاجتماعي وسياق وشروط تشكل مشروعه الفكري… ولعل من أهم العوامل التي تبرر أو تفسر بعض هذه التقاطعات أو التداخلات الآنفة، ما يمكن أن نشير إلى بعضه في الملاحظات الآتية:
-لقد كانت هذه المشاريع كلها، سواء عند الرواد الأوائل المؤسسين أومن حدا حدوهم من تلامذتهم العديدين، تهدف، من بين ما تهدف إليه، إلى إنجاز ما هو مطلوب ومنتظر من “قطيعة منهجية” عقلانية مع “الغربّ” ليس فقط في شكله الاستعماري المباشر، وفك الارتباط به، وتأسيس “دولة وطنية مسـتقلة” عنه إدارة وسياسة واقتصادا وتوجهات نحو التنمية والديمقراطية والتحديث…، إنما يجب أن تشمل هذه القطيعة أيضا مجمل ” معارفه ودراساته الاستشراقية والكولونيالية ” المتنوعة. وذلك عبر نقدها ثم تجاوزها إبستمولوجيا وإيديولوجيا، كي تصبح الإفادة منها ممكنة منتجة. وهذا أيضا هو ما يطلب القيام به بالنسبة للتراث الغربي برمته، بكل علومه ومنتوجاته الفكرية، ونظرياته ومناهجه المتطورة، ومنجزاته الحداثية بتقنياتها وحساسياتها القيمية والثقافية، وبجوانبها المادية والروحية المتداخلة المتعددة…
-إنجاز “قطيعة موازية” أيضا مع كل القراءات والتصورات والفهوم والنماذج التقليدية اللاتاريخية المنتهجة في مقاربة “التراث العربي الإسلامي” سواء في “نصوصه المؤسسة” أو ما أنتج حوله من نصوص وأنماط فهم وتفسير وتأويل… الأمر الذي يستوجب إخضاعه، بشكل علمي عقلاني لا تعسف فيه ولا إسقاط لا مبرر له، لما تقترحه في هذا المجال علوم الإنسان والمجتمع، مثل: السوسيولوجيا والأنتربولوجيا والتاريخ والألسنية الحديثة…وغيرها من مفاهيم ونظريات ومناهج تحليل وبحث مستحدثة متنوعة. وذلك بغرض إعادة بناء جديدة لهذا التراث، تقرأه، على ضوء كل هذه المعارف والمناهج، في زمنيته الذاتية التي انبثق في أحضانها، وفي شروط تحولاته، كما في ظل تاريخيته الراهنة. مما يمكن الباحث/القارئ من فهمه وتملكه إبستمولوجيا وسوسيولوجيا، ومن “الاجتهاد المجدد المتجدد” في عمليات استيعابه والتعامل معه والإفادة منه وفق مقتضيات ومتطلبات العصر بالأساس، وليس دائما بالضرورة وفق معطيات التواريخ الماضية التي أنتجت بعض نماذجه وفهومه ضمن شروط معرفية واجتماعية محددة في الزمان والمكان…
ضمن هه الجهود والاجتهادات المتميزة لهذه المشاريع الفكرية الرائدة، يحاول “منظور النقد المتعدد الأبعاد” أن يتموقع، أهدافا وخلفيات ومضامين ورؤية منهجية منفتحة، وبما هو، كما أسلفنا، “مشروع” ينبذ الفردية والانغلاق، ويرمي إلى الانتماء الحواري التفاعلي إلى دينامية هذه “السيرورة الجماعية المشتركة” من جهود التفكير والبحث وإنتاج الدلالة والمعنى… ولذا فإن ما يمكن أن يلاحظ من تقاطعات أو تشابكات بينه وبين مختلف المشاريع النقدية المذكورة يعد، في تقديرنا وفي إطار رؤيتنا التكاملية المفتوحة، حالة فكرية طبيعية، بل مطلبا علميا وعمليا وحضاريا مرغوبا في مضامينه، وفي مساعيه التي تروم، في المقام الأول، تجديد وتحديث المجتمع العربي فكرا وممارسات سوسيوتاريخية متعددة…
وحتى يكون هذا التموقع المذكور منتجا ذا قيمة مضافة نوعية جديدة، فقد عملت -ولعدة عوامل ذاتية وموضوعية سبقت الإشارة إلى بعضها- على أن أتخذ من قضايا التربية والثقافة والتنمية حقلا للاشتغال والاهتمام، ومن السوسيولوجيا بالأساس زاوية تخصصية للنظر والبحث. ذلك أني قد لاحظت أن الفكر العربي المعاصر ما زال يحتاج في هذا الحقل إلى مزيد من الإضافة والجهد، على الرغم مما قدم فيه حتى الآن من إثراءات قيمة محمودة. إلا أن ذلك، رغم أهميته الوازنة، لم يصل بعد إلى تبلور “فكر تربوي عربي حديث” قائم بذاته: فلسفة ومرجعيات نظرية ومنهجية وإشكالات ومحاور اهتمام وعمل…، وقادر بذلك على دراسة واستيعاب ونقد ما تعرفه نظم التربية والتكوين في مجتمعاتنا من أزمات واختلالات وأعطاب مؤسسية ولامؤسسية مختلفة، مما جعلها، كما أسلفنا، لا تسهم إلا ضمن هوامش ضيقة محدودة في تحقيق استثمار رشيد في “رأسمال الإنسان”، وتأهله بمقومات الاستحقاقية والجودة والجدارة والجدوى، كي يغدو جسر عبور إلى كسب رهانات التنمية الإنسانية والاجتماعية الشاملة. وخاصة في إطار ما تعرفه بلداننا هذه من استشراء لأوضاع رديئة من الفساد والتخلف والاستبداد، مما ساهم في هدر الإمكانات الذاتية والموضوعية المتاحة وفي تعطيل الكثير من خطط ومشاريع وطموحات ومسارات التنمية والتحديث، والانخراط الفاعل في مجمل تحديات ورهانات “الزمن الحاضر” بكل إكراهاته ومطالبه المتعددة…
لذا، حتى حينما كنت أحضر كعضو مشارك في دورات “المؤتمر القومي العربي” كنت أحرص على أن تسير مداخلاتي في نفس المنحى، مقترحا في كثير منها مضاعفة الاهتمام ب “لمسألة التربوية في الوطن العربي” عموما، وبكل أبعادها وديناميكياتها نظرية وممارسة، وبدائل وجهود إصلاح وتجديد، وتضمين ذلك بشكل بارز الحضور، وكمحور أساسي في محتويات التقرير الذي يصدر عقب دورات المؤتمر، والموسوم ب “حال الأمة”. وقد لاحظت أن نخبة مائزة من مثقفي وساسة وباحثي أعضاء المؤتمر قد شاركتني العديد من هذه الاهتمامات والهموم، معتبرة أن إنماء الفكر التربوي العربي يعد، بالفعل، دعامة مفصلية لتطوير وتحديث الفكر العربي بشكل عام…، بل ولكل مشروع مجتمعي وطني أو قومي، يراد منه أن يكون واضح المرجعيات والمعالم، متكامل العناصر والأهداف وبرامج وخطط التنزيل والتطبيق…
ولا ينبغي أن نغفل، ونحن نحاول موضعة “النقد المتعدد الأبعاد” في إطار المنابع الفكرية التي نهل منها، إضافة إلى النتاجات العربية التي سبقت الإشارة إليها، أهمية أن نستحضر بالتساوق والتفاعل معها أيضا مشاريع وأعمالا فكرية غربية مؤسسة لأجيال الرواد المحثين، مثل: هيجل، وفرويد، وماركس، وسارتر، ولاكان، وألتوسير، وغوديليي، وماركوز، ورودينسون، وبيرك، وإرندت، وسترواوس، وبارث، وغولدمان، ولينهارت، وتودوروف، وكريستيفا، وآرون، وتورين، وتشومسكي، وبنفنيست، وفوكو، ودريدا، ودوبري، وبورديو، وموران، وبودون، وبيرنشتاين…إلخ، وغيرهم كثير. هذا كي لا نورد هنا سوى بعض ما يحضرني في الذاكرة الآن من هذه النماذج، التي كان لها، كما لغيرها بكل تأكيد، الدور المؤثر في تشكيل ما غدا يدعى ب ” الحساسية النقدية الجديدة” بما لها من روافد فلسفية وعقائدية وسوسيوثقافية وسياسية وأدبية وفنية … متعددة الأنماط وأشكال التعبير ومحاور ومجالات الاهتمام، وبكل ما كان لها من الذيوع والانتشار، وتوجيه الكثير من مغامرات التفكير والنقد وتجارب الكتابة والإبداع…
وإذا كنت لا أستطيع الادعاء بأني قد استوعبت وتمثلت كل هذه المرجعيات الفكرية الكبرى،عربية كانت اوغربية، وبجل مقاصدها ومضامينها الغنية المتنوعة، فإني لا يمكن أن أغفل أنها، كما أوضحت سابقا، قد كان لها، بالغ التأثير في تكوين وتوجيه ابناء جيلي وغيره، وفي تبلور ونضوج أنماط وعيهم الفكري والسياسي وممارساتهم الثقافية والاجتماعية المختلفة…مما لا شك في أن محمولاته قد انعكست، بصيغة أو بأخرى وبمقدار أو بآخر، في بعض أعمالي. وذلك حسب ما عالجته فيها، من إشكاليات وقضايا، ومما يبقى مشروطا بانهمامات وهواجس ومواضعات سوسيوثقافية وتاريخية معينة متباينة…
هكذا، إذن، وتأسيسا على كل الحيثيات والاعتبارات الفكرية والاجتماعية المسوقة فيما قبل، فإن اجتهادات ومجهودات “النقد المتعدد الأبعاد” قد راهنت دوما على أن تجد لها مواطئ أقدام في حركية المنظورات النقدية المذكورة وغاياتها الأساسية الكبرى، الرامية إلى تملكها لأهلية الاستحقاق المساهمة في تجديد وتطوير الفكر والمجتمع والتاريخ، وذلك على واجهتين هامتين:
-أولا : على مستوى إعادة البناء النقدي للفكر العربي، وطنيا وقوميا، كي يكون منطلقا لتوليد وعي تربوي وثقافي وسياسي وحضاري جديد مستنير، ينتظر منه أن يشكل الأسس الداعمة والمهد الخصب لانبثاق مجتمع جديد، ومواطنة جديدة، ومشروع تنموي حداثي ديمقراطي جديد متجدد الأفكار والقيم والمرجعيات والأطر الحضارية والإنسانية المرشدة لأدوات النظر والممارسة…
-ثانيا : تأهيل مقومات الفكر والمجتمع في واقعنا العربي كي تكسب قدرات المشروع الحواري المفتوح المتفاعل، من جهة، مع هويتنا وخصوصياتنا المادية والروحية المؤطرة بشروطها الزمنية المتعددة، ومن جهة ثانية، مع تحديات ورهانات اللحظة الحضارية الحالية المعولمة ب “نظامها العالمي الجديد” وثقافتها ومستجداتها المادية والرمزية المتسارعة التحول والتجدد على أكثر من صعيد، كما أكدنا على ذلك مرارا، وفي ثنايا هذا الحوار بالذات.
وفي إطار هذا المشروع، بأبعاده المحلية والكونية، يمكن النظر إلى “النقد المتعدد” بما هو أفق فكري حواري مفتوح، ورؤية حضارية رامية إلى الانخراط العقلاني الملتزم المسؤول في مجمل تحديات “تنمية الإنساني” كفيلة بأن تعيد ل “الإنسان”، في جوانبه المادية والروحية، ألق المكانة والدور، وتوهج القيم والمبادئ الأصيلة الجميلة. وخاصة في غمار تفاعلات “وضعنا البشري” المتوتر الآن، ذاك الذي أصبح محاصرا، بل مهددا بتحديات عولمية لاتجاهات وفلسفات واستشرافات ما أصبح يدعى حاليا بتيارات “ما بعد الإنسانية، أو عبر الإنسانية: Trans-humanisme “، المنذرة بما يتوقع أن تمارسه التكنولوجيات الجديدة الفائقة الدقة، والرقمنة العالية التطور من تأثيرات نوعية عميقة في الإنسان وفي “برمجة” عقله وتفكيره ووعيه وذكائه وبناه الجسدية والروحية، ومن تحكم مدهش مريع في مسلكياته: واختياراته السياسية والمهنية والاجتماعية، ومن توجيه وتشكيل لذوقه، وأساليب عيشه ونمط حياته، ومن تدخل مباشر وغير مباشر في تحديد معالم مستقبله المريعة المذهلة الغريبة، بل وحتى في موقعه المركزي في العالم، وفي مصير وجوده على هذا الكوكب الأرضي…ومع ذلك فإن الدفع باتجاه تدعيم “الأنسنة” الآنفة سوف يبقى في تقديرنا -ولاعتبارات أخلاقية وروحية وحضارية ليس هذا مجالا مناسبا لمناقشتها بما هو ممكن من تحليل وتفصيل- هدفا نبيلا ونضالا فكريا وعمليا مشروعا ضد ما يشهده العالم الآن من هيمنة متصاعدة للبؤس والشقاء والاهتراء، والكثير من مظاهر التفاهة و” الترذيل ” والرداءة المستشرية في كل مفاصل حياتنا المادية والرمزية المتباينة.
وفي مختتم هذا الحوار، نرى مفيدا ضرورة التأكيد من جديد على أنه لا يتجاوز كونه مجرد “نافذة/ نوافذ” يفترض أن نطل منها على ما عالجناه في منجز أعمالنا المتواضعة من إشكالات وقضايا سوسيولوجية وتربوية وفكرية عامة وما كان يحركنا في ذلك من اهتمامات وتوجهات وقناعات وهواجس نقدية متعددة…
إلا أنني إذا كنت، بكل صدق واعتراف، أكثر إحساسا بثقل ما عانيته من جهد في سبيل إنجاز هذه الأعمال، رغم ما يعتورها من جوانب المحدودية والقصور، فإن القراء من مثقفين وباحثين ومهتمين وفاعلين سياسيين وتربويين واجتماعيين…، على اختلاف أذواقهم ومقصدياتهم ومرجعياتهم القارئة، هم الأجدر والأحق، كما أرى، بان يصدروا حولها ما يعتقدون أنه ملائم من آراء وتقييمات وتقويمات ومواقف وأحكام…أحسن الظن بأن العديد منها سوف يكون أقرب إلى الموضوعية والتجرد والإنصاف والصواب…كما أرجو أن يجدوا فيها، كما في هذا الحوار بالذات، ، بعض ما ينفع ويفيد في الحاضر والمستقبل، وبعض ما يحفز على تدعيم ورفد وإنماء تلك “الجدلية المفتوحة” المنوه بها فيما قبل، والتي يطمح “النقد المتعدد” إلى أن يجعل منها سيرورة دينامية مشرعة على آفاق أرحب وأوسع احتضانا لقيم ومبادئ وثقافة الاختلاف والتعدد والتنوع الإنساني المبدع الخلاق، مما ينتظر منه أن يخصب، في الوعي والسلوك “إيطيقا” وقواعد الحوار والانفتاح والتعايش والتضامن والتسامح والسلام في هذا العالم الصاخب الموار…