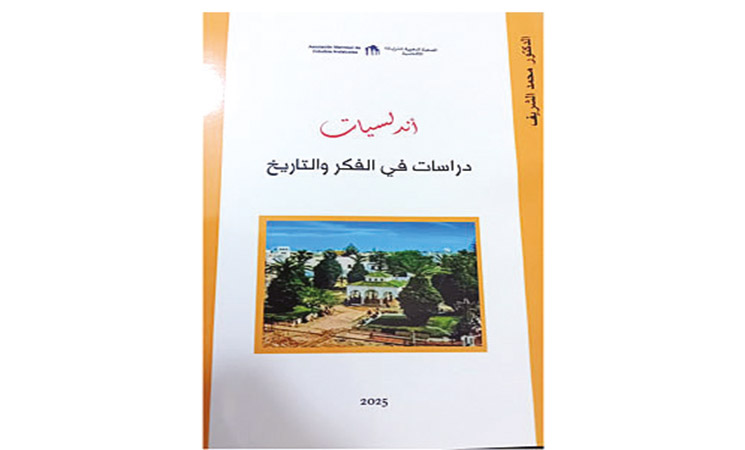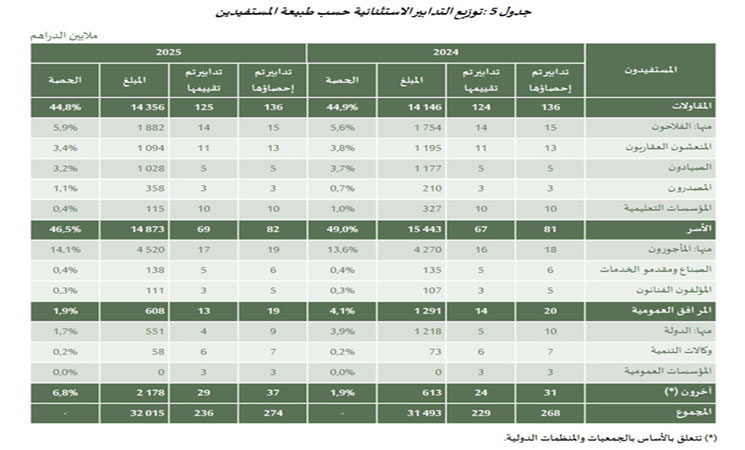إذا كان المبدع والمفكر المغربي الراحل محمد الصباغ قد امتاز باستعمال صيغته الأثيرة «أندلس الأعماق» في وصف التراث الزاخر لجسور التواصل الثقافي الأندلسي داخل بيئته المغربية الحاضنة، فالمؤكد أن الأمر عرف استرسالا لافتا لانفتاح مؤرخي المغرب المعاصر من أجل توسيع آفاق الدراسات الأندلسية التخصصية، ليس -فقط- على المستويات السياسية الحدثية المرتبطة بتجربة الثمانية قرون من الحضور الإسلامي بشبه الجزيرة الإيبيرية، ولكن -أساسا- على مستوى رصد معالم التوهج في حصيلة التراث الثقافي والرمزي الذي لا يزال يرخي بظلاله على مجمل أنساق الفكر المغربي -والإسباني على حد سواء- إلى يومنا هذا. فبعيدا عن الأحكام النوسطالجية الحالمة، وبعيدا عن تهافت القراءات المتباكية على الحلم الذي لن يعود، وبعيدا عن أوهام «الفردوس المفقود»، ظل البحث العلمي حريصا على الانتقال للتأصيل لعناصر الثبات والتغير داخل مجمل مظاهر التلاقح الثقافي بين الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. فكانت النتيجة، بروز توجهات أكاديمية رفيعة، وخاصة بالمغرب وبإسبانيا وبفرنسا وبإنجلترا وبالولايات المتحدة الأمريكية، سعت إلى إعادة قراءة صفحات ماضي الأندلس على ضوء ركائز نقدية مجددة وجريئة، على مستوى المنهج أولا، وعلى مستوى المنطلقات ثانيا، وعلى مستوى الأهداف ثالثا، ثم على مستوى الآفاق المنتظرة للبحث بهذا الخصوص رابعا. وبذلك، أمكن الحديث عن تأصيل علمي لشروط الاشتغال على مكونات ذاتنا الأندلسية، وفق رؤى متحررة من هواجس الحنين العقيم لأرض «الفردوس المفقود»، ووفق ثوابت منهجية تتجاوز إكراهات الضغط والاحتلال والاستعمار في علاقة المغرب بجارته إسبانيا، وانطلاقا من عُدة علمية تُحسن الإنصات لضوابط البحث العلمي الأصيل ولأدواته الإجرائية المؤطرة لصنعة كتابة التاريخ.
ويمكن القول إن الدراسات المغربية المعاصرة استطاعت تحقيق تراكم هام من القيم المميزة لتيارات الاشتغال داخل التراث الأندلسي، واختصت مدينة تطوان بالريادة غير المتنازع حولها بهذا الخصوص، لعوامل تاريخية وثقافية معروفة. لقد أنجزت الجامعة المغربية أعمالا مؤسسة جعلت المكون الأندلسي داخل الهوية المغربية المركبة يستعيد معالم نبوغه وأشكال حضوره، وعناصر استمرار انتصابه داخل حقل التراث الرمزي الواسع لمغاربة الزمن الراهن. ويعتبر الأستاذ محمد الشريف واحدا من أبرز المؤرخين المغاربة الذين نجحوا في تحقيق تراكم علمي محترم حول مجالات الدراسات الأندلسية، من خلال سلسلة من إصداراته ذات الصلة، ومن خلال مشاركاته الغزيرة في منتديات علمية لها مصداقيتها الأكاديمية غير المتنازع حولها، داخل المغرب وخارجه. وقد استلهم -في هذا المنحى- مكتسباته المعرفية المستخلصة من تجربة عقود مسترسلة من الاشتغال على تلاوين تاريخ الغرب الإسلامي الوسيط، مما أكسبه أرصدة معرفية متميزة حول قضايا مركزية في الاشتغال على إبدالات التاريخ الوسيط، بتشعب مجال تعميم الخلاصات والنتائج، إذ جمع بين التأليف المونوغرافي المجهري مثلما هو الحال مع عمله الضخم حول سبتة الإسلامية، وبين تحقيق المتون الدفينة للإسطوغرافيات الكلاسيكية، ثم بين ترجمة أعمال متخصصة من لغاتها الأصلية وتعميم تداولها بين الباحثين والمهتمين.
في سياق تواتر عطاء هذه السيرة العلمية للأستاذ محمد الشريف، يندرج صدور كتابه «أندلسيات- دراسات في الفكر والتاريخ»، سنة 2025، في ما مجموعه 201 من الصفحات ذات الحجم الكبير، وذلك ضمن منشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية. ويوضح المؤلف السقف العلمي لعمله الجديد في كلمته التقديمية المركبة، قائلا: «تعد التجربة الأندلسية من أهم تجارب التاريخ العربي والإسلامي والعالمي، وتعرف الدراسات الأندلسية اهتماما متزايدا على المستوى الجامعي والبحثي الأكاديمي حتى أن المكتبة العربية والأجنبية أصبحت غنية جدا بالدراسات الأندلسية، وأصبحنا الآن على دراية بسمات الحضارة الأندلسية وأهمية إرثها الثقافي والعلمي والتاريخي والاجتماعي على الصعيد العالمي. ونظرا للارتباط التاريخي العضوي بين المغرب والأندلس، كان من الطبيعي أن يولي الباحثون المغاربة أهمية كبرى للتاريخ المغربي الأندلسي المشترك والمتداخل، حتى أصبحت المدرسة التاريخية المغربية تعد من أهم المدارس الفكرية وأكثرها اهتماما ومعرفة بالتاريخ الأندلسي وحضارته. يعتبر المغرب وريث التراث الأندلسي وحضارته، بيد أن الإرث الأندلسي تتقاسمه دول وشعوب أخرى مع المغرب، من حيث هو تراث عالمي، يهتم به باحثون من مختلف أصقاع العالم. وهنا تكمن صعوبة حصر بيبليوغرافية الأندلس، بما أن تاريخها يندمج اندماجا كبيرا في تاريخ المغرب، وتاريخ حوض البحر الأبيض المتوسط، وتاريخ شبه الجزيرة الإيبيرية وتاريخ المشرق. فالإلمام بالكتابات المتعلقة به يقتضي الاطلاع على تاريخ المنطقة كلها… خصوصا وأن الأدوات البيبليوغرافية المتوفرة تشكو من نقص في المعلومات، وعدم الانتظام في توفرها. فنحن لا نتوفر على دليل بيبليوغرافي، أو نشرة منتظمة متعلقة بالإصدارات التاريخية حول تاريخ الأندلس… وهذا الكتاب هو في قسم منه، محاولة لفحص حصيلة الأبحاث الأندلسية والوقوف على توجهاتها العامة في الوقت الراهن وآفاقها المحتملة» (ص ص. 5-6).
تتوزع مضامين كتاب «أندلسيات- دراسات في الفكر والتاريخ» بين سبعة مباحث أساسية، قدمت نتائج النبش الدقيق للأستاذ محمد الشريف في ذخائر البيبليوغرافيات، الكلاسيكية والمجددة، المغربية والعالمية، ذات الصلة بمختلف حلقات تاريخ بلاد الأندلس. ففي المبحث الأول، سعى محمد الشريف إلى تقديم قراءة تاريخية فاحصة لفتوى ابن ربيع الأندلسي (ت 719ه/ 1320م) حول جواز إقامة المسلمين في الأراضي التي استولى عليها النصارى بالأندلس. وفي المبحث الثاني، اشتغل المؤلف على نصوص دفينة حول الحياة الاجتماعية بالأندلس مستخرجة من كتاب «الدعاء والذكر» لأبي الحسن بن علي الأموي القرطبي. أما المبحث الثالث، فاحتوى على قراءة تركيبية في حصيلة الدراسات الأندلسية بتطوان على مستوى الجذور والبنيات والإشكالات. وفي المبحث الرابع، عاد محمد الشريف لفحص حيثيات التحول من مفهوم «إسبانيا الإسلامية» إلى مصطلح «الأندلس» داخل أرصدة الإسطوغرافيا الإسبانية المعاصرة. وقدم محمد الشريف في المبحث الخامس قراءة فاحصة في مضامين كتاب صدر بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2021، للمؤلف شارل هيرشكيند تحت عنوان «الإحساس بالتاريخ: الإسلام والرومنسية والأندلوسة». واهتم المبحث السادس بتفاصيل عالَم علماء الأندلس من خلال كتب التراجم الأندلسية. واختتم المبحث السابع مضامين الكتاب، بدراسة مجهرية قدمت أضواءً فاحصةً على مدينة أندلسية مجهولة، اسمها «البنية»، من خلال مضامين كتاب إسباني جماعي صدر سنة 1999 تحت عنوان «البنية- المدينة الملوكية المرينية بالجزيرة الخضراء».
وفي كل هذه المستويات من البحث ومن التنقيب، ظل الأستاذ محمد الشريف مخلصا لمنطلقاته العلمية في الفحص وفي التدقيق، استثمارا لأرصدة المتون الكلاسيكية العربية الإسلامية والإسبانية الإيبيرية، ومواكبةً لنتائج الأعمال الأكاديمية المعاصرة ذات الصلة بالتاريخ الأندلسي بمختلف جهات العالم، وانفتاحا على عطاء الدراسات الأركيولوجية المتخصصة، وتوظيفا لضوابط منهجية انسيابية تمتلك القدرة على التكيف وعلى التنوع وعلى تحقيق التكامل في رؤاها وفي عناصرها، بتعدد أصول المادة الخام والمظان المصدرية المعتمدة في مجمل الأبحاث. ولعل هذا ما يفسر قدرة المؤلف على تحقيق التنقل السلس بين بياضات الأعمال البيبليوغرافية، والاستثمار المنتج لمضامين نصوص تنتمي لحقول شتى، ولمجالات معرفية مختلفة، ولمرجعيات حضارية متباينة، بدون أية عوائق منهجية أو تنافر في التحليل وفي التركيب وفي الاستثمار. فمِن كتب الفتاوى، إلى أدب الرحلات، مرورا بمصنفات التراجم، واعتمادا على كتب التاريخ العام، وتوظيفا لمتون الفقه والشريعة، ومواكبة للإصدارات العلمية الحديثة بلغاتها المتعددة، تتشكل عناصر الارتكاز في نبش الأستاذ محمد الشريف، مضيفا حلقة مجددة ذات قيمة علمية رفيعة بالنسبة لمجال حقل الدراسات الأندلسية المعاصرة، بالمغرب وبإسبانيا.