عن مؤسسة خطوط للنشر والتوزيع والترجمة بالأردن، صدر في شهر غشت الجاري للكاتب والمترجم المغربي مراد الخطيبي كتاب نقدي تحت عنوان: “الترجمة الأدبية: الممكن والمأمول”.
لا يختلف اثنان حول أهمية الترجمة وصعوبتها في الآن نفسه. الترجمة تؤدي أدوارا ثقافية واجتماعية وسياسية وحضارية وتساهم في الحوار والتواصل في شتى المجالات المعرفية والفكرية والسياسية والدبلوماسية وغيرها، بيد أن صعوبتها تتجلى أساسا في ما هو لغوي وثقافي وسياسي، وقد تتجاوز هذه الحدود فتصبح بالتالي عملية معقدة يصعب فك رموزها وحل خيوطها الملتبسة.
وفي المقابل، تبقى الترجمة ، بالرغم من هذه الصعوبات والحواجز عملية ممكنة كما يقول الأستاذ عبد السلام بنعبد العالي الذي يؤكد أيضا على أنها، أي الترجمة ليست “انتقالا من محتوى دلالي قار نحو شكل من التعبير مخالف، وإنما هي نمو وتخصيب للمعنى بفعل لغة تكشف، بفضل عملية التخالف الباطنية، عن إمكانيات جديدة.”
وتعتبر الترجمة الأدبية التي تشكل محور هذا المؤلف من أهم وأصعب أنواع الترجمة لأن إشكالياتها تتجاوز في بعض الأحيان المبنى والمعنى والوقع أو الأثر لتصبح عملية الترجمة ذات رهانات أقوى لأن الكتابة الإبداعية تنحاز نحو ماهو جمالي وفني تحديدا. ويصبح رهان المترجم هو كيفية المحافظة على العناصر الإستطيقية الموجودة في النص الأصلي مع مراعاة الخصوصيات الثقافية للغة المترجم منها واللغة المترجم إليها.
يحاول هذا المؤلف التطرق إلى مجموعة من المشاكل والصعوبات التي تواجه المترجمين في عملية الترجمة، وأيضا الحلول المقترحة من طرف المترجمين لتذليل هذه الصعوبات. كما يتناول المؤلف أيضا قيمة الترجمة، وقدرتها على نفض الغبار عن بعض الكتب الإبداعية التي طالها النسيان وبالتالي بعثها إلى الحياة من جديد وإعادة طرح ما جاء فيها للنقاش والتداول، سواء على مستوى سماتها الفنية أو الفكرية والثقافية. يطرح المؤلف كذلك سؤال الإبداع في الترجمة. وبالتالي، أفلا يمكن ، بتعبير موريس بلانشو، أن ترقى الترجمة إلى مستوى الكتابة الإبداعية؟
فكما هو معلوم، فنظريات الترجمة ساهمت بشكل فعال في اقتراح مجموعة من الآليات والاستراتيجيات الترجمية والتي أثبتت الدراسات العلمية نجاعتها وقوتها. وهناك عدد كبير من المترجمين من يستعمل هذه الاستراتيجيات بدون إدراك أو وعي، نظرا لافتقارهم ربما إما لتكوين أكاديمي في مجال الترجمة أو ربما لعدم اطلاعهم على النظريات الترجمية بشكل عام.
هناك مجموعات من الآليات والاستراتيجيات تستعمل في الترجمة نذكر منها: الترجمة الحرفية والترجمة عن طريق الاقتراض والاقتباس والتكييف والترجمة الثقافية وغيرها.
للقيام بعملية نقدية لعملية الترجمة ومحاولة الإجابة عن إشكالية الترجمة بين الممكن والمأمول، يضم هذا المؤلف مجموعة من الدراسات تتوزع بين ترجمة الشعر وترجمة الرواية وترجمة الهايكو.
ولأن ارتباطا قويا يجمع بين الفلسفة والأدب، فإن الكتاب يقترح في البداية فصلا نظريا يبسط فيه بعض الإضاءات و يقدم فيه بعض الأسئلة حول الترجمة بين الطرح الفلسفي والتأويل الثيولوجي من خلال قراءة في مشروعي عبد السلام بنعبد العالي وطه عبد الرحمان.
في باب الرواية، تتمحور الدراسة الأولى حول موضوع الترجمة الأدبية ورهانات المحافظة على المعنى والخصائص الجمالية لرواية “الحضارة أمي” لإدريس الشرايبي. وتتطرق الدراسة إلى تحليل عملية الترجمة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية عبر جرد أمثلة وتحليل آليات الترجمة التي لجأ إليها المترجم من أجل حل المشاكل التي واجهته.
أما الدراسة الثانية فتخص ترجمة رواية “الذاكرة الموشومة” للأديب عبد الكبير الخطيبي إلى اللغة الإنجليزية، وذلك انطلاقا من كون الترجمة أحيت من جديد إشكالية الهوية التي طرحتها الرواية منذ صدورها سنة 1971. وبالتالي، تحاول الدراسة تناول الرواية باعتبارها رواية ما بعد كولونيالية قادرة بكل مقوماتها الفنية أن تكون واحدة من المراجع المهمة في الأدب الما بعد كولونيالي خاصة لدى قراء اللغة الإنجليزية.
أما في باب الشعر، فيتضمن المؤلف دراستين. الدراسة الأولى وتتمحور حول مقارنة بين بعض الترجمات لـ “النبي” لجبران خليل جبران من الإنجليزية إلى اللغتين العربية والفرنسية.
انطلاقا من المنهج البنيوي، تحاول الدراسة تناول موضوع الترجمة الأدبية وتحدياتها على مستوى المبنى والمعنى والعناصر الجمالية، وتحاول أيضا البحث عن الترجمة المبدعة من خلال هذه الترجمات التي تم تناولها. أما الدراسة الثانية فهي باللغة العربية وتهم تناول موضوع ترجمة الشعر أو شعرية الترجمة من خلال المجموعة الشعرية “مالم يقل بيننا” للشاعرة فاتحة مرشيد الذي ترجم إلى اللغة الإنجليزية. ومن خلال تحليل بعض العينات والاستراتيجيات المستعملة من طرف المترجم في عملية الترجمة ، تحاول الدراسة ملامسة عنصر الإبداع في عملية الترجمة.
وتهم الدراسة الأخيرة موضوع الهايكو الذي أصبح يأخذ حاليا اهتماما مهما لدى المتلقي والمبدع العربي. ويتمحور موضوع الدراسة حول إشكالية ترجمة الصورة في الهايكو باعتبار أن الهايكو يرتكز أساسا على الصورة. ولمحاولة الإجابة عن هذه الإشكالية، تبني الدراسة فرضياتها ومنطلقاتها المنهجية والبحثية على مجموعة “100 هايكو” للشاعر المغربي سامح درويش”.
جديد الكتب : «الترجمة الأدبية: الممكن والمأمول» لمراد الخطيبي : هل يمكن أن ترقى الترجمة إلى مستوى الكتابة الإبداعية؟
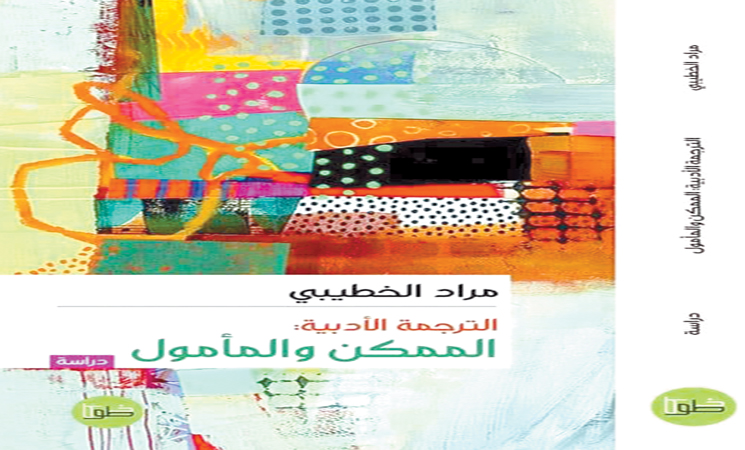
بتاريخ : 27/08/2020





