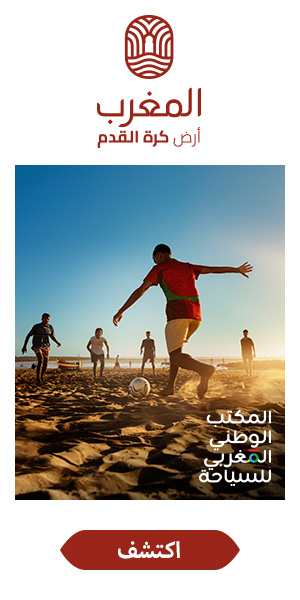لعل من حسنات تطور البحث التاريخي الإسباني وآليات اشتغال الأوساط الإعلامية الإسبانية المهتمة بتاريخ إسبانيا الاستعماري، تبلور توجه عام لتحقيق المصالحة الحقيقية مع الذاكرة المشتركة لدى ساكنة كل من الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. لقد قيل الشيء الكثير عن علاقات إسبانيا بجارها الجنوبي، المغرب هذا «الجار المقلق»، وأُنجزت دراسات وتنقيبات وتصانيف لمقاربة مختلف القضايا العالقة بين الدولتين. وقد طغى على هذا المنحى، هوس النظرة الاستعمارية المتعالية لدى قطاعات واسعة من سياسيي إسبانيا ومن فاعليها المدنيين بل ومن مؤرخيها وباحثيها، مما أنتج ركاما هائلا من الأحكام الاستنساخية الجاهزة، ساهمت في ترسيخ صورة «المورو» المتوحش والهمجي داخل المخيال الجماعي الإسباني الحالي. وتطور الأمر إلى انبثاق رؤى شوفينية سعت إلى توريط المغاربة في الكثير من نكبات إسبانيا المعاصرة، مع أنهم كانوا بعيدين عن الدوائر المسؤولة عن انفجار هذه النكبات، وعلى رأسها ارتدادات الحرب الأهلية التي مزقت إسبانيا بين سنتي 1936 و1939. وفي مجمل الحالات، ظل «المورو» مسؤولا في نظر الرؤى الموجهة والتنميطية عن الكثير من مظاهر القمع الفرانكاوي الذي ساهم في التنكيل بالجمهوريين وبأنصارهم وبعموم مكونات الشعب الإسباني المعارض للفاشية الفرانكاوية. لقد تناسى أصحاب هذه الرؤى السطحية في تناول الموضوع، أن المغاربة كانوا ضحايا مركزيين للقمع الفرانكاوي عندما تم الزج بساكنة منطقتي جبالة والريف في أتون حرب لم تكن تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد. فسقطت منهم أعداد هائلة في ساحة حربٍ لم يكونوا طرفا فيها، ولا فاعلين في مساراتها. دفعوا ثمن ذلك باهظا بأرواحهم وباستقرارهم وبمصير أسرهم، وقبل ذلك، بترسخ صورة سيئة جدا عن ظروف إشراكهم -كُرها- في هذه الحرب وعن مسؤولياتهم في جرائمها البشعة. بمعنى آخر، أصبحت صورة «المورو» وسيلة لتبييض وجه النظام الفرانكاوي الفاشستي عبر إلصاق تهم القتل المجاني والاغتصاب الجماعي والعنف الدموي بالمقاتلين المغاربة القرويين البسطاء، وفي ذلك أكبر إساءة لكرامتهم ولسيرتهم بل ولإنسانيتهم.
وبموازاة مع هذه الرؤى المغالطة لحقائق الواقع والتاريخ، بدأت تبرز بإسبانيا أصوات «أخرى»، حاولت إعادة مقاربة الموضوع من زاوية مغايرة أساسها الإنصات لضمير البحث العلمي ولمصداقيته الإجرائية في إنصاف الذاكرة الجماعية الإسبانية بعد تطهيرها من أوثان أحكام القيمة التي هيمنت على مواقف إسبانيا تجاه علاقاتها بالمغرب وبالمغاربة. على رأس هؤلاء الباحثين المجددين، نذكر ديونيسيو بيرييرا الذي كرس الكثير من الجهد للاشتغال على التباسات الحرب الأهلية الإسبانية بمنطقة غاليسيا، من منطلق رؤى يسارية تنتصر لحق الشعب المظلوم في التصدي للديكتاتورية الفرانكاوية. وفي خطوة موالية، انتقل إلى توسيع دوائر بحثه بالتوجه نحو رصد آثار الظاهرة الفرانكاوية بالمستعمرات الإسبانية، وعلى رأسها بييا سان خورخو. وقد أثمر ذلك صدور عمل توثيقي هام تحت عنوان «القمع الفرنكوي في الحسيمة والريف الأوسط خلال الحرب الأهلية الإسبانية»، بترجمة إلى العربية للأستاذ عبد الله الجرموني، وذلك سنة 2025، في ما مجموعه 164 من الصفحات ذات الحجم الكبير.
ويحدد المؤلف الأفق العام لهذا الإصدار في كلمة تقديمية، جاء فيها: «نؤكد ختاما أن هذا الكتيب بمثابة مساهمة تاريخية في سياق إعلامي، وقد كُتب بهدف إنقاذ ذاكرة «المهزومين والمهزومات» وانتشالها من الخفاء والتواري، خصوصا وأنها مرتبطة بالثقافة الشفوية. وهي أساسية في جوهرها للتعرف على ماضٍ مؤلمٍ وشقيٍ، لكنها تبقى غير كافية وحدها للإحاطة بكل تجليات ذلك الواقع الجريح المتشظي، مما يستوجب بالضرورة تفسير الوقائع في ضوء المصادر التاريخية المتعددة. لقد كان هدفنا من هذا العمل هو تقديم تكريمٍ صادقٍ لكل من ضحى في سبيل الدفاع عن السيادة والحرية والعدالة الاجتماعية. هذه المثل العليا التي نريدها أن تستمر وتمتد لتشكل جزءً من المخيال الجماعي لساكنة الحسيمة في ماضيها كما في حاضرها، لأن ذاكرة المواساة/ السلوان بالنسبة للأزمنة الماضية لا تنهض على نسيان الضحايا وإقبار الحقوق المدنية» (ص.63).
وزع المؤلف عمله بين فصول متراتبة، نجحت في رسم السياق العام لتبلور الفظاعات والجرائم التي ارتكبها النظام الفرنكاوي الإسباني فوق الأرض المغربية، انطلاقا من نموذج مدينة الحسيمة. ففي الفصل الأول، سعى إلى رصد مظاهر الانقلاب الفرنكاوي بمدينة الحسيمة وأحوازها، من خلال الآليات والوسائل. وانتقل في الفصل الثاني لتتبع مظاهر الإعدامات وردود الأفعال المقاوِمة، وتوقف في الفصل الثالث عند مظاهر القمع الشامل الذي فرضه الإسبان على المدينة، وخصص الفصل الرابع لتوضيح تفاصيل القمع الاقتصادي والمهني الذي كان وسيلة ناجعة في يد مشاريع التدجين الاستعماري الإسباني. واهتم الفصل الخامس والأخير بجهود إسبانيا في إسكات الأصوات المغربية المعارضة للانقلاب وخاصة بين صفوف النخب والأعيان مما شكل جريمة حرب كاملة الأركان لاتزال الكثير من ملفاتها مؤجلة تنتظر تبلور معالم الجرأة العلمية الضرورية لاقتحام حقل ألغام الطابوهات الجاثمة -بقوة- على تفاصيلها.
لقد نجح المؤلف في إبراز حقيقة الانقلاب الفرانكاوي عند وضع حدود فاصلة ودقيقة بين الجلاد الإسباني والضحية المغربي. وتجاوز ذلك باستحضار أشكال مثيرة من الترابطات والتوازي بين جرائم الفرانكاوية هنا وهناك، بمنطقة غاليسيا وبمنطقة الريف المغربي. لم يركن المؤلف للأحكام السهلة والمبتذلة لدى قطاعات الباحثين الإسبان الذين ارتبطوا في أعمالهم بأفق ظل يعمل على شيطنة الآخر المغربي، بل كانت له الجرأة ليضع حجر الأساس لإعادة مقاربة قضايا الموضوع، وفق رؤى بديلة لا ولاء لها إلا لحقائق التاريخ ولأدوات البحث العلمي الإجرائية والنقدية. دليل ذلك، إقدامه على استثمار مواد مرجعية متنوعة وجَّهَها تحرره من كل الأحكام الجاهزة، مثلما كان الحال مع توظيفه لمصادر بحثه المتنوعة مثل الدراسات القطاعية، والأطاريح الجامعية، والمواكبات الصحفية على اختلاف مشاربها، والتقارير الإدارية، ووثائق الهيئات القنصلية والديبلوماسية، والصور الفوتوغرافية، والشهادات المحلية المستقاة من ساكنة منطقة الريف، والدراسات الأكاديمية المغربية التي اشتغلت على الموضوع مثلما هو الحال مع أعمال الأساتذة محمد ابن عزوز حكيم وعبد المجيد بن جلون وبوبكر بوهادي وعبد الحميد الرايس.
وبذلك، نجح ديونيسيو بيرييرا في تقديم أرضية صلبة، يمكن اعتبارها خارطة طريق لتمهيد المجال العلمي الضروري لبروز أعمال قطاعية متخصصة، بنفَسٍ أكاديمي خالص وبروح تجديدية مبادرة، إنصافا لذاكرة أليمة اكتوت -عبرها- ساكنة مدينة الحسيمة وباقي أصقاع شمال المغرب بنار «قتل رمزي» أساء لصورة المغاربة بإسبانيا، وفتح الباب لإنتاج كليشيهات نمطية هيمنت على ثنايا الذاكرة الجماعية الإسبانية، وأرْخَتْ بظلالها على الكثير من الملفات العالقة بين إسبانيا والمغرب إلى يومنا هذا.
جديد دراسات التجربة الكولونيالية بالشمال: القمع الفرانكاوي بالريف خلال الحرب الأهلية الإسبانية
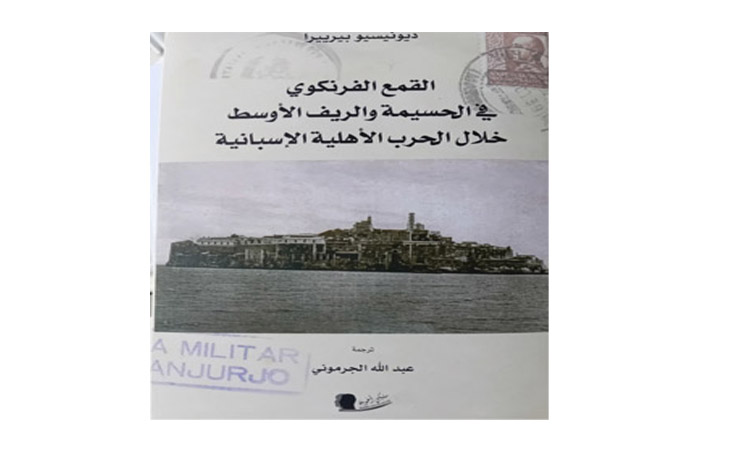
الكاتب : أسامة الزكاري
بتاريخ : 21/11/2025