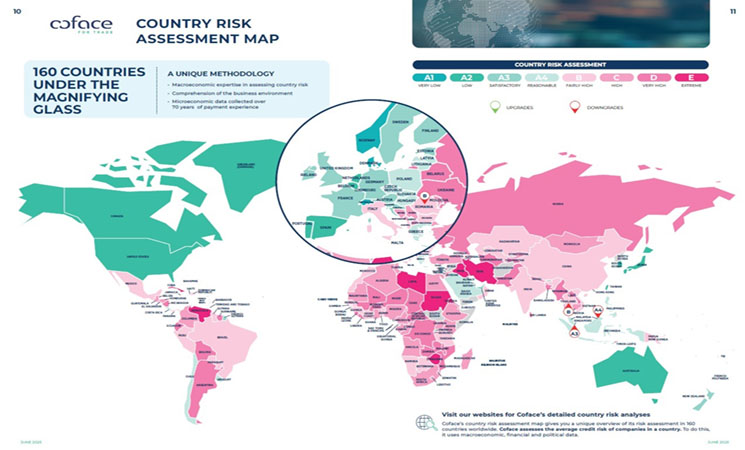تماما، مثلما في باقي الفنون كالموسيقا والتشكيل، والرواية والقصة، والغناء والرقص. وكالوهم تماماً من جانب آخرَ. فبقدر ما ندرك أننا واهمون متوهمون، حارثو مياه، وسادرون في الهلاميات والرماديات والماورائيات، وأن ما نسعى إليه بالوهم، مستحيل القبض عليه، لأنه باطلٌ، بل باطل الأباطيل بلغة سِفْر الجامعة، بقدرـ ياللمفارقة العجيبة ـ ما نستزيد منه ونَرْكبُه ونتوخاه ونطلبه. وليس من معنى لذلك سوى لأننا نستطيبه ونستسيغه، ونستلذ استحالته. ففي الممانعة والزئبقية لذاذةٌ أين منها باقي اللذاذات. بل، إننا نُسَوِّغُ لهاثنا وإجهادنا حتى نقنع أنفسنا وأرواحنا بجدوى أفعالنا ووَعْثائنا، بجدوى الوهم، وبِمُكْنَة تحققه كأنْ يصيرَ إلى ماء قَرَاحٍ سائل منساب يَبَلُّ ويُرَوّي، بعد أن كان أطيافا وسرابا وأشباحا؛ وإلى شعور وإحساس بالسعادة والهناءة بعد أن كان ألما واخزا، ومعاناة ضَنْكَى. فهل يكون الوهم إياه قرينَ المحال، والمحال محال إذ هو بالعدم عاقد زواجٍ ووِصال، أو قرين الخيال؟ لكن الخيال صورةٌ للواقع مجردا من حسيته ونتوئه وجهامته ورتابته. وإذاً هو هوَ. وإذا كانا قرينين شبيهين مع الأخذ في الاعتبار، بعض ظلال فارقة طفيفة بينهما، فما قولنا في الشعر كصوت منبعه النفس والروح، ولسانه التشذيب والتهذيب واللهج بالجمال، ومصدره المادي: اللغة، ومأتاه مالا يدرك بحال، وجناحاه: الأمس والغد، أو اللاَّزمان؟، أَهوَ وهمٌ عَنْقاويٌّ، وخيالٌ مجنح مُنْبَثٌّ عن العناصر الأربعة: الأُسْطُقْسات التي بها قوام الحياة والأحياء، ودوام الوجود واستمراره؟. وما قولنا في الموسيقا والتشكيل والرواية والقصة وغيرها. هل تكون وَهْماً في وهم، وفضلات لا حاجة لنا بها، إذ لا ينتظر منها تقديم وتوزيع خبز وماء على الجائعين والظامئين، ولا كساء وثياب على الأنْضاءِ والعرايا والمشردين؟ فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، فيما قال المسيح عليه السلام، بحكمة صارت مضرب الأمثال، وسائرةً حيِيّة على مر الأحقاب والأزمان.
لكن، هل بالشعر والموسيقا والفنون وحدها يحيا الإنسان؟
ولئن كان الخبز ضروريا للإبقاء على حياة الآدمي والكائن الحي بإجمال، والعيش العلائقي مع الأشباه والأغيار، فإن الفنون ضرورة أنطولوجية نفسية وروحية للإنسان. فَبِها تمايزُه وآدميته وعقله، والسمو بذوقه، والعلو بروحه، واستطابة الحياة واستحلاؤها حيث تصبح حلوة سائغة رائقة، جديرة بأن تعاش. فالشعر كباقي الفنون، حامل ورافع لواء القيم الإنسانية الخالدة، وحامي حِمَى اللغة من الأوشاب، واليباس، والمَوَات، وحارسها الذي لا ينام من أجل أن تبقى مُفَتَّحة العيون، تَنْضَحُ رُواءً، وتشتعل ألقا وضحكا وهي تخرج مغتبطة سعيدة فراشةً ضوئية ملونة، من شرنقة القواميس، ودواليب المعاجم، من أقفاص الأوراق والكنانيش القديمة، والاستعمالات الفقهية المتحجرة. إنه ( الشعر الذي يتيح لنا استعمال اللغة استعمالا متعددا ونقديا بتعبير كويتشيرو ماتْسورا مدير اليونسكو الأسبق ).
إن أكثر ما يضغط على الشعر، وينتف ريشه الزاهي، وينزع حريته، ويزهق نفسه، ويطفيء جذوته، ويقصقص أجنحته، ويعيق طيرانه، ويشده إلى أرسان النظم البارد، والأراجيز التعليمية السطحية والباهتة، والدوران حول الموضوعة الموطوءة الواحدة كما يدور البغل المعصوب العينين حول الرحى، هو الأخلاقُ بالمعنى الديني الضيق لا بالمعنى التنويري الإنساني الرحيب. أيْ بما يتصل وينشبك بالقيم والمُثُلِ العليا الخالدة: الحق والخير والعدل والجمال. فإذا أنت نذرتَ شعرك للطوطم والطابو ( الدين والسياسة والجنس )، خنقته. وإذا أنت أوقفته على الفخر والهجاء والمديح، خطفت روحه. وما ذاك إلا لأن الشعر « طفل مرِحٌ لعوب «، منذور لقدره أي لدوره ووظيفته في الارتقاء باللغة وهدهدتها على أرجوحة الخيال، ومحاورة الإنسان مخلوقا وخالقا مبدعا. فمسكن الإنسان عُشٌّ في شجرة الوجود، عشٌّ مؤسس على اللغة عادية بادية، وسامية عالية مرفرفة وغائصة في الأغوار والكهوف السحرية الأسطورية ماضيا وحاضراً. وفي بواطن ودفائن الإنسان، كاشفة عن أسراره واستسراريته، وسرائره. فالشعر بهذا المعنى، خادمٌ ومخدومٌ: خادم للغة من حيث إنه يحرسها ويصقلها، ويغسلها من الصدإ، ويحييها، ويعرض عبقريتها بالمجاز والاستعارة، والصور، والبناء الفاتن، والتركيب العجيب. ومخدومها إذ تتيح له المناولة الناعمة، والمعالجة الدائمة، فتنشر بين يديه ذوائبها المنقوعة في العطر المعطور، وسوالفها في جنان الريحان والزهور. وتبيح له النفخ من روحه فيها، وضخ دمه الأخضر المُهراق في وَتينها وشرايينها وعروقها، ورش الهواء والأنداء في مهجتها ونبض قلبها الخافق أبدا. ومن ثمَّ، فعبقريتها في أبديته، وأبديته في عبقريتها.
فبهذا المعنى، وبه فقط، يكون للشعر كما للموسيقا والأغنية والتشكيل والرقص والقص والرواية، جدوى. جدوى في لا جدواه إذا تقصدنا من لا جدواه، عُسْرَ بل استحالةَ القبض على فائدته الفورية والمباشرة، وغَلَّته الدانية القطوف، والمطروحة في الطريق، والمجعولة طوع اليد والفم واللسان.
ترانا نقول فلسفة ومعمياتٍ؟. أبداً، فليس ما نقول سوى محاولة في تقريب الأفهام من جدوى ولا جدوى الفنون، وفي مقدمتها الشعر والقص الفني، والموسيقا، والتشكيل. أما حرصنا على إيراد الفنون المذكورة كرديف للشعر، وأجناس تعبير قائمة بذواتها، ومصدر سحر وإمتاع وجمال، فلأن الموسيقا ـ على تجريدها وإيغالها في الرمز والنغم والانغلاق ـ هي بنت اللغة، بنت الشعر والأصوات الطبيعية المرئية والمسموعة، أو الروحية اللامرئية. فجل السمفونيات العظيمة، والكونسرتات، والسوناتات، والأوبرات، وغيرها، تقوم على عيون الشعر الغربي الشاهق، والمسرحيات التاريخية والأسطورية المستمدة من اليونان والرومان، وشكسبير. فقد عمد مثلا: هايدنْ، وموتسارتْ، وبيتهوفن، وشوبير، وفاغنر، وتشايكوفسكي، وليدزْ، وشوبانْ، وغيرهم من العظماء، إلى قراءة واستلهام أشعار غوته، وشللروآخرين فصاغوا موسيقاهم الإلهية الخالدة. وإذاً، فاللغة ثاوية قابعة في خلفية الموسيقا. ونفس الكلام يسري على الفنون التشكيلية . فما الفنون اللوحات الرائعة الأخاذَّة، سوى ترجمة راقية ملونة للغة المعتملة في أعماق الفنان المتحولة أطيافا وشعرا وأخيلة ورؤى، ونماذج مقتطعة ومفتلذة من الطبيعة والشعر العذب الجميل، والكلام الرقراق الأثيل.
والرواية والقص ما هما غير تبديع اللغة، وقصقصة زعانفها وذيولها الوحشية الشائهة، وتمسيد عضلاتها المتورمة من فرط الاستخدام ، طلباً لرشاقتها، وتسفيرها عبر الأزمنة والأمكنة من خلال الوصف والسرد والحوار الذي يوقعه شخوص واقعيون وما هم بواقعيين في صوغ تاريخي واقعي تخييلي، وأحيانا أطروحي وملحمي كما تفعل الرواية. شخوص ورقيون يتجسدون من لحم ودم بفعل سحر الوصف وروعة السرد، وتوريطهم في مواقف وأوضاع إنسانية تخلع عليهم حقيقة أو وهم وجودهم في زمن ولَّى، أو معيشهم وحياتهم بيننا.
أفلا نلمس جدوى في اللاجدوى، وفائدة في ما لانرى فيه فائدة بمنطق الخبز والعيش المادي، وقرب المأتى والمعطى. وحياة رائقة سامية تعلو بنا، وترفعنا فوق معيشنا العادي، إذْ تجعلنا نستلذ ونستمريء، ونستطيب وجودنا، كما نستطيب قضمَ فاكهة شهية مثقلة سكرا وماءً ولذاذةً، وشربَ نبيذٍ معتق طال أمده ومكوثه في خوابي السومريين والأشوريين، والفراعنة، واليونان، وجرار الرومان، ودنان العرب زمن « الجاهلية «، وفي كل الأزمان.