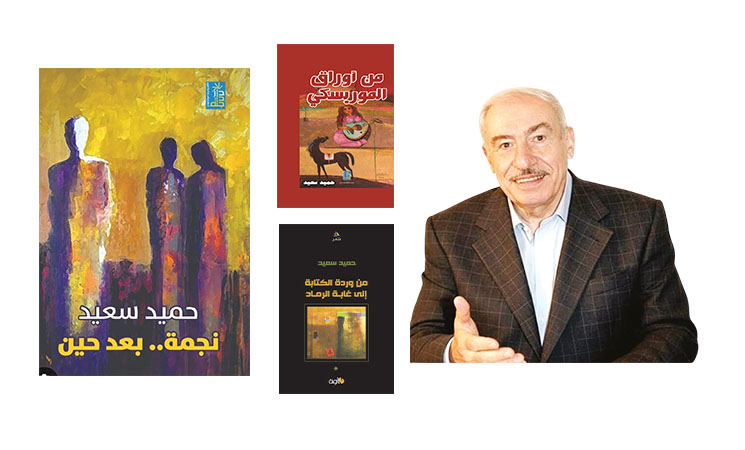” هل يكفي العبور بقطار في غابة لمدة تزيد عن العشر سنوات، كي تتخلّق تجربة خاصة، تُخوّله الزعم بأنه يعرف الغابة تماما؟” (الرواية: ص88)
مدخل:
ليست صدفة أن يَتخذ الروائي المغربي إسماعيل غزالي ( 1977) الغابةَ مكاناً سردياً أثيراً لروايته الجديدة ( عزلة الثلج: منشورات دار العين 2018 )، بل نكاد نقول أنّ وراء هذا الاختيار رؤية فلسفية وجمالية بالغة الأهميّة، تنسج في صمت نصّها غير المرئيّ، والذي يترك إشاراته السيميائية على سطح النص الظاهر للرواية. وليست هي المرة الأولى التي يحتفي بها بالغابة، ففي روايته الأولى ( موسم صيد الزنجور ) اتخذ بحيرة أكلمام أزكزا فضاء لأحداثها الشيقة.
في مقال طريف موسوم بعنوان هنا الغابة، هنا الكتابة ، كتب إسماعيل غزالي في أحد محاوره عن علاقة الغابة بفكر نيتشه ثم هيدغر، وفي اعتقادي أنّ المقالَ مهمّ، لأنّه يفتح لنا مسالكا لدخول روايته؛ بل كشف لنا عن مرجعيات تصوّره لفضاء الغابة. وقد سجّلنا، بعد فراغنا من قراءة الرواية، بأنّ غابة بلدة عين الوشق هي غابة هيدغرية بامتياز – الغابة السوداء -.
الغابة الفلسفية
متى يبدأ زمن التفلسف؟ هذا ما يبدو سؤالا أساسيا، طرحه الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر، والذي يمكن أن نوسع مداه ليشمل السؤال التالي: متى يبدأ زمن الإبداع الروائي؟
هيدغر، الذي فضّل العزلة في أعماق الغابة السوداء، اعتبر التفلسف هو مجاورة الغابة، وتحديدا في تلك اللحظة التي تضرب فيها عاصفة ثلجية لتحاصر الكوخ بثلوجها العاتية. فوحدها قسوة الطبيعة وعنف العواصف الثلجية هي الجديرة بتفجير الأسئلة الفلسفية، إذ تستدعي صياغة الفكرة، في قسوتها تجربةَ معايشة قسوة الطبيعة، ويشبّه هيدغر صمود الأفكار أمام عواصف الوجود بصمود أشجار التنوب وهي تقف في وجه العواصف القوطية. قال هيدغر: ” إنّ ثقل الجبال وصلابة صخورها القديمة، والنموّ المُحترس لأشجار التنّوب، والبهاء المُضيء للحقول المُزهرة، وهمس السيول في ليل الخريف الطويل، وأيضاً البساطة الصارمة للحياة اليومية هناك في الأعالي، وفيها تتجمّع وتتراكم وتتموّج […] العمل وحده يفتح الفضاء لواقع الجبل هذا. وسيره يظلّ منتظما في تحوّلات المشهد الطبيعي”.
في كتابه السيري ( التلمذة الفلسفية ) كتاب الفيلسوف الألماني ( هانس جيورغغادامير ) (1900 – 2002 ) عن كتاب هيدغر ( في دروب الغابة )، خاصة في حديثه عن المسالك الغابية؛ مع العلم أنّ هيدغر كان ممنوعا من التدريس في فرايبورغ بسبب تورطه مع النازية، وفي ذلك العام بالتحديد، قضى جلّ أسابيعه في كوخه الجبلي في غابة شفاردتسفالد، المسماة بالغابة السوداء. لقد حوّل هيدغر الغابة والجبل والمنحدرات والمسالك الجبلية عميقة…إلخ، إلى استعارات فلسفية، مثلا في قوله: ” يستطيع المرء أن يتعلّم التزلّج فقط على المنحدرات ومن أجل المنحدرات”.وكان يصف هذه الدروب الغابية بأنها الطرق التي تحدد وجهة السالكين، والتي ترتقي بهم إلى المجهول؛” إنها تشجع المرء على أن يتسلّق إلى منطقة يجهلها آنئذ “. تحضر الغابة أيضا في بعض الكتب النقدية، لعل أشهرها كتاب أمبرتو إيكو الذي بعنوان (ست نزهات في غابة السرد )، والكتاب يقوم على استعارة أساسية، وهي أنّ السردَ غابةٌ، وأنّ قراءة رواية، هي تدرّب على التوغّل داخل الغابات السردية، وسيكون تحدي القارئ هو عدم التيهان بين شعابها المتشابكة، وأشجارها العالية. ” وإذا استعملت استعارة بورخيس […] فإنّ الغابة هي حديقة تتداخل دروبها، وحتى إذا كانت الغابة لا تتخللها الدروب، فسيكون في مقدور أيّ كان أن يرسم لنفسه مسارا والذهاب يمين تلك الشجرة التي صادفها أو يسارها”.
إذا كان السرد هو غابة رمزية، فأمام القارئ تحدٍّ كبير هو الدخول إلى الغابة، لكن: هل يعرف القارئ دروبها؟ ألا يخاف أن يتوه فيها، خاصة إذا كان أمام رواية تدفعه عن قصد نحو الخيارات السيئة، كما يقول إيكو؟
– تداخل المسالك السردية في الرواية
رواية إسماعيل غزالي تجسّد هذا المعنى المتاهي للغابة، فقد عمد إلى قذف شخصياته داخل غابة قوطية، مسكونة بأسرار كثيرة، وتتخللها مسالك خفية ومخفية تحت طبقات من الثلج.
نفهم أنّ الرواية تقترح مفهومها الخاص للقراءة، وهي الانتباه إلى آثار الأقدام فوق الثلج، بحثا عن الحقيقة المطمورة تحت طبقاته السميكة، وما يؤكّد هذا التصوّر أنّها انتهت باكتشاف سر عظيم مدفون تحت الأرض. هنا نفهم أن لعبة الرواية هي أن تدفع بالقارئ إلى الحفر، فالحقيقة مخفية تحت طبقاتها المترسبة.
– جريمة في الغابة..بداية المتاهة السردية
تبدأ الرواية بالجملة التالية: ” الثلج يندف..”، وسيظل الثلج طيلة الرواية يندف دون توقّف، كأنّه شتاء أبدي لا نهاية له. فكل المشاهد تبدأ بـ ” تشاب تشاب تشاب..”، وهو الإيقاع الذي يخلفه تساقط الثلوج.
الثلوج المتساقطة هي التي تخفي الآثار بسرعة. هل يريد الروائي أن يخفي بسرعة أسرار لعبته السردية؟ كأنه يريد من القارئ أن يتيه، بأن يخفي عليه آثار الحقيقة.
في مشهد أوّل، نرى ثلاث نسوة يدخلن الغابة متخفيات وهاربات من خطر ما، مفزوعات من موت يتربّص بهن في منعطفات الغابة. هربن من بلدة الخلاسيات، ومن بين النسوة العجوز زرقاء وهي تحمل عصاها الطويلة ( وهي العصا التي ستلعب دورا مفتاحيا في الكشف عن السر الكبير في الرواية، لهذا، فإنّ الرواية تهتم بهذه التفاصيل الصغيرة التي قد يغفل عنها القارئ – القارئ غير المنتبه –)، وفتاة تدعى (نجمة) وأخرى وهي الأصغر تدعى ( شمس )، هذه الأخيرة كانت تحمل شيئا ما كان ملفوفا في إزار أبيض.
النسوة الثلاث يلاحقهنّ قنّاص يُدعى قطرب، وسنكتشف بعد ذلك أنه متّهم بقتل والد الفتاتين. وفي الناصيةالأخرى من الغابة، شاب يدعى “سديم ” كان في بحث عن حيوان الوشق وستة من طيور العقاعق، إرضاء لطلب امرأة تدعى (إيلينا) توحّمت بأكبادها وهي الفتاة التي كانت عالمة فضاء، وصارت نزيلة المصحة، ادّعت وِفْق ما باحت به للممرّضة (شهلاء ) بأنّها كانت على علاقة بالفضائيين، وأنّها حبلت من كائن فضائي من المريخ.
ستغرينا الرواية منذ هذا المشهد، بملاحقة آثار هذه الشخصيات التي ارتسمت فوق الثلج، كحبكة بوليسية مسبقة:
” الخارطات الثلاث المتشابكة للأقدام جميعا ( أقدام الوشق، أقدام النسوة الثلاث، وأقدام القناص الذي هو أنا )، قد تكون الحبكة البوليسية لجرائم هذا اليوم الفادح” ( ص11).
لقد أصبحت الغابة مسرحا للجريمة، حين صرع القناص (قطرب ) العجوز زرقاء برصاصة مدوية، قبل أن يجهز عليه الشاب سديم ببندقيته من وراء أجمة، لينقذ الفتاة نجمة من موت محتوم. من هنا تبدأ الرواية، من ملاحقة ضارية، ثمّ جريمة قتل مزدوجة.
تؤسس الرواية سرديتها على ثلاثية: الغابة، الجريمة، اللغز. ولكن هل هي رواية بوليسية؟ حضور الجريمة قد يوحي للوهلة الأولى بأن الرواية تنتمي إلى النوع البوليسي، إلاّ أنّ الأحداث لا تتحرك وفق النسق البوليسي المألوف، لأنّ ما وقع في الغابة كان هدفه الكشف عن حقائق أخرى تتجاوز جريمة الغابة، وبالأخص لغز بلدة عين الوشق، وهي بلدة غريبة، شهيرة بحوادث الانتحار الغامضة.
يرافق سديم الفتاتين إلى بيته، وفي الطريق ينسج الثلاث قصصهم، لتنكشف حقيقة هروبهن. يطرح القارئ أسئلة من قبيل: لماذا خرجت النسوة الثلاث من بلدة الخلاسيات؟ وما الذي كنّ يحملنه داخل الإزار الأبيض؟ أسئلة كثيرة، أحدثتها تلك الفجوات المقصودة التي تركها السارد، حتى يستدرج قارئه إلى مواصلة رحلته في الغابة الثلجية:
” خطر في باله أن يسألهما عن هوية الشيء الذي يحملانه ملفوفا في الإزار. ثمّ أجّل ذلك، حتّى يكشف الأمر في اوانه من تلقاء ذاته “( ص 21).
عمدت الرواية، كحيلة فنية إلى تأجيل الاجابات عن الأسئلة المحتملة التي يمكن لأي قارئ أن يطرحها. تأجيل يحمل دافعا إغوائيا، لكن أيضا يترك للقارئ مساحة لإعمال مخيلته. أليست القراءة عملية تخييلية، تهدف إلى ملأ فراغات النص؟ ( كان إيكو يصف النص بأنه آلة كسولة! )
كانت رغبة الشاب سديم أن يتعرّف إلى قصة الفتاتين شمس ونجمة، وهما أيضا كانتا ترغبان في معرفة قصته. وجميع شخصيات الرواية: شهلاء، مدير محطة القطار، كنزة، قاسم بن زيدان، إيلينا، زهير خروب، عنقاء…إلخ تخفي قصصها الخاصة.
– غابة الرؤى
كتب السارد مُعرّفا الغابة:
” الغابة محض متاهة مقفلة المخارج” ( ص14)، و ” الغابة محض كابوس تعربد فيها أشباح الرؤى والهذيان” ( ص16).
تتحوّل الغابة، وفق هذا التعريف، إلى متاهة سردية مُحكمة الإغلاق، مصيدة لا يمكن لمن دخلها أن يخرج منها. إنّها أيضا فضاء الرؤى الحلمية؛ فالغابة، كانت وظلّت مصدر أحلام البشرية، إذا ما عدنا إلى توصيف لغاستون باشلار.
في كتابه ( جماليات المكان ) تحدث باشلار عن ( ضخامة الغابة )، وعلاقة تلك الضخامة بالاتساع الداخلي داخل مخيلة الإنسان؛ فهذه الضخامة، يقول: ” تنبثق من مجموعة من الانطباعات التي ليس لها في الواقع إلاّ القليل من المعارف الجغرافية. ونحن لا نحتاج أن نقضي وقتا طويلا في الغابة لنعيش ذلك الانطباع القلق، إلى حدّ ما، بأننا سرنا بشكل أعمق وأعمق في العالم غير المتناهي. وبعد قليل نُدرك أننا ما دمنا لا نعرف إلى أين نتجه فنحن لا نعرف أين نحن”.
إنّ الموقف الظاهراتي من الغابة كما صاغه باشلار يكشف عن دور المخيلة في تشكيل تجربتنا مع هذا المكان، وهي تجربة داخلية في الأساس. وقد اشترط قاعدة أساسية تتمثل في أنّ الجهل بدروب الغابة هو دليل جهلنا بطبيعتها. لقد كان سديم يعرف طرق الغابة جيدا، حتى السرية منها، لأنه يعرف الغابة في ذاتها.
بالمقابل يتفق موقف باشلار من خبرات الغابة مع موقف شخصية سائق القطار بشكل مجازي، هذا الذي تساءل : ” هل يكفي العبور بقطار في غابة لمدة تزيد عن العشر سنوات، كي تتخلّق تجربة خاصة، تُخوّله الزعم بأنه يعرف الغابة تماما؟” (الرواية: ص88) . فكان الجواب ، وإن لم يسكن في الغابة فهي التي تسكنه بالأحرى، وتلاحقه إلى المدن البعيدة التي يصلها بقطاره، وتظل تهسهس في داخله شجرة شجرة، ورقة ورقة، وحيوانا حيوانا،…الخ وهذا ما يتماهى مع اعتبار الغابة تجربة داخلية بحسب باشلار، أي هي وليدة انفعالات داخلية تشكلها المخيلة اللامتناهية. نجد بأن رواية غزالي هي تجسيد للمخيلة الواسعة، التي حوّلت الغابة إلى فضاء تخييلي، وإلى فضاء للرؤى الحلمية.
إنّ الغابة هي لاوعي الذاكرة البشرية، ولجوء الرواية إلى هذا الفضاء، جاء ملائما مع حضور الأحلام والرؤى التي دفعت بالشخصيات إلى المغامرة داخلها أو بمحاذاتها؛ فالصحفية كنزة، مثلا، التي جاءت من العاصمة الرباط كي تعدّ ملفا حول اعتصام عمال منجم (إغرم أوسار )، أدركت أنّ سفرها إلى بلدة عين الوشق، كان استجابة لنداء عميق وسري اندلع داخل أحلامها الباطنية، إذ تكتشف بأنّ لها صلة غريبة بسلالة عاشت في مدينة أثرية بجوار بلدة عين الوشق، إسمها التاريخي هو مدينة (معدن عوام)، التي أسسها الموحدون في القرن 12. أما سائق القطار، وبعد أن جاءه هاتف من المحطة يؤكد له حادثة انتحار السيدة الأربعينية تحت عجلات قطار السابعة، فقد أوقف قطاره خارج البلدة وأقفل راجعا على قدميه في الغابة، وهناك صادف حيوان الوشق الذي ظل يمشي معه ويحرس أحلامه حين سقط وغاب عن وعيه.
لقد طرح باشلار سؤالا مهما من شأنه أن يفتح علينا مسالكا مهمة لقراءة هذا الحضور المهيب للغابة في رواية غزالي؛ تساءل: ” ولكن من يستطيع معرفة الأبعاد الزمنية للغابة؟ التاريخ لا يكفي. إنّ علينا أن نعرف الكيفية التي تعيش بها الغابة تجارب عصرها العظيم، ولماذا لا يوجد في مجال الخيال غابات حديثة العهد؟ ”
تريد الرواية أن تنبهنا إلى حكاية الغابة، أي إلى زمنيتها القديمة، بوصفها حكاية قديمة، هي أقدم من حكاية الإنسان نفسه. تنتهي باكتشاف سر عظيم في إحدى كهوف الغابة، سر يكشف عن العراقة الزمنية لهذا المكان بما يتجاوز ذاكرة الإنسان.
– محطة القطار أو استعارة لزمن النهايات
تنتقل الرواية إلى مشهد مواز، وتحديدا إلى محطة قطار بلدة عين الوشق، كان المكان هادئا، وجميع من كان في المحطة ينتظر قطار السابعة، إلا امرأة أربعينية، تقف وحيدة على حافة الرصيف، لا شيء يوحي بأنها جاءت لتلقي بنفسها تحت عجلات القطار القادم. وقبيل وصول القطار، تتجرد من معطفها الأسود، وتلقي بنفسها عارية على سكة القطار فيتمزق جسدها.تحت أنظار رجل غريب صاحب الشارب الأحمر.
من تكون تلك المرأة؟ ومن يكون ذلك الرجل؟ لن تجيب الرواية عن السؤالين مباشرة، بل ستترك ظلالا من الحيرة، التي من شأنها أن تبني على مهل أفق لا توقع القارئ.ففي هذه الرواية، تنحاز الأحداث إلى نفي توقعات القارئ، وفي هذا ما يخلق متعة القراءة.
لم تكن هذه المرأة المنتحر الوحيد في هذه المحطة بالذات، بل سبقها ستة منتحرين ألقوا بأنفسهم تحت عجلات القطار، لأسباب ستكشفها الرواية في فصلها الأخير. تتحوّل المحطة، إذن إلى ملاذ للمنتحرين الذين أغرتهم المحطة بالموت. هذا يدفعنا إلى التأمل في دلالة المحطة، وكأنّ الحياة في آخر المطاف هي رحلة في القطار. إنها تعبير رمزي عن الزمن وعن حركته التي تتوزع بين الحركة السريعة والسكون التراجيدي. إنّ الموت تحت عجلات القطار هو تعبير عن أقصى معاني النهاية.
ستثير اهتمامنا شخصية حارس المحطة، الذي أصبح أكثر من حارس لهذا المكان، بل أصبح حارسا لذاكرة هؤلاء المنتحرين، الذين كانوا يتركون رسائلا، يروون فيها قصصهم.
” وأما قصصهم فيحفظها عن ظهر قلب، كما لو يحفظ نصوصا مقدسة. إنها القصص الوحيدة التي يمتلك القدرة العجيبة على حكيها”. ( ص38)
تلك القصص هي إرثه الوحيد والثقيل، كأنّ أرواح المنتحرين لا تفارقه، يستدعيها حينما يغرق في السكر إذ يتسلل بين الحين والآخر إلى حانة (ذيل الثعلب ) المجاورة، فيستعيد تلك القصص الأليمة.
بعد تجربته العجائبية في الغابة، واكتشافه لحيوان الوشق الذي كان أقرب إلى روح كانت تسهر عليه، عاد سائق القطار إلى محطة القطار، ليكتشف بأنّ الكوميسار كان في انتظاره لأجل استجوابه في حادثة انتحار المرأة. وكانت دهشته حين سأله عن علاقته المسماة بآسيا العروي، وهي المرأة التي أحبها، وفرّقت بينهما الظروف. الحقيقة أنّ المرأة المنتحرة ليست إلا آسيا العروي، التي جاءت لأجل الانتحار في المحطة التي يمرق فيها قطار السابعة، القطار الذي يقوده حبيبها السابق الذي نكتشف إسمه أخيرا (حليم السرابي). لقد تركت آسيا رسالة أخيرة له، تكشف عن سبب انتحارها، وعن قصتها مع زوجها الذي خانها. وبهذا يكون انتحارها شكلا من أشكال عناقها الأخير له ، أي سائق القطار.
– فضاء المصحة: حديقة المجانين الشعراء:
نتعرّف إلى شهلاء، وهي أخت سديم من الزوجة الثانية لوالده، وهي ممرضة في مصحة المجانين تدعى مصحة غابة الثلج، لكنها مصحة ذات خصوصية نادرة، وهي أنّ أغلب المرضى بالرغم من اختلاف وضعياتهم الاجتماعية ووظائفهم ( عالمة فضاء، باحث أركيولوجي، سباح، موظف في مؤسسة نشر…الخ )، فصدمة اختلالهم بسبب ( حالات الفقد الشديدة، التي دمرت حياتهم، وألقت بهم داخل غياهب المصحة ) فجّرت في داخلهم نزوعهم الفني وميولهم الشعري.
تتوزع أهم أحداث الرواية بين محطة المنتحرين ومصحة المجانين؛ والمجانين هم مشاريع منتحرين، أو أشخاص فشلوا مؤقتا في إيجاد طريقة مثلى للموت. ويروي السارد أنّ المصحة كانت:
“فيما قبل بيتا لأحد البلجيكيين من مالكي الأسهم في شركة منجم الرصاص والفضة والزنك الواقع في الجوار، شيّد منزله المتاهي على طرف الغابة. تزوج من مغربية في الرباط تدعى “دلال الباز” كانت تدرس الطب النفسي في العاصمة…” ( ص41 )
وبعد انفصالها عن زوجها، حوّلت البيت إلى مصحة للمجانين. وأغلب روادها هم من نوعية انتقائية، مرضى أغلبهم من فئة رفيعة، عاشوا تجارب قاسية مع الفقد أو الخيانة أو الانتقام أو الانتحار. ثم وجدوا أنفسهم بقدرة قادر في مهب الجنون محض شعراء وفنانين، أو هكذا ترصدهم عين الممرضة شهلاء، وتراهم على نحو خاص. ومن بين هؤلاء، نذكر شخصية قاسم بن زيدان، وهو رسام اشتهر برسم بورتريهات المستحمات في الأنهار والبحيرات، أما عن سبب جنونه فهو أنّ أحد موديلاته غرقت في النهر وهو يرسمها عارية.
سنلاحظ أنّ تجربة الجنون، كما عاشتها أغلب شخصيات الرواية، اقترنت بالموت، أو تحديدا بجريمة ما. فالفنان أو الشاعر يمثل ذاتا هشة أمام قسوة التجارب الحياتية، وليس الجنون إلا ردة فعل قوية إزاء تلك القسوة. نفهم أنّ الحدود بين الفن والجنون، وبين الشعر والموت رفيعة جدا، ففي أي وقت يمكن أن تنهار تلك الحدود، ويسقط الفنان أو الشاعر في براثن الجنون أو بين أنياب الموت. كتب نيتشه في كتابه (الفجر ) بأنّ الجنون هو الذي مهّد الطريق للفكرة الجديدة في كل مكان تقريبا، وتخلّص من العادة، ومن الخرافة المبجلة.
ما جعل شهلاء تستأنس بهذا المكان، هو المتعة التي تجدها وهي تفكك خربشات المجانين، وتدونها كلما سنحت لها الفرص.
” ” شهلاء ” مهوسة بالشعر فوق ما يخطر على بال أحد. ثمّة علاقة غامضة وقوية بين أن تكون ممرضة وأن تكون شاعرة في آن” ( ص43 )
وحبها اللامحدود للشعر هو ما جعلها تقع في حب مدير محطة القطار، الذي كان يحفظ عددا كبيرا من الأشعار العالمية، وقد تحوّلت حياته جذريا يوم انتحرت عشيقته الأولى “الباخوسية” إلى جحيم حقيقي. حدث هذا في مدينته الأصلية قبل قدومه إلى عين الوشق.
يباغتنا السارد بسؤال لاذع: ” ما علاقة الشعر بالانتحار؟” ( ص47 )لقد كانت الممرضة شهلاء تجد في هذيانات المرضى وهلوساتهم قيمة جمالية، تنم عن روح فنية هي أقرب إلى الروح الديونيزوسية،فهذياناتهم تخفي طاقة طافحة من الإدهاش ومن المباغتة، لهذا كانت تعتبر الدخول إلى المصحة هو نوع من الإنتماء إلى كون آخر، تسيره قوانين غير القوانين التي تتحكم في الحياة خارجها.
في قرارة نفسها، أصبحت المصحة مكانا شعريا أو طافحا بالشعر، تجد في توترات شخصياتها ما يمنحها متعة اكتشاف ما تخفيه ذوات طافحة بحساسيات مقلقة ومرعبة ومذهلة في الوقت نفسه. هي لا تنظر إلى الجانب المظلم من تجربة الجنون، بل إلى تلك الجهة الشعرية والتي تخاطب أقاصيها وأغوارها مثلما لا يفعل الناس العاديون.
في هذه المصحة، اكتشفت شهلاء الشعر، وتفجرت في دواخلها منابعه السرية.صحيح أن علاقتها الأولى بالشعر كانت ذات صلة بعلاقة الحب التي جمعتها بشاب صيدلي درس الصيدلة في أوكرانيا وكان عاشقا لأشعار ماياكوفسكي، إلاّ أنّ تلك العلاقة لم تستمر، بل تحوّلت إلى جرح في حياتها، ولم تستطع أن تلملم تمزقاتها إلاّ داخل المصحة.
ستتوطد علاقة شهلاء بالمريض المهووس بالدُّمى ( المحرر الكازاوي : كان يشتغل بوظيفة محرر في دار نشر )، بسبب قبلة طائشة، وقد اكتشفت فيه جنونه الشعري، وهو الذي اقترح عليها إقامة أمسية شعرية داخل المصحة، ودعوة الجميع لهذه الحفلة التي سيلقى فيها المرضى أنفسهم أشعارهم وكذلك بعض الزوار. كانت الأمسية طافحة بالأشعار، غير أنها انتهت بوضع إلينا لحملها، ثم وفاتها في المشفى. ثم تفصح لعبة المفاجآت لشهلاء عن حقيقة المحرّر الكازاوي، الذي لم يكن في واقع الأمر مجنونا، بل مجرد ممثل مسرحي جاء إلى المصحة كي يتمرن على تقمص دور شاعر مغرم بالشواعر المنتحرات. وكان طريقه لاكتشاف هذه البلدة هي إعجابه بشعر الشاعر ( زهير خروب ) المنتحر في كوخ الغابة السوداء، وازداد فضوله، حين اكتشف غرابة البلدة، واشتهارها بالانتحار. أما عن علاقته بشهلاء فهي معقدة، وكان يتساءل:
” هل هو من يحب ” شهلاء ” فعلا أم شخصية المجنون التي تقمصها ” ( ص184 ). ألا يمكن أن يكون الجنون كذلك مجرد دور تمثيلي يؤديه الإنسان؟
الجنون، والموت، والفن ثلاثية محبوكة بشكل غريب في هذه المدينة الملعونة عين الوشق. و ليس بعيدا عن المصحة، سنكتشف أنّ في غابة عين الوشق كوخ، هو بمثابة الذاكرة الفنية والشعرية لهذه الغابة، إذ كانت في الأصل إقامة إبداعية يؤمّها المبدعون من كل الجهات ليجدوا في عزلة الغابة ملاذا لتفجير قرائحهم الإبداعية. كوخ يشبه إلى حد بعيد الكوخ الذي كان يلوذ إليه هيدغر ليمارس تأملاته الفلسفية، كما أشرنا إلى ذلك في مدخل هذا المقال.
للكوخ قصة، ارتبطت بانتحار الشاعر زهير خروب. أما صاحب الكوخ فكان لحكيم فينيق وهو مجند مغربي في الجيش الفرنسي تمرد على أوامر قادته، عندما رفض المشاركة في قصف مدن فيتنامية، ففرّ بطائرته، قبل أن يسقط في غابة عين الوشق. ينجو بأعجوبة من الحادثة، فيقرر أن يشيد كوخا ليكون بمثابة محراب للكتابة ضد الاستعمار وضد آلة الحرب المدمّرة، وبعد موته، حُوّل الكوخ إلى إقامة إبداعية.
– لغز الزربية.. نسج خريطة الحقيقة
كانت والدة سديم نساجة زرابي محترفة، وقد تربى على جمال وسحر وغموض زرابيها، فولع بهذا الفن التقليدي، وكان يحتفظ بإحدى زربياتها التي ورثها عن خالته، بعد أن ضاعت كل زرابيها إما بيعا أو حرقا. فتلك الزربية، التي بها رسومات ورموز غريبة، ستتحول إلى خريطة عجيبة لاكتشاف حقيقة دامغة كانت خفية على الجميع.
في مجرى الأحداث وحمى الوقائع سينكشف سر الشيء المجهول الذي كانت تتبادل شمس ونجمة حمله ملفوفا في إزار داخل الغابة، هو محض زربية من نسج والدتهما في بلدة الخلاسيات الشهيرة بفن انتاج الزّربية والغريب أنّ هذه الزربية، كانت تحمل نفس الرموز والرسومات في زربية والدة “سديم”. كلاهما يُكمّل الآخر كما لو يتعلق الأمر بلغز، وهذا ما كشفه الجمع بين الزربيتين الذي أدى إلى تشكل كامل لجسد حيوان غريب كما لو أنّهما من نسج المرأة نفسها.
عشق سديم للزرابي، أكسبه إطلاعا بأسرار المهنة ما جعله يتحرى حول دلالات الرموز التي ترسم عليها، وهي ذات صلة بتاريخ بلدة عين الوشق. لقد جعلت منه زرابي والدته متحريا حقيقيا، ومتخصصا في البحث عن دلالات الرموز والرسومات التي كانت توشج بها زرابيها.
سيكتشف سديم الشبه الكبير في رموز ورسومات زربية نجمة وشمس بزربية والدته. وبحسب هيثم الرند، وهو أحد نزلاء المصحة، وعالم أنثروبولوجي، فإنّ الحيوان المرسوم على الزربية هو ديناصور، والعجيب أن كل زربية رسمت جزءا من الحيوان، وعند الجمع بينهما يكتمل جسد الديناصور.
وستكون عصا العجوز زرقاء المصنوعة من عظم وليس من فحم حجري كما كان يعتقد سديم وشمس ونجمة، هي الدليل إلى المكان السري الذي سيجدون فيه كنزا لا يخطر على بال ، وبعد عملية حفر، يحدث الاكتشاف العظيم؛ لقد اكتشف سديم مع هيثم رند والفتاتان هيكل ديناصور:
” لقد كان شكل الديناصور يطابق تماما صورة أو رمز تخطيطه في نسيج زربيتي أم سديم وأم الفتاتين شمس ونجمة ” ( ص206 )
إنه السر الكبير الذي تكشفه الرواية في الأخير، سر هيكل الديناصور الذي يكشف عن عراقة بلدة عين الوشق، الأرض التي كانت تعيش فيها الديناصورات في العصور القديمة جدا، ولعل السر الأكبر هو كيف انتقل هيكل هذا الحيوان إلى زربية أم سديم وأم نجمة وشمس؟ هذا ما يبدو سؤالا يكشف عن حقيقة غرائبية بامتياز.
بعد وفاة صاحبة المصحة، اشترى هيثم الرند المصحة، ثم أهداها لسديم، هذا الأخير حولها إلى متحف للزربية الأطلسية، ومركزا لتلقين فن نسج الزرابي، حتى لا يندثر هذا التراث الأطلسي العظيم.
في رواية “عزلة الثلج” تحضر الغابة في علاقتها بمكونين أساسيين: الجريمة والفن. لا نتصوّر غابة في معزل عن المكونين، لأنهما يعبران عن التوظيف الرمزي للغابة بوصفها الروح المتمردة للفن؛ ما أثار انتباهنا هي تلك الحفلة الشعرية في آخر الرواية، والتي اقترحها أحد مجانين المصحة، وكان ممثلا متنكرا في دور شاعر مهووس بالدمى، والتي التقى فيها الشعر بالمسرح وبالحب الجسدي وبالموت. لقد اجتمعت كل خصائص الرؤية الديونيزوسية للفن، وفي تصورنا أن رواية غزالي مسكونة بهذه الروح المتمردة داخل الفن؛ متمردة على النسق التقليدي للرواية. تنتهي الحفلة بوفاة إلينا بعد أن وضعت حملها، إلا أنّ أهلها رفضوا الاعتراف بطفلتها، فاعتبروها مجرد لقيطة. لنربط هذا الموقف بالتصور الديونيزوسي للفن، أليس الفن المتمرد مجرد فن لقيط في نظر المؤسسة الأدبية الرسمية؟
ننهي قراءة الرواية، لكن يبقى إيقاع الثلج المتساقط يرن في داخلنا.
تشاب.. تشاب.. تشاب.
ناقد من الجزائر