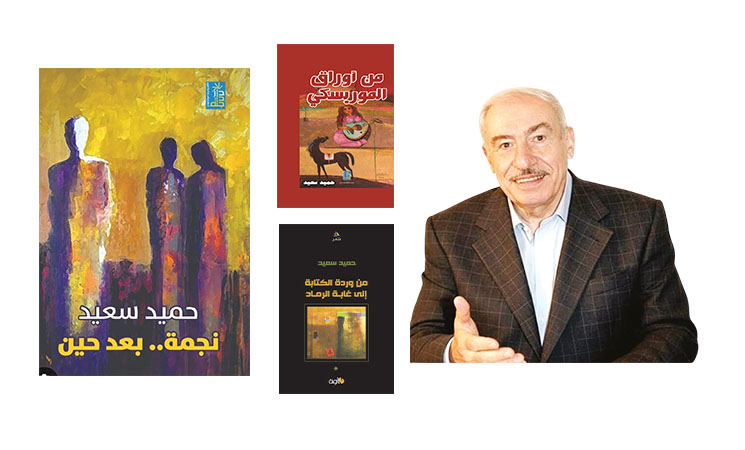في زمن الستينيات كان المغرب يتنفس عبق الثقافة من كل بيت وكانت المكتبات المنزلية هي الشاهد الصامت على شغف الأسر المغربية بالعلم والمعرفة. لم تكن المكتبة مجرد ركن جامد في زاوية البيت، بل كانت روحا تنبض بالكتب والموسوعات والروايات التي حملت أحلام جيل بأكمله. كان الكتاب رمزًا للوجاهة الفكرية والموسوعة هي الكنز الذي لا يفرط فيه إلا من ضاق به العيش.
في تلك الفترة كان الأطفال في الأحياء المغربية يتجمعون عند بائع “الزريعة”، ليس فقط لشراء بذور اليقطين أو دوار الشمس، بل لاستئجار قصص الكرتون.
كان هذا البائع يحمل معه كنزا صغيرًا من القصص المصورة مثل “كيوى” “زامبلا” و”قصص الحب والغرام” والتي كان يؤجرها بريال واحد فقط. كانت هذه القصص تنتقل بين الأيادي الصغيرة تُقرأ بشغف تحت ضوء المصابيح الزيتية أو في زوايا الأزقة، قبل أن تعود إلى البائع لتستمر دورة الحكايات.
كان الكتاب في تلك الأيام رفيق العائلة الذي لا يمل من سهر الليل مع أطفاله. في كل منزل، كان هناك مكتبة لا تخلو من كتب الأدب والتاريخ والشعر، وكان الأفراد يتنافسون على اقتناء كل جديد يتبادلون الكتب كما يتبادلون الأماني المكتبة كانت القلب النابض للبيت حيث يتجمع الجميع للقراءة والمناقشة وبين الصفحات كان ينتقل الفرد إلى عالم آخر، ينسى هموم اليوم ويغرق في السطور التي تقوده إلى عوالم جديدة.
وفي الجانب الآخر كان الكبار يخصصون أوقاتًا لمكتبات بيوتهم يحرصون على ملء أرففها بالجديد من الإصدارات.
زيارة المكتبات أو معارض الكتب كانت طقسًا محببًا ومناسبة لتعزيز روابط الأسرة مع الكتاب. لم يكن التفاخر بالمكتبة أمرًا شكليًا، بل كان انعكاسًا لعمق الأسرة المغربية واهتمامها بالعلم والمعرفة.
لكن مع مرور الزمن تغير المشهد. بدأت المكتبات المنزلية تفقد رونقها تدريجيًا وأصبحت تزيحها رموز جديدة للتفاخر مثل صحون الطاووس المزخرفة. تلك الصحون التي كانت تُعد من أغلى مقتنيات الأسر المغربية كانت تُعرض بفخر على الأرفف، بل وتُعار للأقارب في المناسبات مع الحرص على كتابة اسم العائلة على ظهرها لضمان عودتها.
لقد تغيرت الأولويات ولم يعد الكتاب هو مركز الجذب في الحياة المنزلية. عوضًا عن الصفحات التي كانت تعج بالمفردات، أصبحت العين تركز على لمعان الصحون وألوانها البراقة. كان هناك جيل جديد يفضل التلفزيون على الكتاب ويغرق في المسلسلات والأفلام التي تبثها الشاشة الصغيرة. بدأ التلفزيون بنغماته وضوئه الساطع يأخذ مكان الكتاب في البيوت، وأصبح المصدر الأول للترفيه والمعرفة على حد سواء.
ومع انتشار الأجهزة الإلكترونية من الكاسيت إلى الألعاب الفيديو، بدأت فكرة القراءة تختفي تدريجيًا.
كانت الأسر تتخلص من الكتب التي تراكمت على مر السنين فتباع في أسواق الكتب المستعملة أو تُهدي من دون تفكير.
وقد كان ذلك التغيير بمثابة محو تدريجي لذاكرة الأجيال التي كانت تعرف قيمة الكتاب. في هذا الزمن الذي طغت فيه المظاهر أصبح الكتاب شيئًا قديمًا كالعهد الماضي الذي لا يجد مكانه في عالم السرعة والتكنولوجيا.
اختفى الكتاب وغابت معه لحظات تجمع العائلة حول قصة أو مناقشة فكرة. تحولت المنازل إلى فضاءات صاخبة تفتقر إلى السكينة الفكرية التي كان يضفيها الكتاب.
في هذا الزمن الذي تلاشت فيه قيمة الكتاب، لم تعد الثقافة مقياسًا للرقي بل صار التفاخر بالمظاهر هو السائد.
قصيدة تحسر
أيا مكتبة الأمسِ أين الحكايا
وأين رفوفُكِ وأين المنايا؟
ألم تحتضني كتابًا قديمًا
يسامرُ طفلاً ويجلو العطايا؟
أما كنتِ بيتًا لعلمٍ ونور
فكيف غدا النورُ طي الخفايا؟
رحلتِ وفي النفس ألفُ سؤالٍ
وفي القلب شوقٌ لنجمٍ تهاوى