
أكد خالد هجلي، أستاذ الفلسفة، في حوار مع الجريدة أجرته معه في خضم المخاض الذي أفرزته نتائج البكالوريا والنقط المرتفعة التي حصل عليها بعض التلاميذ في مقابل ما عرفته نتائج التاسعة إعدادي من اندحار سافر ومعدلات سقوط غير مسبوقة، أن معضلة نفخ النقط خصوصا في المدراس الخصوصية من أهم صيغ هدم مشاريع الإصلاح بمنظومتنا التربوية، متحدثا من منطلق تجربته بالقطاع الخاص لما يقارب 13 سنة، في ارتباط بخمس مؤسسات تعليمية خصوصية، وبمدينتين مختلفتين، أن الظاهرة قائمة ولها قواعدها، ومحكومة بمنطق علاقات متشعبة تتجاوز حدود المؤسسات التعليمية الخصوصية ذاتها، ولها «مبرراتها» التي تقدمها الأسر قبل الأطر التربوية والإدارية المساهمة في هذه الظاهرة التي تصادر قيم الإنصاف وواقعه بمنظومتنا التعليمية التعلمية.
مستطردا بالقول إن الإشكال قائم أولا في الصورة التي ينظر بها إلى التلميذ في القطاع الخاص، فهو ليس مجرد تلميذ بل زبون، والقاعدة «السوقية « تشهد دوما أن « الزبون ملك! «، و على هذا الأساس فمراعاة مصالح هذا الزبون ضرورة اقتصادية ملحة، كي تستطيع بعض المؤسسات الحرة الحفاظ على قدرتها التنافسية وحصتها في سوق المقبلين على التعليم الخصوصي، وما نتعجب منه هو تغييب جانب المراقبة الفعلية من طرف الأجهزة الوصية، بل أحيانا يتم توقيع كشوفات التنقيط على أنها سليمة مع العلم أن كل من في هذه المؤسسات من بواب المدرسة إلى مجلسها الإداري يعلم أن نسبة كبيرة من هذه الكشوفات لا تمتلك من الصدق إلا التوقيعات ! ثانيا، هنالك نوع من الأساتذة الذين يساهمون بشكل أو بآخر، بصمت أو بتواطؤ، في عملية « نفخ النقاط « وخصوصا في الأقسام الإشهادية، إرضاء لمطالب بعض الأسر التي أصبح لديها هذا الوضع المشين بمثابة حق غير قابل للتنازل عنه، و إرضاء للساهرين على الشأن الإداري و التربوي بهذه المؤسسات حفاظا على جودة خدماتها لزبنائها، و حفاظا على المصالح الذاتية بطبيعة الحال، و الضحية مرة أخرى هو المستوى التكويني لتلاميذ هذه المؤسسات، فكيف يعقل لتلميذ لا يستطيع أن يكتب فقرة إنشائية متكاملة أسلوبا وإعرابا، ومعرفة، ومنهاجا، أن تجد في كشوفات نقاطه في مادة كالفلسفة أو اللغة العربية مثلا نقطة 18/20، ؟ !، في حين أن حقيقة نقطته يستحيل أن تقارب المعدل، والمسكوت عنه هو الفرق الكبير بين التضخيم الذي تشهده الكشوفات المحلية للنقاط والنقطة المحصل عليها في الامتحان الاشهادي، والتي أحيانا تصل إلى فارق يفوق عشر نقاط؛ بل في أحيان كثيرة نجد بعض تلاميذ هذه المؤسسات لا ينجزون الفروض مع بقية زملائهم وتمنح لهم صلاحية إنجازها في ظروف خاصة أنأى عن التصريح بها، يردف أستاذ الفلسفة، فقط لأن لغة المصالح ورنات الهواتف اشتغلت في خلفية المشهد، وألزمت الكثير من زملائنا الأساتذة للأسف أن يخضعوا لحيثيات ابتزاز يمارس عند نهاية كل دورة، وعلى مرأى ومسمع من الجميع.
وعن مدى استفحال المعضلة بالمدارس العمومية أكد أن الأمر موجود لكن ليس بنفس درجة استفحال ورم نفخ النقط في المدارس الخصوصية، قائلا إنه لا يدافع « عن المدرسة العمومية، بل أرصد الأمر بعين التجربة و الخبرة، وبالإمكان أن نجد أكثر من مبرر لوجود هذه الظاهرة المسيئة للجسد التعليمي برمته، أولاها تفشي وباء الساعات الإضافية ومنطق الزبونية، الذي يُفقد الأستاذ سلطته على الفصل الدراسي، فما بالك بتدبير الأهداف التربوية باقتدار، فأحيانا نجد التلميذ – أو أولياؤه – هو الذي يحدد النقطة بحكم أن أسرته تدفع طيلة السنة، وبالتالي من غير المعقول أن لا يحصل على المقابل، الذي يتحدد في نقطة تفضيلية، وبإمكان الطلبة أنفسهم تقديم شهاداتهم بهذا الصدد.
ثاني هذه المبررات هو تفشي وباء المحسوبية التي تجعل النقطة تتحدد بدرجة القرب من دائرة التأثير الإدارية والتربوية، بل إن منطق بعض الهيئات الإدارية التي تسعى إلى تلميع صورة مؤسستها بأي شكل وبأي ثمن، تستخدم مقولة شائعة : « شوف كيفاش دير … ينجحو و يعطيونا التيساع «، تحت ذريعة الاستجابة لضغوطات الخارطة المدرسية، وتجاوز المشاكل الناجمة عن الاكتظاظ؛ وأحيانا يتم الضغط بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل إبراز أهمية شعبة دون أخرى، وحث الجميع على منح فصولها نقاطا تسمح لهذه الشعبة أن يُراهن عليها كواجهة للمؤسسة دون أخرى؛ و ثالثها يرتبط برغبة بعض الإخوة الأساتذة – سامحهم الله – في إصطناع واقع ملغوم يشهد بكفاءتهم التدريسية، وبالتالي تقديم شهادة كمية بالنفخ في نقاط الفروض، وللأسف تتحول هذه المعطيات داخل برنامج مسار إلى أرقام إحصائية يُعتد بها، وهي في نسبة منها لا تقدم شهادة صادقة على المستوى الفعلي لطلبتنا.»
وشدد الأستاذ خالد هجلي على أنه من الصعب أن يتم التصدي بشكل كلي لمثل هذه السلوكات التي تنخر الجسد التربوي، «بالرغم من وجود لجان مراقبة تحاول جاهدة رصد هذه المظاهر السلبية، لكن في ما أعتقد أن أساليب مراقبتها للوضع يجب أن تشهد تطورا تقنيا ومنهجيا، وأن الأمر يجب أن تتم مراقبته بشكل عمودي وأفقي، أي بحكم مواقع المسؤولية وبشكل مفاجئ، فمراقبة معلن عنها هي بمثابة ضوء أخضر لتصبح مجرد مشهد تمثيلي، تهيئ ضمنه الوثائق اللازمة الاطلاع عليها للمراقبة، والتي تتحول ساعتها إلى مراقبة شكلية وورقية ليس إلا .
لكن بعيدا عن لغة المراقبة و العقاب الإشكال هو بالدرجة الأولى قيمي، ويجب أن نعمل على تغيير العقليات قبل الممارسات، عبر التوعية والتحسيس، وخلق حوار وطني مفتوح، وليس مناسباتيا، وأن يمتد تأثير هذا الحوار من الأسرة إلى ردهات المؤسسات التعليمية بكل مستويات مسؤولياتها المحلية و الجهوية والوطنية، وأن ينظر إلى التلميذ كشريك فعلي وميداني وليس كموضوع صراع أوكزبون، فالأمر يتعلق بمستقبل بلد برمته، ومستقبل أطره التي ستتحمل مسؤولية قيادة هذا الوطن نحو ذرى التميز الفعلية، لمقارعة الكبار شئنا أم أبينا، خصوصا وأن طبيعة التغيرات الجيوسياسية التي يشهدها موقع المغرب تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، تحمل رسائل جلية بأن مغرب الغد بحاجة إلى تعليم يفرز نخبا من القادة من رجال ونساء يتمتعون بكل القدرات المعرفية والمنهجية والنفسية، وبالمهارات الحياتية اللازمة لتطوير المكتسبات والإنجازات التي يحققها مغربنا الحبيب على مدار الساعات والأيام، وعلى جميع الأصعدة، والاستجابة لرهانات العشرية القادمة.
وفي ما يتعلق بموضوع تركيز السياسة التعليمية ببلادنا على حصد النقط دون صقل مهارات التلاميذ شدد المتحدث على أنه من الواجب التحلي بجرأة الطرح البديل قبل جرأة النقد،» لأنه من السهل أن نضع أيدينا على مواطن الخلل، لكن الأهم هو خلق بدائل تربوية قادرة على المساعدة على تجاوز مواطن الخلل، كتلك التي تختزل مجهود التلميذ، ولربما حضوره برمته ضمن الجسد التعليمي، في ما يحصله من نقط، وإصدار أحكام تلغي أهمية الكيف على حساب لغة الكم ( أرقام، إحصائيات، جداول ومبيانات … )، في حين أن النقطة لا تعكس بأي شكل من الأشكال قيمة التلميذ كذات، بل فقط هي تُقَوِم مجهودا محدودا، في شروط زمكانية محدودة، ولغايات في كثير من الأحيان تكون بعيدة عن الأهداف التي يضعها التلميذ لنفسه، بل و في غالب الأحيان حين يتم تقديم التقويم المؤسساتي يغيب التلميذ كفاعل، ويحول إلى مجرد رقم نقبل به أونرفضه بحسب خدمته للصورة التي نريد أن نبنيها للمؤسسة التعليمية إجمالا، والدليل بكل بساطة يمكن أن نقدمه على شكل تساؤل : ما مدى قدرة مؤسساتنا التعلمية على تتبع مسار الناجحين من طلبتنا لاستثمار نماذج النجاح ليس فقط كنماذج تعليمية بل كنماذج حياتية ؟ ماذا عن الراسبين والفاشلين، أي دور تربوي وحياتي بإمكان مؤسساتنا أن تلعبه ؟ أم أنه ينظر إلى هذه الفئة باعتبارها «فضلة» يجب أن ترمى خارج دائرة الاهتمام، وأن تواجه مصيرها بنفسها، وهنا لا بد أن نثير معضلة التوجيه، وضعف آليات تأثيره المنهجية والعملية، القبلية والبعدية، وتتبع مسارات الاختيارات ومدى استحقاق تلك الاختيارات، وفاعليتها على المدى القريب والمتوسط بالنسبة للتلميذ-الطالب، فالتلميذ يجب أن ينظر إليه ككيان سيكو-اجتماعي مقبل على تحولات سوسيو-اقتصادية تخول له لعب أدوار اجتماعية واقتصادية تضمن له كرامة العيش وحرية الإبداع، فهو مشروع وجودي بامتياز، يرمي بقوة الانجاز إلى المستقبل، بناء على فاعلية الحاضر، وقوة خبرة الماضي».
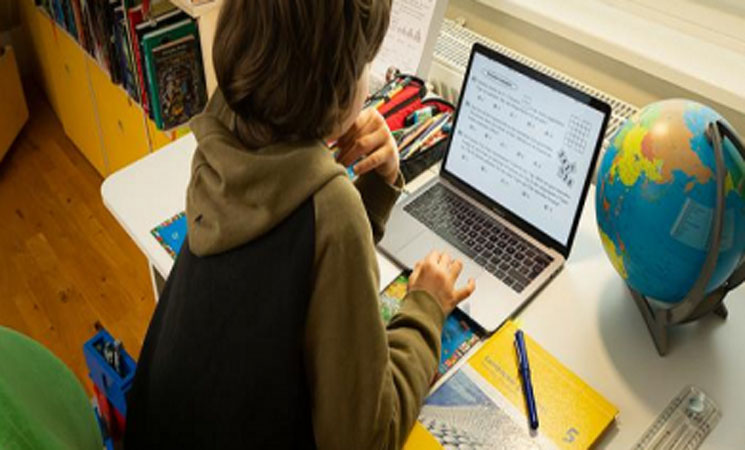






اترك تعليقاً