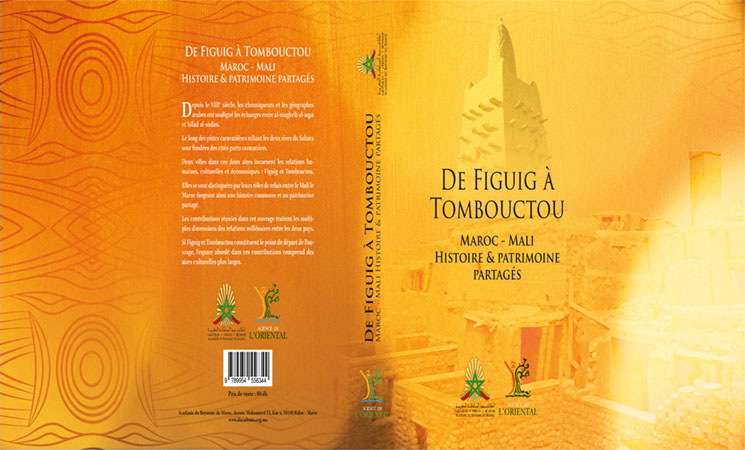في بداية الثمانينات اقترحت علي رفيقتي أن نذهب لزيارة أحد معارفها في قلعة السراغنة، امتطينا حافلة مهترئة من بني ملال وعبرنا المسافات المسطحة بين المدينتين، طريق واحدة كالصراط المستقيم، تقودك عبر دار ولد زيدوح، واد العبيد، أولاد كليب، القراقرة، لوناسدة، وصولا إلى قلعة قبائل السراغنة. وسط الحر الشديد، القيظ، الغبار، المتسولين الشرسين الذين يملؤون ما يشبه محطة مسافرين مزروعة وسط الخلاء. حين ترجلت عن الحافلة شرعت أنظر لرفيقتي، كأنني أسألها ما الذي نفعله هنا. لا أدري من أين أتى هذا الاسم، هل كانت هناك قلعة ما هنا في زمن ما تشبه قلعة لعبة العروش، التي تبين من بعد بأنها صورت فقط في قلعة أيت بنحدو في الجنوب. أنقذنا من تيه الأسئلة الشخص الودود المبتسم الذي تعرفه رفيقتي والذي هرع إلينا مرحبا. المكان محاط بغابة من أشجار الزيتون. أينما وليت وجهك تراها. آمتطينا طاكسي، نزلنا في حي شعبي، عبرنا أزقة ودروبا ضيقة. الناس كانوا يوجهون نظرات فضولية لرفيقتي ذات الشعر الأشقر المنطلق، والبشرة البيضاء خصوصا وأن أغلب النساء هنا سمراوات. رحبت بنا أسرة الشخص أيما ترحيب. ونحن ذاهبون للمقهى عند المساء أرانا الصديق منزلا متواضعا في طابق أول وحيد، منزل ضيق وقال لنا بأن هنا كان يسكن السوسيولوجي المغربي العظيم Paul Pascon، في غرفة واحدة ومطبخ ضيق، حين كان يسير المصلحة المكلفة بإعادة تهيئة حوز مراكش. بقينا واقفين منبهرين من تواضع العالم العظيم المتقشف في حياته، فكرت في أشباه الباحثين الذين يلهفون تعويضات بالملايين من أجل البهتان. اقترح علينا الصديق الذهاب لزيارة بويا عمر، هكذا ببساطة كما لو أننا سنذهب لزيارة ديزني لاند. في محطة طاكسيات هلامية وكارثية مليئة بالغبار والمجانين واللصوص، والواشمين وشخصيات أخرى ذات سحنات غامضة، ركبنا طاكسي عجيب، آنحشرنا فيه مع آخرين كالسردين في علبة. السائق كان يسوقه كما لو أنه في سيرك يلعب لعبة جدار الموت، بدا لي حينها كما لو أن الطاكسي كان يسير وحده بفعل قوة سرية غامضة. فرحنا حين وصلنا الضريح بالسلامة، هنا بمجرد ما تطأ هذه الأرض، تعرف بأنك قد صرت داخل بعد آخر، في مجرة أخرى، خطيرة، مربكة، شديدة الاختلاف. مجانين ومجنونات في كل مكان يدورن، يسيرون الهوينى كالملاعين أو الأرواح المعذبة في دوائر الجحيم الذي تخيله دانتي، بعضهم يجثو على ركبتيه أمام برك ماء موحلة ويشرب منها مباشرة بالرغم من أنها مليئة بالميكروبات، في مشاهد قيامية بدت لي كما لو أنها طالعة من كتاب «الجنون في العصر الوسيط» لميشيل فوكو، آنذاك كان الناس يعتقدون بأن الجنون مرض معد، وبالتالي يضعون المجانين في سفينة يسمونها، la nef des fous، ويتركونها عرضة البحر. بويا عمر ليس سفينة بل معزلا قروسطويا.. مكان جحيمي تراقبه السلطة من بعيد، إذ ليس ضروريا أن تحضر في أرض المجانين، علما أن للسلطة نفسها جنونها لكن من نوع آخر. الجنون هنا مدر للربح بالملايين، بدليل أن صندوق الضريح كان يخضع بيعه لنوع من المزايدة التجارية كما يقع في بورصة. في مقهى مهترئ طلبنا براد أتاي. المجانين يجوسون في الأمكنة كما في سيرك العجائب، سلاسل وأغلال في كل مكان تقيد الأيدي والأرجل بأقفال محكمة الإغلاق يؤدى عنها ثمن. كل الأكسسوارات المرتبطة بالجنون هنا بثمن. شابة تضع سلاسل في يديها ورجليها جلست بجوارنا، رفيقتي أصيبت بالرعب فأمسكت بذراعي، سألت الشابة من أين أتت فقالت من الرباط، وأضافت بأن السيارة التي أحضرها أهلها فيها كانت تحلق في السماء محاطة بدراجات نارية. آقترحت عليها أن تزيل السلاسل من رجليها. ذهبت بعيدا وشرعت تضرب القفل بحجر ضخم إلى أن آنكسر القيد ورمت بالسلاسل. لكن أحد سدنة الضريح رآها فهرع إليها، أمسكها من شعرها وشرع يضربها، جرها إلى الداخل وبعد خروجها كانت هناك سلسلة أخرى في قدميها. أخطر ما يقع هنا هو أن أهالي الأشخاص الذين يعتبرون مجانين يحضرونهم هنا، يتركونهم لمصيرهم الأسود ويكتفون بإرسال قدر مالي شهري متفق عليه لسدنة الضريح. اقترح الشخص الدخول للضريح لزيارة قبر الولي، وهنا عشنا تجربة مرعبة لا تنسى، طلب منا أحدهم الدخول حفاة الأقدام، كنت ألبس حذاء رياضيا جديدا من ماركة نايك، خفت أن يسرقه أحدهم فسلمت شخصا بدا مجنونا هو الآخر ورقة نقدية وطلبت منه حراسة أحذيتنا. المشاهد كانت مرعبة، جوق يعزف موسيقى هذيانية بالليرة أي الناي، آخرون يدقون الطبول والدفوف، أشخاص يتحيرون، يرقصون منخطفين كأنهم في عالم آخر. أحدهم كان يرقص ويضرب جسده بسكين، الدم يسيل من جسده الهش النحيل، لو شئت كتابة سيناريو مثل هذا لما نجحت. دخلنا المكان الذي يوجد وسطه القبر. إحداهن كانت تجلس، فوقه وتتحدث عن مشاكلها مع المحكمة والقضاة. آخرون كانوا يدورون حول القبر بسرعة هذيانية. طلب منا القيم على الضريح منحه المال، وضع سلاسل في أعناقنا، وهنا جمد الدم في عروقي، رفيقتي أمسكت بذراعي كما لو أنه خشبة خلاص، شرعت تدور وتبكي وتسالني: [هل سيطلقون سراحنا، هل سنعود إلى حياتنا السابقة]. أنا حينها لم أكن متيقنا من شيء، الرعب شل قدرتي على الكلام، استحضرت حينها لقطة بطل فيلم ميدنايت إكسبريس في سجن إسطنبول، حين رأى السجناء المجانين يدورون حول عمود، فدار عكس اتجاههم فقط ليؤكد لنفسه بأنه ما زال في كامل قواه العقلية. المجانين يدورون كما لو أنهم يشاركون في «الفرمولا وان»، رأى القيم على الضريح آلة تصوير فوتوغرافي في يدي، صعد فوق القبر وطلب أن أصوره، أخذت له العديد من الصور، لكنه نزل وطلب الحصول عليها توا، أقنعناه بعد بذل مجهود كبير بأنه يجب تحميض الفيلم في المختبر قبل طبع الصور. لا أدري هل اقتنع أم لا، لكنه تركنا لحالنا. غادرنا مكان القبر، الرقص والموسيقى الهذيانية مازالا يصدحان في البهو العاري وأحدهم يشرب الماء الساخن من فوهة إبريق. لبسنا أحذيتنا، انسللنا إلى الخارج. لم نعثر على طاكسي ركبنا عربة يجرها حصان لتذهب بنا إلى خميس العطاوية ومنها إلى قلعة السراغنة. بقيت كوابيس ضريح الجنون تزورني شهورا، فأصحو ليلا صارخا مغسولا بالعرق وهو ما حدث لرفيقتي أيضا، وبقيت أتساءل: «لماذا ذهبنا؟» …. «لماذا ذهبنا؟»، هذا هو السؤال الذي ظل يتصادى في أروقة ذهني. بعد عودتنا إلى بني ملال، أنا ورفيقتي أصبنا معا بنوع من الصدمة من هول ما رأيناه، ما شاهدناه كان غير مألوف، وحين كنا عائدين ممتطيين عربة تجرها فرس دونكيخوتية، ظلت امرأة مجنونة، غير بعيد عن الضريح تقذفنا بأحجار ضخمة، حتى أن إحداها كادت أن تشج رأس الحوذي. بقيت أستفيق ليلا مرعوبا وجبيني يتفصد عرقا، وأنا أتساءل، لماذا ذهبنا إلى هناك، إلى الربع الخالي، إلى أقصى الليل، لماذا قمنا بهذا voyage au bout de la nuit، بلغة الروائي العظيم Céline، لماذا ارتدنا أرض الجنون، عبرنا نهر الستيكس. بعض الأمكنة يجب أن تظل سادرة في صمتها، ما الذي يقع لي / لنا، ولا أعود للنوم إلا بعد مدة، أصحو أحيانا وأقضي الليل أدخن إلى الصباح. رفيقتي كانت تستيقظ ليلا صارخة، تنتابها الكوابيس، هكذا حكت لي، حتى خافت أن تصاب بالشيزوفرينيا أو بخلل عقلي ما، معروف بأن العصاب la névrose يقود إلى الذهان la psychose الذي لا رجعة منه. هناك تخيلت إبان الزيارة لضريح الجنون بأنني في زيارة لدوائر الجحيم التي تحدث عنها دانتي، حيث يجوس الملاعين في شساعة غيابهم، وحتى في أحلك السيناريوهات يظل واقع الضريح غريبا، لا يضاهيه مستشفى شارونتون للمجانين في القرن التاسع عشر بباريس: حيث قضى الماركيز دو ساد السنوات الأخيرة من حياته ونظم عروضا مسرحية، ولا مستشفى الأمراض العقلية في فيلم «طيران فوق عش الوقواق» لميلوس فورمان، ثم إن الجنون ظاهرة اجتماعية كما قال فوكو، ولا علاقة لها بالفكر الشاماني السحري. منظر أو مشهد قيامي لن أنساه أبدا، حين ولجنا مكانا كان يحبس فيه عتاة المجانين العنيفين، في غرف متربة تزورها العقارب والافاعي، حيث يبدو مثل سجن من القرون الوسطى تشد فيه سلاسل مثبتة في الجدران أجساد المحكومين، الشخص الذي رأيناه كان ذا بنية قوية ظل يحفر الأرض بمؤخرته إلى أن صار شبه معلق من معصميه وسط الحفرة التي حفرها. كان يصرخ، يزمجر، كأن روحا ما تتعذب داخل جسده المعنى، ثم الكوبل الشمالي القادم كما أخبرنا صاحب مقهى شعبي ونحن نشرب الشاي بأنه ينتمي لتطوان، عيونهما زرقاء وشعرهما أشقر مليء بالأوساخ والقاذورات. تساءلت حينها عن الاستمرار عند نهاية القرن العشرين وبداية ألفية قادمة، عن السر في استمرار ربط الجنون كظاهرة ببركة الأولياء، كأن الأضرحة مستشفيات للأمراض العقلية، تساءلت ومازلت عن الأدوار المتعددة المتناقضة التي تلعبها البركة La Baraka، في مجتمع معاق يسوده الفكر الأسطوري والشعوذة، تنتشر فيه سلوكات وعادات لا عقلانية سحرية مثل السلوكات الشامانية، ناهضة على التقمصات والتحولات، وعلى التفسير السحري الأسطوري للأحداث والوقائع، والأمراض. لكن التفسير الأقرب إلى المنطق هو أن ربط الشفاء من الاختلالات العقلية ببركة الأولياء وأضرحتهم يشير لغياب منظومة صحية استشفائية عقلانية كما يحدث في مستشفيات الأمراض النفسية في برشيد إبان فترة الدكتور زيوزيو، هذا الغياب الصارخ هو الذي حوّل الأضرحة إلى أماكن استقبال للمرضى وحوّل الأزقة والشوارع والساحات، إلى أماكن مليئة بالمجانين. غير بعيد عن بويا عمر هناك بويا رحال وسيدي شمهاروش، ومناطق قصوى أخرى بالغة النأي. بعد مرور ثلاثة أسابيع تجاوزنا أنا ورفيقتي صدمة الزيارة، (هذا لأن الزيارة كانت بمثابة صدمة بكل المقاييس)، وبدا كما لو أننا لم نكن قرب خميس العطاوية، على بعد كيلومترات منها،بل في قارة أخرى dans une autre dimension، في عوالم الزومبي والكائنات الغرائبية، في منطقة حيث يمكن مجاورة الخطر ومعاينته عن قرب، منطقة كل الحدوسات والافتراضات، منطقة جحيمية قد تكون طالعة من متخيل دانتي، كأننا كنا كما قال الشاعر والمفكر الإيطالي داخل una selva oscura. الزيارة العجائبية كانت بمثابة ترياق، أو أنها بالأحرى كانت الداء والترياق، أن تذهب، ترى، تعاين عن قرب، تسمع، تختزن مشاهد في الذاكرة، كل هذا كان مهما، شريطة أن تزورك الكوابيس لعدة ليال بعد عودتك وتصاب بالرعب، وتتخيل بأنك قد صرت مجنونا مختلا عقليا، كما حدث لرفيقتي التي ظلت مرعوبة وطلبت مني أن أراقب سلوكاتها وطريقة كلامها، وفي النهاية انفجرنا ضاحكين، تذكرنا ذلك بعد أسابيع ونحن جالسان في رصيف مقهى في قرطبة بالأندلس، بعد «الزيارة» لقصر الحمراء الذي شيده مجانين تاريخ آخرين، ألم يقل نيتشه العظيم بعدما استضافه ليل الجنون في إحدى رسائله: «كل اسماء التاريخ أنا»، استعدنا ذكرى تلك الزيارة التي لا ندري كيف نصفها وضحكنا، قلت لها بأن نيتشه الفيلسوف العظيم الذي قضى العشر سنين الأخيرة من حياته مصابا بالجنون بالفعل، قال عن الجنون بأنه مجرد حل ساخر. هناك بويا عمر الذي قمنا بزيارته، أي القبة الكائنة في مكان معين، محاطة بقبيلة زمران، وهناك بويا عمر التصور، le concept de Bouya Omar، أي كمفهوم وبالتأكيد أنه صار أكثر شيوعا من المكان ذاته، تماما كما وقع ذلك مع تصور برشيد أو مصلحة 36، التي تحولت إلى concept «الترانت سيس» وتطلق على أي شخص غريب الأطوار، بويا عمر سال، سال، تمدد، انتشر، تناسل، تفاقم، صار معمما لا على أمكنة أخرى بل على أجزاء كبيرة من مجتمعنا. منذ سنوات كنت في محطة أولاد زيان للسفر إلى بني ملال، وحين طال الانتظار وعبرت عن احتجاج هادئ جدا للمسؤول عن المكتب الذي اشتريت منه تذكرة السفر، هب الشخص واقفا وقال لي: «شوف بلا متهضر معايا أنا راني بويا عمر». ويكفي في مجتمعنا المليء بالأعطاب النفسية، الاجتماعية، العقلية، أن يصرح لك أحدهم بمثل ذلك لتبتعد عنه، لتطلب السلامة.. بويا عمر معناه أقصى درجات الجنون، الناس عموما ينعتون مجتمعهم بنفس الاسم، يقولون بأنهم يعيشون داخل بويا عمر، ومع تفاقم أعداد المجانين وانتشارهم في مختلف مدن ومناطق البلاد، لا أحد يدري هل بويا عمر هو الذي صار داخل المجتمع أم أن المجتمع هو الذي رحل وهاجر نحو بويا عمر، تم إغلاق الضريح، هذا ما شاع، لكن التصور أو المفهوم ظل مفتوحا بل تفاقم انفتاحه، هناك مدن وبلدات وأمكنة الآن يكفي أن تشيد حولها سورا عاليا، تضع بوابة حديدية ضخمة وتكتب فوقها ضريح بويا عمر، مع إضافة أرقام تسلسلية. المجانين يمخرون الأزقة والشوارع كأرواح معذبة، يصرخون برعب، يضربون بالحجر، يحملون العصي، وقطع الحديد.. المجتمع، في جانب كبير منه، تحول إلى ضريح للجنون، الأمراض العقلية طبعا ليست معدية، ولكنها تكون أحيانا كثيرة وراثية، كما في حالة زواج الأقاربle mariage consanguin، وتكون جماعية، كما في حالة الجماهير حين ترغب في الفاشية وتريد زعيما يمارس عليها القمع والاضطهاد، وترغب في العبودية كما لو أنها الحرية، وقد تكرر هذا مرارا عبر التاريخ وما زال يتكرر. بعض الأمكنة تكون منذورة لتصير تصورا، استعارة، كما حدث، لبويا عمر، الكلمة صارت تطلق حتى على بعض اجتماعات المجالس المنتخبة التي تعمها الفوضى ويختلط فيها الحابل بالنابل، وتتطاير فيها الكراسي والطاولات، ويقال الأطباق أيضا. الغريب أن الدراسات الأنثروبولوجية والإثنولوجية حول المعتقدات والعادات والسلوكات ومنظومة بويا عمر، كلها نادرة جدا، ومنذ سنوات قرأت كتابا من الكتب النادرة حول الظاهرة عنوانه le culte de Bouya Omar، تذكرت كلمة أخرى صارت بها الركبان وانتقلت من اسم مكان إلى مفهوم وتصور، وهي كلمة بوسبير في كازابلانكا، فقد دلت في البداية على اسم حي للدعارة أسسته الحماية الفرنسية، لكن الكلمة «بوسبير»، انتشرت وشاعت لتدل على أي سلوك للدعارة أو وضع اعتباري، أو امرأة تمارس ذلك، لأن الكلمات تطفح خارج مسمياتها، ولا تصير هناك علاقة بين الدال والمدلول، ولأن الكلمات هي التي تصنع الواقع أحيانا، تصنع الواقع الذي تحيل عليه، وخصوصا في زمن ما بعد – الحقيقة، زمن صناعة الأكاذيب والأخبار الزائفة وفبركة واقع مصطنع، زمن اندحر فيه الواقع لصالح السيمولاكر، زمن صرت فيه حقيبة يد من ماركة عالمية أهم بكثير مما أنتجته عقول الإنسانية من فكر وثقافة، وصارت فيه قدم لاعب كرة قدم أهم بكثير من عقل وفكر كارل ماركس.. في هذا الزمن يكون عاديا جدا أن يتعمم تصور concept، بويا عمر على سائر المجتمع.