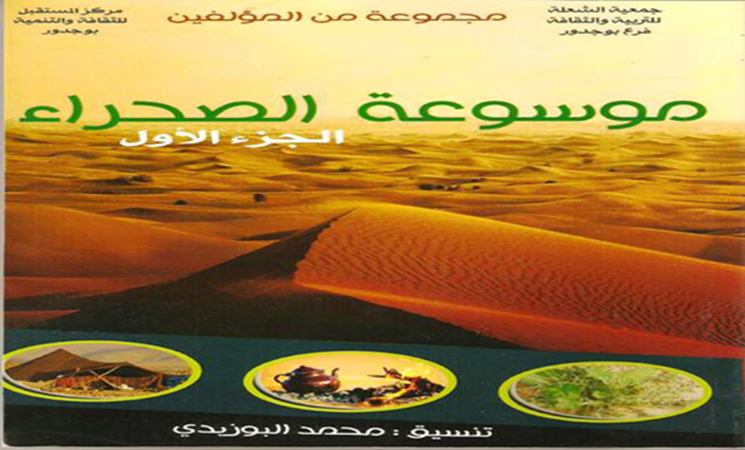يتحصل مما أسلفناه أنه بتثميننا لهذا التوجه إنما نؤشر إلى محاولات لتنشيط المخيال تعمل على زحزحة الحدث التاريخي بناء للحدث الأسطوري وإضفاء هالة من القداسة، تعززه بنية القصص الديني من حيث ما هي بنية أسطورية مفتوحة على العجيب والمدهش وأيضا محكومة بهاجس البحث عن العبرة رغبة منها في التأسيس لزمن مطلق. وهو ما يدفعنا شديدا للقيام بنقد تاريخي لتحديد أنواع الخلط والحذف والإضافة والمغالطات التاريخية التي أحدثتها الرواية القرآنية بالقياس إلى معطيات التاريخ الواقعي المحسوس [6].
هناك حدث قلّ أن لفت النّظر، ولكنه استرعى انتباهنا هنا. فالنص القرآني ههنا هو كل النصوص التفسيرية والإخبارية والأحداث التاريخية لذلك نرى “الصديق” يسعى بخطى وئيدة بين النص والتأويل يحاول استئناف الحوار مع سر هذا المحلوم به وقد رفرف.
وعلى طريقة “أركون” يشدّد “الصدّيق” على وجوب الانتباه إلى أنه يتم الخلط عادة بين الوحي بما هو كلام الله الأزلي المثبت في أم الكتاب أو اللوح المحفوظ وبين الوحي كتنزيل تجسد في لغة بشرية على الرغم من أن القرآن نفسه يلحّ على وجود كلام إلهي أزلي لانهائي محفوظ في أم الكتاب وعلى وجود وحي على الأرض بصفته الجزء المتجلي والمرئي والممكن التعبير عنه لغويا والممكن قراءته وهو جزء من كلام الله اللانهائي بصفته إحدى صفات لله على هذا النحو أشعت لحظات مضيئة، لحظات أولئك الذين حاولوا تحرير القرآن من هيمنة الدغمائية ومن له أن يجحد إسهام المعتزلة في فتح إشكاليات عميقة في مسألة المعنى وعلاقة اللغة بالمعنى ودور آلية التأويل في تكوين المعنى.
لقد بلغنا في هذا الطور من تقصينا، مرادنا في تحديد يذهب إلى أنه إذا كان النصّ، أي نص، يستدعي التأويل حكما ليقع به بيانه، أي فهمه وفهم الرسالة التي يحمل، فإن هذا التأويل إنما يكون أدعى إلى اللزوم حين يكون النص المراد قراءته هو النص الديني، ذلك أن الأخير تكتنفه كمية هائلة من اللغة المجازية، والمجاز تعريفا انتقال في الدلالة أو انتقال بها، وقد انتبه المعتزلة كما المتصوفة إلى أمره.
ها هنا لابد من الإشارة إلى أن “الصدّيق” ما فتئ يوضح أن القرآن تتخلله محاولات في مستواها يتدرب الإنسان على تحمل الانفراد في التعامل مع المجاز. وقد اندرجت “رحلة إبراهيم” فيه حين رفع رأسه إلى السماء بحثا عمّن سيتّخذه ربّا محاولا تمثّل الذات الإلهية تمثلا جديدا.
وكما سبق وأن أومأنا إلى ذلك، فليس للنص القرآني معنى واحد، وقراءته لم تكتمل، من جهة ما هو نص مبني على المجاز: فكيف لنا أن نمرّ مرّا أمام الانفلاق الجبّار، ما ينطق بإقامة الإلهي في قلوب البشر ويبدو أن أمرا حاسما أنجز الانعطاف، يوم ذاك كان محمّد يعتزل للتأمّل، فقد: أتانا من كل جانب خبر يحكي بداية الكلام وانبثاق الفجر شظايا، وزج بالبيان الإسلامي في تدفّقه الأول لحظتئذ تم انفتاح المكان الذي فيه الكتاب – كان بنفاذ بصيرة وألمعية يذهب “الصدّيق” إلى أن كل طغيان يتحول إلى حقيقة تنتصب ضد الحياة المستندة عندما نعلم أنه وبالرغم من محاولات المؤسسة الفقهية احتكار حقيقة اللحظة الفاصلة بين القول الإلهي المفارق والقول البشري المحايث، بل طمسها – والتي تودّ لو أنّ بينها وبينها أمدا بعيدا – تأبى القراءة النقدية إلا أن تقف عند انفتاحات للمعنى في منتهى الكثافة.
وهكذا فإنه علينا أن نستبصر وجه الحضور الكثيف الذي يصّرفه “الصدّيق” لهذا الدور التوسطي للتنوير والحداثة وما ولّدته الثورات العلمية المعاصرة من مناهج في علوم المجتمع والإنسان والتاريخ والأديان. وليس ببعيد أن يكون ذلك سرّ الأسئلة والاستفهامات حول الآخر والآخرين في القرآن، وهي المقولة التي بدت له الأدل على أن العالم أنبنى على الغيريّة .
لقد اهتدى “الصدّيق” إلى مسألة تبدو له وقد بلغت نقطة بالغة الخطورة مفادها أن نسيانا مزدوجا ،أتلف حقيقة وشائج القربى التي لها من التأثيرات ما ليس بالقليل ،تلك التي انعقدت طويلا بين العقل اليوناني وثقافة عرب ما قبل الإسلام. ولأن غرضه أن يتعقب تلك الأطوار يوضح أن العربية استطاعت أن تراكم مكتسباتها من لغات العالم الأولى التي نشأت واندثرت على مساحة اللّغات السّامية الشاسعة، إلا أن العرب غيبوا فيهم دور ثقافة اليونان، لحظة سارع من سارع إلى وقف استعمال هذه اللغة. وحقيق بنا أن نشير إلى أن ثاني ذينك الحدثين يتمثل في محاولة الغرب النسّاء أيضا إخفاء وطمس دور العرب في إثراء ثقافته. فهل يمكن إنكار التشابه بين ما ورد في النص القرآني وما أثبت في الثقافة الإنسانية السابقة، واليونانية بخاصة.
إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن تراثنا زمن النبي ّ مليء بالأمثلة الدالة على التسامح في العيش، وبالتالي فالتسامح هو الإلزام الوحيد لكل واحد منا إزاء الآخر، بشرط أن يتخلى عن نغمته المسيحية ولئلا يكون إحسانا ولكيلا يمتلك أحد امتياز وضع حدود التسامح وبالتالي يصير التسامح قمعيا، وهو ما اقتضت نشأته أرضية فكرية علاماتها تحوّل تاريخيّ من مبدأ اللذة إلى مبدأ الواقع، ما يؤشر إلى أكبر حدث صادم من جهة ما هو أمارة التحول من السرور إلى النجاعة من الارتواء المباشر إلى الارتواء المؤجل من اللذة إلى تقييد اللذة في حزمة من الخطابات القمعية الهائلة والمضمرة باقتصاديات الندرة ومبادئ عقلانية مبدأ المردودية.
وما يتبلور من خلال الأطروحة آنفة الذكر إنما محاولة بيان أنه لم يوجد قط نفوذ بيانيّ خالص دون نفوذ مؤسساتّي وأنّه ما من وجود اليوم لنفوذ مؤسساتي محض ، دون إسهام ودون مرتكز رمزيّ من طبيعة بيانيّة.
ولا يخفين على الأذهان أن “الغربيين” قد انتبهوا إلى أهمية الصياغة المنهجية للوعي الرافض لسيادة الفكر الديني مجسدا في المؤسسات الكنسية والاتساع المطرد لهيمنتها التي غدت في تماس عضوي مع المؤسسة السياسية وأنظمة الحكم كما حاولوا إيجاد تركيب أولي متصاعد نحو انجاز بناء نقيض للغيبية التي تتحكم بطرائق التفكير السائدة، وكان ذلك من بواعث الإصلاح الديني.
وإنّه لخليق بنا أن نشير إلى أنّ الأزمة التي نعيشها نحن أكثر تعقيدا لأنّ تأثيراتها خطيرة وحاسمة. فالنموذج المثاليّ للحظة الرسول والشيخين امّحى، و فقد الكثير من مصداقيّته. إنه ما من شأنه أن ينبئ بأنّ الأزمة أصبحت مزدوجة فنحن نعيش مرّة أخرى على نحو ما أزمة فقدان النموذج المثاليّ لمصداقيّته وهكذا يكون مناط بنا أن نحفر خطا سرديا يؤكد وشائج القربى مع الأحداث المؤسسة، وأمارة وأثر من الله وبالتالي تمّحي مساحة التغاير بين النفوذ المرتبط بالنموذج المثاليّ ولحظتنا الراهنة و تلتغى الفروق بينهما .
إلاّ أنه تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الذي يُنَصَّب نموذجا ينسى قصة تأسيسه، وهكذا فإنّ إعلان قداسة القرآن حدث قد حدث ، ولكنه أيضا بوابة لقطيعة بين النصوص المقدسة والدنيويّة . إنّ ما نريد إظهاره بصورة بارزة إنما يتعلّق بالتساؤل إن لم يكن انهيار مصداقيّة النصوص لم يترك شاغرا موقع ذلك النفوذ المتأتّي من المستبد السياسي. وهكذا انفرض علينا أن نركن إلى أنفسنا ومعضلات راهننا ولو قليلا – فهذا الإشكال / المشغل ، الذي نعمل عليه في أفق طروحات “الصدّيق” لتحديد دلالات واستتباعات التلاوة / القراءة ، لا يكون إلا إذا ملنا ميلا يسيرا إلى تلمّس المسالك التي سلكتها الوجهة العامة للخطاب السياسي في الإسلام والتي كانت تروم السمو بالخليفة إلى منزلة “سلطان لله في أرضه” وذلك في إطار الملابسات التي عرفتها صيرورة تطور وتحول السلطة في الإسلام وانتقالها من الخلافة إلى الملك العضوض وقد اتخذت “مماثلة الأمير بالإله”، عدة مسالك أبرزها: تسييس المتعالي والتعالي بالسياسي. وما كانوا يدركون أن الآلهة التي يعبدون ماتت منذ زمن بعيد وقد جاء النــور.
ويوضح “الصدّيق” بدرجة باهرة من الإيمان والجدية وفي جلال من اللغة والتركيب لا يستحيل فيها عليك مراد، أن النص “المقدس” يتعرض إلى حنين غائب عن نفسه ، مشتبه فيه، يؤكد قراءة إيمانية ، تحجب الممكن من القراءات، وهو ما يكاد يعصف بالطيف الدلالي الممتد، وضخامة الإتقان المجازي الذي اختص به لله والذي لا يبلغ منتهاه، وتدرب الإنسان المضني على تحمّل الانفراد في التعامل مع المجاز، إذ يقتضي سعة قصوى في التبصّر.