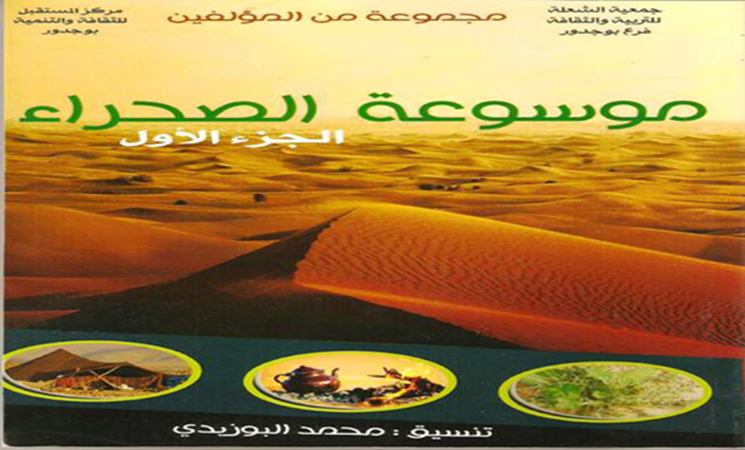يتحصل مما أسلفناه أنه بتثميننا لهذا التوجه إنما نؤشر إلى محاولات لتنشيط المخيال تعمل على زحزحة الحدث التاريخي بناء للحدث الأسطوري وإضفاء هالة من القداسة، تعززه بنية القصص الديني من حيث ما هي بنية أسطورية مفتوحة على العجيب والمدهش وأيضا محكومة بهاجس البحث عن العبرة رغبة منها في التأسيس لزمن مطلق. وهو ما يدفعنا شديدا للقيام بنقد تاريخي لتحديد أنواع الخلط والحذف والإضافة والمغالطات التاريخية التي أحدثتها الرواية القرآنية بالقياس إلى معطيات التاريخ الواقعي المحسوس [6].
هناك حدث قلّ أن لفت النّظر، ولكنه استرعى انتباهنا هنا. فالنص القرآني ههنا هو كل النصوص التفسيرية والإخبارية والأحداث التاريخية لذلك نرى “الصديق” يسعى بخطى وئيدة بين النص والتأويل يحاول استئناف الحوار مع سر هذا المحلوم به وقد رفرف.
وعلى طريقة “أركون” يشدّد “الصدّيق” على وجوب الانتباه إلى أنه يتم الخلط عادة بين الوحي بما هو كلام الله الأزلي المثبت في أم الكتاب أو اللوح المحفوظ وبين الوحي كتنزيل تجسد في لغة بشرية على الرغم من أن القرآن نفسه يلحّ على وجود كلام إلهي أزلي لانهائي محفوظ في أم الكتاب وعلى وجود وحي على الأرض بصفته الجزء المتجلي والمرئي والممكن التعبير عنه لغويا والممكن قراءته وهو جزء من كلام الله اللانهائي بصفته إحدى صفات لله على هذا النحو أشعت لحظات مضيئة، لحظات أولئك الذين حاولوا تحرير القرآن من هيمنة الدغمائية ومن له أن يجحد إسهام المعتزلة في فتح إشكاليات عميقة في مسألة المعنى وعلاقة اللغة بالمعنى ودور آلية التأويل في تكوين المعنى.
من اللافت للنظر أن لحظة تجلّي الوحي هي تجربة شخصية لا تعاد، فنحن لا نعرف الظّروف الحافّة بهذه اللحظة. فكان نزول الوحي عسيرا مرهقا،وكان محمد، لحظات تقبّل العقل الإلهي،مأخوذا بهول التجليات الربّانية، لا يسمع ما يقال له فـ “ما نزل علي الوحي مرّة واحدة ولم أشعر بأن نفسي نزعت مني”، “وكان غالبا ما يشعر، في أول الوحي بإلهام داخلي لا يعبّر عنه بكلام واضح، وإذا كفّ عنه الإلهام يتلو كلاما يتناسب بصورة واضحة في ذهنه مع ما كان قد ألهم به”.
وحين ننعم النظر نلاحظ أن الأوائل اختلفوا حول كيفية إنزال القرآن : فما هو هذا الذي نزل وحيا؟ هل هو اللفظ، والمعنى من عند الله؟ أو أن المعنى القرآني من لله، والتعبير من الرسول؟ أو أن جبريل أخذ المعنى وعبّر عنه بلغة العرب؟.
إن ما تقوله قصة الوحي، هو أن الرسالة المقدسة عتبة لسرّ غير مقروء، كما هي عتبة للجنون والموت، يدخل الجسد النبوي هذه التجربة بتحرره منها، مطببا “جنونه” بتلاوة الآيات الأولى الموحاة. ولأن تلك الومضات والإيماءات الإيمانية نادرة ندرة كادت تذهب بألقها باعتبارها في عداد مسائل رجع صداها بعيد، ذلك أن جبريل يقرئ الرسول والرسول يقرئ أصحابه وهؤلاء يقرئون غيرهم، نكاد نجزم أن النبي إنما كان وعاء الكلام الإلهي. فبين حشمة جبريل وحنان خديجة المطمئن[، أخذت الرسالة هيأتها، فقد اكتشفت خديجة بعض علامات النبوة على جسدها المسألة التي لن تخصها ولكنها تنساب هاربة من بين أصابعها. بيد أن هذا النحو من التفطن إلى الإمكان الأخص للإشكال لا يمنع “الصديق” المدقق في التفاصيل من تناول المسألة بروحية توحي بالكونية الإنسانية إلى درجة الإدهاش. فالإله لا يكتفي بالجهر بمبادئ روحانيّة ما ورائية لا تتقيّد بزمن بل هو يأخذ بعين الاعتبار هموم المسلمين الأوائل الآنية فيتدخّل مثلا في بعض الأحيان في مواضيع ظرفيّة بحتة. فالله يتعالى عن الزّمن، بينما كلامه يحلّ حتما في الزمنيّة، ولا يمكن أن نستنتج من أبدية الله أزليّة قوله.
وما يلاحظه “الصدّيق” هو أن بعض العلماء يقصر ويتوحّل في خضخاض من الأغلاط حين لا ينتبه فلا يرى التجاور بين عالمي الغيب والشهادة، فالله يحاور الناس في القرآن بواسطة النبيّ.
في هذا الموضع بالذات يتراءى لنا ضرورة مواجهة المفارقة فالقرّاء هم قارئو القرآن أو مرتلوه – قرّاء القرآن أي حفظته والمتخصصون في قراءته-، لأن القرآن يتلى بصوت مرتفع تلاوة جماعية غالبا،(والقرآن كلمة تعني التّلاوة أو النصّ المتلو، ففي المعجم الجديد “اقرأ” يعني القراءة ولكن في المعاجم القديمة معناه التّلاوة) وغالبا من الذاكرة أيضا، لحظة تخضع إلى رهيب ما ينعقد بالزّمان وبالأصل حول قديم مرعب، زمنذاك كانوا يفسرون النص جاعلين منه مركز اهتمامهم وانشغالاتهم.
ولو نحن تأملنا ما أسلف “الصديق” ذكره لألفيناه يظهر لنا أنه من شأن هذا التصور أن يمدنا بالمنعطف أو المنعرج، وما يثير الإعجاب حقا هو الالتفات في كل مرة بحنكة ودربة من عاشر النصوص طويلا إلى التنبيه على أن الصحابة، كانوا يشعرون أنهم يعيشون تجربة فريدة تجربة علاقة استثنائية مع الله نفسه، لله المتكلّم عبرهم مع العالم والإنسانية، فقد جعل أتباعه يتعلمونه وفي نهاية المطاف جعلهم يكتبونه.
في هذا المستوى بالذات يتبين أنه ليس من المبالغة في شيء إذا هو شدّد على أن كتابة الوحي ظاهرة مرتبطة باستقرار جهاز الدولة. والاهتمام بجمع كلام الله في كتاب والحفاظ على النص وصونه من عاديات الزمن ومن نواقص الذاكرة البشرية، من جهة ما هو ملجأ نلجأ إليه عند الاختلاف والمكابرة، إنما ظهر عند “أبي بكر” فقد جمع الأجزاء المتناثرة تلك التي وصلت “حفصة”..
ولأنه كاتب كوني النزوع تضرب جذور اهتماماته فيما صار اليوم شيئا منسيا يلح “الصديق” كثيرا على أن مشروع “عثمان” قد صادر سلطة أمناء الذاكرة الشفهية – أيّ القرّاء – وهم جماعة من المحترفين، ليسلّمها لكتبة يمتلكون القدر نفسه من الحرفيّة في “تفريغ” الذاكرة.
وهكذا فنحن نلمح في ثنايا هذا الطرح أن “الصديق” ارتأى أيضا ضرورة التأكيد وبقوة أن وضع النسخة العثمانية، وإن شئت فقل وضع مدونّة قرآنية، ظاهرة كبرى في تاريخ الإسلام، فإلى جانب مصحف “أبي بكر” الذي تحفظه “حفصة” كان يوجد عندئذ مصاحف – كان كل منهم يحمل نسخة من مصحفه الخاصّ به، فكلا من هؤلاء قام بكتابة ما سمعه وما حفظه بطريقته الخاصة انطلاقا من مشاعره المتميزة وطعم لهجة قومه – كان القصد توحيد النّص وتقديم نسخة عنه رسمية ونهائية، لكن هذا الأمر صادف مقاومات، ومن بين أخطر المطاعن ضد “عثمان” أنه أراد “محو الكتاب”. وإذا مددنا نظرنا صوب ما آل إليه الحال يتضح لنا أنه أغلقه نهائيا حين جعله واحدا فقد “كان القرآن كتبا فتركتها إلا واحدا”. فيظنّ ظانّ أنه إنما يوشك أن يحبس فكرة الوحي في مفهوم شديد الضيق، وهو مبلغ بالغ من الحيرة بين ما ألفوه، وبين ما راموا أن يصلوا إليه ألم يكن حدثا منبئا بتحويل وتبديل وتغيير؟
هكذا جعل “عثمان” القرآن غير ما كان، ورغم ذلك تبقى هذه الملافيظ أخف وطأة وأضعف تأثيرا من مفردة “التحريف” والتي من شأنها أن تحيل إلى القتل فـ”تحريف نص هو فعل يماثل القتل”