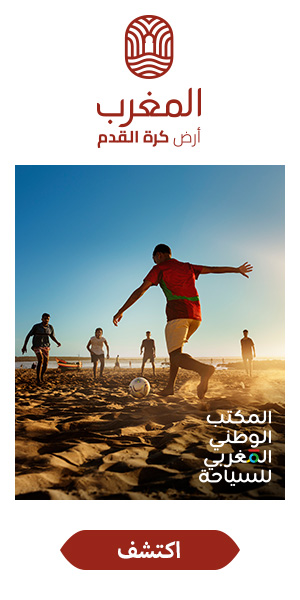مع تسارع الزمن وتغير أنماط الحياة أصبح تراثنا وعاداتنا كمغاربة والتي ورثناها أبا عن جد، خصوصا عاداتنا في شهر رمضان، والتي حافظنا عليها لأجيال، تنقرض شيئا فشيئا بل أصبح بعضها ملكا مشاعا تترامى عليه أعين المتلصصين ولصوص التاريخ، فهل مع هيمنة الهاتف والانترنيت على يومياتنا سننسى وستنسى الأجيال القادمة هذا التراث وستهديه لقمة سائغة لكل جائع فقير ؟هل ستمر سنوات ستنسى بعدها كيف نستعد لليالي رمضان الطويلة، كيف نجهز أكلاتنا الخاصة به وبكل منطقة من مناطق بلادنا التي تختلف في عادتها وأطباقها ولكنها تتلاقى في انتمائها وفخرها وتتوحد تحت سماء مغرب واحد متماسك. هل سنحافظ على تلك «اللمة» المميزة التي تؤثث مساءاته؟ أم أن الهاتف المحمول أخذ على عاتقه مهمة حملنا بعيدا إلى ركن قصي نوزع فيه «لايكاتنا»بسخاء على كل غريب بعيد، بينما نشيح النظر عن أقرب القلوب إلينا؟ وهل ستفقد أسواقنا روائحها في غمرة ما تعرفه سنواتنا العجاف من غلاء فاحش؟ هل سنفقد رائحة ماء الزهر، وعبير الجلجلان وعطر التوابل المطحونة التي تملأ الأجواء في أسواقنا وقيسارياتنا، لتنفذ دون استئذان إلى أنوفنا وتعيدنا لننغمس في ذكرياتنا الجميلة المرتبطة باستعدادات الأسر والأمهات التي تبدأ قبل أسابيع كثيرة من الشهر الفضيل؟
هنا في هذه الحلقات نحاول التذكير ببعض تقاليدنا وبعض أطباقنا وعادتنا التي لا يزال من بينها المحتفظ بمكانته لدى المغاربة فيما بدأ البعض الآخر في الاندثار والتواري والتعرض لمحاولات السرقة والسطو مع سبق للإصرار والترصد…
شهد المجتمع المغربي، عبر العصور، تطورات ثقافية واحتفالية أثثت يومياته وميزت احتفالات أبنائه بالمناسبات المختلفة خصوصا الدينية منها، ولحب المغاربة لطلبة العلم وحفظة القرآن، خصصوا لهم احتفالات لا تزال تقام إلى اليوم في بعض المدن والبوادي المغربية، وهي احتفالات وأعراس تنصب فيها الخيام (الوثاقات)، وتذبح الذبائح ويستدعى لها القريب والبعيد للاحتفاء ب”الطالب” الذي أتم حفظ القرآن وخرج “السلكة” في تقليد يسمى “عرس لقران”بتسكين اللام والقاف، يتم فيه تكريمه وتكريم الفقيه الذي أشرف عليه طوال مدة حفظه للقرآن الكريم، لكن يبقى احتفال “سلطان الطلبة” الذي توقف العمل به منذ خمسينيات القرن الماضي، أحد أبرز مظاهر التراث المغربي العريق الذي يمزج بين الجدية والفكاهة، معبرا عن جانب من ثقافتنا المغربية المتجذرة.
لقد كان للاحتفال بهذه “السلطنة” طابع خاص، يتضمن مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية، حيث يحيط بالسلطان طيلة أيامه مجموعة من التقاليد والعادات، بما في ذلك اللباس التقليدي والهيئة الحكومية التي يعينها بنفسه. من بين أبرز الشخصيات التي تشارك في هذا الاحتفال، نجد “المحتسب” الذي يتجول في الأسواق، مرتدياً زيّا فكاهيا بهدف التهريج وإثارة انتباه الناس وتسليتهم. ويختتم الاحتفال بعد أسبوع واحد، بعد أن يمتزج الجد بالهزل، في مشهد يعكس خفة الظل المغربية وحبها للفكاهة.
اليوم لم يعد لاحتفالات سلطان الطلبة من أثر في المدن المغربية العتيقة خصوصا بجامعة القرويين فقد كانت آخر مرة تم تنظيمه خلال خمسينيات القرن الماضي، ولكنها في ما مضى من الزمان كانت تشكل حدثا مهما في كل فصل ربيع ويحمل رغم طابعه الفكاهي والتمثيلي الكثير من الأهمية في أوساط طلبة العلم، وقد استأثرت هذه الاحتفالات باهتمام كتاب أجانب أفردوا لها صفحات لوصفها في كتبهم ومؤلفاتهم نذكر منه ما أوردته الكاتبة الفرنسية ماثيلد زييس في مؤلفها “المغرب كما رأيته ..فرنسية في مغرب 1908” والذي ترجمه إلى العربية الكاتب الصحفي سعيد عاهد.
تقول ماثيلد زييس الأديبة التي حلت بالمغرب وبالضبط في سنة 1907 بمدينة طنجة مبعوثة من طرف مجلة “تور دي موند” :” مرة في السنة، يقيم “الطلبة” احتفالا تقليديا مهما يبدو أنه يعود إلى عهد مولاي رشيد الثاني. ويتمثل هدف هذا الاحتفال في إحياء ذكرى الدعم الذي قدمه، في الماضي، طلبة تازة لهذا السلطان. وبالفعل، فإنه انتفض ضد أخيه مولاي محمد وحارب من أجل تأكيد حقوقه في العرش، وقد سعى، بمساندة القبائل الشرقية، إلى شق طريقه إلى فاس لدخولها. وفيما كان اليهودي بن مشعل(…) يحظى بنفوذ واسع في جبال جبالة، فإذا بأربعين “طالبا”، مختبئين داخل صناديق كان مفترضا أن تحوي هدايا، يستطيعون الوصول إليه وقتله. واعترافا بهذا العمل المتسم بالوفاء، أقر مولاي رشيد وخلفاؤه على العرش احتفالات “سلطان الطلبة””..، وتسترسل الكاتبة في وصف الاحتفال:” أياما قبل الموعد المضروب للاحتفال، تتوجه بعثة من المتعلمين عند السلطان، بعد تحديده موعدا لاستقبالها، وتلتمس من العاهل الإذن بانتخاب “سلطان الطلبة”، الطلب الذي يحظى دائما بالموافقة، مع منح مبلغ مالي كمساعدة على تغطية مصاريف الاحتفال وإثر هذا، يقوم “الطلبة” باختبار عاهلهم، أو بالأحرى يضعون هذا التشريف موضع مزاد لبيعه إلى من يدفع أكثر. وبمجرد تعيينه يشكل السلطان بلاطه وفق النموذج المعمول به في البلاط المغربي الفعلي. ولذا، فهو يختار حامل مظلته السلطانية، وحاجيه والخازن، والصدر الأعظم إلخ وعقبها، وبكل مظاهر الأبهة الواجبة، يطوف، برفقة موكب مهيب أزقة العاصمة، ويؤدي الصلاة في مسجد الأندلس، ثم يزور “قبة” حامي الطلبة”، سيدي على بن حرازم، ويقدم التجار هدايا للطلبة بالمناسبة، كما يقوم هؤلاء مقابل أسعار مناسبة، ببيع التين والليمون والتمر للأشخاص الراغبين في نيل بركتهم.
وأخيرا وليس آخرا يغادر سلطان الطلبة فاس، يرافقه أعضاء بلاطه جميعهم ورعيته، ومعهم جمهرة من سكان المدينة دافعهم الفضول أو الرغبة في التسلية، ويذهب ليستقر في موضع واقع في مكان منتقى على ضفة النهر. أما فترة حكمه فلا تدوم سوى أسبوع واحد، وطوال هذه المدة، يأتي الناس يوميا إلى المخيم للتعبير عن تقديرهم له. وفي عين المكان، تزوره، لتقديم خرجها له، مختلف هيئات الحرفيين من إسكافيين وتجار الثوب وعمال النحاس وغيرهم، وذلك الواحدة تلو الأخرى، كل واحدة خلال يوم بعينه محدد لها. ومن جهته، يبعث السلطان له “هدية” مخصصة له، وهي تشمل عادة 500 “مثقال”77 فضي وثلاثين “قالب” سكر، وشايا، وشموعا، وزبدة وسميدا، ويأتي لتسليم هذه الهيات السلطانية أحد أفراد عائلة العاهل مصحوبا بأعيان سامين. وفي اليوم الأخير من ولاية “سلطان الطلبة”، وهو اليوم الموالي لتسلم هدية السلطان، ينتقل الأخير بنفسه إلى المخيم. وإذا كان “سلطان الطلبة” يمتطي صهوة جواد ليخرج لاستقبال العاهل، فإنه يجوز له حينها استغلال الموقف لالتماس الحصول على امتياز ما، وهو ما جرت العادة بأن يستجيب له السلطان بدون تردد، مثلما ينال امتيازا آخر جد مهم يقضي بإعفائه من أداء الضرائب. وبالمقابل، ففي فجر اليوم الموالي، وصفحة هيبته السلطانية قد طويت، يكون “سلطان” “الطلبة مجبرا على الفرار بسرعة خارج المخيم مطلقا العنان لفرسه قصد الإفلات من خدع وألاعيب رعاياه السابقين وإثرها، يُحل البلاط وتنتهي الاحتفالات، لتعود الأمور إلى نصابها في انتظار فصل الربيع المقبل”.
أما بيير لوتي، الفرنسي الذي رافق بعثة ديبلوماسية للوزير الفرنسي “باتينوتر” فقد عبر في كتابه “AU MAROC ” الذي وصف فيه مغرب القرن التاسع عشر عن انبهاره بهذا المغرب واندهاشه به، اندهاش لا يخلو من انتقاد المستشرق الباحث عن أي ثغرة ليظهر تفوقه الأوروبي وتحضره، وفي وصفه لاحتفالات سلطان الطلبة يقول: “الخبر ينتشر بأن *سلطان الطلبة* قد فرّ منذ الليلة الماضية، لقد كان ملكا مؤقتا، خارج الأسوار قليلا، في مدينته المؤقتة المصنوعة من القماش الأبيض. أمام خيمته، كان لديه محاكاة لبطارية من المدافع الضخمة، مصنوعة من قطع الخشب والقصب.
في جامعة فاس، التي حُفظت على حالها منذ عصر الازدهار العربي، هناك تقليد قديم يقضي بأنه، كل عام، خلال عطلة الربيع، يقيم الطلاب احتفالا كبيرا يستمر عشرة أيام؛ حيث يختارون لأنفسهم ملكا (يشتري انتخابه في مزاد مقابل قطع ذهبية كثيرة) ثم يذهبون للتخييم معه في الحقول على ضفاف النهر(نهر فاس)، ثم يفرضون الإتاوات على سكان المدينة، ليتمكنوا كل مساء من الاحتفال بالموسيقى والغناء والكسكس وأكواب الشاي. ويتقبل الناس هذه التقاليد بوجه بشوش وخضوع طوعي، فيأتون جميعًا—الوزراء والتجار وأصحاب الحرف—في مواكب حسب مهنهم، حاملين راياتهم، لزيارة مخيم الطلبة وتقديم الهدايا. وأخيرا، في اليوم الثامن تقريبا، يأتي *السلطان الحقيقي* بنفسه ليؤدي التحية لسلطان الطلبة، الذي يستقبله بكل إجلال”.
ورغم سقوطه في بحر النسيان إلا أن هذا الاحتفال سيظل شاهدا حيا على عراقة تراثنا وهويتنا الثقافية، فهو يجسد بجدارة قيم التآخي والتلاحم بين المغاربة في ذلك الزمان، ومن المؤكد أن صونه هو تعزيز لذاكرة الأجداد ومظهر وثيق من مظاهر الارتباط بجذورنا، حتى يظل هذا الإرث حاضرا في وجدان الأجيال القادمة.